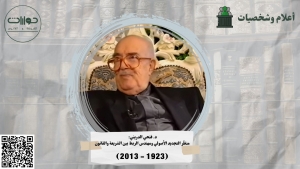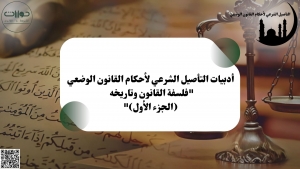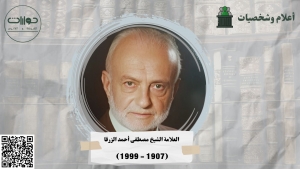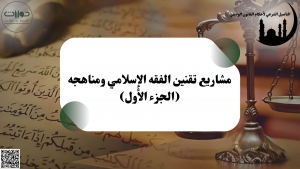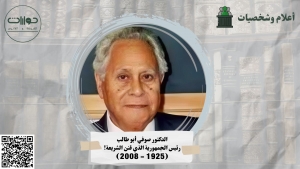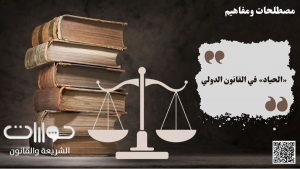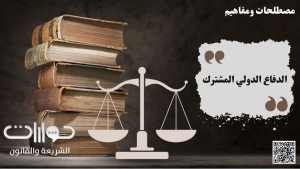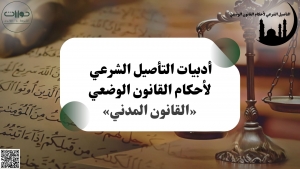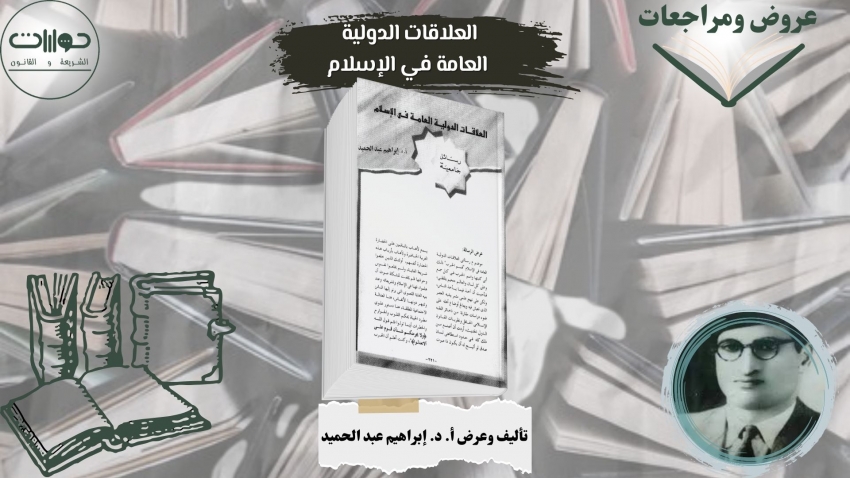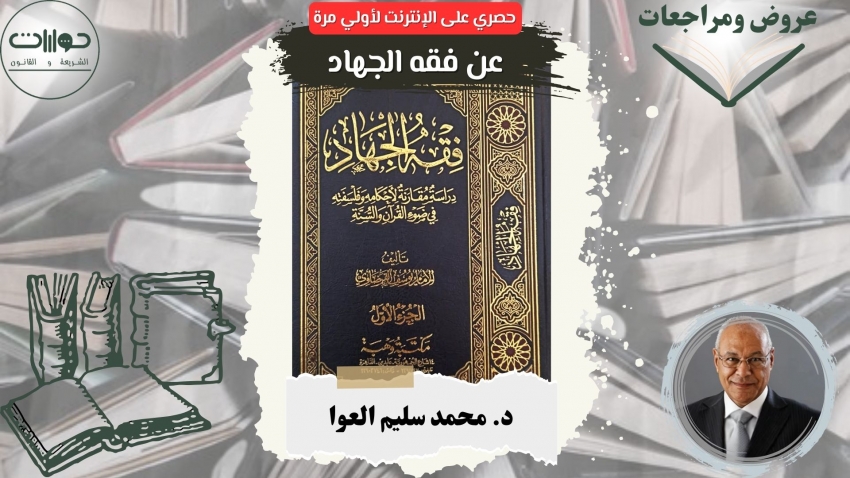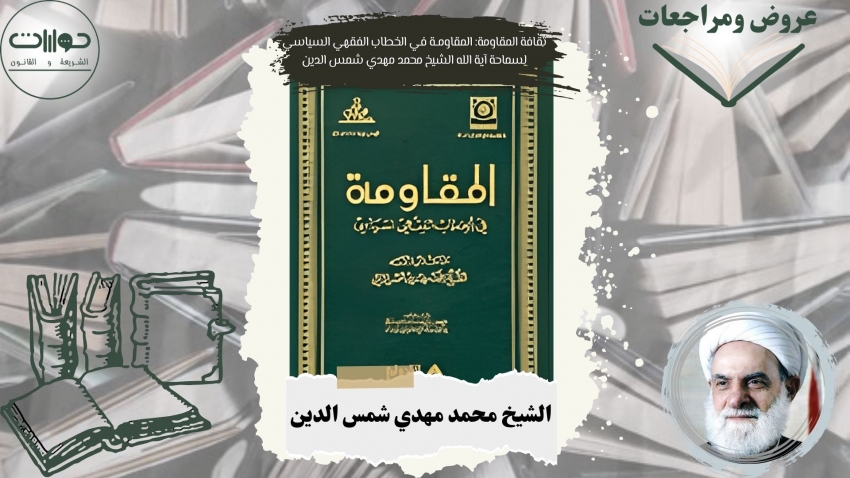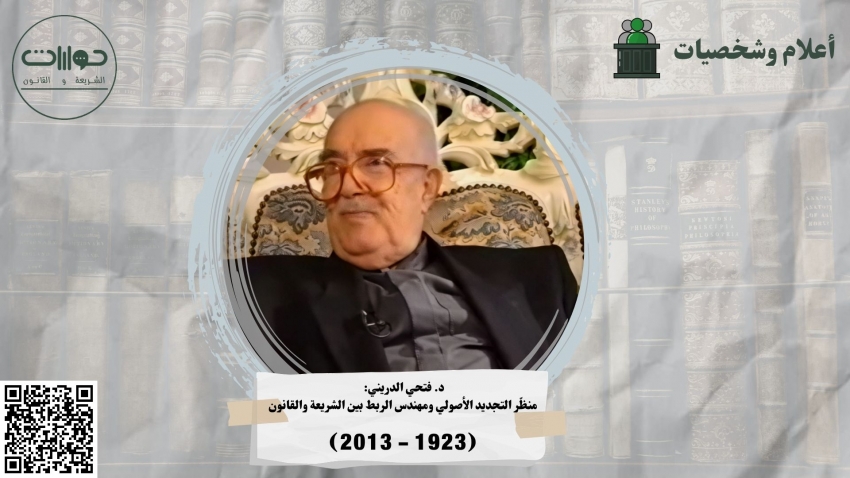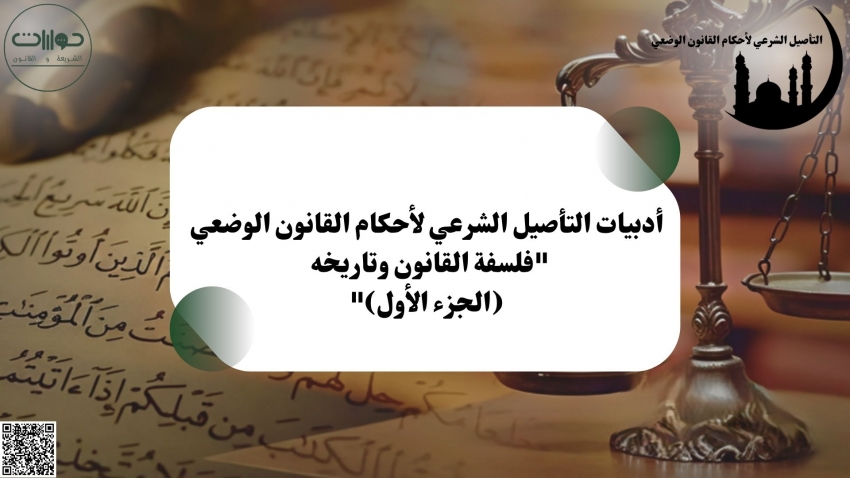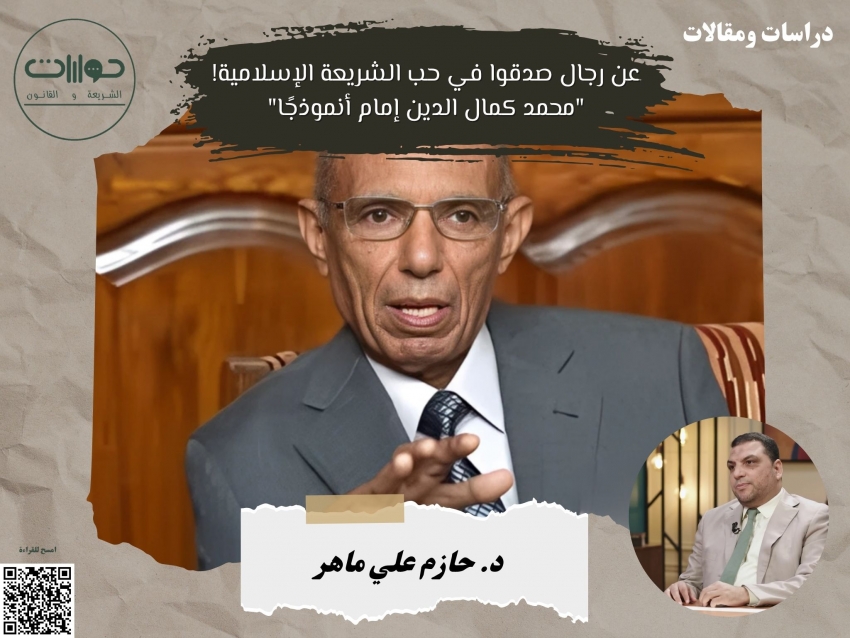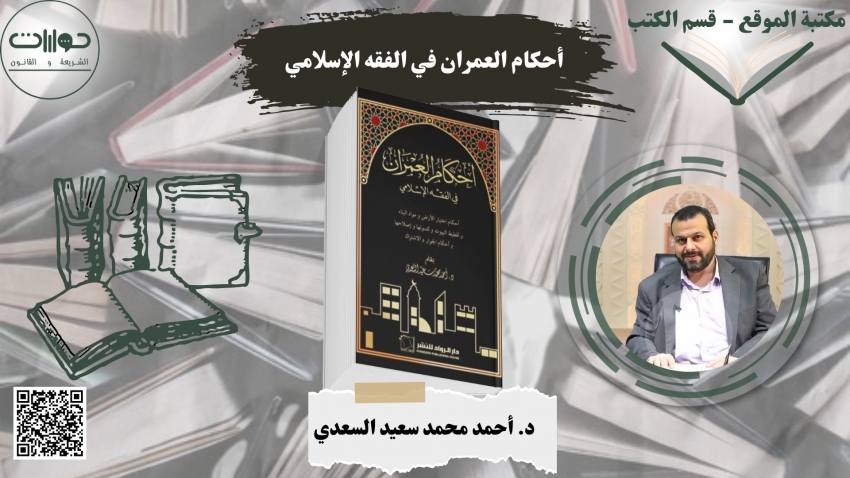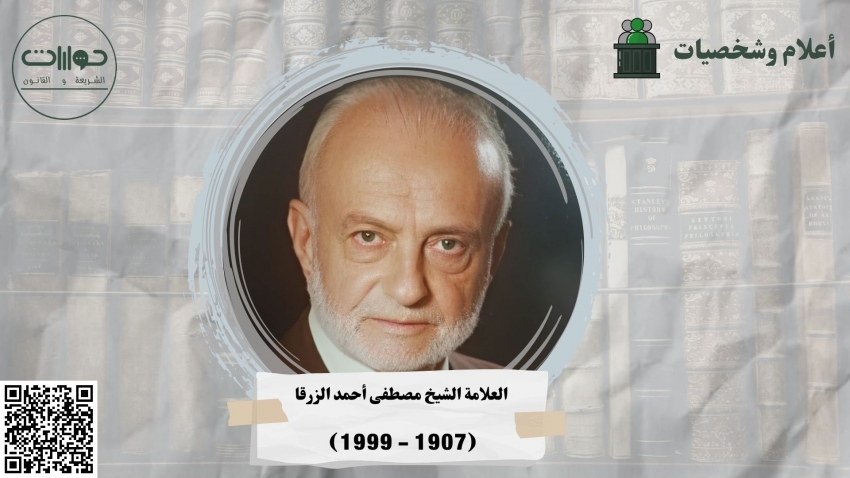أولاً: التعريف في القانون الدولي
هو: "نظام تعاقدي بين دولتين أو أكثر، يقوم على اتخاذ تدابير عسكرية وسياسية واقتصادية وأمنية لمواجهة أي عدوان على إحداها باعتباره عدوانًا على جميع الأطراف، في إطار مبدأ التضامن الجماعي".
وقد تجسد هذا المفهوم بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 51 الخاصة بالدفاع الشرعي الفردي والجماعي)، وكذلك في مواثيق المنظمات الإقليمية مثل: حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وجامعة الدول العربية عبر معاهدة الدفاع المشترك.
ثانيًا: أسس الدفاع الدولي المشترك
1- الشرعية الدولية:
يجب أن يتم الدفاع المشترك في إطار احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بحظر استخدام القوة إلا في حالات الدفاع الشرعي.
2- مبدأ التضامن الجماعي:
فالاعتداء على دولة عضو يعتبر اعتداءً على جميع الدول الأطراف، مما يستوجب ردًا جماعيًا منسقًا.
3- التوافق والالتزام التعاهدي:
يقوم الدفاع المشترك على معاهدات أو اتفاقيات رسمية، تُلزم الدول باحترامها وتنفيذها.
4- الأمن الجماعي:
يعتمد على فكرة أن استقرار وأمن كل دولة مرتبط بأمن المجموعة كلها، مما يعزز السلام الإقليمي والدولي.
5-التوزيع المتوازن للأعباء:
أي إنَّ الدول المشاركة تتقاسم التكاليف العسكرية والمالية والسياسية بشكل عادل وفق قدراتها
6-التكامل بين الوسائل:
الدفاع لا يكون عسكريًا فقط، بل يشمل التعاون في المجالات الأمنية، الاستخباراتية، الاقتصادية، والإعلامية لمواجهة الأخطار.
ثالثًا: أهداف الدفاع الدولي المشترك
- ضمان التأمين ضد أي عدوان.
- تقليل احتمالات الحرب من خلال الردع.
- التعاون العسكري والسياسي بين الدول.
- مواجهة الحروب، ولاسيما الحروب الجديدة، مثل: الإرهاب، الحرب السيبرانية، والصراعات الهجينة.
رابعًا: التحديات التي تواجه اتفاقيات الدفاع المشترك
- الاختلافات في اتخاذ القرارات.
- تباين المحفزات والدوافع والمصالح مع الدول غير المنضمة إلى الحلف.
- التباين في الطموح العسكري.
- المسائل المتعلقة بالاقتصاد أو الشؤون الداخلية أو الشؤون المالية بين الدول الأعضاء.
خامسًا: أبرز اتفاقيات الدفاع العربي المشترك
- معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي (1950):
-أُقرت في إطار جامعة الدول العربية في 18 يونيو 1950.
-تنص على أن أي اعتداء مسلح على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، وتلتزم الدول بالرد المشترك.
- تضمنت أيضًا إنشاء مجلس دفاع عربي مشترك للتنسيق العسكري.
- اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا (1955م):
- عُقدت لمواجهة النفوذ الغربي والإسرائيلي في المنطقة.
- نصت على التعاون العسكري وتبادل الدعم في حال تعرض أي طرف لعدوان.
- اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن (1957م):
- هدفت إلى مواجهة التهديدات الإسرائيلية بعد العدوان الثلاثي (1956م).
- تضمنت التزامات بالتنسيق العسكري وتبادل المساعدة الدفاعية.
- اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والعراق والأردن (1958م) – (ضمن إطار الاتحاد العربي بعد وحدة مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة):
-أكدت التعاون العسكري والسياسي لمواجهة التحديات الأمنية.
- اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي (1984م):
- عُرفت بإنشاء قوة "درع الجزيرة" كقوة دفاع مشترك.
- تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو يعتبر اعتداءً على بقية الدول الأعضاء.
- اتفاقية الدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وباكستان (2025م):
- تأتي في إطار "سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم".
- كما تهدف إلى "تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء".
- نصت الاتفاقية على أن "أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما"، كما نصت على التنسيق في مواجهة التهديدات المشتركة: خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتطرف، وأي تهديدات لأمن الخليج أو شبه القارة الهندية.
الدفاع المشترك في الفقه الإسلامي
أولا: تعريف اتفاقيات الدفاع المشترك في الفقه الإسلامي وسندها:
هي عهود أو مواثيق تُبرم بين المسلمين أنفسهم، أو بينهم وبين غيرهم من الدول والجماعات، غايتها التناصر والتعاون العسكري ضد أي اعتداء خارجي، وفق ضوابط الشرع. وهي ترتكز على نصوص أصيلة منها:
- قوله تعالى:{وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [سورة الأنفال: جزء من الآية رقم 72].
2- قوله ﷺ: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" (رواه البخاري ومسلم).
3- إجماع الفقهاء، فإذا اعتُدي على بلد من بلاد المسلمين وجب على بقية المسلمين نصرته (فرض كفاية يتحول إلى فرض عين عند الحاجة).
4-كما تندرج تحت مبادئ فقهية عميقة كمبدأ التكافل الدفاعي الذي يجمع الأمة الإسلامية في مواجهة العدوان.
5- وثيقة المدينة المنورة التي نصّت على أن "المؤمنين يد على من سواهم".
ثانيًا: صور اتفاقيات الدفاع المشترك في الإسلام
1-اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول الإسلامية:
وهو الأصل في هذه الاتفاقيات، وأصل العلاقة بين المسلمين حتى بدون اتفاق.
2-اتفاقات الدفاع المشترك مع غير المسلمين:
والأصل فيها التأقيت، والاحتكام للمصلحة؛ فهي جائزة مثلا إذا كان الهدف دفع العدوان المشترك، ولها أمثلة منها:
معاهدة النبي ﷺ مع خزاعة ضد قريش، وكذلك صلح الحديبية وما تلاه.
ثالثًا: الضوابط العامة لاتفاقيات الدفاع المشترك في الإسلام:
- أن يكون الهدف رد العدوان المشروع لا العدوان والظلم.
- ألا يترتب عليها تنازل عن ثوابت الدين أو استقلال المسلمين.
- أن تكون القيادة للمسلمين أو في إطار يضمن عدم ذوبان الهوية.
- الالتزام بالعهود والمواثيق لقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} (سورة الإسراء، جزء من الآية رقم 34).
مقارنة بين مفهوم الدفاع المشترك في الفقه والقانون
1- الدفاع المشترك واجب شرعي في الإسلام على الأمة، يتجاوز حدود الدولة القُطرية، ولا يحتاج حسب أصول الإسلام إلى اتفاقيات، وإن كانت جائزة، وغير ممنوعة، بخلاف القانون الدولي، فالأصل أن كل دولة تدافع عن نفسها، ولا يحدث التناصر إلا باتفاق مشروط.
2-وضع الفقه الإسلام مجموعة من القواعد التي تضمن أن يكون الدفاع المشترك موجها في الاتجاه الصحيح، كرد العدوان ونصرة المظلوم، أما القانون الدولي، فقد يتخذ قرارات بناء على مصالح اقتصادية أو سياسية لا تراعي البعد الإنساني، ولا تحترم العدالة .
3-طبيعة الالتزام في الفقه الإسلامي هو التزام ديني وأخلاقي، أما القانون الدولي فهو التزام قانوني وسياسي قابل للتفاوض.
المراجع:
- آلية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء التحديات الراهنة، محمد حسن أحمد جاد. مجلة مصر المعاصرة، المجلد 110، العدد 533 - الرقم التسلسلي 4، أكتوبر 2019م.
- التجربة والخطأ في استراتيجية الدفاع العربي المشترك، جميل الجبوري. مجلة "شؤون عربية" التابعة لجامعة الدول العربية. العدد 21، نوفمبر 1982م.
- تاريخ الوحدة العربية بين زمنين، د أحمد يوسف أحمد، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، فبراير، 2018م.
- نحو استراتيجية سياسية واقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه العراق في مرحلة ما بعد الحرب د. عبد العزيز بن صقر مركز خليج للأبحاث، 1 يناير، 2004م.
- دور حلف شمال الاطلسي بعد الحرب الباردة، نزار الحيالي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2003م.
- الأمن الجماعي في جامعة الدول العربية، أحمد علي سالم، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016م.
- آثار الحرب في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق. 1998م.
- أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، 1982م.
- في النظام السياسي للدولة الإسلامية، محمد سليم العوا، دار الشروق، 2006م.
- العلاقات الدولية في الإسلام، محمد حميد الله، ترجمة: محمد أحمد سراج، مركز نهوض، بيروت- لبنان، 2022م.