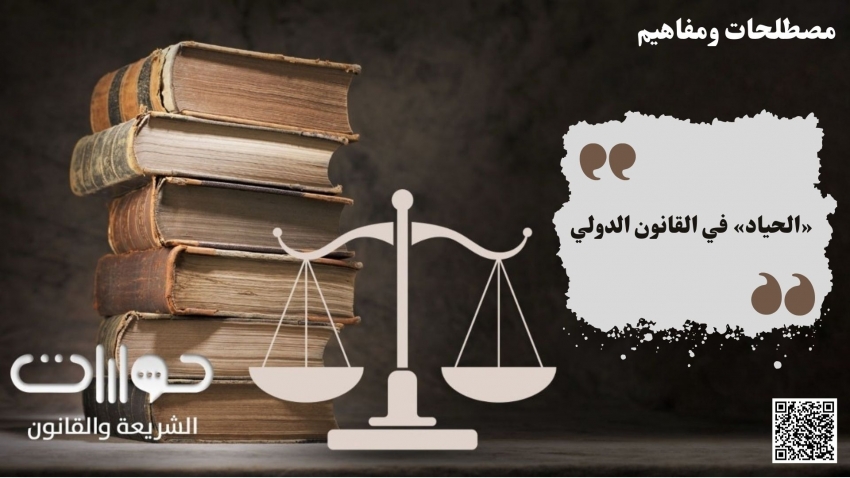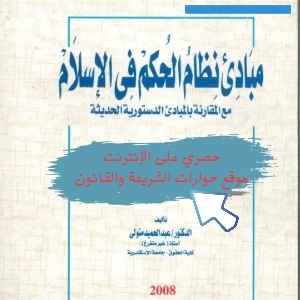أولًا: تعريف الحياد
يُعرف الحياد بأنه: الوضع القانوني لدولة تختار عدم المشاركة في نزاع مسلح قائم بين دول أخرى، مع التزامها بالامتناع عن تقديم أي دعم عسكري أو سياسي أو اقتصادي لأطراف النزاع، وبواجبات محددة نصت عليها اتفاقيات لاهاي لعام 1907، أهمها: عدم السماح باستخدام أراضيها أو مواردها في العمليات الحربية مع احتفاظها -في المقابل- بالحقوق المقررة لها، مثل حرمة إقليمها وعدم التعرض لمصالحها.
ويُعد الحياد موقفًا قانونيًا وسياسيًا في آن واحد، يُفترض أن الدولة تلتزم بقواعد صارمة لضمان عدم انحيازها لأي طرف.
ثانيًا: أسس الحياد في القانون الدولي
تستند قواعد الحياد إلى مجموعة من الأسس القانونية، وأهمها:
يُعد العرف الدولي المصدر التاريخي الأساسي لقواعد الحياد، حيث تطورت ممارسات الدول المحايدة خلال الحروب الأوروبية، وقد تم تدوين الكثير من هذه الأعراف لاحقًا في معاهدات.
- اتفاقيات لاهاي لعام 1907م:
حيث تضمنت الإطار القانوني الرسمي الرئيسي المنظم للحياد في القانون الدولي الحديث.
للدولة الحق في اختيار موقفها من النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتخاذ موقف الحياد، طالما لم تكن طرفًا في معاهدات تحالف أو دفاع مشترك تُلزمها بالمشاركة.
ثالثًا: واجبات الدولة المحايدة
- منع أطراف النزاع من استخدام أراضيها لأغراض عسكرية.
- منع تجنيد المقاتلين أو إرسال الأسلحة من أراضيها.
- احتجاز القوات المسلحة لأطراف النزاع التي تلجأ لأراضيها.
- احترام الحظر البحري المشروع الذي يفرضه أحد أطراف النزاع.
- عدم السماح بمرور قوافل عسكرية أو أسلحة عبر أراضيها.
رابعًا: حقوق الدولة المحايدة
- حقها في حماية أراضيها ومصالحها من أي اعتداء من أطراف النزاع.
- حقها في التجارة مع أطراف النزاع، شريطة ألا تكون البضائع من الممنوعات الحربية.
- حقها في الاحتجاج على أي انتهاك لحيادها.
خامسا: أنواع الحياد
- الحياد الدائم: وهو حياد مُعلن ومُعترف به دوليًا، ويُلزم الدولة بعدم الدخول في أي تحالفات عسكرية.
- الحياد المؤقت: تتخذه الدولة في نزاع معين دون أن يكون موقفًا دائمًا، مثل حياد بعض الدول في الحرب العالمية الثانية أو في النزاعات الإقليمية.
ومن زاوية أخرى قد يكون الحياد اختياريًا أو إلزاميًا بأن يُفرض عليها بموجب معاهدات أو قرارات دولية.
الحياد في الفقه الإسلامي
الحياد من القضايا التي لم تفرد لها الأدبيات الفقهية مؤلفًا أو بابًا، مما دفع رجال الإحياء التشريعي للم شتاتها من الفروع الفقهية، والتصرفات النبوية، مع تتبع سير الدولة الإسلامية؛ ليقيموا نظرية مكتملة الأركان لهذا المفهوم.
أولًا: مفهوم الحياد في الفقه
مصطلح الحياد: عرَّفه العرب قديمًا بمعنى "الاعتزال"، وهو يعني: عدم الانضمام لأي من الدول المتنازعة[1].
ثانيًا: المستند الشرعي للحياد
رغم أن مصطلح "الحياد" لم يرد في النصوص الشرعية بصيغته القانونية الحديثة، إلا أن الفقه الإسلامي أرسى قواعد شرعية وأحكامًا عملية تُجيز الامتناع عن القتال، أو عقد الهُدَن ومن هذه المستندات:
- آيات القرآن الكريم: مثل قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء:90). فهذا النص صريح وواضح في أن من يريد الحياد يناله، وهو يتوافق مع المبادئ العامة في الفقه التي تدعو للسلم، ومراعاة المصالح.
- السنة النبوية: فواقعة صلح الحديبية النموذج العملي للهدنة بدل القتال، فالنبي ﷺ اختار تعليق القتال وعقد الصلح رغم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مستعدين للقتال، وهذا يُعد تطبيقًا عمليًا لما يشبه الحياد الاستراتيجي، مستندًا إلى المصلحة العليا.
- قواعد الفقه الكلية، ومنها:
- قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، فإذا كان القتال يؤدي إلى مفاسد أعظم (كإراقة دماء المسلمين، أو تمكين الظالم)، فإن الامتناع عنه -أي الحياد- يكون واجبًا.
- قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، فلا يجوز أن يُسبب انحياز المسلم لطرف في نزاع ضررًاعلى نفسه أو على غيره، ففي هذه الحالة يكون الحياد موقفًا شرعيًا.
- قاعدة "المصلحة المرسلة" فيجوز للمسلمين عقد الهُدَن، أو التحالفات، أو الامتناع عن القتال إذا كان فيه مصلحة راجحة، حتى لو لم يرد فيه نص خاص ما دام لا يخالف نصًا أو إجماعًا.
ثالثًا: صور الحياد، وأحكامه في الفقه
يختلف حكم الحياد في الفقه الإسلامي حسب الحالة التي يندرج تحتها وفقًا للتوضيح التالي:
أولًا: إذا كانت هناك معركة بين المسلمين وغيرهم، ورفض قوم (أو دولة) المشاركة بين الطرفين، فهنا يجب أن يوافق المسلمون على حياد تلك الدولة. بنص القرآن: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء:90).
ثانيًا: أن يكون النزاع بين طافئتين من المؤمنين، ففي هذه الحالة لا يجوز الحياد، بل يجب الإسراع للمصالحة، وجمع الشمل، فإن بغت إحداهما على الأخرى يجب الانضمام إلى الدولة المعتدَى عليهم حتى تتراجع الدولة الباغية وتستجيب للصلح العادل.
ثالثا: أن يكون النزاع بين دولة إسلامية، وغير إسلامية، وهنا لا يجوز الحياد، بل يجب الانضمام للدولة المسلمة نصرة، وتأييدًا.
رابعًا: أن يكون الحياد بين دولتين غير مسلمتين، وهنا يوجد تفصيل:
- أن تكون إحدى الدولتين ليست علاقتها مع المسلمين علاقة سلم، ولكن سكنت الحرب، فهنا يجب الموادعة، إلا إذا تبين أنها تأخذ هدنة لاستكمال حربها ضدنا.
- أن يكون بين المسلمين وإحدى المتنازعتين معاهدة نصرة في الحرب، فهنا يُعد الحياد خيانة، ويجب نصرتهم.
- ألا تكون هناك معاهدة أو حرب مع إحدى الدولتين المتنازعتين، فهنا يجب الحياد.
ويشير أبو زهرة إلى أنه يجب عدم الحياد في هذه الحالة الأخيرة إذا تبين ظلم إحداهما؛ لأن الإسلام جاء لنصرة المظلوم، لكنه خفف من صرامة هذا الحكم حين أوكل حكم هذه الحالة لرؤية الدولة بما يرعى مصالح المسلمين دينًا ودنيا.
مقارنة بين نظرية الحياد في القانون الدولي والفقه الإسلامي
تتشابه نظرية الحياد في الفقه الإسلامي والقانون الدولي في بعض الجوانب، ويختلفان في نقاط جوهرية، فمفهوم الحياد يكاد يكون واحدًا في الفكرين، لكن آليات التطبيق ودوافعه قد تكون متباينة، ويتضح ذلك بصورة جلية في النقاط الآتية:
- يُبنى الحياد في القانون الدولي على مبدأ السيادة الوطنية، وعدم التدخل كحق للدولة، لكنه يُبنى في الفقه الإسلامي على المصلحة الشرعية، وتحقيق العدل، ودرء الفتنة، ومقاومة البغي، كواجب ديني وأخلاقي، فالحياد في الإسلام ليس موقفًا سلبيًا من الصراع، بل هو موقف إيجابي مشروط بالحكمة والمصلحة وعدم الإضرار.
- يستند الحياد في القانون الدولي إلى مصادر قانونية وضعية، أهمها: الاتفاقيات الدولية، والعرف الدولي، ومبدأ السيادة، ويُنظر إليه كحق من حقوق الدولة المستقلة في اختيار موقفها من النزاعات. ولا يهتم بالقيم الخُلقية حتى لو كان أحد أطراف النزاع ظالمًا ؛ لأن القانون الدولي لا يتدخل في تقدير "العدل" أو "الظلم" في الحرب، بل ينظم العلاقات بين الدول المتحاربة والمحايدة.
أما في الفقه الإسلامي، فالمرجعية هي الوحي -القرآن والسنة- ثم الاجتهاد الفقهي القائم على مقاصد الشريعة. فلا يُقبل موقف الحياد، أو الامتناع عن القتال إذا كان يؤدي إلى نصرة الباطل، أو إضعاف الحق، أو إراقة دماء المسلمين.
- في القانون الدولي، يُشترط لإعلان الحياد أن تعلن الدولة موقفها صراحة أو يُعترف به ضمنًا، وأن تلتزم بعدم التحيز، ومنع استخدام أراضيها، وعدم توريد الأسلحة، ومعاملة الأطراف بالمساواة. وإذا خرقت هذه الالتزامات تفقد صفة الحياد، وتتعرض للمساءلة الدولية.
أما في الفقه الإسلامي، فالضوابط أعمق وأعقد. فمثلًا: يجوز عقد الهدنة مع العدو الكافر إذا كان فيها مصلحة للمسلمين، كما في صلح الحديبية، حتى لو كان العدو ظالمًا. ويجوز إعطاء الأمان لفرد أو وفد من العدو، ويحرم خيانته. ويحرم نصرة الباغي أو الظالم، بل يجب على المسلم أن يعتزل الفتنة إن لم يستطع إنصاف المظلوم. ولا يجوز الحياد إذا كان يؤدي إلى إقرار الظلم أو إضعاف شريعة الله.
وهكذا، فإن الحياد في الإسلام مشروط بـنية صالحة ومصلحة راجحة، وعدم الإضرار بالدين.
المراجع
- أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، إسماعيل كاظم العيساوي، مكتبة الرشد، الرياض، 2016م.
- أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، حامد سلطان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968م.
- أساليب فض تنازع القوانين ذي الطابع الدولي في الإسلام، عنايت عبد الحميد، دار النهضة، 2017م.
- انفصال جزء من إقليم الدولة: دراسة فى إطار القانون الدولي والفقه الإسلامي، عبد الرحمن محمد حمود الوجيه، طبعة جامعة القاهرة، 2003م.
- التحفظ على المعاهدات الدولية، في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، عبد الغني محمود، دار الاتحاد العربي، بدون سنة نشر.
- حالات عدم الوفاء المشروع بالتعهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، يحيى محمد علي عبد الله، جامعة القاهرة، بدون سنة نشر.
- حماية المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب، جمعة شحود شباط، ط جامعة القاهرة،2003م.
- العلاقات الدولية في الإسلام ، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، 2017م.
- العلاقات الدولية في الإسلام، محمد حميد الله، ترجمة، محمد أحمد سراج، دار نهوض، الكويت، 2022م.
- العلاقات الدولية في الإسلام، إبراهيم عبد الحميد، ضمن الأعمال الكاملة لطبعة دار الإفتاء، إشراف محمد كمال إمام، وشوقي علام، 2017م.
- العلاقات الدولية في السنة النبوية، أحمد أبو الوفا، دار النهضة، 2009م .
- قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني، نعمان عطا الله الهيتي، دار رسلان، 2008م.
- القانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنة بالشريعة عبد الغني محمود، دار النهضة.
- القانون الدولي العام دراسة تأصيلية، محمـد سعـادي، منشأة المعارف، 2020م.
- قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، عبد الواحد محمد الفار، دار النهضة.
- قواعد السلوك الدبلوماسي في الإسلام، عبد القادر سلامة، دار النهضة العربية، 1999م.
- المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، أحمد ابو الوفا، دار النهضة، 2007م.
- المنظمات الدولية، في القانون والفكر الإسلامي، صلاح عبد البديع شلبي، دار النهضة العربية، 2010م.