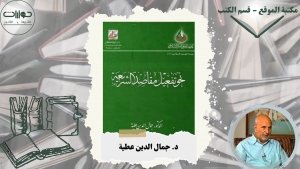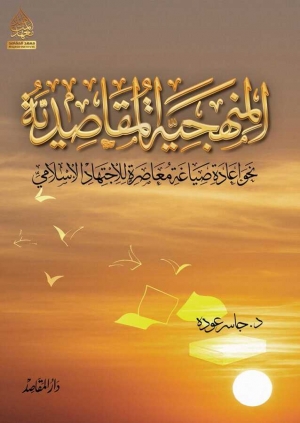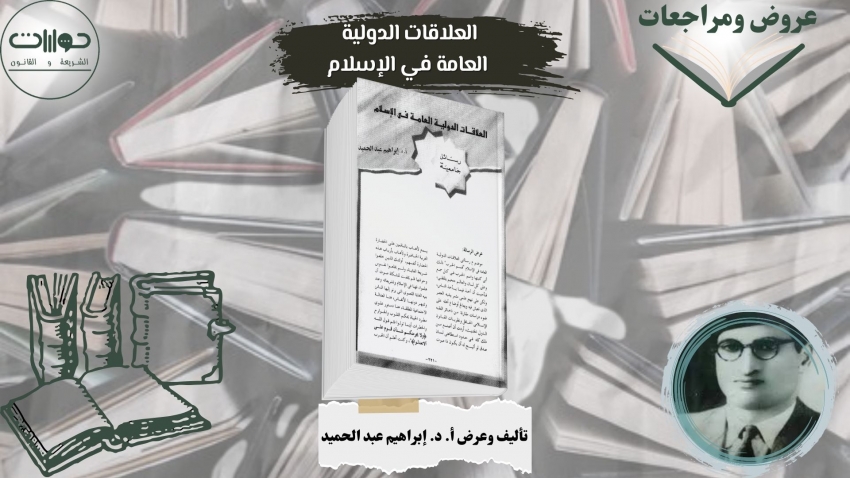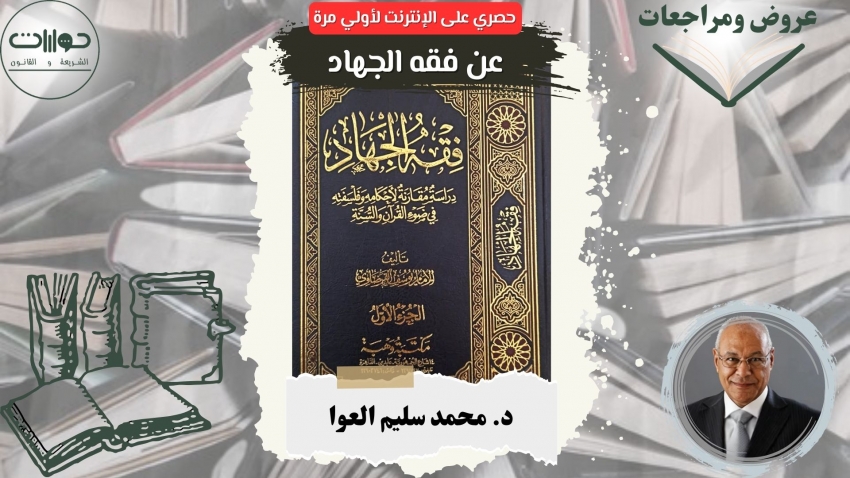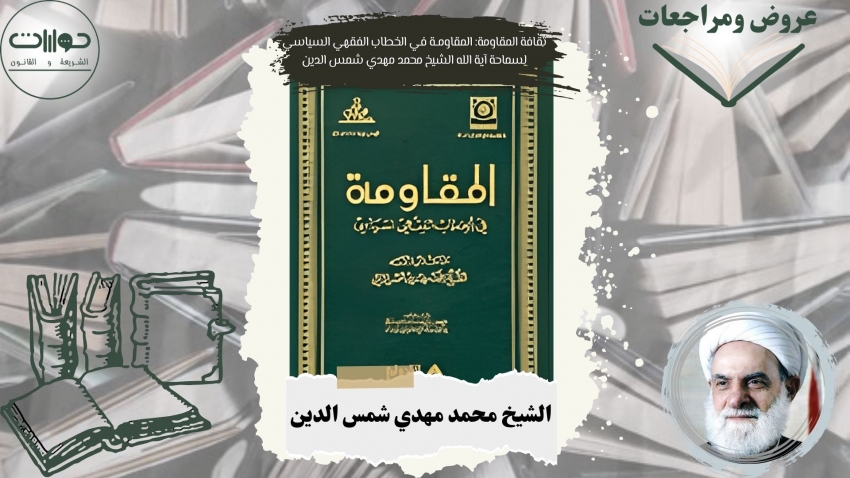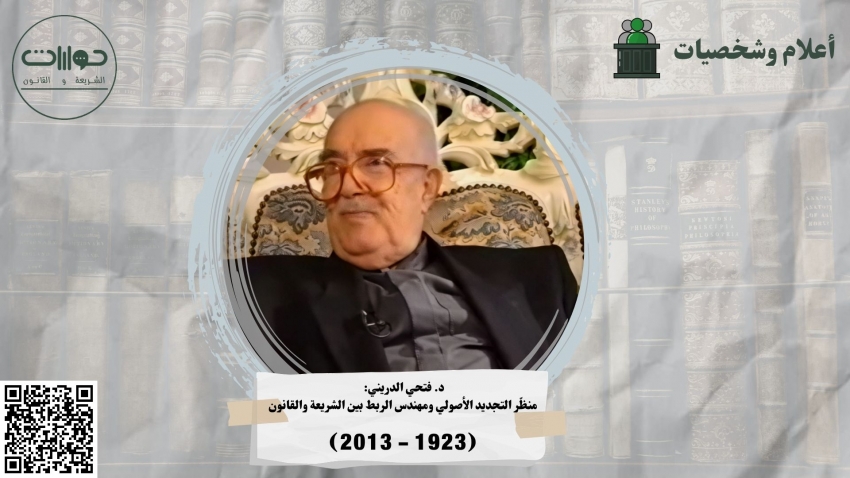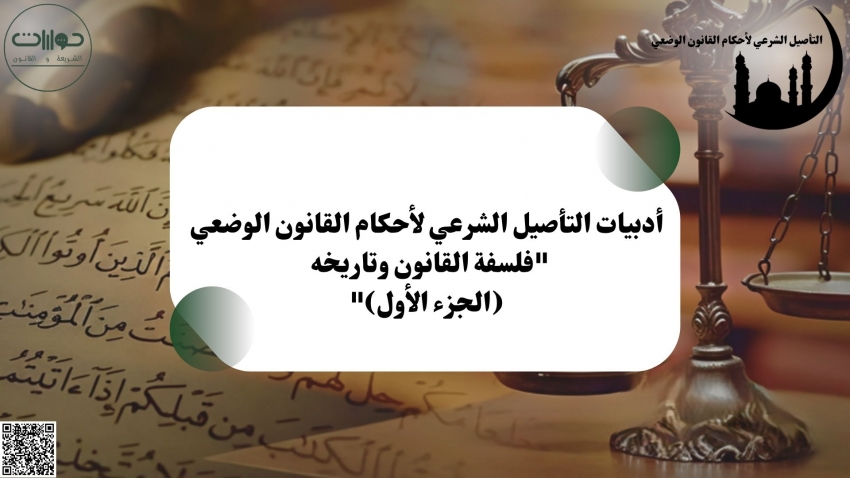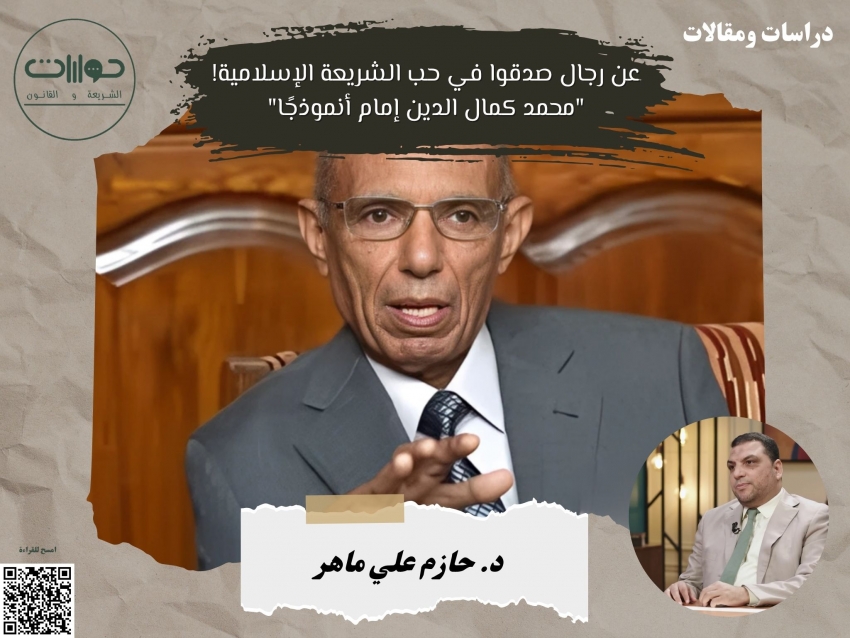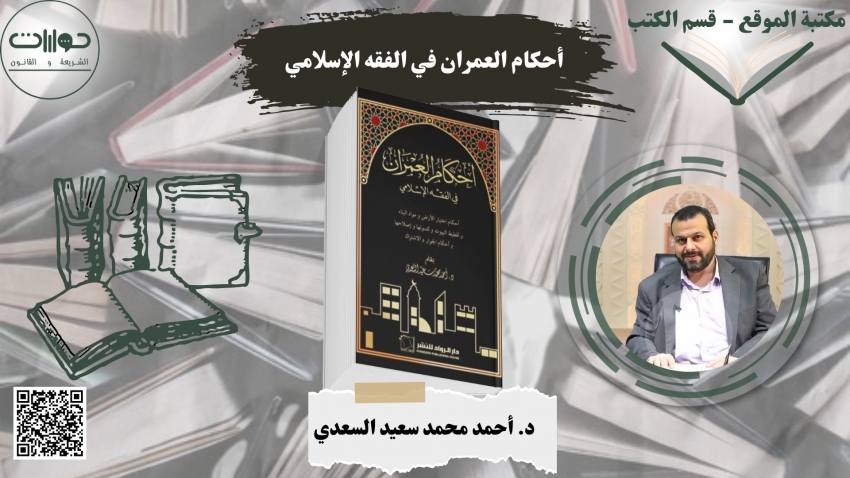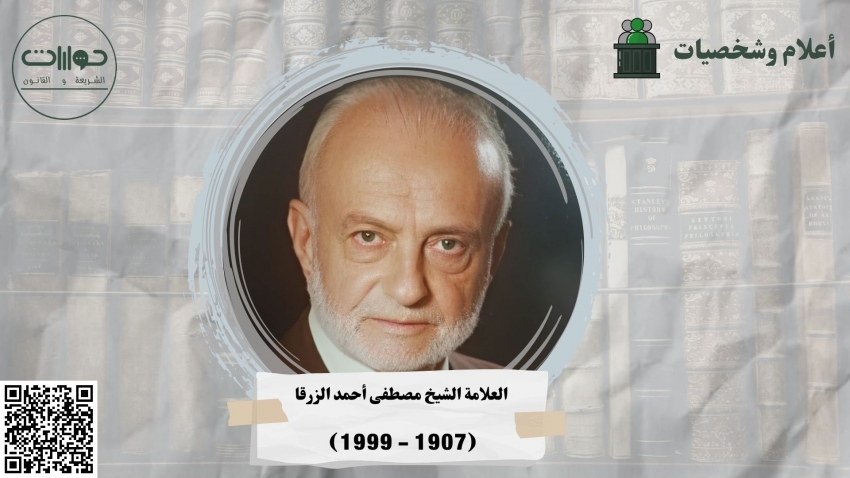صدر هذا الكتاب ضمن أعمال سلسلة "المنهجية الإسلامية" الصادرة عن "المعهد العالمي للفكر الإسلامي"، وقد نشرته "دار الفكر" الدمشقيّة في طبعة لها عام 1424ه - 2003م، لمؤلفه د. جمال الدين عطية، مؤسس مجلة "المسلم المعاصر"، والذي كان مشرفًا على المعهد العالمي للفكر الإسلامي لمدة أربع سنوات منذ 1408 - 1412ه،/ 1988م - 1992م.
حصل د. جمال الدين عطية على الدكتوراة من جامعة جنيف عام 1959م، وقد درس الحقوق والشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة، وعمل في عدة مجالات: فقد مارس المحاماة في مصر والكويت، وتولى منصب الأمين العام للموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت، وكان رئيسًا لتحرير مجلة المسلم المعاصر، وعمل رئيسيًا تنفيذيًا للمصرف الإسلامي الدولي في لوكسمبورج (بيت التمويل الإسلامي العالمي حاليًا)، ومستشارًا قانونيًا وشرعيًا للمعاملات المالية والمصرفية (مكتب خاص في لوكسمبورج)، ومستشارًا أكاديميًا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي (واشنطن) ومدير مكتبه بالقاهرة.
اعتنى في كتاباته بالاجتهاد الفقهي والتجديد في مجالات: الفقه والمقاصد وأصول الفقه والقواعد الفقهية، وكذلك اهتم بالتجديد في البنوك الإسلاميّة.
يبحث د.جمال الدين عطيَّة في هذا الكتاب قضية تفعيل مقاصد الشريعة في ثلاثة محاور رئيسيّة:
المحور الأول: قضايا هامة في مسألة مقاصد الشريعة.
المحور الثاني: تصور جديد للمقاصد.
المحور الثالث: تفعيل المقاصد.
وقد عمد في كل قضية إلى استقراء آراء المقاصديين بترتيبهم الزمني وعرض مناقشاتهم في القضايا التي يعرضها من خلال نقل نصوصهم حرصًا منه على معايشة القارئ للقضية بتسلسلها الفكري.
- المحور الأوّل: قضايا هامة في مسألة مقاصد الشريعة:
في هذا المحور يبحث د.جمال الدين عطيّة أربعة قضايا مهمة وهي:
1- قضية مصدرية المقاصد:
حيث يستهل بسؤال بسيط لكنه تأسيسي: (كيف نحدد المقاصد؟).
ويرى من استقرائه لكلام الأصوليين - بدءًا من الشاطبيّ ومن تلاه- أن مصادر المقاصد تتلخص عندهم في ثلاثة: (النص الصريح على التعليل من الكتاب والسنة، واستقراء تصرفات الشارع في الأحكام أو في أدلة الأحكام، والاهتداء بالصحابة في فهمهم لأحكام الكتاب والسنة).
2- ترتيب المقاصد فيما بينها:
يرى د. جمال الدين عطية أنه وإن كان مبدأ التفاوت بين المصالح متفق عليه إلا أن ترتيب المقاصد الخمسة المشهورة ليست محل اتفاق فضلًا عن أن تكون محل إجماع، ثم يبدأ في إظهار الاختلاف بين الفقهاء في هذه القضية متتبعًا مفهوم ترتيب المصالح عند العلماء بترتيبهم الزمني من الأقدم إلى الأحدث.
3- ترتيب وسائل المقاصد:
ينقل د.جمال الدين عطيّة عن ابن عاشور في حديثه عن نفوذ الشريعة أنها استخدمت لهذا الغرض أنواع الوازع المختلفة: (الجِبلّي والديني والسلطاني)، وبعد بيان أنواعها يبدأ في ترتيبها؛ أيها يعتمد عليها الشرع ابتداءًا وأيها يأتي متأخرًا؟ ثم يبحث في مراتب الضروري والحاجي والتحسيني وتعلقها بالوسائل لا بالمقاصد؛ حيث يعرض كلام الأصوليين في التفريق بين المقاصد الأصلية والتي يرون أنها ضرورية والمقاصد التبعية والتي تكون الحاجيات والتحسينيات ضمنها.
ثم ينتقل في حديثه عن الترتيب بين المقاصد إلى مدى إمكان إضافة مقاصد ليست من الثلاثي (الضروري، الحاجي، التحسيني)، ويتحدث هنا عن ما دون الضروري وما وراء التحسيني، فالأصل -كما سبق- أن مراتب المقاصد من حيث الأهمية (ضروري، وحاجي، وتحسينيّ)، لكنه يطرح تساؤلًا عن الحالة التي لا تتحقق فيها مواصفات الضروري، وكذلك الحالة الذي يزيد فيها الإسراف عن حد التحسيني.
وأخيرًا يختتم حديثه بملاحظات تطبيقيّة.
4- نسبية تحديد الوسائل وتسكينها في المراتب:
ثم تأتي القضية الرابعة خاتمةً لقضايا الفصل الأوّل، بعنوان (نسبية تحديد الوسائل وتسكينها في المراتب بحسب الزمان والمكان والأشخاص والأحوال)، فيرى أنه وإن كانت وسائل المقاصد ثابتة إلا أن تسكينها في متغيراتِ الزمان والمكان والأشخاص والأحوال يستدعي إعادة نظر في العلاقة بين الثابت - المقاصد - والمتغير محل التسكين - الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
- المحور الثَّاني: تصور جديد للمقاصد:
لا يبحث هذا المحور قضايا جديدة في المقاصد بقدر ما يحاول إعادة النظر في بعض مفاهيم ومضامين المقاصد وما اشتهر في تقسيمات المقاصد وخرائطها؛ بحيث يناقش في هذا المحور أول ما يناقش قضية حصر المقاصد في الخمسة أصول الضرورية منذ بلورها الإمام الغزالي، ويحاول مناقشة مبدأ حصرها في خمسة أو ستة مقاصد حيث يرى أن حصرها ظل "مصدر قلق لم يستقر"، وأن ثمة إمكانيّة لتوسيع نطاقها ويستعرض في هذا جهود المتأخرين المشتغلين بالمقاصد.
وبعد الحديث عن مبدأ حصر المقاصد، يدخل في نقاش حول أنواعها ومراتبها مجتهدًا في إعادة رسم خريطة مقاصديّة أشمل وأوضح؛ بحيث تتكون الخريطة التي يقترحها من: (مقاصد الخلق، مقاصد الشريعة العالية، مقاصد الشريعة الكلية، مقاصد الشريعة الخاصة، مقاصد الشريعة الجزئية، مقاصد المكلفين)، وهكذا يجتهد في وضع تقسيم أكثر تجليةً وتفريقًا بين أنواع المقاصد الرئيسية منها والفرعية.
وبعد توصله إلى توسيع نطاق المقاصد إلى أربعة وعشرين يبدأ في توزيعها على مجالات أربعة: (مجال الفرد، ومجال الأسرة، ومجال الأمة، ومجال الإنسانية).
- المحور الثّالث: تفعيل المقاصد:
بعد التأسيس، يأتي التفعيل وهو المقصد الثاني الذي أراده من هذا الكتاب.
وقد تناول فيه:
- الصورة الحالية لاستخدامات المقاصد: وفيها حاول جمع ما يمثل الصورة الحالية لاستخدامات المقاصد من خلال الكتابات القديمة والحديثة؛ ثم توصل بعد الاستقراء إلى أن صور استخدامات المقاصد تتمثل في الآتي: (بيان كمال الشريعة الإسلامية، الاطمئنان على الإيمان، أن يعرف المؤمن مشروعية العمل، ردع المشككين، موافقة الأحاديث الصحيحة للمصالح الشرعية، الترجيح، منع التحايل، فتح الذرائع وسدها، النصوص والأحكام بمقاصدها، الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة، اعتبار المآلات، والتوسع والتجديد في الوسائل، التقريب بين المذاهب وإزالة الخلاف).
- الاجتهاد المقاصدي: يبحث هنا حقيقة هذا المصطلح ومدى صحته؛ حيث يحاول بحثه عند المجددين من الفقهاء، ثم يخلص في النهاية إلى أن: "مصطلح (الاجتهاد المقاصدي) بالصورة التي عرضها لا تستحق أن يطلق عليها هذا المصطلح، وأنه في الحقيقة ليس إلا صورة للمصلحة المرسلة أو الاستصلاح والتي هي أدلة شرعية تكلم فيها الأصوليون منذ القديم".
ويحاول في هذا الجزء طرح كيف حاول الجهد الفقهي - الحديث خاصة- "تجاوز المنحى التجزيئي في تفهم أحكام الشريعة، ومحاولة معالجة مشكلات المسلمين وفق رؤية كلية تنزل الحلول الشرعية على الوقائع والنوازل .." من خلال رصد الإرهاصات الأولى في بعض المجهودات الفقهية الحديثة التي اجتهدت في تأصيل بعض القضايا من ناحية فقهية للخروج ببعض النظريات المستقاة من الفهم الكلي للفقه الإسلامي في النظريات: الأخلاقية، والجنائية، والحقوقية، والاقتصادية، ثم يبدأ في تحرير مفهوم (النظرية الفقهية) وهو أمر مهم يفتح به بابًا لفهم مستويات التنظير الفقهي (من العام إلى الخاص) وعلاقته بالعلوم الشرعية.
- العقلية المقاصدية للفرد والجماعة:
يشير فيها إلى نقطة مهمة قد لا تجد اهتمامًا في الحديث عن المقاصد تنظيرًا أو تفعيلًا؛ وهي تحوّل المقاصد من التنظير المجرد أو حتى الاستخدام الفقهي إلى أن تكون مَلَكَةً عقليّةً لدى الفرد المسلم والجماعة المسلمة، ثم أبرز أهمية اتجاه الجماعة المسلمة للعناية بالتقعيد الفقهي واستخلاص القوانين الفقهية من مجال حيوي وهو مجال "السياسة الشرعيّة".
في حديثه عن مستقبل علم المقاصد يستهل د.جمال الدين عطيّة بسؤال يطرح فيه رؤى أكثر مما يطرح سؤالًا مجردًا عن مستقبل المقاصد: هل علم المقاصد هو علم مستقل بذاته أم أنه علم وسيط أم أنه تطوير للأصول؟
ويقوم برصد توجهات الفقهاء المجددين ومقارنته ومقاربته بين رؤيتهم وبين ما أشار إليه المتقدمون من قبل إشارات واضحة أو في ثنايا حديثهم عن المقاصد في هذا الصدد.
وبعد عرض آراء الفقهاء المجددين مثل ابن عاشور، والريسوني، يرجح د.جمال الدين عطية ما رآه د.عبدالله دراز من أن استنباط الأحكام يحصل بأمرين: العلم بلسان العرب، والعلم بمقاصد الشريعة وأسرارها. ومن هذين العلمين يتكون علم أصول الفقه. ويختلف د. جمال الدين عطية مع رأي ابن عاشور في تأسيس علم مستقل لمقاصد الشريعة وترك علم أصول الفقه على حاله؛ يقول:"فأرى أنه ضار بكلا العلمين إذ يجمد الأصول على حالها ويحرمها من روح المقاصد، كما أنه يبعد المقاصد عن الدور الوظيفي الذي تقوم به حاليًا والذي ينبغي أن نحرص على تطويره".
- وقد جاءت خاتمة الكتاب على شكل (توصيّات بمقترحات علمية) لقضايا بحاجة إلى جهد الباحثين فيها والتي منها مثلًا:
- نظرية المقاصد عند أئمة المقاصد كالغزالي، وابن تيمية، وابن القيم، والعز بن عبدالسلام، وولي الله الدهلوي.
- المقاصد العالية للشريعة والمفاهيم التأسيسية.
- المقاصد الخاصة بكل قسم من أقسام الفقه، وبكل علم من العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية.
رابط تحميل الكتاب