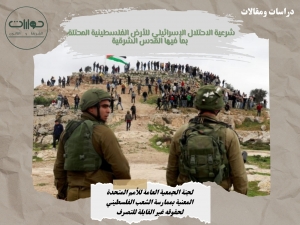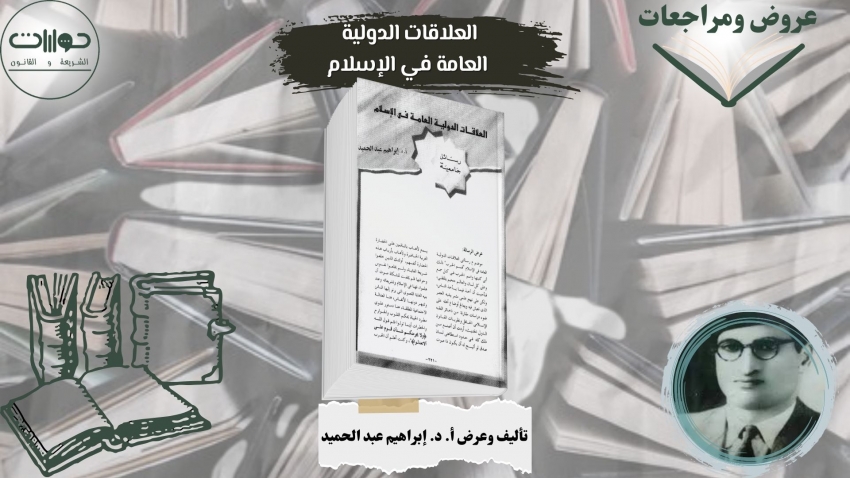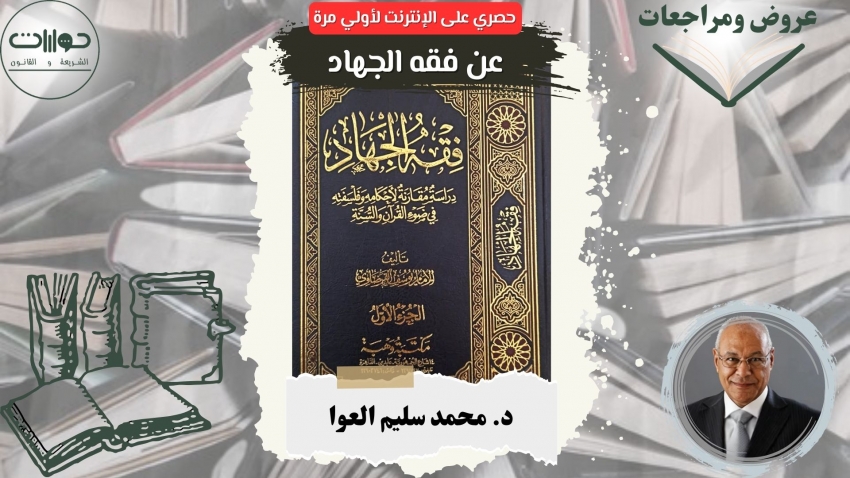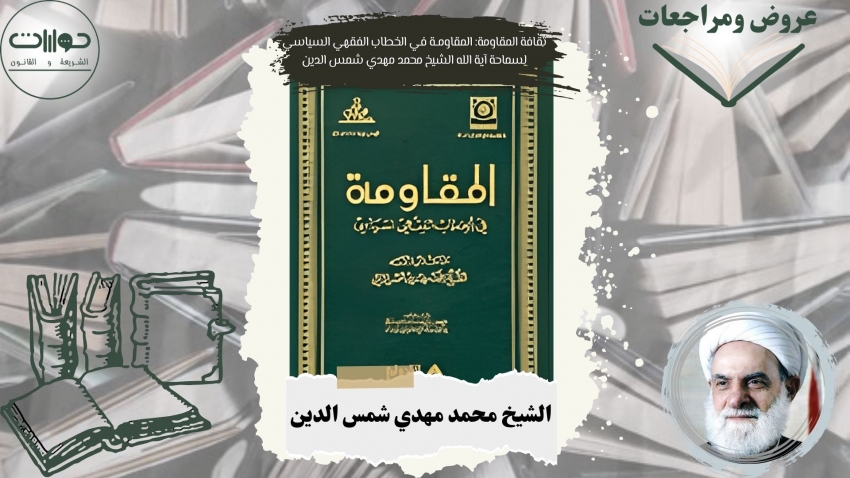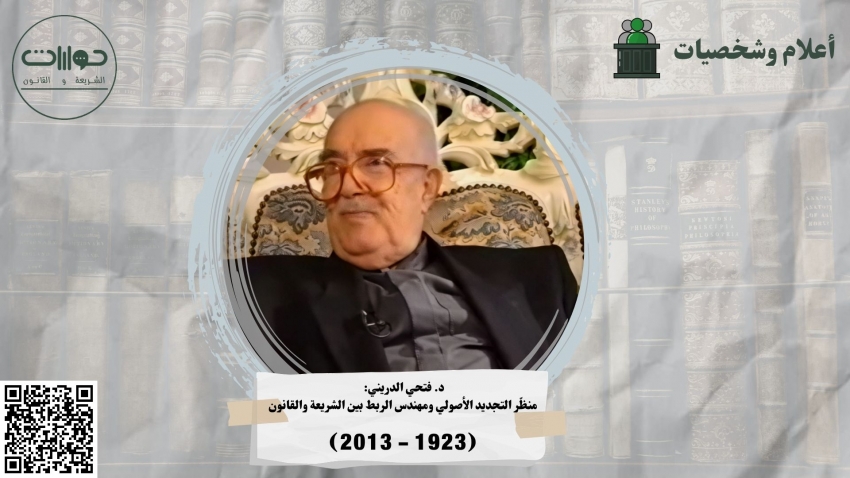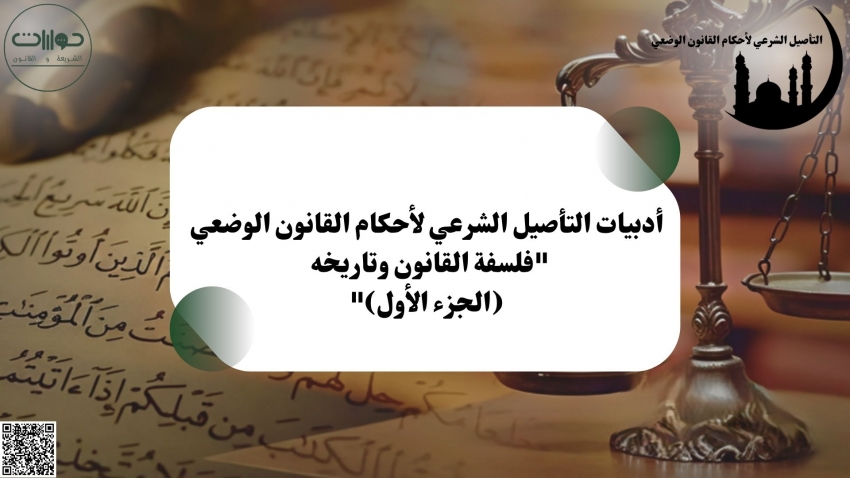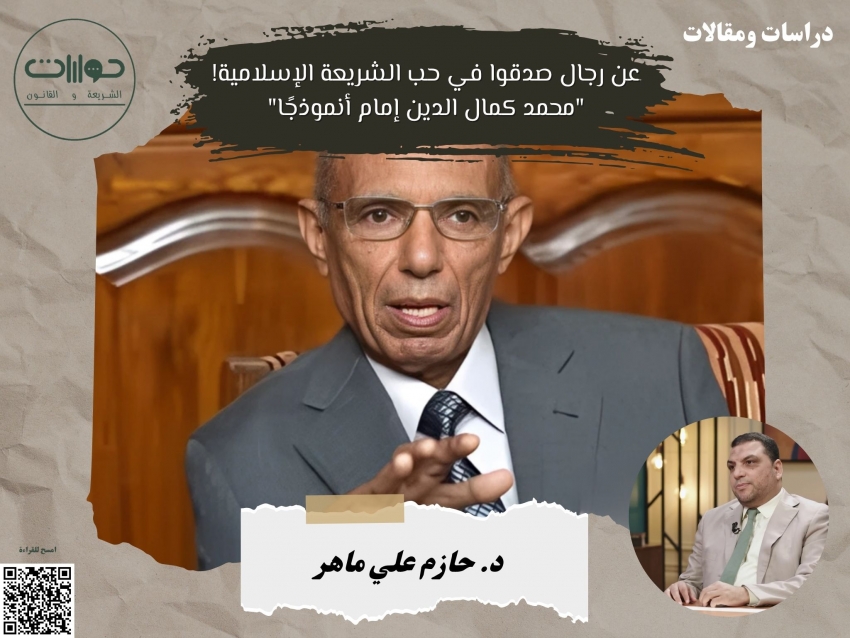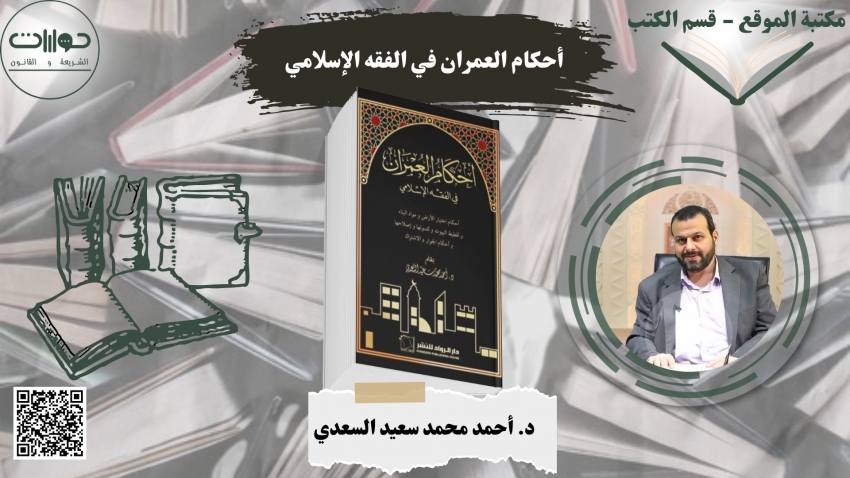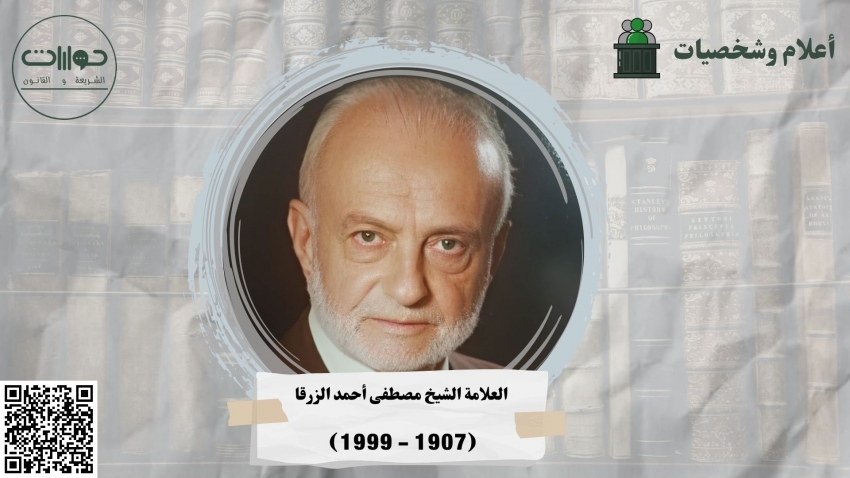"نحن نقاتل حيوانات بشرية [...] ونتصرف على هذا الأساس"، بهذا التصريح العنصري الفج، وصف وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، أهالي غزة ومقاومتها، مُحاولًا نزع صفة البشر عن أكثر من مليونين ونصف المليون من مدنيي القطاع، لتبرير ما ارتُكِب وما سيُرُتَكب من جرائم وانتهاكات ضدّهم. هذه المرة كانت الانتهاكات غير مسبوقة، مع ما يزيد على عشرة آلاف شهيد، بينهم أكثر من أربعة آلاف طفل، وأكثر من 26 ألف مُصاب حتى وقت إعداد الدراسة، حيث يشكل الأطفال والنساء والمُسنّون ما نسبته حوالي 70 في المئة من الضحايا، إلى جانب تدمير الآلاف من المباني السكنية، والبنية التحتية والمدنية، بأنواعها كلها، بما في ذلك – على سبيل المثال - المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، بقصفه المستشفى المعمداني (الأهلي).
وفي هذا السياق، يبقى السؤال: أين القانون الدولي الإنساني؟ وإلى أي مدى جرى تطبيقه؟ فقد بدا واضحًا ارتكاب إسرائيل، وفقًا لتقارير وشهادات عدة، انتهاكات فاضحة لطَيفٍ واسع من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية المتعلقة بقواعد النزاعات المسلحة، في ظل تجاهل معظم دول المجتمع الدولي، التي عمدت مؤخرًا إلى التبرير والدفاع عن تلك الانتهاكات، في مقابل أصوات خجولة من منظمات دولية وصفت أعمال الاحتلال بأنها جرائم حرب، وانتهاك للقانون الدولي4، مُطالبةً بمحاكمته، وهي أصواتٌ يبدو كأنها تستدعي قانونًا نائمًا.
لا تسعى هذه الدراسة لإثبات ما هو مُثبت، إنما تحاول مناقشة مجموعة من القضايا المحورية لفهم القانون الدولي الإنساني وتوصيف حالته في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة؛ حيث تبدأ ببيان ماهيته وغاية سنّه، ثم الإجابة عن موضع حالة غزة في إطاره، لتنتقل بعدها إلى بحث أبرز الانتهاكات الإسرائيلية له خلال فترة الحرب الآنية على القطاع، لتجيب بعدها عن التساؤلات المثارة بغرض نفي الانتهاكات وتسويغها، مثل حق الدفاع عن النفس ومسألة توجيه الإنذارات قبل القصف. عقب ذلك، تلقي الدراسة الضوء على المخالفات الدولية للقانون والتقاعس في اتخاذ التدابير الممكنة لتعزيز الامتثال له.
أولًا: القانون الدولي الإنساني: التعريف والمصادر وآليات التنفيذ
القانون الدولي الإنساني، أو ما يعرف بقواعد الحرب، هو فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يهدف إلى تخفيف حدّة النزاع المسلح والمعاناة الناتجة منه عبر تحقيق حماية للأشخاص الذين لا يشاركون، أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية خلال النزاعات المسلحة، وكذلك تحديد الوسائل والأساليب المسموح بها، وغير المسموح بها في القتال 5؛ أي إنه يمثل إطارًا قانونيًا يحاول تحقيق حدٍّ أدنى من الحفاظ على الإنسانية في النزاعات المسلحة وحماية الأبرياء والتخفيف من المعاناة، بالتوازن مع هدف إضعاف العدو، آخذًا في الحسبان "الاحتياجات العسكرية" لأطراف النزاع المسلح، خلال سعيها ل "هزيمة الخصم"، وذلك من منطلق كون الحروب حقيقةً واقعةً منذ الأزل.
يستند القانون الدولي الإنساني في ذلك إلى مصادر عدة؛ أبرزها: اتفاقيات جنيف التي تم توقيعها في عام 1949، وبروتوكولات جنيف الإضافية في عام 1977، حيث يهدف البروتوكول الأول إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية؛ ويتخصص البروتوكول الثاني بالنزاعات غير الدولية. هذا إلى جانب القوانين والعُرف الدولي المحدّد للسلوك في هذه النزاعات. وقد صدقت الدول، البالغ عددها 196 دولة، على اتفاقيات جنيف (وهي العنصر الرئيس للقانون الدولي الإنساني). وجدير بالذكر أنه لم يحظَ سوى عدد قليل من المعاهدات الدولية بهذا المستوى من الدعم.
على الرغم من وجود بعض الخلافات الموضوعية، القديمة والجديدة، حول قواعد هذا القانون، بما في ذلك ادّعاءاتٍ حول عدم مناسبة القانون الدولي الإنساني بعد الآن لواقع النزاعات المسلحة المعاصرة، فإن ثمة توافقًا شبه كامل بين الدول والباحثين على أن التحدي الرئيس يكمن في تنفيذه بفعالية على أرض الواقع، نظرًا إلى كون قواعده تدور حول محاولة الحدّ من همجية الحروب، وهو سياق معقّد. وتُقسم آليات تنفيذ هذا القانون إلى فئات ثلاث؛ أولها: التدابير الوقائية في وقت السلم، عبر سن التشريعات الوطنية والبرامج التدريبية والتوعية؛ وثانيها: التدابير التي تضمن احترام القانون خلال/ أو في أثناء النزاعات المسلحة، مثل توثيق الانتهاكات ولجان التحقيق وممارسة الضغط على الأطراف المتنازعة؛ وثالثها: التدابير المخصصة لقمع الانتهاكات في حال ارتكابها، مثل توثيق جرائم الحرب وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
ثانيًا: غزة: حرب أم احتلال؟
وفقًا لقواعد لاهاي في عام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة في عام 1947، "تعتبر الأرض محتلة عندما تكون واقعة تحت سلطة الجيش المعادي. ويمتد الاحتلال فقط إلى الأراضي التي أُنشئت فيها هذه السلطة ويمكن ممارستها". وتبعًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن أراضي قطاع غزة - إلى جانب الأراضي الأخرى التي سيطرت عليها إسرائيل في أعقاب حرب عام 1967 - تُعدّ خاضعةً للاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم هي خاضعة لقانون الاحتلال، المعتمد من المحكمة العليا في إسرائيل نفسها في أحكامها القضائية، مُعبّرّة عن قبولها به، بحكم الأمر الواقع. وتُفسّرّ اللجنة الدولية حكمها باعتبار قطاع غزة أرضًا محتلة على أساس كون إسرائيل، على الرغم من عدم وجودها على الأرض، تمارس عناصر رئيسة من السلطة عليها، بما في ذلك السيطرة على مجالاتها الجوية والبحرية والبرية، ولذا تبقى مُلزمةً بما يفرضه قانون الاحتلال، بما يتناسب مع درجة سيطرتها على القطاع. ويشمل هذا تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وما يسمح به للعيش ضمن ظروف مادية مناسبة (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة)، فضلًا عن احترام مبدأ التناسب في الظروف كلها. وتعكس قواعد "قانون الاحتلال" مجموعة من المبادئ، أبرزها "أن القوة المحتلة لا تكتب حقوقًا سيادية على الأرض المحتلة، وبالتالي لا يمكنها أن تحدث تغييرات في وضعها وسماتها الجوهرية"، وأن "الاحتلال وضع مؤقت"؛ أي منع تبني سياسات وتدابير تؤدي إلى تغييرات دائمة، ومبدأ موازنة الاحتياجات العسكرية مع احتياجات السكان المحليين، ومبدأ عدم السماح "للقوة المحتلة ممارسة سلطتها من أجل تعزيز مصالحها الخاصة" (بخلاف مصالحها العسكرية).
مع ذلك، هناك من يميل إلى تصنيف الوضع في غزة، تحديدًا، بصورة مختلفة، استنادًا إلى حجة أن وقوع أحداث قتالية في منطقة محتلة، ووصولها إلى مستوى النزاع المسلح بين جهتين، مثلما هي الحال عند تصاعد المواجهات بين حركة حماس وإسرائيل، يجعلها تُدرج تحت مظلة قانون النزاعات المسلحة فحسب، فضلًًا عمن يجادل في أن إسرائيل "تنازلت عن السيطرة الفعالة" المطلوبة بموجب التعريف القانوني للاحتلال، ومن ثم أنهت الاحتلال في غزة، وهو قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية في عام 2008، لكن التصريحات الإسرائيلية نفسها تناقض ذلك، فقد صرّح غالانت نفسه، مؤخرًا، بأنه بعد التطورات الأخيرة، لن يكون على إسرائيل "أي مسؤولية بعد الآن عن الحياة في قطاع غزة"؛ ما يشير إلى أن هذا تغيير طارئ.
يبقى الرأي الدولي الرسمي السائد ممثلًا في كل من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، والاتحاد الأوروبي (EU) والاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية (الدائرة التمهيدية الأولى ومكتب المدعي العام) ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش"، إضافة إلى خبراء قانونيين دوليين ومنظمات أخرى وباحثين، ويعتبر هذا الرأي أن غزة منطقة محتلة منذ عام 1967، مُعلّلًا ذلك بأن إسرائيل تحافظ على السيطرة المطلوبة عبر الوسائل المختلفة، بما فيها الوسائل الحديثة واستخدام التكنولوجيا، ويشمل ذلك السيطرة على "المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر البرية على الحدود وإمدادات البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المياه والكهرباء، والوظائف الحكومية الرئيسة، مثل إدارة السجل السكاني الفلسطيني"، وممارستها "أشكالًا أخرى من القوة، مثل التوغلات العسكرية وإطلاق الصواريخ"، وكونها "لم تنقل السلطات السيادية"، وهو ما يفرض على إسرائيل الالتزام بمزيد من القوانين في غزة، باعتبارها دولةً مُحتلة، إلى جانب قواعد النزاعات المسلحة، وتتمثل تلك القوانين في اتفاقية لاهاي الرابعة واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي العرفي والبروتوكول الإضافي الأول.
ثالثًا: الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني
منذ حصار غزة (2006)، وما تخلّله من حروب ومواجهات، لم تتوقف إسرائيل عن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وفي ظل الحرب الدائرة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ، باتت تلك الانتهاكات أكثر فجاجة من حيث الكم والكيف، وتشمل انتهاكات لكل من اتفاقيات جنيف والبروتوكولات المُلحقة بها، وميثاق الأمم المتحدة، وإعلان سان بطرسبرغ في عام 1868 لحظر القذائف المتفجّرة، وقانون الاحتلال الحربي، واتفاقية لاهاي في عام 1907 الهادفة إلى وضع قيود على استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحّة، وبروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات السامة في عام 1925 ، واتفاقية منع استخدام الأسلحة الكيماوية، واتفاقية أوسلو لمنع استخدام بعض الأسلحة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية 13 . وتعرض هذه الدراسة، باقتضاب، أبرز الاشتراطات القانونية المنتهكة.
بدايةً، من الجلي، في المواجهات والغارات الإسرائيلية التي تركزت على الأهداف المدنية، وحتى في الحصار المفروض في حد ذاته، وما جدّ فيه من تشديداتٍ 14 ، انتهاك المادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والمادة المشتركة الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربع، التي تنص على أن "الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ]...[ يُعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية"، إضافة إلى القاعدة 7، المقنّنة في المادتين (48) و (52 / 2) من البروتوكول الإضافي الأول، وفحواها ضرورة التمييز في الأوقات كلها بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وعدم توجيه الهجمات إلّّا إلى الأهداف العسكرية فحسب 15 .
كما يمكن تأطير تلك الانتهاكات وفقًا للمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمعنية بالأفعال الموجّهة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وإلحاق الأذى الجسدي الخطر وتعمّد إحداث معاناة شديدة وإلحاق دمار واسع، والإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع، وقائمة أخرى طويلة جدًا، تتّبعها إسرائيل بحذافيرها، وليس آخرها "تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية ... والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى"، كما حدث يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر، عند استهداف المستشفى المعمداني، وهي مجزرة فاضحة حاولت إسرائيل التنصّل من ارتكابها، وهي التي درجت على عرض ما تراه "إنجازات عسكرية". كل ما سبق يُصنَّف جريمة حرب، وفقًا للمادة المذكورة. مع ذلك، استمرت إسرائيل باستهداف المؤسسات الصحية وكوادرها، وبحلول الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدفت أكثر من 105 مؤسسات صحية، قتلت فيها أكثر من 150 شخصًا من الكوادر الطبية، كما دمّرت 27 سيارة إسعاف، فضلًا عن تأثر المستشفيات بنقص الغذاء والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة، كما تفيد منظمة الصحة العالمية. ويشكل استهداف أفراد الخدمات الطبية والأنشطة والوحدات الطبية، تحديدًا، اختراقًا للمواد 12 و15 و16 من البروتوكول الإضافي الأول.
فضلًا عن ذلك، تخترق التدابير الإسرائيلية المتّخذة في بداية الحرب، على خلفية تصريح غالانت حول محاربة "حيوانات بشرية"، مثل قطع الإمدادات الأساسية من كهرباء وماء ووقود، وقطع الإمدادات الغذائية وفرض حصار شامل، ومحاولة فرض التهجير القسري على أكثر من مليوني ونصف المليون فلسطيني، المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محميّ على جريمة لم يرتكبها هو شخصيًا. وتحظر العقوبات الجماعية". وفي هذا السياق، كان فولكر تورك، مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد رد على تلك التدابير في بيان رسمي، يؤكد أن "فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني". وفي هذا الصدد، صّرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أن إسرائيل أظهرت في "نيّتها المعلنة في استخدام كافة الوسائل ... ازدراءً صادمًا لأرواح المدنيين"، وهو ما تدور حوله غالبية قواعد القانون الدولي الإنساني.
يظهر هذا من جديد في اختراق آخر لقواعد القانون الدولي الإنساني بشأن مرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها وتأمين حرية حركة العاملين في الإغاثة الإنسانية، حيث راح ضحية هجمات إسرائيل نحو 72 شخصًا من عمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال أقل من شهر، وهو "أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين قتلوا في صراع في مثل هذا الوقت القصير في تاريخ الأمم المتحدة"، بحسب بيان المفوض العام للأونروا. هذا عدا عن أن منع وصول المساعدات الغذائية في ظل الحصار المشدد، يُعدّ اختراقًا للمواد المتعلقة بحظر استخدام التجويع أسلوبًا من أساليب الحرب.
يرقى ما سبق إلى اعتباره جريمة إبادة جماعية وفقًا للمادة (6) من نظام روما الأساسي، فما ترتكبه إسرائيل في ظل تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتحويل غزة إلى أنقاض، واصفًا إياها ب "مدينة الشر" 25 ، يبدو كأنه تطبيقٌ مباشر للأفعال التي تشير إليها المادة (6)، والتي تُرتكب "بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكًا كلّيًا أو جزئيًا"، وتشمل قتل أفراد تلك الجماعة وإلحاق الأضرار الجسيمة بأفرادها، وإخضاعهم "عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلّيًا أو جزئيَا". وفي ظل كون الأطفال يشكلون ما تزيد نسبته على 47 في المئة من سكان القطاع، ولكون بنك الأهداف الأخير لإسرائيل في حقيقة الأمر، عبارة عن أهداف مدنية ذات كثافة سكانية عالية، فإن الأفعال الأخرى التي تتضمنها المادة (6)، مثل "فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب" و"نقل أطفال الجماعة عُنوة إلى جماعة أخرى"، تبدو أقل إجرامًا مما يحدث فعليًا في الميدان من استهداف مباشر للأطفال.
علاوة على سبق، حتى المادة (7) من نظام روما، والمعنية بالجرائم ضد الإنسانية، تبدو منطبقة على السياق الذي تعالجه هذه الدراسة، فالأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية هي الأفعال التي تُرتكب "في إطار هجوم واسع أو منهجي، موجّه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين"، وتشمل القتل العمد وإبعاد السكان أو النقل القسري والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية والفصل العنصري. وقد دانت منظمة أوكسفام في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر أمر الإخلاء، الصادر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر بحق سكان شمال غزة، ففضلًا عن "المخاطر الإضافية التي خلقها" وفقًا للمنظمة، فهو يرقى إلى الترحيل القسري.
رابعًا: موقف القانون الدولي الإنساني من ادّعاء "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"
يكرر المسؤولون الإسرائيليون وحلفاؤهم الحديث عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تبريرًا للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة. لكن ما يجدر تأكيده هو أن قوانين الحرب تنطبق على الأطراف كلها المشاركة في القتال، بغض النظر عن دوافعها، وبغض النظر عما فعله الطرف الآخر. يحكمُ القانون الدولي الإنساني ما يتعلق بسير الأعمال العدائية، وهو مختلف عن القانون الذي يحكم قرار استخدام القوة؛ أي قانون استخدام القوة الذي يُنظّمه ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول، ومن ثم مهما حظي قرار استخدام القوة بالشرعية، افتراضًا، يبقى على الأطراف كلها الالتزام بقواعد قانون الحرب. وكما تفيد هيومن رايتس ووتش، فإن أي استهداف متعمد للمدنيين، أو عقوبات جماعية، "لا يمكن أبدًا تبريرها بالادّعاء بأن طرفًا آخر ارتكب انتهاكات، أو أن هناك اختلالًا في موازين القوى، أو غير ذلك من المظالم"؛ أي إنه لا يمكن شرعنة جرائم الاحتلال، ولا حتى عبر رفع ورقة الجوكر (تهمة الإرهاب) التي درجت القوى الاستعمارية خلال العقود الأخيرة على استخدامها.
من ناحية أخرى، ونظرًا إلى وقوع غزة تحت الاحتلال، وإن اختلفت الأساليب، فالقانون الدولي الإنساني يمنح الشعب المحتل حق المقاومة من خلال البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في عام 1949، ومن خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 37 / 43 الذي يؤكد "شرعية نضال الشعوب من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية ... والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بالوسائل كلها المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح". في المقابل، لا يضم القانون أي بنود تُعطي قوى الاحتلال "حق الدفاع" عن نفسها ضد من تحتلهم. ولا يمكن منح استثناءات خاصة لإسرائيل على أي أساس قانوني.
درجت الحكومة الإسرائيلية وصنّاع القرار فيها على ازدراء القانون الدولي الإنساني، والإفلات من العقاب، واحتكار الحقوق، في مقابل تبرير الجرائم والاستهداف المتعمد للمدنيين، بغض النظر عن أي معطيات أو عن شرعية ممارساتها قانونيًا. برز هذا خلال الحرب الدائرة الآن، من خلال التصريحات الرسمية للمسؤولين الإسرائيليين، فعلى سبيل المثال، عندما وُجّه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت سؤال من إحدى الوكالات الإعلامية حول ما يتعرّض له الأطفال في غزة في ظل الحرب الدائرة، كان ردّه: "هل أنت جاد بسؤالي عن المدنيين الفلسطينيين؟ ماذا دهاك؟ ألم ترَ ما حدث؟ نحن نقاتل النازيين". وصرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: "هناك أمة بكاملها تتحمل المسؤولية"، محاولًًا تبرير جريمة العقاب الجماعي.
بينما قال الممثل السابق لإسرائيل في الأمم المتحدة، دان غيلرمان: "إنني محتار بشأن اهتمام العالم المستمر بالمدنيين الفلسطينيين وتعاطفه مع حيوانات غير آدمية متوحشة"، منتقدًا عدم انسياق ذلك "العالم" إلى نزع الآدمية عن هذه الفئة الواقعة تحت حماية القانون الدولي الإنساني. بينما قال السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا، درور إيدار: إسرائيل "غير مهتمة، ولديها هدف واحد، وهو تدمير غزة"، مع عدم الإشارة إلى أي استثناءات من ذلك "التدمير". هذا الخطاب غير المكترث بأي أبعاد إنسانية أو قانونية، صُعّد إلى حد تصريح عميحاي إلياهو، وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية، بأن "إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، وبالنسبة إلى المختطفين، فالحرب لها أثمان". واجه هذا التصريح تحديدًا، دون غيره، ردات أفعال غاضبة من الحكومة، لكن ما أثار حفيظة منتقديه تركّز أساسًا في قضية التصريح بفكرة التضحية بالأسرى الإسرائيليين، علمًاً أن المادة (51/ 2) من البروتوكول الإضافي الأول، تُحرّم حتى مجرد التهديد بأعمال العنف، بهدف بثّ الذعر بين السكان المدنيين، ومن ثم، لا يمكن إرجاع هذه التصريحات - وإن بقيت تصريحات مجردة - إلى حق الدفاع عن النفس، وكأنها ردة فعل غاضبة على مظلمة مدّعاة.
خامسًا: هل تُعفي الإنذارات إسرائيل من التزاماتها القانونية؟
يحتجّ بعض الأطراف المحسوبة على الحكومة الإسرائيلية، أو المؤيدة لها، بتوجيه إنذارات إلى المدنيين قبل قصف منازلهم، أو الأعيان المدنية الأخرى من مستشفيات وغير ذلك، على اعتبار أن هذا يُبرِّئها مما يوجّه إليها من اتهامات بانتهاك القانون. في الواقع، لا يقدم القانون الدولي الإنساني إعفاءً من أي التزامات قانونية، بناء على توجيه إنذارات تسبق الأعمال العدائية غير القانونية. وقد وثّقت منظمة العفو الدولية عددًا كبيرًا من الحالات التي لم يتم فيها تحذير المدنيين من الجيش الإسرائيلي، أو أصدر فيها "تحذيرات غير كافية"، وأنه "في بعض الحالات، أبلغ شخصًا واحدًا عن هجوم انتهى بتدمير مبانٍ بأكملها أو شوارع مكتظة بالناس، أو أصدر أوامر "إخلاء" غير واضحة أو مُضللة. ولم تضمن القوات الإسرائيلية بأي حال من الأحوال توفير مكان آمن للمدنيين للجوء إليه. فضلًا عن مثال في إحدى الهجمات على سوق جباليا، حين غادر الناس منازلهم استجابة لأمر "الإخلاء"، ليُلاقوا حتفهم في المكان الذي فرّوا إليه.
ومع قرينة وجود حالات متكررة لمجازر جماعية، راح ضحيتها مئات المدنيين والأطفال، مثل مجزرتي مخيم جباليا، فلا يمكن تكوين قناعة بأنه قد سبقتها تحذيرات كافية، علاوة على أنّه حتى مجرد الإضرار بهذا الحجم الواسع بالأعيان المدنية - على افتراض كفاية التحذيرات - لا يُعد قانونيًا، فوفقًا للقاعدة (14)، المقنّنة في المادة (51 / 5 (ب)) من البروتوكول الإضافي الأول، "يُحظر الهجوم الذي قد يُتوقع منه أن يُسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضرارًا بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مُفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة". وقد أشار فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة (الأونروا)، إلى أن وجود "ما يقرب من 3200 طفل قُتلوا في غزة خلال ثلاثة أسابيع فقط ... لا يمكن أن يكون هذا 'أضرارًا جانبية'".
سادسًا: مسؤولية المجتمع الدولي عن فرض احترام القانون الدولي الإنساني
استنادًا إلى القاعدة 144، المبنية على مواد في اتفاقيات جنيف الأربع كلها والبروتوكول الإضافي الأول، فعلى الدول الأطراف التعهد بأن تكفل احترام بنود الاتفاقيات، و"ألّا تُشجّع الدول انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع المسلح. ويجب أن تمارس نفوذها، إلى الحد الممكن، لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني". وحيث إن جرائم "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"جرائم الحرب"، كما عرّفها نظام روما، هي ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فيبدو أن إسرائيل استطاعت أن تنجو - حتى الآن – من ملاحقاتٍ مستحقة من أكثر من جانبٍ ومدخلٍ قانونيّ. ومع تصاعد الاعتداءات وسَعة نطاقها، وتواطؤ عدد من دول الشمال العالمي معها، يبدو للمراقب أن الحديث عن قانون الحرب كقانون نائم، أو قانون لا ينطبق على الأقوياء هو حديث واقعي، ما دعا أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، للقول: إن "عقودًا من الإفلات من العقاب والظلم والمستوى غير المسبوق من الموت والدمار الناجم عن الهجوم الحالي لن تؤدي إلّّا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار"، داعيةً إلى تسريع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاته الجارية في أدلّة جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
وقد عمد عدد من الدول إلى تجاوز الاكتفاء بالتشجيع المُحرّم قانونيًا، إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، على الرغم من انتهاكاتها، فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، أرسلت إمداداتٍ عسكرية يتم استخدامها في الحرب الدائرة، وقد طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار لدعم إسرائيل في حربها، بينما لم تضع واشنطن شروطًا لاستخدامات مساعداتها العسكرية. فضلًا عن تعهد زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، قبل ذلك في بيان مشترك، بدعم "قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"، مؤكدين "دعمهم الثابت والموحد لإسرائيل"، مع رفع حق النقض الفيتو من الدول المعنية في مجلس الأمن مرات عدة، لمنع القرارات الرامية إلى إيقاف العدوان.
وقد دعت مواقف عدد من الدول الأوروبية، رئيس قسم العلاقات الدولية والتنمية في جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن "إس أو إيه إس" (SOAS)، جيلبرت الأشقر، إلى التصريح بأن "مسارعة الدول الأوروبية لإظهار الدعم المطلق لإسرائيل هو خطأ فادح، لأن هذه الدول التي تقول إنها ديمقراطية، وتحترم حقوق الإنسان تدعم حكومة يقودها اليمين المتطرف، وترتكب جرائم حرب". ولا يبدو أن الدول الأخرى تمارس نفوذها المنصوص عليه من أجل وقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
ففي حين ترفض إسرائيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتمنع سفر محققيها إلى الأراضي التي تحت سيطرتها أو الأراضي المحتلة، فقد دعت ثلاث دول فقط رسميًا إلى تدخّل المحكمة الجنائية الدولية، وهي جنوب أفريقيا وسويسرا وليختنشتاين. ولم تُمُارس تلك الدول تدابير من شأنها الضغط لمنع الانتهاكات، مثل فرض حظر شامل لتوريد الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى إسرائيل، أو اشتراط استخدامات محددة قانونيًا لها، كما لم تمارس أي ضغوط ملموسة لإنهاء الحصار غير القانوني، ولم نشهد خطوات دبلوماسية، مثل قطع العلاقات أو استدعاء السفراء، عدا تحركات خجولة متأخرة بعد مرور أكثر من شهر على بدء الحرب والانتهاكات، كما لم نشهد أبدًا تهديدات بوقف تصدير النفط، أو غير ذلك من المعاملات التي تمنح الدول نفوذًا قد يساعد في الضغط لتعزيز الامتثال للقانون.
خلاصة:
إذا كان الغرض من القانون الدولي الإنساني و"قواعد الحرب" التقليل من وحشية الحرب، والموازنة ما بين تحقيق الأغراض العسكرية وحماية الأبرياء، فإن حالة الحرب على غزة تُمُثل نداءً عاجلًا للاحتكام إلى ذلك القانون. وبغض النظر عن تصنيفها حالة احتلال أم حالة حرب، فإسرائيل تبقى متورطة في انتهاكات واسعة لتلك الأطر القانونية وارتكاب جرائم ترقى إلى درجة جرائم حرب. في ظل هذا، لا يقبل القانون والواقع الميداني أي تبريرات لتلك الجرائم والانتهاكات، سواء كان حق الدفاع عن النفس أم استخدام الإنذارات للتنصل من الالتزامات القانونية، أم حتى التعلل بالأضرار الجانبية. أما عن المجتمع الدولي، فهو متورط في عدد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الحرب الدائرة، متمثلة في دعم بعض أعضائه الانتهاكات الإسرائيلية، وتقاعس بعضه الآخر عن اتخاذ التدابير اللازمة للضغط من أجل الامتثال لقواعد القانون.
ومما يجدر ذكره هنا، أن من المهم ألّا يُشترَط - كما هي الحال عادةً - اتخاذ الفلسطينيين مواقف محددة وامتثالهم لمعايير "الضحية المثالية"، كما يراها صاحب "الامتياز الغربي"، في مقابل تقديم الدعم السياسي والقانوني والأخلاقي اللازم. ومن دون ذلك، فإن اعتراضات أبناء ما يطلق عليه "الجنوب العالمي" بشأن القانون النائم لقواعد الحرب، وكونها تتحول إلى حبر على ورق وفقًا لقوة اللاعب ونفوذه، ستشكل توصيفًا دقيقًا لحقيقة الأمر.
لتحميل نسخة pdf من الدراسة
________________________
غسان الكحلوت- مني هدية، إسرائيل والقانون الدولي الإنساني: البحث عن إجابات في ظل حرب وحشية وقانونٍ مهمش، المركز العربي لأبحاث ودراسات السياسات، 26 نوفمبر 2023، https://2u.pw/ebt04Ze.