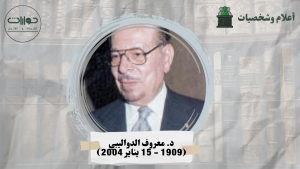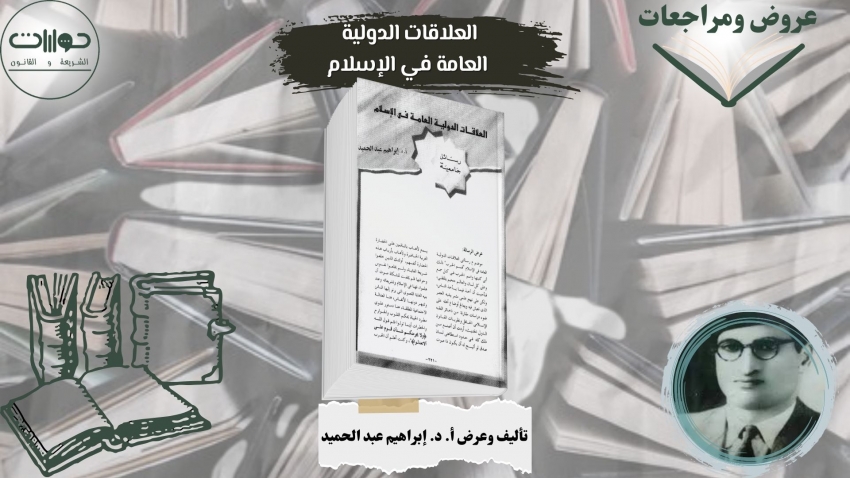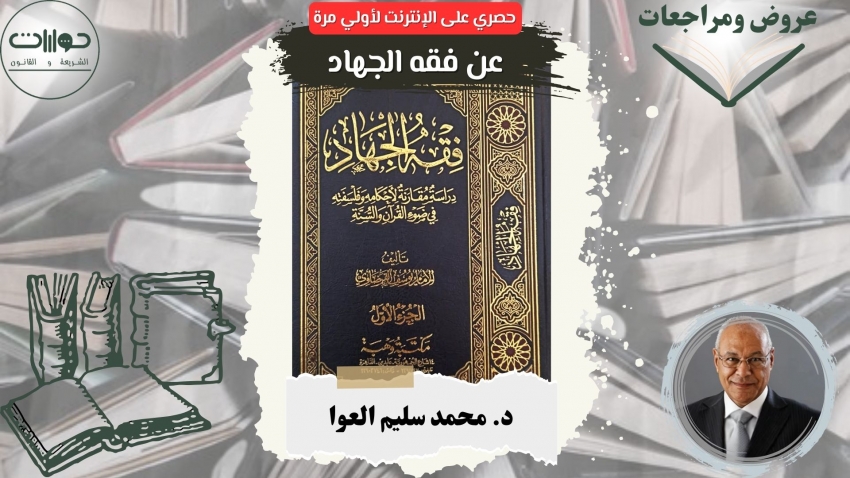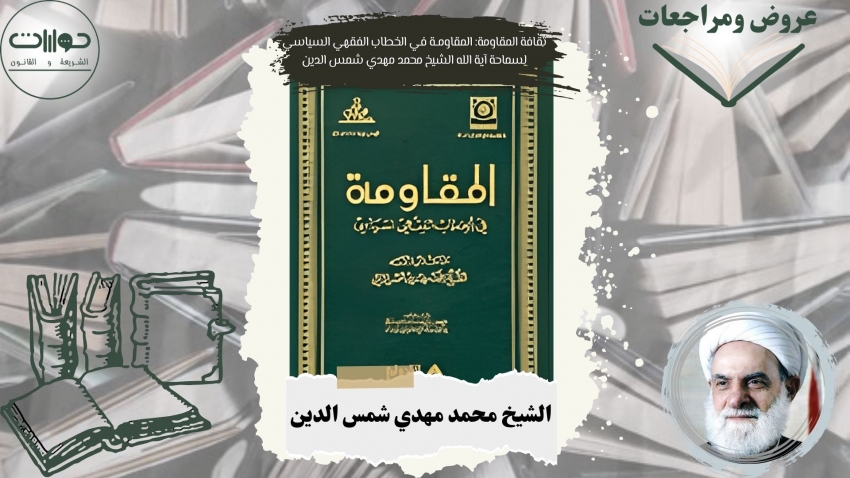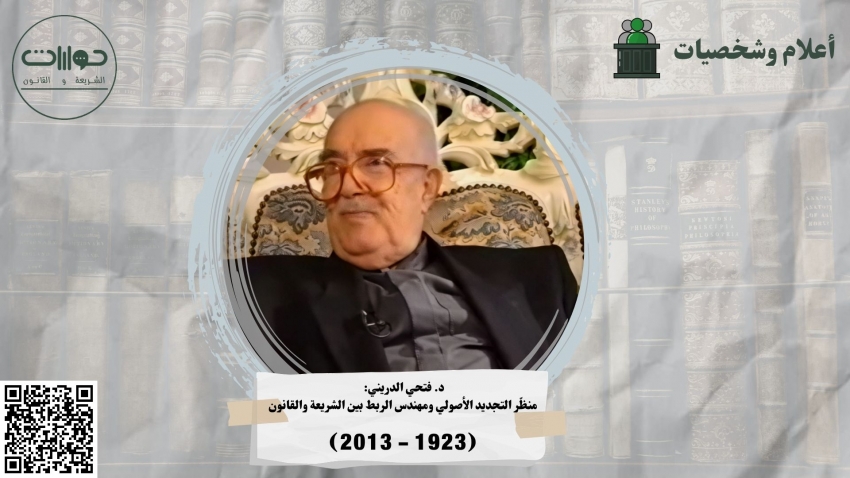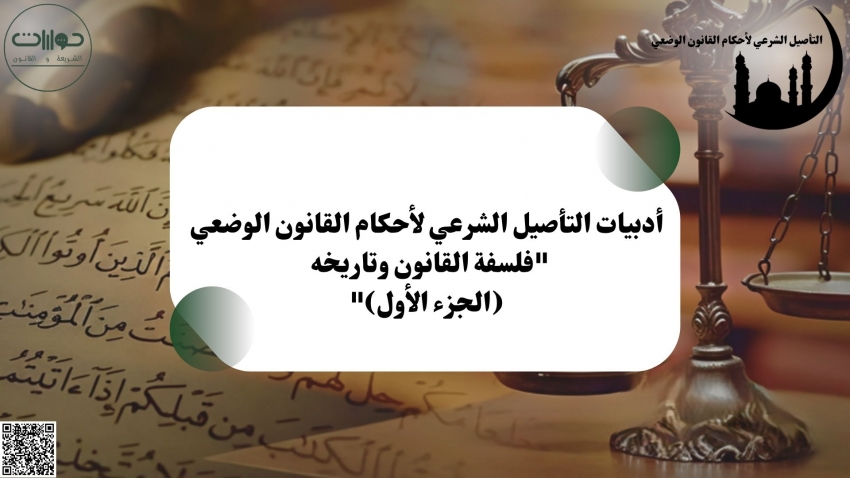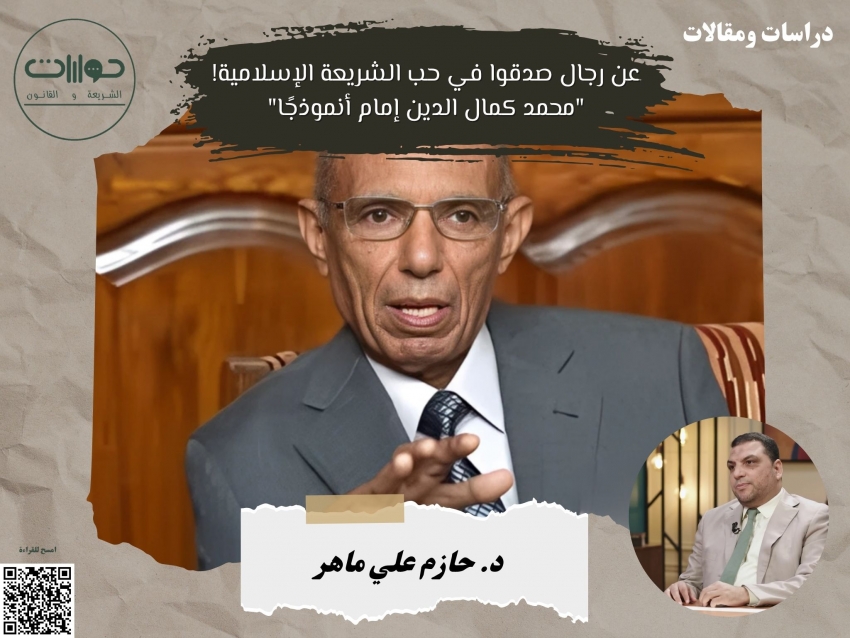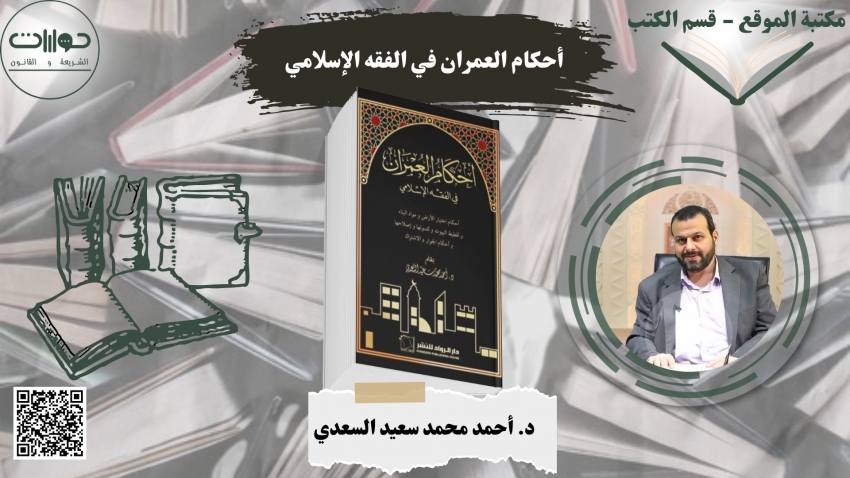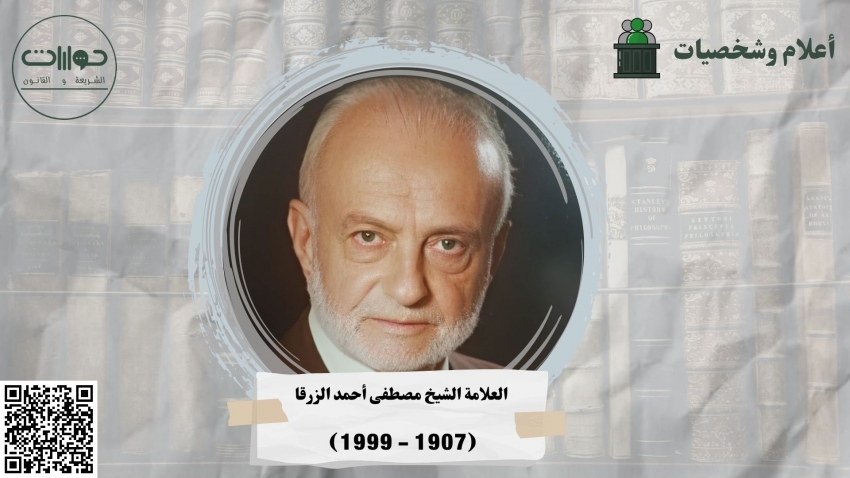صدر هذا الكتاب عام 1989م عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.
ويدور حول إبراز الجانب الفلسفي والعقلي لعلم أصول الفقه من ناحية وإبراز اتصال علم الأصول بعلم مقاصد الشريعة من ناحية أخرى من خلال حديث المؤلف عن الشاطبي وجهده الذي يراه غير مسبوق في علم المقاصد ونظرته التي توسع فيها عمن قبله من الفقهاء والتي يرى المؤلف أنه بسبب هذه النظرة غير المألوفة للأصول في تناوله وتبويبه؛ لم يعر أحد جهد الشاطبي الاهتمام المستحق لعمله.
ويحتوي الكتاب على مقدمة تمهيدية وسبعة فصول:
يعرض في الفصل الأول حياة الشاطبي من خلال عرضه للبيئة الجغرافية والثقافية والسياسية التي نشأ فيها؛ فالأندلس –بلد نشأته- بلد يميل لليسر والسماحة واللين بطبيعته الجغرافية والثقافية، مما أثر في تكوين الشاطبيِّ وتوجهاته التي تميل لليسر والنفور من التشدد. وسياسيًا كان العالم الإسلامي في عصر الشاطبي (في القرن الثامن الهجري) بصفة عامة يموج بالانقسامات السياسية والمذهبية. ويرى المؤلف أن أهم أثر خلَّفَته الأحداث السياسية في فكر الشاطبي هو أنها وجهته نحو جمع المذاهب الفقهية كلها في وحدة واحدة؛ لأن المسلمين وإن كان اختلافهم السياسي سببًا في ضعفهم فإن الاختلاف المذهبي أيضًا سببٌ في فرقتهم.
ويرصد في الفصل الثاني تأثير علم المقاصد في علم أصول الفقه؛ فهو يرى أن علم الأصول بعد أن اتخذ الشكل العلمي له على يد الشافعي، لم يضع الشافعي معيارًا للرأي والاجتهاد، ومن هنا زادت الاختلافات بين أنصار المذاهب الفقهية، وأصبح علم أصول الفقه وكأنه علم جدلي؛ فكان على الشاطبي أن يضع معيارًا للاجتهاد بالرأي، وكان هذا المعيار هو "مقاصد الشارع"، وينقل عن الشاطبي في هذا قوله: "حال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، ولذلك فعلى المجتهد أن يكون عالمًا تمامًا بمقاصد الشريعة على كمالها بالإضافة إلى تمكنه من الاستنباط بناءً على فهمه فيها، فإذا بلغ عن الإنسان مبلغًا فهم فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها، ففي هذه الحالة فقط يحق له أن يحصل على درجة الاجتهاد بالرأي." ويرى المؤلف أن الاختلاف بين هذه المذاهب وتعددها هو اختلاف شكلي؛ فهو إما أن يرجع إل عدم فهم اللغة وطبيعتها أو إلى الميل مع الهوى والرغبة في التحزب، كما يرى أن السبب الحقيقي وراء كل ذلك هو عدم فهم مقاصد الشارع من وضع الشريعة. ولكى نفهم مقصد الشارع؛ علينا مراعاة القواعد التي أقرتها المقاصد لتوحيد المختلفين.
وفي الفصل الثالث يتناول المؤلف علاقة علم أصول الفقه بالعلوم الفلسفية والصوفية من خلال عرضه لموقف الشاطبي من الفلسفة؛ فيرى أن أهل الأندلس كانوا ذوو "عقلية عملية" تحاول الابتعاد عن الأفكار النظرية التي لا تؤدي إلى عمل، وكذلك كان الشاطبي؛ فقد رأى أن الفلاسفة والمتكلمين قد خاضوا في مشكلات خارجة وبعيدة عن الواقع العملي للإنسان، ويرى المؤلف أن التفلسف عند الشاطبي يعتمد بصفة أساسية على رفض الأفكار الميتافيزقية كما يرفض بناء المذاهب بناءً شامخًا بعيدًا عن واقع الإنسان، ولذلك تختلف الفلسفة عند الشاطبي عما عهدناه عند الفلاسفة، فقد رأى أن دور الفلسفة: العمل على ربط الإنسان بواقعه. ويرى المؤلف أن علم الأصول رفع من قدر العقل حتى جعله مناظرًا للشرع في كل أمر، وأن المقاصد وضعت معيارًا للتصوف.
وفي الفصل الرابع يدرس المؤلف منهج الاستقراء المعنوي عند الشاطبي مبينًا طبيعته، ويرى أن هذا المنهج هو المنهج الوحيد الذي يصلح للدراسات الإنسانية، بعد أن فشل المنهج العلمي في تحويل الدراسات الإنسانية إلى دراسات علمية بحتة.
وفي الفصل الخامس يدرس المؤلف الأساس الذي تقوم عليه فكرة القيم في المقاصد؛ فيرى أن المصلحة هي الغاية من وضع الشريعة، وهي تتحقق إذا حافظنا على الضروريات. ويبين أن هناك قيمًا خمسةً ضروريةً ضرورةً مطلقةً، وأن الحفاظ عليها يتم في مراتب ثلاث؛ الأولى هي مرتبة الضروريات، والثانية هي مرتبة الحاجيات، والثالثة هي مرتبة التحسينات وبين العلاقة بين هذه المراتب بعضها والبعض الآخر؛ فالأولى هي الأصل والأساس والثانية مكملة للأولى، والثالثة مجملة ومزينة للأولى والثانية. ثم بين كيف أنها في مجموعها تشكل وحدة بحيث لا يمكن أن نقول بأن هذه أولى من تلك، كما بين أن هذه القيم الخمس هي قيم وسيلية تنتهى بقيمة غائية وهي المصلحة، وهي تختلف عن المصلحة في الاستعمال الدارج لها، وتختلف عن المصلحة التي استعملها "برتراند راسل"، وتتميز بخصائص عدة عن مذهب المنفعة العامة، ومذاهب اللذة في أنها عامة، ولكن ليس معنى العمومية أنها لا تقبل الاستثناء كما هو الحال في عمومية «كانت» وإنما عموميتها هي في أن الاستثناء طالما لا يشكل قاعدة تقف في مقام القاعدة الأصلية فهذا الاستثناء لا قيمة له، كما أنها مصلحة كلية بحيث لا تخص فردًا أو تميزه عن غيره، وكذلك هي مصلحة مطلقة ولذلك أطلق علماء أصول الفقه عليها اسم المصلحة المرسلة.
وفى الفصل السادس درس المؤلف العلاقة بين المصلحة من حيث هي قيمة خلقية وبين النية من حيث ارتباطها بالفعل، وأوضح أن هناك معيارًا يمكن من خلاله أن نميز النية الصالحة من النية السيئة أو الحيلة؛ فلا بد من "معيار تجريبي" يمكن من خلاله الحكم على نوعية النية، ولذلك يرى المؤلف أن الشاطبي ربط بين النية وبين القيم الخمس الضرورية، ورأى أن النية الطيبة تتحقق إذا كان قصد الإنسان من عمله موافقًا لهذه المقاصد، فإذا اتحد القصدان تحققت النية الطيبة وإذا لم يتحدا كانت خلاف ذلك أَيْ نية سيئة. وبيَّن أن هناك نوعًا من التحيل قد يكون مقبولًا وذلك إذا كان يعمل على الحفاظ على القيم الضرورية وهو يختلف عن سوء النية التي أقرها ميكافيلي مبدءًا خلقيًا في سياسته للأمير.
وفى الفصل السابع تكلم عن الامتثال وعلاقته بالفعل، وبيَّن أن الامتثال لا بد وأن يكون ضرورة بحيث لا يمكن أن يحيا الإنسان حياة صالحة دون أن يكون مقيدًا بقواعد يسير وفقًا لها ويعمل من أجلها، وأن هذا الامتثال محكوم بقدرة الإنسان عل القيام بالفعل، وأن هناك حدودًا للقدرة، وما يخرج عن تلك الحدود أطلق عليه علماء الأصول التكليف بما لا يطاق، وبين أن هذا النوع من الأفعال ليس له وجود في الشريعة، ولا يجوز لأن الشريعة قد اكتملت ولا يجوز أن يضاف إليها نصوص جديدة.
وفي الخاتمة يوضح أن من الحقائق المهمة التي يبينها البحث؛ أن الوحي من الناحية التاريخية هو المصدر الذي صدر عنه الأخلاق؛ فقد أوضح أن مقاصد الوحي هي المصلحة العامة؛ وهي أساس التشريع والحالة القصوى الأخلاقية، ويرى أن هذه الحالة -في نظره- لم يكن باستطاعتنا استخلاصها من الوحي مباشرة؛ لذلك يرى من وجهة نظره أنه كان لا بد من تحويل الفكر الديني إلى فكر نظري وأن ذلك لم يكن مستطاعًا إلا من خلال علم أصول الفقه حتى نصل إلى المبدأ العام الذي تقوم عليه فكرة المصلحة. ويبين كيف أن هذه القضايا التي وردت في البحث تكوِّن نظرية في الأخلاق تتميز عن كل النظريات الفلسفية وتهدف إلى إيجاد قيم أساسية مشتركة للحياة.
رابط مباشر لتحميل الكتاب