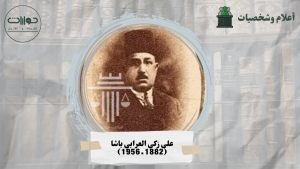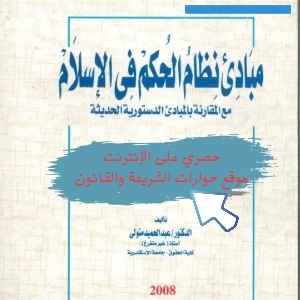في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في 18 ديسمبر 2023، خلصت فيه إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل جريمة حرب. يتعمد الجيش الإسرائيلي منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدًا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
منذ هجوم حركة "حماس" على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدلى مسؤولون كبار من دولة الاحتلال الإسرائيلي، منهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، بتصريحات علنيّة أعربوا فيها عن نيّتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء، والمياه، والوقود – هذه التصريحات تعكسها العمليات البرية للجيش الإسرائيلي. وصرّح مسؤولون إسرائيليون آخرون علنًا بأن المساعدات الإنسانية لغزة ستكون مشروطة إما بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس أو بتدمير الحركة.
قال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة".
قابلت هيومن رايتس ووتش 11 فلسطينيا نازحًا في غزة بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني و4 ديسمبر/كانون الأول. ووصفوا الصعوبات الشديدة التي يواجهونها في تأمين الضروريات الأساسية. قال رجل غادر شمال غزة: "لم يكن لدينا طعام، ولا كهرباء، ولا إنترنت، لا شيء على الإطلاق. لا نعرف كيف نجونا".
وفي جنوب غزة، وصف الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات ندرة المياه الصالحة للشرب، ونقص الغذاء الذي أدى إلى خلو المتاجر والطوابير الطويلة، والأسعار الباهظة. قال أب لطفلين: "تبحث باستمرار عن الأشياء اللازمة لتعيش". أفاد "برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة" في 6 ديسمبر/كانون الأول أن 9 من كل 10 أسر في شمال غزة وأسرتين من كل ثلاثة في جنوب غزة أمضوا يوما كاملًا وليلة كاملة على الأقل دون طعام.
يحظر القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وينص "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أن تجويع المدنيين عمدًا "بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية" هو جريمة حرب. لا يتطلب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، ولكن يمكن أيضًا استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية.
كما أن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلًا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاما، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية.
في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، حذّر برنامج الأغذية العالمي من "احتمال مباشر" للموت جوعًا، مسلطا الضوء على أن إمدادات الغذاء والمياه كانت معدومة عمليًا. وفي 3 ديسمبر/كانون الأول، أبلغ عن "تهديد كبير بالمجاعة"، ما يشير إلى أن النظام الغذائي في غزة كان على وشك الانهيار. في 6 ديسمبر/كانون الأول، أعلن أن 48٪ من الأسر في شمال غزة و38٪ من النازحين في جنوب غزة مرّوا بـ "مستويات حادة من الجوع".
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن "المجلس النرويجي للاجئين" أن غزة تواجه "كارثة في احتياجاتها للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الشخصية". وأُغلقت مرافق الصرف الصحي وتحلية المياه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول بسبب نقص الوقود والكهرباء، وأصبحت غير صالحة للعمل إلى حد كبير منذ ذلك الحين، وفقا لـ "سلطة المياه الفلسطينية". وحتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للأمم المتحدة، لم يكن في غزة تقريبًا مياه صالحة للشرب.
قبل الأعمال القتالية الحالية، كان يقدّر أن 1.2 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون انعداما حادًا في الأمن الغذائي، وأكثر من 80٪ منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية. تمارس إسرائيل سيطرة شاملة على غزة، تشمل حركة الأشخاص والبضائع، والمياه الإقليمية، والمجال الجوي، والبنية التحتية التي يعتمد عليها القطاع، وسجل السكان. يجعل ذلك سكان غزة، الذين تخضعهم إسرائيل لإغلاق غير قانوني منذ 16 عاما، يعتمدون بشكل شبه كامل على إسرائيل للحصول على الوقود، والكهرباء، والدواء، والغذاء، والسلع الأساسية الأخرى.
بعد فرض "الحصار التام" على غزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، استأنفت السلطات الإسرائيلية ضخ المياه إلى بعض أجزاء جنوب غزة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ومنذ 21 أكتوبر/تشرين الأول سمحت بوصول مساعدات إنسانية محدودة عبر معبر رفح مع مصر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 18 أكتوبر/تشرين الأول إن إسرائيل لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية "على شكل الغذاء والأدوية" إلى غزة عبر معابرها "طالما لم تتم إعادة رهائن [إسرائيل]".
واصلت الحكومة منع دخول الوقود حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، رغم التحذيرات من العواقب الوخيمة لذلك، ما تسبب بإغلاق المخابز، والمستشفيات، ومحطات ضخ الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، والآبار. وهذه المرافق، التي لم تعد صالحة للاستعمال، لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. ورغم السماح بدخول كميات محدودة من الوقود لاحقًا، إلا أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز وصفتها في 4 ديسمبر/كانون الأول بأنها "ليست كافية على الإطلاق". وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، وافقت حكومة الطوارئ الإسرائيلية على زيادة "بقدر الحد الأدنى" في إمدادات الوقود إلى جنوب غزة.
في 1 ديسمبر/كانون الأول، مباشرة بعد وقف إطلاق النار لسبعة أيام، استأنف الجيش الإسرائيلي قصف غزة ووسّع هجومه البري، قائلا إن عملياته العسكرية في الجنوب "لن تقل قوة" عما هي عليه في الشمال. وبينما قال مسؤولون أمريكيون إنهم حثوا إسرائيل على السماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة بنفس مستويات فترة وقف إطلاق النار، قالت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في 1 ديسمبر/كانون الأول إنها أوقفت دخول جميع المساعدات. استؤنفت عمليات تسليم المساعدات المحدودة في 2 ديسمبر/كانون الأول، لكنها ما تزال بمستويات غير كافية إلى حد كبير، وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا).
وإلى جانب الحصار الساحق، ألحقت غارات الجيش الإسرائيلي الجوية المكثفة على القطاع أضرارا واسعة أو دمرت المواد الضرورية لبقاء السكان المدنيين. قال خبراء أمميون في 16 نوفمبر/تشرين الثاني إن الأضرار الجسيمة "تهدّد باستحالة استمرار الحياة للشعب الفلسطيني في غزة". الجدير بالذكر أنّ قصفَ الجيش الإسرائيلي آخر مطحنة قمح عاملة في غزة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني يضمن عدم إنتاج الدقيق محليا في غزة في المستقبل المنظور، كما أبرزت أوتشا. وقال "مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات" إن تدمير شبكات الطرق صعّب على المنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها.
قال سكوت بول، مستشار أول للسياسات الإنسانية في "أوكسفام أمريكا"، لـ "أسوشيتد برس" في 23 نوفمبر/تشرين الثاني: "تدمرت المخابز ومطاحن الحبوب، ومرافق الزراعة والمياه والصرف الصحي".
وكان للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أيضًا تأثير مدمر على قطاعها الزراعي. وفقا لـ أوكسفام، بسبب القصف المستمر، إلى جانب نقص الوقود والمياه، ونزوح أكثر من 1.6 مليون شخص إلى جنوب غزة، أصبحت الزراعة شبه مستحيلة. في تقرير صادر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت أوتشا إن الماشية في الشمال تواجه التجويع بسبب نقص العلف والمياه، وإن المزارعين يهجرون محاصيلهم بشكل متزايد وبات التلف يصيب المحاصيل بسبب شح الوقود اللازم لضخ مياه الري. وأدت المشاكل القائمة، مثل شح المياه وتقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية القريبة من السياج الحدودي، إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها المزارعون المحليون، الذين نزح العديد منهم. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، قال "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" إن خسائر غزة اليومية في الإنتاج الزراعي لا تقل عن 1.6 مليون دولار أمريكي.
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد "قطاع الأمن الغذائي الفلسطيني"، الذي يقوده برنامج الأغذية العالمي و"منظمة الأغذية والزراعة"، أن الأعمال القتالية دمرت أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في الشمال. تُشير صور الأقمار الصناعية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش إلى أنه منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول، تم تجريف أراضٍ زراعية، منها البساتين والبيوت البلاستيكية والمزارع في شمال غزة، على يد الجيش الإسرائيلي على ما يبدو.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب. عليها الالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وترفع حصارها عن قطاع غزة. على الحكومة أن تعيد توفير المياه والكهرباء، وتسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم.
على الحكومات المعنية مطالبة إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات. كما على الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما يستمر جيشها بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.
قال شاكر: "تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح الحرب. الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي".
الخلفية
أسفرت الهجمات التي قادتها حركة حماس في جنوب الأراضي المحتلة والتي تضم مستوطنات صهيونية في 7 أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل 1,200 إسرائيلي وأجنبي على الأقل، وأخذ أكثر من 200 شخص كرهائن، وأدى رد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقصف والهجوم البري إلى مقتل أكثر من 18,700 فلسطيني، بينهم أكثر من 7,700 طفل، وفقا لسلطات غزة.
صرّح خبراء أمميون في 16 نوفمبر/تشرين الثاني أن نصف البنية التحتية المدنية في غزة قد تدمر. وأفادت "أوتشا" أنه حتى 10 ديسمبر/كانون الأول، دمر قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أو أصاب بأضرار أكثر من نصف الوحدات السكنية في غزة، وفقًا لوزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، بالإضافة إلى مستشفيات، ومدارس، ومساجد، ومخابز، وأنابيب مياه، وشبكات صرف صحي، وشبكات كهرباء. في 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني وحدهما، وفقا لـ أوتشا، تعرضت سبعة مرافق مياه في مختلف أنحاء القطاع لقصف مباشر وتضررت بشكل جسيم، منها خزانات المياه في مدينة غزة، ومخيم جباليا للاجئين، ورفح.
تمعن هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة وغير القانونية المفترضة على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، ما يعيق حصول السكان على العلاج المنقذ للحياة، بما فيه الوقاية من الأمراض، والهزال، والوفيات المرتبطة بسوء التغذية، ما يفاقم الوضع المزري. قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في 28 نوفمبر/تشرين الثاني: "سنرى أن الناس يموتون بسبب الأمراض أكثر من القصف إذا لم نتمكن من ترميم هذا النظام الصحي".
العواقب الإنسانية
في 13 أكتوبر/تشرين الأول، أمرت السلطات الإسرائيلية أكثر من مليون شخص بمغادرة شمال غزة خلال 24 ساعة؛ كانت هذه الأوامر مستحيلة التنفيذ. منذئذ، ومع تدهور الأوضاع في الشمال، نزح مئات الآلاف إلى محافظتي رفح وخان يونس في الجنوب، حيث تزداد صعوبة تأمين سبل البقاء على قيد الحياة. بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف تضمن حصول النازحين على المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما فيها ما يكفي من الغذاء والعمل، وإلا فقد تصبح تهجيرًا قسريًا. تُحظر عمليات الإجلاء التي تزيد احتمال التجويع.
العواقب الإنسانية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وخيمة. خلال الأسابيع الثمانية الأولى من القتال، كان شمال غزة محور الهجوم الجوي المكثف للجيش الإسرائيلي، ثم الهجوم البري لاحقا. باستثناء وقف إطلاق النار الذي استمر سبعة أيام بدءا من 24 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي أدخلت خلاله قوافل الأمم المتحدة كميات محدودة من الدقيق والبسكويت عالي الطاقة، قُطع وصول المساعدات إلى الشمال إلى حد كبير. بين 7 نوفمبر/تشرين الثاني وعلى الأقل 15 نوفمبر/تشرين الثاني، لم تعد أي مخابز تزاول عملها في الشمال بسبب نفاد الوقود، والمياه، ودقيق القمح، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بها، بحسب أوتشا.
بحسب "برنامج الأغذية العالمي"، هناك خطر جدي من التجويع والمجاعة في غزة. قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان غزة، نازحون داخليًا، وقالوا إن الظروف في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة الآخذة في التقلص قد تصبح "كالجحيم أكثر فأكثر".
صرّح كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في 5 ديسمبر/كانون الأول أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة أدت إلى ظروف "مروعة"، ما جعل من المستحيل القيام بعمليات إنسانية مجدية.
حتى 6 ديسمبر/كانون الأول، كانت محطة تحلية المياه الوحيدة في شمال غزة معطلة، وظل خط الأنابيب الذي يزود الشمال بالمياه من إسرائيل مغلقا، ما يزيد خطر الجفاف وتفشي الأمراض المنقولة بالمياه بسبب تناول المياه من مصادر غير آمنة. تضررت المستشفيات بشكل خاص، فحتى 14 ديسمبر/كانون الأول، كان ما زال واحد فقط من أصل 24 مستشفى في شمال غزة يعمل وقادرًا على استقبال مرضى جدد، ولكن بقدرات محدودة.
في جميع أنحاء قطاع غزة، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول، وقطع الاتصالات أكثر من مرة الذي حرم الناس من المعلومات الموثوقة بشأن السلامة والخدمات الطبية الطارئة، وأعاق بشدة العمليات الإنسانية. إذ قالت أوتشا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني إن انقطاع الاتصالات بين 16 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الرابع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تسبب في "وقف عمليات تقديم المساعدات الإنسانية التي تواجه التحديات بالفعل وقفا تاما تقريبا، بما تشمله من المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المصابين أو المحاصرين تحت الأنقاض نتيجة للغارات الجوية والاشتباكات".
منذ بداية الهجوم البري للجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول، تشير صور الأقمار الصناعية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش إلى أن البساتين والخيم الزراعية والأراضي الزراعية في شمال غزة دُمرت، على ما يبدو من قِبل القوات الإسرائيلية، ما يفاقم المخاوف من انعدام الأمن الغذائي الشديد وفقدان سبل العيش. تشير صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تجريف الأراضي الزراعية في شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار الذي استمر سبعة أيام، والذي بدأ في 24 نوفمبر/تشرين الثاني وانتهى في 1 ديسمبر/كانون الأول، عندما كان الجيش الإسرائيلي يسيطر مباشرة على المنطقة.
في حين سمحت الحكومة الإسرائيلية بتدفق مستمر ومتزايد قليلا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر سبعة أيام وانتهى في 1 ديسمبر/كانون الأول، بما فيها غاز الطهي للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإنها كانت قد تعمدت عرقلة إمدادات الإغاثة بالكميات اللازمة لأكثر من شهر، تزامنا مع الحصار الذي فرضته وأثّر على جميع السكان المدنيين. ساهم ذلك في نشوء وضع إنساني كارثي له عواقب بعيدة المدى، حيث نزح أكثر من 80% من السكان، ولجأ عديد منهم إلى أماكن مكتظة غير نظيفة أو صحية في مراكز إيواء أممية في الجنوب. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني إن المساعدات التي دخلت خلال وقف إطلاق النار "بالكاد تلبي الاحتياجات الهائلة لـ 1.7 مليون نازح".
كانت نحو 200 شاحنة، بينها أربعة صهاريج تحمل ما يصل إلى 130 ألف لتر من الوقود وأربعة صهاريج تحمل غاز الطهي، تدخل إلى غزة في كل يوم من أيام وقف إطلاق النار. بالمقارنة مع ذلك، كان يدخل غزة ما متوسطه 500 شاحنة من المواد الغذائية والسلع كل يوم قبل النزاع، وهناك حاجة إلى 600 ألف لتر من الوقود في غزة يوميا فقط لتشغيل محطات ضخ المياه وتحليتها. مع استئناف القصف وتقدم القوات الإسرائيلية جنوبًا، تعّرض وصول المساعدات لعقبات ضخمة مرة أخرى. في 5 ديسمبر/كانون الأول، ولليوم الثالث على التوالي، أفادت أوتشا أن محافظة رفح في غزة هي الوحيدة التي توزعت فيها كميات محدودة من المساعدات، وإن توزيع المساعدات في محافظة خان يونس المجاورة توقف إلى حد كبير بسبب شدة القتال.
شهادات مدنيين في غزة
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 11 مدنيًا غادروا شمال غزة إلى منطقة آمنة في الجنوب بسبب القصف العنيف، أو خوفًا من غارات جوية وشيكة، أو لأن إسرائيل أمرتهم بالمغادرة. قال عديد منهم إنهم نزحوا عدة مرات قبل أن يصلوا إلى الجنوب بينما عانوا للعثور على ملاجئ مناسبة وآمنة طوال رحلتهم. في الجنوب، وجدوا ملاجئ مكتظة، وأسواقا فارغة، وأسعارًا مرتفعة، وطوابير طويلة للحصول على إمدادات محدودة من الخبز ومياه الشرب. لحماية هوياتهم، استخدمت هيومن رايتس ووتش أسماء مستعارة لجميع من أجريت معهم مقابلات.
قال مروان (30 عاما)، الذي فر إلى الجنوب مع زوجته الحامل وطفليه في 9 نوفمبر/تشرين الثاني: "عليّ أن أمشي ثلاثة كيلومتر للحصول على غالون واحد [من الماء]. ولا يوجد طعام. إذا تمكنا من العثور على طعام، فهو طعام معلّب. جميعنا لا نأكل جيدًا".
قالت هناء (36 عاما)، التي فرت من منزلها في الشمال إلى خان يونس في الجنوب مع والدها، وزوجته، وشقيقها في 11 أكتوبر/تشرين الأول: "ليس لدينا ما يكفي من أي شيء". قالت إنهم في الجنوب لا يحصلون دائمًا على المياه النظيفة، ما يجبرهم على شرب المياه المالحة وغير الصالحة للشرب.
أضافت هناء أن الاستحمام أصبح رفاهية بسبب عدم توفر وسائل تسخين المياه، ما يتطلب منهم البحث عن الخشب. وأنه في الحالات الصعبة، يلجؤون حتى إلى حرق الملابس القديمة للطهي. عملية صنع الخبز لها تحدياتها الخاصة بسبب شحّ المكونات التي لا يستطيعون تحمل تكلفتها. قالت: "نصنع خبزًا رديئًا لأننا لا نملك جميع المكونات ولا نستطيع تحمل ثمنها".
قال ماجد (34 عاما)، الذي فر مع زوجته وأطفاله الأربعة الباقين على قيد الحياة إلى الجنوب في 10 نوفمبر/تشرين الثاني تقريبًا، إنه رغم أن الوضع في الجنوب كان سيئًا، إلا أنه لا يقارَن بما اضطر إلى تحمله هو وعائلته أثناء إقامتهم في الشمال. كانوا في منطقة قريبة من مستشفى الشفاء في مدينة غزة لمدة تزيد قليلا عن شهر بعد قصف منزلهم في 13 أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى مقتل ابن ماجد البالغ من العمر 6 سنوات: "في تلك الأيام الـ 33 لم يكن لدينا خبز لأنه لم يكن هناك دقيق. لم تكن هناك مياه - كنا نشتري الماء، أحيانا بـ 10 دولارات [أمريكية] للكوب. لم يكن صالحا للشرب دائما. في بعض الأحيان، كان [الماء الذي نشربه] يأتي من الحمام وأحيانا من البحر. كانت الأسواق المحيطة بالمنطقة فارغة. لم يكن هناك حتى طعام معلّب".
وصف طاهر (32 عاما)، الذي فر جنوبا مع عائلته في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ظروفا مماثلة في مدينة غزة في الأسابيع الأولى من نوفمبر/تشرين الثاني: "نفد كل شيء من المدينة، الطعام والماء. إذا وجدت طعامًا معلبًا، فالأسعار مرتفعة جدا. قررنا أن نأكل مرة واحدة فقط في اليوم من أجل البقاء أحياء. كان المال ينفد منا. قررنا أن نحصل على الضروريات فقط، وأن نحصل على كمية أقلّ من كل شيء".
المعايير الدولية والأدلة على الأفعال المتعمدة
تجويع المدنيين كأسلوب الحرب محظور بموجب المادة 54 (1) من "البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف" والمادة 14 من "البروتوكول الإضافي الثاني". رغم أن إسرائيل ليست طرفًا في البروتوكولين الأول والثاني، إلا أن الحظر معترف به باعتباره يمثّل القانون الإنساني الدولي العرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. لا يجوز لأطراف النزاع "التسبب عمدا [بالتجويع]" أو التسبب عمدا في "معاناة السكان من الجوع، ولا سيما عبر حرمانهم من مصادر الغذاء أو الإمدادات".
يُحظر على الأطراف المتحاربة أيضًا مهاجمة الأهداف التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل الإمدادات الغذائية والطبية، والمناطق الزراعية، ومنشآت مياه الشرب. الأطراف ملزمة بتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية السريعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية عمدًا أو تقييد حرية حركة موظفي الإغاثة الإنسانية. في جميع حروبها الأربع السابقة في غزة منذ 2008، أبقت إسرائيل تدفق مياه الشرب والكهرباء إلى غزة وفتحت المعابر الإسرائيلية لتوصيل المساعدات الإنسانية.
الدليل على نية استخدام التجويع عمدًا كوسيلة حرب يمكن إظهاره من خلال التصريحات العلنية للمسؤولين المشاركين في العمليات العسكرية. من المتوقع أن يلعب المسؤولون الإسرائيليون الكبار المذكورون أدناه دورًا مهما في تحديد السياسة بشأن السماح بوصول الغذاء والضروريات الأخرى إلى السكان المدنيين أو منعه.
في 9 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الدفاع يوآف غالانت: "نفرض حصارًا كاملًا على [غزة]. لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا غاز – كل شيء مغلق. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك".
قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في تغريدة بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول: "طالما لم تطلق حماس سراح الرهائن – الشيء الوحيد الذي يجب أن يدخل غزة هو مئات الأطنان من متفجرات سلاح الجو – ولا ذرة واحدة من المساعدات الإنسانية".
قال وزير الطاقة يسرائيل كانتس، الذي صرّح بأنه أمر بقطع الكهرباء والمياه، في 11 أكتوبر/تشرين الأول:
لسنوات، قدّمنا إلى غزة الكهرباء والماء والوقود. وبدلًا من الشكر أرسلوا آلاف الحيوانات البشرية للذبح والقتل والاغتصاب، وخطف الأطفال، والنساء، والشيوخ. لهذا قررنا قطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود، والآن انهارت محطة توليد الكهرباء المحلية، ولا يوجد كهرباء في غزة. سنواصل فرض حصار محكم حتى يُرفع تهديد حماس عن إسرائيل والعالم. ما كان سائدا لن يستمر.
قال كانتس في 12 أكتوبر/تشرين الأول:
مساعدات إنسانية لغزة؟ لن يتم الضغط على مفتاح كهرباء، ولن يُفتح صنبور، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود الرهائن الإسرائيليون إلى ديارهم. إنسانية مقابل إنسانية. فلا يحاضرنا أحد عن الأخلاق.
وقال في 16 أكتوبر:
أيدتُ الاتفاق بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس بايدن لتزويد جنوب قطاع غزة بالمياه لأنه يتوافق مع المصالح الإسرائيلية أيضًا. أنا أعارض بشدة رفع الحصار والسماح بدخول البضائع إلى غزة لأسباب إنسانية. التزامنا تجاه عائلات القتلى والرهائن المختطفين – وليس القتلة من حماس والأشخاص الذين ساعدوهم.
في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموترتش أنه لا يجوز دخول الوقود إلى غزة "تحت أي ظرف كان". ووصف لاحقًا قرار مجلس الحرب الإسرائيلي بالسماح بدخول كميات صغيرة إلى القطاع بأنه "خطأ فادح"، وطالب بـ "وقف هذه الفضيحة فورا ومنع دخول الوقود إلى القطاع"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
وفي فيديو نُشر على الإنترنت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قال العقيد يوغيف بار شيشت، نائب رئيس "الإدارة المدنية"، في مقابلة من داخل غزة: "من يعود إلى هنا، إذا عاد إلى هنا بعد ذلك، سيجد أرضًا محروقة. لا بيوت، لا زراعة، لا شيء. ليس لديهم مستقبل".
في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، قال مارك ريغيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع "سي إن إن"، إن إسرائيل تحرم غزة من الوقود منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لتعزيز موقف إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن، وقال: "لو أننا فعلنا ذلك [سمحنا بدخول الوقود]... لما تمكنّا من إخراج رهائننا قط".
في 1 ديسمبر/كانون الأول، قال منسق أعمال الحكومة في المناطق في وزارة الدفاع اللواء غسان عليان إن دخول الوقود والمساعدات إلى غزة توقف بعد خرق حماس شروط اتفاق وقف إطلاق النار. أكد مكتبه تصريحه ردا على استفسار لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قائلا: "بعد أن انتهكت منظمة حماس الإرهابية الاتفاق، بالإضافة إلى إطلاق النار على إسرائيل، تم وقف دخول المساعدات الإنسانية بالطريقة المنصوص عليها في الاتفاق".
دعا مسؤولون آخرون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى دخول محدود للمساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلين إن ذلك يخدم الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
أجاب رئيس الوزراء نتنياهو في 5 ديسمبر/كانون الأول على سؤال حول احتمال خسارة إسرائيل نفوذها ضد حماس إذا سمحت بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلًا: "جهود الحرب مدعومة بالجهود الإنسانية... وهذا لأننا نتبع قوانين الحرب لأننا نعلم أنه إذا حدث انهيار – أمراض وأوبئة، وعدوى في المياه الجوفية – فسوف يتوقف القتال".
قال وزير الدفاع غالانت: "نحن مطالبون بالسماح بالحد الأدنى الإنساني للسماح باستمرار الضغط العسكري".
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في مؤتمر صحفي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني: "إذا كان هناك وباء، سيتوقف القتال. إذا كانت هناك أزمة إنسانية واحتجاجات دولية، فلن نتمكن من مواصلة القتال في تلك الظروف."
في 18 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن إسرائيل لن تمنع المساعدات الإنسانية من دخول غزة من مصر بعد ضغوط من الولايات المتحدة وحلفاء دوليين آخرين، وأضاف: "في ضوء مطلب الرئيس بايدن، لن تمنع إسرائيل الإمدادات الإنسانية من مصر طالما أنها تقتصر على الغذاء، والماء، والدواء للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة".
تدمير المنتجات الزراعية وأثره على إنتاج الغذاء
خلال العمليات البرية في شمال غزة، يبدو أن القوات الإسرائيلية دمرت المنتجات الزراعية، ما فاقم نقص الغذاء مع ما لذلك من آثار طويلة المدى. شمل ذلك تجريف البساتين، والحقول، والخيم الزراعية.
قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى عمليات عسكرية في منطقة بيت حانون، شملت منطقة زراعية لم يكشف عنها في بيت حانون، لتأمين الأنفاق ولأهداف عسكرية أخرى.
مثلًا، تضررت الحقول والبساتين الواقعة شمال بيت حانون لأول مرة خلال الأعمال القتالية بعد العمليات البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول. شقّت الجرافات طرقًا جديدة، ما أتاح الطريق أمام المركبات العسكرية الإسرائيلية.
منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على المنطقة نفسها في شمال شرق غزة، تظهر صور الأقمار الصناعية أن البساتين والحقول والخيم الزراعية دُمّرت بشكل منهجي، ما خلف الرمال والأتربة. تواصلت هيومن رايتس ووتش مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق في 8 ديسمبر/كانون الأول، لكنها لم تتلق ردًا.
زرع المزارعون في هذه المنطقة محاصيل مثل الحمضيات، والبطاطس، وفاكهة التنين، والتين الشوكي أو الصبار، ما دعم سبل عيش الفلسطينيين في غزة. تشمل المحاصيل الأخرى الطماطم، والملفوف، والفراولة. جُرفت بعض الأراضي في يوم واحد. تحتاج أشجار الحمضيات، بالإضافة إلى نباتات الصبار التي تحمل فاكهة التنين، إلى سنوات من الرعاية حتى تنضج قبل أن تتمكن من إنتاج الفاكهة.
تُظهر صور الأقمار الصناعية عالية الدقة استخدام الجرافات لتدمير الحقول والبساتين. يمكن رؤية آثار سير الجرافات، بالإضافة إلى أكوام من التراب على أطراف الأراضي الزراعية السابقة.
سواء كان السبب يعود إلى التجريف المتعمد، أو الأضرار الناجمة عن القتال، أو عدم القدرة على ري الأرض أو استصلاحها، فقد تقلصت الأراضي الزراعية في شمال غزة بشكل كبير منذ بداية العمليات البرية الإسرائيلية.
كما تضررت المزارع والمزارعون في جنوب غزة. وجدت منظمة "العمل ضد الجوع" أن من بين 113 مزارعًا من جنوب غزة شملهم الاستطلاع بين 19 و31 أكتوبر/تشرين الأول، قال 60% إن ممتلكاتهم و/أو محاصيلهم تضررت، و42% أنهم لا يستطيعون الحصول على المياه لري مزارعهم، و43% إنهم لم يتمكنوا من حصاد محاصيلهم.
_____________
المصدر: إسرائيل: استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، موقع: هيومَن رايتس وتش، 18 ديسمبر 2023، https://2u.pw/TRdZfEg