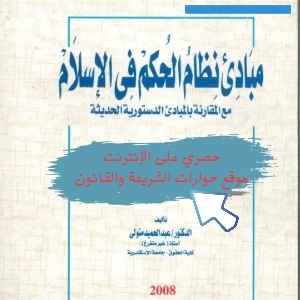يعد فهم العدالة الانتقالية أمرًا معقدًا بسبب تعدد أبعادها السياسية والاجتماعية والقانونية. يضاف إلى ذلك أن كل تجربة انتقالية تختلف حسب سياقها التاريخي والاجتماعي. وقد ازداد الاهتمام بهذا المفهوم في العالم العربي مع مرور عدة دول بمرحلة انتقالية بعد ثورات الربيع العربي، فأصبح هذا المفهوم مهمًا للدراسة والبحث.
أولًا: التعريف اللغوي:
العَدْلُ ضد الجور، (عَدَل، عدلًا، عدولًا)، يقال في حكمه عدل وعدالة: أي حكم بالعدل، عادل بين الشيئين: أي وازن بينهما وسوى الشيء بالشيء. والعدل هو الإنصاف؛ وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه. والعدالة هي إحدى الفضائل التي قال بها الفلاسفة من قيم الزمان؛ وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. يقال للرجل عدْل وللمرأة عدْل. وقد وردت في العديد من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على أهمية إقامة العدل في كل مجالات الحياة، قال الله تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواْ الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ" (النساء: 58). وقد استخدمت كلمة العدل والعدالة في أكثر من معنى باللغة العربية بيد أن أكثر استخدام لمعنى العدالة استقر في حقل حقوق الإنسان، ومن هنا وجدت رابطة صحيحة بين القانون الأخلاقي والعدالة، فهما مرتبطان لا ينفصلان وإن كانا مختلفين كل الاختلاف، فقاعدة العدالة مرتكزة على طبيعة الحوادث ذاتها، هذه الحوادث ليست أمورًا افتراضية اخترعها المشتركون وإنما حوادث حسبة مشاهدة.
أما الأصل المحدد لمفهوم العدالة الانتقالية فيتمثل في العدالة: حيث الاعتماد على ما يدركه الإنسان ذاته من القانون الأخلاقي، ذلك لأن القانون الأخلاقي هو الموجب على الإنسان احترام العدالة، أما الانتقالية: فهي اسم مؤنث منسوب إلى المصدر انتقل، فنقول حكومة انتقالية (السياسية) حكومة تتولى زمام الأمور فترة معينة حتى يعتمد نظام ثابت للحكم، ونقول أحكام انتقالية بـ (القانون) أي نصوص تشريعية مؤقتة ترعى الأحوال القائمة إلى أن يتم سن تشريعات دائمة. ونقل الشيء: حوله من موضع إلى موضع، والانتقال والتغيير من حال إلى حال، ومن موضع إلى آخر، فالانتقالي مكان غير دائم.
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للعدالة الانتقالية:
العدالة هي الاستقامة والمساواة أمام القانون، والإنصاف في الحقوق، وهناك شبه إجماع بين الباحثين في موضوع العدالة على أنها مجموعة القيم التي تراعى فيها حقوق الإنسان وترتبط بالحرية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وهي القيم التي تجيب على قضايا الديمقراطية والإصلاح.
أما الانتقالية فتعني من الناحية الاصطلاحية، تحول المجتمعات من نمط معين إلى آخر، وهنا لابد من توضيح أن العدالة الانتقالية تختلف عن العدالة التقليدية في كونها تعنى بالفترات الانتقالية؛ مثل الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة الحكم الديمقراطي أو التحرر من احتلال أجنبي بتأسيس حكم سياسي تسلطي إلى حالة الحكم الديمقراطي أو التحرر من احتلال أجنبي بتأسيس حكم محلي بإتباع إجراءات إصلاحية معينة، ومن هذا المنطلق تعرف العدالة الانتقالية بأنها مجموعة من الأساليب والآليات التي يستخدمها مجتمع ما لتحقيق العدالة بفترة انتقالية في تاريخه، وتنشأ هذه الفترة غالبًا بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب، ويترتب عليها انتهاء حقبة من الحكم الاستبدادي داخل البلاد والمرور بمرحلة انتقالية نحو تحول ديمقراطي. خلال هذه المرحلة تواجه المجتمع إشكالية مهمة جدًا وهي التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان سواء كانت حقوق جسدية أم قضايا سياسية أم اقتصادية.
ثالثًا: التعريف القانوني للعدالة الانتقالية:
لكون مصطلح العدالة الانتقالية حديث النشأة فقد تعددت تعاريفه، وسوف نتناول أهم التعريفات التي تناولته في النقاط التالية:
أ- تعرف العدالة الانتقالية على أنها: "إعادة إقامة القواعد التي تحكم العيش المشترك في المجتمع وتحديده، والعلاقة بين المواطن والمؤسسات، بمعنى آخر أن تؤسس لقواعد جديدة يكون على المؤسسات والأفراد احترامها".
ب- أنها استجابة للانتهاكات الممنهجة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، تهدف إلى تحقيق الاعتراف الواجب بما يكابده الضحايا من انتهاكات وتعزيز إمكانية تحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية، وهي نوع من المحاسبة والمسائلة يعيد ثقة المواطن في العقد الاجتماعي بينه وبين الدولة.
ج- تعريف الأمم المتحدة: "مجموعة كاملة من العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق، بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، مع تفاوت المشاركة الدولية (أو عدم وجودها مطلقا).
ه- العدالة الانتقالية طريق للمصالحة، وبناء لسلام دائم، والتعاون بين المحاكم الوطنية والمحاكم الجنائية، وسيكون من الممكن إجراء اتفاقات دولية، وخاصة إذا أفلتت الدول، ذلك إنهم يمثُلون تماما لالتزاماتهم القانونية، بما في ذلك وضع تشريعات داخلية، حسب الاقتضاء لتمكينها من الوفاء بالالتزامات الناشئة عن انضمامها إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية (ICC) أو غيرها من الصكوك الملزمة.
ج- تعريف كل من "هوغوفانديرميروي" و"فكتوريا باكستر" و"اوردري تشابمان"، يشيرون إلى أن العدالة الانتقالية هي الاستجابات المجتمعة للقمع الشديد، العنف المجتمعي، وحقوق الإنسان النظامية، التي تسعى إلى إثبات الحقيقة حول الماضي، وتحديد المسائلة، وتقديم شكل من أشكال الانتصاف، على الأقل من طبيعة رمزية، أضف إلى ذلك أن العدالة الانتقالية توفر مساحة للتصدي، والتوافق مع شقاء الماضي في مجموعة متنوعة من السياقات، كما هو الحال في المستوطنات، أو مجتمعات الصراع.
رابعًا: نشأة وتطور مفهوم "العدالة الانتقالية":
لقد تبلور مفهوم العدالة الانتقالية عبر مراحل مختلفة، أسهم كل سياق تاريخي خلالها في صياغة المفهوم لتصبح حقلا مستقلا، ويمكن تقسيم المراحل التاريخية لتطور المفهوم إلى ثلاث مراحل رئيسة:
المرحلة الأولى: يعد الكثير من الباحثين مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي المرحلة الأولى لتشكل المفهوم، وذلك من خلال محاكم نورمبورغ Nuremberg وطوكيو Tokyo؛ التي تمثل إنجازها في الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، في شكل يؤسس لعدالة بعيدة عن الانتقام، ورغم كل الملاحظات التي طالت محاكم ما بعد الحرب العالمية الثانية، فلا يخفى دور تلك المحاكم في تطوير الجنائية الدولية؛ إذ تمكنت من تعزيز الوعي الحقوقي على المستوى الدولي، عبر تأسيسها للبنية القانونية والتنظيمية لفكرة حقوق الإنسان.
المرحلة الثانية: ارتبطت تلك المرحلة لتطوير مفهوم العدالة الانتقالية بتسارع مرحلة الديمقراطية Democratization، والتحول السياسي التي عاشته الكثير من الدول، خلال الحرب الباردة، وحتى نهاية الثمانينيات، والتي شهدت حالات صراع داخلي وجرائم ضد الإنسانية متأثرة بالصراع الدولي. تميزت هذه المرحلة بانتشار لجان الحقيقة، فكان أول إنشاء لها في أوغندا عام 1974م تحت اسم لجنة التحقيق في الاختفاء القسري، ثم في بوليفيا سنة 1982م، وكذلك في الأرجنتين سنة 1983م للتحقيق في مصير ضحايا الاختفاء القسري، إبان الحكم العسكري بين 1976م و1983م.
المرحلة الثالثة: عدت مرحلة تشكل مفهوم العدالة الانتقالية بعد نهاية الحرب الباردة؛ إذ شاع استخدام المصطلح بين عدد من الأكاديميين الأمريكيين، لوصف الطرائق المختلفة التي عالجت بها البلدان مشاكل وصول أنظمة جديدة إلى السلطة، ومواجهتها للانتهاكات الجسيمة للحكومات السابقة، في هذه المرحلة أضحى مفهوم العدالة الانتقالية أكثر استقرارًا؛ إذ أصبحت أهداف المفهوم ووسائله ونهجه أوسع، فتضمن دور العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الصراع تنظيم العلاقات وقت السلم.
خامسًا: مراحل العدالة الانتقالية:
تمر العدالة الانتقالية بعدة مراحل متكاملة تعمل معًا لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وفيما يلي عرض لهذه المراحل:
- مرحلة الحقيقة: تتضمن الكشف عن الحقائق المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت في الماضي. يهدف هذا إلى توفير الاعتراف الرسمي بما حدث للضحايا، وتوثيق الجرائم، وإعطاء الفرصة للمجتمع لفهم الماضي بوضوح. في هذه المرحلة، قد تُنشأ لجان الحقيقة والمصالحة التي تعمل على جمع شهادات الضحايا والجناة، وتقديم تقارير توثق الجرائم والانتهاكات.
- مرحلة المساءلة: تتمثل في محاكمة مرتكبي الجرائم والمسؤولين عن الانتهاكات. قد تشمل هذه المحاكمات الأفراد الذين ارتكبوا الجرائم بشكل مباشر أو المسؤولين الحكوميين الذين كانوا وراء تلك الانتهاكات. العدالة الجنائية تعتبر جوهرية في تحقيق العدالة الانتقالية، وتساهم في إنهاء الإفلات من العقاب.
- مرحلة التعويض: تهدف إلى تقديم تعويضات للضحايا سواء مادية أم معنوية. قد يشمل ذلك تقديم التعويضات المالية للمتضررين أو توفير الرعاية الصحية والنفسية لهم. كما قد يشمل إعادة الممتلكات التي تم مصادرتها أو الاعتذار العلني للضحايا.
- مرحلة الإصلاحات المؤسسية: تشمل هذه المرحلة تعديل القوانين والسياسات وإصلاح المؤسسات الحكومية لضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات. يُعتبر إصلاح النظام القضائي والأمني من أهم عناصر هذه المرحلة لضمان عدم وقوع المزيد من التجاوزات والانتهاكات في المستقبل.
سادسًا: نماذج دول مرت بتجارب عدالة انتقالية:
مرت عدة دول بتجارب في العدالة الانتقالية، خصوصًا في أعقاب الثورات أو التغيرات السياسية الكبيرة. ومن أبرز هذه التجارب:
- شهدت الأرجنتين أعمال قمع واسعة النطاق تحت الحكم العسكري بين 1976 و1983، قضى فيها نحو 15 ألف شخص وعُدَّ ضعفهم مفقودين، وبلغ عدد السجناء الذين أُفرج عنهم بعد التحول الديمقراطي تسعة آلاف، في حين دَفعت سياسات القمع مليون ونصف المليون شخص إلى اللجوء، وبعد التحول السياسي عام 1983، أنشأ الرئيس ألفونسان لجنة وطنية للتحقيق ضمت حقوقيين ومنظمات أهلية وممثلين عن الكنيسة، وكانت الأولى من نوعها في العالم، وأسندت إليها مهمة التحقيق في الماضي الحقوقي للبلاد وكشف الجرائم المرتكبة ومنفذيها والمسؤولين عنها، ووضع الآليات الكفيلة بمنع وقوعها في المستقبل، وتُوّج ذلك المسار بمحاكمة أبرز قيادات النظام العسكري والحكم عليهم في 1986، لكن خليفة ألفونسان في الحكم كارلوس منعم، يُصدر عفوا عاما عن العسكريين في 1989.
- شهدت جنوب أفريقيا هي الأخرى تجربة العدالة الانتقالية بعد إلغاء نظام التمييز العنصري عام 1991، وشُكلت لجنة الحقيقة والمصالحة بقيادة القس ديزموند توتو، وعلى مدى ثلاث سنوات استمعت اللجنة لشهادات الآلاف من ضحايا "الأبارتايد"، وحُكم على الآلاف من المسؤولين وعناصر الشرطة، واستفاد آخرون من العفو الذي كان مشروطا بالاعتراف بالجريمة والتأكد من أنَّها ارتُكبت عن "حسن نية"، ومع ذلك فإنَّ تجربة جنوب أفريقيا تعثرت لعدم نفاذ العدالة وطول الإجراءات.
- تونس: تعتبر تونس واحدة من الدول العربية التي نجحت نسبيًا في تطبيق العدالة الانتقالية بعد الثورة التونسية عام 2011. أنشأت تونس هيئة الحقيقة والكرامة في عام 2013 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بين عامي 1955 و2013. عملت الهيئة على توثيق الانتهاكات وجمع شهادات الضحايا والجناة، مع تقديم توصيات للإصلاحات المؤسسية والتعويضات للضحايا.
- ليبيا: بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011، واجهت ليبيا تحديات كبيرة في محاولة تطبيق العدالة الانتقالية. على الرغم من محاولات محاكمة رموز النظام السابق وتقديم الجناة للمساءلة، إلا أن استمرار الصراع المسلح في ليبيا حال دون تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
- دشَّن المغرب، بعد جلوس الملك محمد السادس على العرش عام 1999، مسار عدالة انتقالية، كان هدفه إلقاء الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها البلاد بين 1956-1999، والتي تُعرف "بسنوات الرصاص"، وفي عام 2004 شُكَّلت لجنة الإنصاف والمصالحة، حيث استمعت لشهادات مئات الضحايا رغم أنَّه كان مفروضا على الشهود عدم ذكر أسماء جلاديهم، وهو ما جلبَ على التجربة الكثير من النقد، لا سيما في غياب أي محاكمة للضالعين في الانتهاكات، وإن كان يُحسب للتجربة إلقاء الضوء على تلك الحقبة المظلمة من تاريخ البلد، عُوّض الضحايا ماديا، وفضلا عن ذلك فإن التجربة عزَّزت حضور الهمّ الحقوقي في المشهد العام بالبلاد من خلال توصيات اللجنة، خاصة ما يتعلق منها بخلق هيئات للرقابة والرصد وتشجيع المجتمع المدني.
سابعًا: التحديات التي تواجه تطبيق العدالة الانتقالية في العالم العربي:
رغم النجاحات التي تحققت في بعض الدول، فإن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق العدالة الانتقالية في العالم العربي. من أبرز هذه التحديات:
- استمرار الصراع المسلح: في العديد من الدول العربية، مثل سوريا واليمن، لا تزال الصراعات المسلحة قائمة، مما يعوق أي جهود نحو تحقيق العدالة الانتقالية. الصراعات تمنع الوصول إلى الحقيقة، وتحول دون إمكانية محاسبة الجناة أو تعويض الضحايا.
- ضعف المؤسسات القضائية: العديد من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية تعاني من ضعف في النظام القضائي، وهو ما يشكل عائقًا أمام تحقيق العدالة. عدم استقلالية القضاء أو عدم وجود بنية تحتية قانونية قوية يعيق جهود المحاسبة.
- التوترات السياسية: التوترات السياسية بين الفصائل المختلفة في بعض الدول تجعل من الصعب تحقيق التوافق على آليات العدالة الانتقالية. هذا قد يؤدي إلى إعاقة العمليات القضائية أو تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة.
ثامنًا: مفهوم العدالة الانتقالية في الشريعة الإسلامية:
من المهم أن نلاحظ أن مفهوم العدالة –بصفة عامة- ليس غريبًا عن الشريعة الإسلامية، بل هو من الأسس الجوهرية التي بُنيت عليها المبادئ الإسلامية، في الشريعة الإسلامية. يشكل مفهوم العدالة جزءًا لا يتجزأ من النظام الأخلاقي والقانوني، فالعدالة ليست فقط قيمة اجتماعية، بل هي من أهم القيم الدينية التي دعا إليها الإسلام. القرآن الكريم والسنة النبوية يقدمان أدلة كثيرة على وجوب تحقيق العدالة، سواء في العلاقات الاجتماعية أم السياسية أم القضائية.
1. العدالة كمبدأ أساسي في الإسلام:
الإسلام يُعلي من شأن العدالة ويعتبرها أساس الحكم الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ" (النحل: 90). فالعدالة لا تقتصر فقط على النزاعات الفردية أو الصغيرة، بل تشمل الحكم بين الناس، سواء في الأمور الكبيرة أو الصغيرة. العدالة هنا ليست فقط في معاقبة الجاني، بل في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ورد الحقوق إلى أصحابها، ومنع الظلم والاستبداد.
2. القصاص والعقوبات في الشريعة الإسلامية:
أحد جوانب العدالة في الإسلام يتمثل في القصاص والعقوبات التي يقرها الشرع. القصاص هو نظام عقوبات يضمن أن الجاني يُعاقب بما يعادل جريمته، كما ورد في قوله تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة: 179). وهذا النظام يشمل الجرائم الكبرى مثل القتل أو الاعتداء الجسدي، وهو جزء من تحقيق العدالة الانتقالية من خلال المحاسبة، إضافة إلى القصاص، توفر الشريعة آليات أخرى للعقوبة تهدف إلى تحقيق الردع والإصلاح. الحدود، على سبيل المثال، هي عقوبات محددة شرعًا للجرائم الكبرى مثل الزنا والسرقة، والتي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام. في هذا السياق، يمكن رؤية نظام العقوبات في الإسلام كآلية للعدالة الانتقالية من خلال المساءلة عن الجرائم والانتهاكات.
3. التوبة والعفو كجزء من العدالة الانتقالية:
في الشريعة الإسلامية، لا تقتصر العدالة على العقاب والمساءلة، بل تتضمن أيضًا جوانب من التوبة والعفو. الإسلام يُشجع على التسامح والعفو عن الجناة الذين يعترفون بأخطائهم ويطلبون الصفح. يقول الله تعالى: "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ" (الشورى: 40). هذا البُعد من العدالة يمكن أن يتجلى في العدالة الانتقالية من خلال تسهيل المصالحة بين الأطراف المتنازعة، مع التركيز على إعادة بناء الثقة الاجتماعية، في هذا الإطار، تبرز مفاهيم التوبة والإصلاح كمبادئ مركزية. الجاني الذي يعترف بجريمته ويتوب قد يُمنح فرصة للعفو إذا كانت هناك نية صادقة للإصلاح، وهذا يتماشى مع أهداف العدالة الانتقالية في تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء المجتمع.
4. رد الحقوق والتعويض في الشريعة الإسلامية:
الشريعة الإسلامية تشدد على ضرورة رد الحقوق إلى أصحابها كجزء من تحقيق العدالة، وهذا المبدأ يتوافق مع أحد أركان العدالة الانتقالية المتمثل في تعويض الضحايا، الإسلام يُلزم الجاني بتعويض ضحاياه، سواء كان ذلك تعويضًا ماليًا (مثل الدية في حالة القتل) أم إعادة الممتلكات التي سُلبت بغير حق، وتعويض الضحايا في الإسلام يشمل جوانب مادية ومعنوية، وهو ما يتماشى مع مفهوم العدالة الانتقالية الحديثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمة عند أخيه من عرضه أو شيء، فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم"، مما يوضح أهمية رد الحقوق وإقامة العدل.
5. الإصلاح المؤسسي في ضوء الشريعة الإسلامية:
من المبادئ التي يدعو إليها الإسلام أيضًا الإصلاح المؤسسي لضمان أن العدالة تتحقق بشكل دائم ومستدام. الإصلاح المؤسسي يشمل إصلاح القضاء والنظام الإداري، وضمان استقلالية القضاء لتحقيق العدالة، وهو جزء أساسي من العدالة الانتقالية، والشريعة الإسلامية تشجع على تأسيس نظام حكم يقوم على العدل والشورى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أقاموا نظام حكم يقوم على هذا الأساس. كما جاء في حديث رسول الله: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، وهو ما يعكس أهمية مساءلة الحكام والمسؤولين وتحقيق العدالة.
6. العدالة الانتقالية في التاريخ الإسلامي:
شهد التاريخ الإسلامي العديد من الفترات التي يمكن أن تعتبر تطبيقًا عمليًا لمفهوم العدالة الانتقالية. على سبيل المثال، بعد الفتوحات الإسلامية، تعامل المسلمون مع الشعوب المفتوحة بطريقة تضمن حقوقهم وحمايتهم، كما حدث في صلح الحديبية وفتح مكة، ففي فتح مكة، قرر الرسول صلى الله عليه وسلم العفو عن معظم المشركين الذين حاربوه، وقال كلمته الشهيرة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، مما يمثل مثالًا على المصالحة والعفو كجزء من العدالة الانتقالية.
7. العدالة الانتقالية من منظور المقاصد الشرعية:
المقاصد الشرعية تقدم إطارًا واسعًا لتحقيق العدالة، حيث تهدف الشريعة إلى حماية الدين، النفس، العقل، النسل، والمال. العدالة الانتقالية، التي تسعى إلى إصلاح ما أفسدته الفترات السابقة، تتفق مع هذه المقاصد من خلال حفظ النفس والعقل وكرامة الإنسان. من هنا، يمكن القول إن العدالة الانتقالية في الشريعة الإسلامية ليست مجرد أدوات قانونية، بل هي جزء من نظام أوسع يسعى لتحقيق التوازن والعدل في المجتمع.
تاسعًا: العدالة الانتقالية بين الشريعة الإسلامية والقانون:
ترتبط بعلاقة تكاملية ومقارنة بين الأطر القانونية الحديثة المستندة إلى القانون الوضعي، والأطر الدينية القائمة على الشريعة الإسلامية. ويمكن توضيح العلاقة بينهما من خلال عدة جوانب:
1. الأساس القيمي والتشريعي:
في الشريعة الإسلامية: العدالة تمثل قيمة جوهرية محورية في الشريعة الإسلامية، وهي أساس الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. القرآن الكريم والسنة النبوية يشتملان على مبادئ قانونية وأخلاقية تؤكد على ضرورة تحقيق العدل والمساواة بين الناس، سواء في فترات السلم أم في فترات النزاع والتحول.
في القانون الوضعي: العدالة الانتقالية كإطار قانوني ظهر في العصر الحديث كنتيجة لتجارب العديد من الدول التي واجهت صراعات سياسية وانتهاكات لحقوق الإنسان. تقوم العدالة الانتقالية في القانون الوضعي على مبادئ مثل المحاسبة، الإصلاح، والتعويض.
2. مبادئ العدالة الانتقالية:
في الشريعة الإسلامية: تقوم على تحقيق العدالة من خلال القصاص، رد الحقوق إلى أصحابها، وضمان المصالحة والتسامح. تُشجع الشريعة أيضًا على العفو عند المقدرة والإصلاح الاجتماعي والسياسي من خلال إعادة بناء النظم والمؤسسات وفقًا لمبادئ الشورى والمساواة.
في القانون الوضعي: ترتكز العدالة الانتقالية على أربع ركائز رئيسية: المحاسبة على الجرائم، الحقيقة، التعويض، والإصلاح المؤسسي. تهدف هذه المبادئ إلى ضمان محاسبة الجناة على الجرائم المرتكبة ضد حقوق الإنسان، واستعادة حقوق الضحايا، وبناء مستقبل يعتمد على حكم القانون.
3. التركيز على حقوق الضحايا:
في الشريعة الإسلامية: يُعطي الإسلام أهمية كبيرة لحماية حقوق الأفراد والضحايا. نظام القصاص، الذي يهدف إلى تحقيق العدل من خلال المعاملة بالمثل، يُمكن أن يُطبق جنبًا إلى جنب مع مبادئ العفو والتسامح في الشريعة، مما يوفر توازنًا بين تحقيق العدالة والمصالحة.
في القانون الوضعي: يُعتبر تعويض الضحايا أحد الأركان الأساسية للعدالة الانتقالية. يُركز القانون الوضعي على توفير تعويضات مادية ومعنوية للضحايا، بالإضافة إلى ضمان حقوقهم من خلال التحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضدهم.
4. المساءلة والمصالحة:
في الشريعة الإسلامية: المساءلة تتم من خلال نظام العقوبات الإسلامية مثل الحدود والقصاص، ولكن مع قد يتم إعطاء فرصة للجناة للتوبة والإصلاح. كما أن الإسلام يُشجع على المصالحة والعفو كجزء من العدالة.
في القانون الوضعي: تتم المساءلة من خلال محاكمات عادلة ومحاسبة الجناة على الانتهاكات التي ارتكبوها. المصالحة قد تأتي من خلال إجراءات رسمية مثل لجان الحقيقة والمصالحة، التي تعمل على كشف الحقيقة وإعادة بناء العلاقات بين الضحايا والجناة.
5. الإصلاح المؤسسي:
في الشريعة الإسلامية: الشريعة تقر إصلاح المؤسسات وتؤصل لضمان نزاهتها وعدالتها، سواء كان ذلك من خلال النظام القضائي أم النظام السياسي. يتجلى هذا الإصلاح في الشورى ومبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون.
في القانون الوضعي: العدالة الانتقالية تسعى إلى إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية والسياسية لضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.
6. التطبيق العملي
في الشريعة الإسلامية: هناك العديد من الأمثلة التاريخية التي تُظهر تطبيق العدالة الانتقالية في الإسلام. من أبرزها فتح مكة، حيث تم العفو عن الخصوم وتحقيق المصالحة العامة.
في القانون الوضعي: العدالة الانتقالية تُطبق في مراحل ما بعد الصراعات السياسية أو الحروب الأهلية، مثلما حدث في جنوب أفريقيا ورواندا وتونس، حيث تم تأسيس لجان حقيقة ومصالحة، ومحاكمات للجرائم المرتكبة خلال الفترات السابقة.
وإجمالًا؛
العلاقة بين العدالة الانتقالية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي تتسم بالتكامل في كثير من جوانبها. الشريعة الإسلامية تُقدم إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا يعزز من تحقيق العدالة والمصالحة، بينما القانون الوضعي يُقدم أدوات ومؤسسات حديثة تضمن تحقيق هذه الأهداف في سياقات معاصرة. كلا المنهجين يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف، مع اختلاف في الآليات والمفاهيم المستخدمة.
_________________
المصادر:
- لمحة عن العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، https://bit.ly/42FFfk6
- العدالة الانتقالية، الجزيرة نت، 18 نوفمبر 2015، https://bit.ly/3WIsCRG
- العدالة الانتقالية والعزل السياسي … في سؤال وجواب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، https://bit.ly/40XzpcC
- العدالة الانتقالية والعدالة الانتقامية، الجزيرة نت، 1 نوفمبر 2012، https://bit.ly/3Q6RRsV
- مفهوم العدالة الانتقالية، الموسوعة السياسية، https://bit.ly/4aPbbof
- مني أبو الدهب، الإبداع في العدالة الانتقالية: تجارب من المنطقة العربية، معهد بروكينجز الدوحة، 24 نوفمبر 2020، https://bit.ly/4hzoBHL
- العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية، المجلد الأول: حالات عربية ودولية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 14 أغسطس 2022، https://bit.ly/40W2xAR
- أحمد على الأطرش، العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا: جدلية الأولويات، مركز الجزيرة للدراسات، 6 أكتوبر 2021، https://bit.ly/3CBPw6h
- ياسر حسن، العدالة الانتقالية: دراسة فقهية، استراتيجيات العدالة والتنمية المؤتمر الدولي لكلية الأداب جامعة المنيا السادس والثلاثون، https://bit.ly/3Q2hICC
- ابتسام بو معزة، مدى مشروعية العدالة الانتقالية في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، العدد 38، 24 يوليو 2024، https://bit.ly/40WpGDp