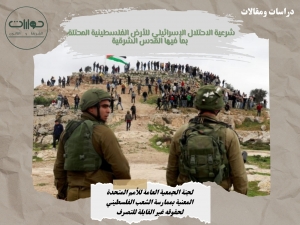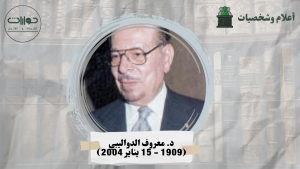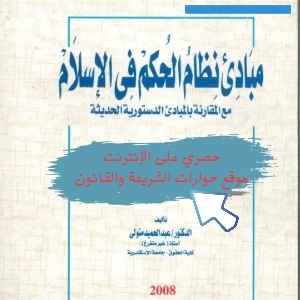مما لا شك فيه أن فكرة الضرورة العسكرية (Military necessity)[1] ليست حديثة النشأة بل هي فكرة قديمة أثارت العديد من الإشكاليات لا سيما في فترات النزاعات المسلحة سواء الدولية أم غير ذات الطابع الدولي، وكلما حدث نزاع مسلح أثيرت فكرة الضرورة العسكرية من جديد[2]، ويمكن القول بأن فكرة الضرورة العسكرية هي التي تبرر الخروج عل الأصل الذي يتمثل في عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية[3]، فكثيرًا ما تلجأ الدول بسببه إلى استخدام القوة والسلاح دفاعًا عن أراضيها ومواطنيها والممتلكات العامة والخاصة بها، ومن هذه الحالات التي قد تلجأ فيها الدول لاستخدام السلاح والقوة العسكرية حالة الضرورة العسكرية، وفيها تستخدم الدول القوة العسكرية لدفع خطر قد يسبب ضررًا لا يمكن تفادي أثاره في المستقبل[4]، حينها يبرز مفهوم "الضرورة العسكرية أو ما يطلق عليه البعض الضرورة الحربية"[5].
تعريف الضرورة العسكرية لغةً:
يحتوي مصطلح الضرورة العسكرية على مفردتين: "ضرورة" و"عسكرية"، والضرورة لغة اسم بمعنى الاضطرار، والحاجة الملحة والشدة، ويقال رجل ذو ضرورة أي ذو حاجة[6]، وجاء في لسان العرب أن الضرورة اسم لمصدر الاضطرار، تقول حملتني الضرورة على كذا وكذا، وقد اضطر فلان إلى كذا وكذا[7]، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيِّنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم﴾ [سورة النحل الآية: 115]، أي فمن أُلجئ لأكل الميتة وما حرم وضُيق عليه الأمر بالجوع، وأصله من الضرر وهو الضيق[8]، ومنه قيل في القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات"[9].
وأما مفردة "العسكر" لغة فأصلها فارسي عُرِّب، وأصله لشكر ويريدون به الجيش، ويقرب منه قول ابن الأعرابي إنه الكثير من كل شيء، يقال عسكر من رجال ومال وخيل وكلاب، وعسكر الرجل جماعة ماله ونعمه، ويقال العسكر مقبل ومقبلون فالإفراد على اللفظ والجمع على المعنى[10]، والعسكرة الشدة والجدب، وقالوا العسكران عرفة ومنى؛ لتجمع الناس فيهما، والعسكر مجتمع الجيش، وعسكر الليل ظلمته، وقد عسكر الليل؛ تراكمت ظلمته[11].
تعريف الضرورة اصطلاحًا في الفقه الإسلامي:
اتفق الفقه الإسلامي على قاعدة شرعية وهي أن "الضرورات تبيح المحظورات"[12]، وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي بأن الضرورة هي "بلوغ المكلف حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب على الهلاك"[13]، وعرفها المالكية بأنه: " الخوف على النفس من الهلاك علمًا أو ظنًا"[14]، ومثل الفقهاء المسلمين للضرورة بحال تترس العدو بالمدنيين يقاتل من خلفهم، لو كففنا عنهم والتحمت الصفوف ظفروا وتمكنوا واتخذت عادة فيهم، وعند الضرورة فحفظ الجيش أهم[15].
ويجب أن نشير هنا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعد هي أسبق الشرائع في الأخذ بنظرية الضرورة، كما وضعت لها القواعد المحكمة التي تكفل الوقوف عند حد الضرورة بل وجعلت منها أيضًا الوجه الثاني للمشروعية، وبمقتضاها تملك السلطة العامة حفظًا للمصالح الأساسية للمجتمع الإسلامي إصدار القرارات التي توجبها الضرورة، والتي تخالف الأحكام التي قررها الشارع للظروف العادية بحيث لا تعتبر هذه القرارات اعتداءً علي مبدأ المشروعية، وإنما تُعد هذه القرارات مشروعة ومرتبه بكافة آثارها باعتبارها الشريعة اللازمة والواجب تطبيقها إعمالًا لما تقتضيه الضرورة، وذلك لأن حدود المشروعية في الظروف الاستثنائية لابد وأن تختلف عن حدودها في الظروف العادية[16].
ويمكن تعريف الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي بأنها: "الوسائل التي تؤدي إلى التسليم الكامل أو الجزئي من قبل العدو بأسرع وقت ممكن وبطرق القهر المنظمة التي لا تتعارض مع القانون والعرف، وما زاد عن تلك الوسائل فهو محرم؛ لأنه خارج عن الضرورة الحربية"[17].
وفي الحقيقة إن قراءة هذا المفهوم على هذا النحو قد يثير بعض الغموض، ولإزالة هذا الغموض يتعين قراءة هذا المفهوم على النحو الآتي[18]:
- الوسائل لفظ عام، فقد تكون مادية كالسلاح، وقد تكون غير ذلك؛ كالحصار أو قطع المؤونة وكل وسيلة مشروعة تمكن من تحقيق هدف عسكري، والهدف التسليم الكامل أو الجزئي.
- المقصود بالتسليم الكامل إحكام السيطرة التامة على العدو وإنهاء سطوته وقدرته على القتال وإبعاد الخطر والضرورة، أما التسليم الجزئي فهو ما يمكن من إضعاف قوة العدو، أو يفتح ثغرًا يمكن من فرض السيطرة على ما تبقى، ويحقق بذلك هدفًا عسكريًا جليًا.
- يذكر المفهوم السابق أن يتم الأمر بأسرع وقت ممكن وهذا ضابط يحد من توسع الإطار الزمني للنزاع والقتال وما يزيد الدماء سفكًا وهلاك النسل والحرث، ثم إن طرق القهر والقوة يجب أن تكون منظمة بحيث لا تتعارض مع قواعد النزاع تجنبًا للعشوائية وعدم التمييز، ومنه الوقوع في المحظور، وذلك وفق هندسة دقيقة للعمل العسكري تضمن مشروعية الوسيلة العسكرية، والتصرف وفق الضرورة والتي تقدر بقدرها فلا يمكن اعتباره من الضرورة ما زاد عن تلك الوسائل، فما يمكن تحقيقه من أهداف عسكرية واضحة وكافية بوسائل غير قتالية، كالحصار العسكري أو قطع المؤونة، واستعملت فيه وسائل قتالية يعتبر تجاوزا للضرورة العسكرية، وعليه فالضرورة العسكرية تقتضي التقيد بالمشروعية، فكل أعمال الإنسان المسلم تعبدية في السلم والحرب، يبتغي من خلالها مرضاة الله وثوابه في الدنيا والآخرة[19].
تعريف الضرورة العسكرية في القانون الدولي العام وفي القانون الدولي الإنساني:
إذا نظرنا إلى موقف القانون الدولي العام من مصطلح الضرورة، فيمكن القول بأن قواعده لم تعرف مصطلح الضرورة، ولكنها جاءت لتكرس حالة الضرورة، وعدم التزام القواعد الدولية للحقوق والحريات في حالة الطوارئ، وخير مثال على ذلك ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتحديدًا في نص المادة (4/1) التي تنص على أنه: "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميًا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شرط عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي"[20]، وكما هو واضح من نص المادة السابقة فإنها تتحدث عن الحالات الطارئة التي تجيز استثناء اتخاذ تدابير وفي نطاق ضيق، تعبيرا عن حالة الاضطرار[21].
وقد أجمعَ فقهاءُ القانون الدولي على تعريفِ الضرورة العسكرية بأنَّها: "الحالةُ التي تكون مُلحةً لدرجةِ أنَّها لا تترك وقتًا كافيًا للأطراف المُتحاربة لاختيار الوسائل المُستخدمة في أعمالها، أو هي الأحوالُ التي تظهر أثناء الحرب وتفرض حال قيامها ارتكاب أفعال مُعيَّنة على وجه السرعة بسبب موقف، أو ظروف استثنائية ناشئة في ذات اللحظة"[22].
وتأسيسًا على ما سبق يمكن القول بأن مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني[23] يتمثل في عدم تجاوز مقتضيات الحرب، وهي تحقيق النصر وإضعاف قدرة العدو بالطرق والأساليب التي لا تخالف أي حكم من قوانين الحرب سواء كان هذا الحكم قد تقرر بموجب قاعدة عرفية أم اتفاقية، فلا يجوز مهاجمة الأهداف المدنية حتى لو كانت خالية من السكان المدنيين لعدم وجود ضرورة تسوغ ذلك[24].
وبعبارة أخرى يمكن القول بأن مبدأ الضرورة يدور في إطار فكرة قوامها أنَّ استعمالَ أساليب العنف والقسوة والخداع في الحرب يقف عند حد قهر العدو وتحقيق الهدف من الحرب وهو هزيمته وتحقيق النصر[25]، أو إخضاع الطرف الآخر وإلحاق الهزيمة به، فإذا ما تحقَّق الهدفُ من الحربِ على هذا النحو، امتنع التمادي والاستمرار في توجيه الأعمال العدائيَّة ضد الطرفِ الآخر[26].
ومما تجدُر الإشارةُ إليه أنَّ مبدأ الضرورة العسكريَّة قد وردت الإشارةُ إليه صراحةً في كثيرٍ من مواد الاتفاقات سارية المفعول في أوقاتِ الحروب والنزاعات المُسَلَّحة ومنها[27]:
- المواد (23/ج) من اتفاقيَّة لاهاي الرابعة لعام 1907.
- المواد (4/2،11/2) من اتفاقيَّة لاهاي المُتَعَلِّقة بحماية الأعيان الثقافيَّة في أثناء النزاع المُسَلَّح لعام 1954.
- المواد (53، 143، 147) من اتفاقيَّة جنيف الرابعة.
- المادة (126) من اتفاقيَّة جنيف الثالثة المُتَعَلِّقة بأسري الحرب.
- المواد (8، 28، 51) من اتفاقيَّة جنيف الثانية المُتَعَلِّقة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى ومنكوبي السفن أفراد القوات المُسَلَّحة في البحر.
- المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأوَّل باتفاقيَّات جنيـف.
الفرق بين حالة الضرورة العسكرية وحالة الدفاع الشرعي:
قد يتداخل على القارئ مصطلح حالة الضرورة ومصطلح حالة الدفاع الشرعي، ولكن هناك اختلافات وفروق بين الحالتين، نوضحها فيما يلي[28]:
- تشترك حالة الضرورة العسكرية وحالة الدفاع الشرعي في أن كلا الحالتين يحميان المصلحة الأجدر بالحماية والرعاية، وأنهما يقومان بالدفاع عن المعتدى عليه لا المعتدي، ويجوز في الحالتين استعمال القوة المسلحة للدفاع في هذه الحالة.
- تنشأ حالة الدفاع الشرعي بناءً على عدوان صادر من دولة معتدية، فيكون من حق الدولة أن تدافع عن نفسها، وتدفع هذا العدوان، أما حالة الضرورة العسكرية فتنشأ نتيجة خطر يهددها قد يترتب على وقوعه ضرر جسيم يلحقها أيا كان مرتكبه.
- حالة الدفاع الشرعي تكون في صورة رد فعل أو عدوان قد تحقق على أرض الواقع، أما حالة الضرورة العسكرية فلا يشترط أن يكون هناك فعل قد حدث، وإنما تنشأ في حالة ما إذا كان متوقعًا حدوث هذا الفعل، حتى ولو كانت حالة الضرورة قد تمس أشخاصًا لم يرتكبوا أي فعل إجرامي وقتها، ولكن يتوقع حصوله منهم فيما بعد لو لم تتم مقاومتهم.
- يمثل الدفاع الشرعي سببًا من أسباب الإباحة؛ إذ يترتب عليه زوال صفة عدم المشروعية عن الفعل، خلافا لحالة الضرورة التي تعد مانعًا من موانع المسئولية، فيظل الذي تأتيه الدولة في حالة الضرورة غير مشروع مع رفع العقوبة نظرًا لانتفاء المسئولية الجنائية عنها، ومنه قد يوجب الفعل المرتكب في حالة الضرورة تعويض الضرر الذي سببه، ويجوز الدفاع الشرعي ضده[29].
الشروط الواجبة توافرها للاستناد إلى مبدأ الضرورة العسكرية:
اتَّفق الفقهُ والقضاءُ الدوليَّان على أنَّ الضرورة العسكريَّة محكومةٌ ومُقيَّدةٌ بعدة شروط قانونيَّة هي[30]:
- ارتباطُ قيام هذه الحالة بسير العمليَّات الحربية خلال مراحل القتال بين المُتحاربين، أو لحظة الاشتباك المُسَلَّح بين قوات الاحتلال والمُقاومة، ولذلك لا يُمْكِن الادِّعاء بتوافر الضرورة الحربية في حالةِ الهدوء وتوقف القتال.
- الطبيعةُ المؤقَّتةُ وغير الدائمة للضرورة الحربية، وإنما هي – بالنظر لطابعها الاستثنائي- ليست أكثر من حالة واقعية تبدأ ببداية الفعل وتنتهي بنهايته وزواله، فإذا ما كان مُبرِّر هذه الضرورة مثلًا تدمير منزل لصد هجوم، زالت الضرورة بانتهاء التدمير أثناء الهجوم، ولكن لا يجوز تدمير المنزل بعد انتهائه.
- ألَّا تكون الإجراءاتُ المُستخدمةُ لتنفيذ حالة الضرورة محظورةً بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي كالتذرُّع باستخدام الأسلحة المحرَّمة دوليًا أو قصف وإبادة السُكَّان المدنيين أو عمليات الثأر والاقتصاص من المدنيين ومُمْتَلَكاتهم بحجة الضرورة العسكريَّة.
- ألَّا يكون أمام القوات المُتحاربة في حالة الضرورة أي خيار بتحديد طبيعة ونوع الوسائل سوى التي استُخْدِمَت بالفعل حال قيام وتوافر الضرورة الحربية، والتي تسمح باستخدام وسائل مُتفاوتة الضرر، مثل استخدام وسيلة الاستيلاء والمُصادرة للمُمْتَلَكات كإجراءٍ بديل عن التدمير أو الأسر بدلًا من القتل، ويجب في هذه الحالة على القوات المُتحاربة العزوف عن التدمير أو القتل، واللجوء إلى استخدام البدائل الأخرى الأقل ضررًا[31].
الهوامش:
[1] ترجع فكرة الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني إلى ميكافيللي الذي خلص في كتابه "الأمير" إلى أن "أنَّ الحربَ تكون عادلةً عندما تكون ضروريةً، وأنَّ الرغبةَ في الانتصار شيءٌ طبيعي وعام، ويبرر استخدام القوة الضرورية اللازمة لتحقيق هذه الرغبة".
انظر: د. إبراهيم دسوقي أباظة ود. عبد العزيز الغنام، تاريخ الفكر السياسي، دار النجاح، بيروت، لبنان، 1973م، ص173-185.
[2] انظر: د. روشو خالد، مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي، مجلة المعيار، مج: 4، ع: 8، ديسمبر 2013م، ص75.
[3] انظر: د. عمر صالح علي العكور، محددات تطبيق مبدأ الضرورة في القانون الدولي الإنساني، المجلة العالمية للتسويق الإسلامي، الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي، مج: 6، ع: 3، سبتمبر 2017م، ص95.
[4] مصاب مصطفى: مبدأ الضرورة العسكرية في القانون الدولي، محامو الأردن في 10 سبتمبر 2021م، https://jordan-lawyer.com/2021/09/10/principle-of-military-necessity/ (تاريخ الدخول الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024م).
[5] انظر: بوبكر مصطفاوي، مبدأ الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي وفي القانون الدولي الإنساني، مخبر الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، الجزائر، سبتمبر 2020م، ط1، ص21.
[6] انظر: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مصطفى حجازي، مج: 12، مطبعة الكويت، 1973م، ص358.
[7] انظر: جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور المصري الأفريقي، لسان العرب، ج: 4، دار صادر، بيروت، لبنان، 199م، ص483.
[8] المرجع السابق، ص483.
[9] انظر: عامر عبد الحسين عباس، مبدأ الضرورة الحربية في القانون الدولي الإنساني، مجلة مركز دراسات الكوفة، ع: 55، ديسمبر 2019م، ص587.
[10] بوبكر مصطفاوي، مبدأ الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي وفي القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص22-23.
[11] انظر: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مج: 13، مرجع سابق، ص38-39.
[12] إن المتفق عليه في الفقه الإسلامي أن المحظورات هي الممنوعات والمحرمات التي أمر الشرع الحكيم المكلفين بتجنبها وتركها على وجه الإلزام، فأوجب العقاب على فاعلها والثواب لتاركها، وهي كل ما يمنع على المسلم تناولها والعمل بها، فالمكلف قد تلجئه الحاجة الملحة دفعا للهلاك على نفسه أو غيره، والقاعدة تقول: "أن الضرورات تبيح المحظورات" واستنادا لقوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[سورة الأنعام الآية: 145] ووجه الدلالة في الآية أن الضرورة تبيح تناول المحظور.
بوبكر مصطفاوي، مبدأ الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي وفي القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص23-24.
[13] انظر: جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، ج: 1، د. ت، ص84.
[14] ورد هذا التعريف في: عبد العزيز الزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مؤسسة الثقافة، الإسكندرية، 1993م، ص19.
[15] ابن قدامة المقدسي، الكافي، ج: 5، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، د.ت، ص478. مشار إليه في: بوبكر مصطفاوي، مبدأ الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي وفي القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص24-25.
[16] انظر: د. فؤاد النادي، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي، دار الكتاب الجامعي، 1980م، ط2، ص91؛ باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي، نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري "دراسة مقارنة"، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، دقهلية، مج: 15، ع: 6، 2013م، ص 3278.
[17] انظر: بوبكر مصطفاوي، مبدأ الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي وفي القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، معهد العلوم الإسلامية، جامعة الشهيد حمه لخضر- الوادي، الجزائر، 2016م/ 2017م، ص12.
[18] المرجع السابق، ص12.
[19]) في قضية الجدار العازل تذرعت إسرائيل بأنها في حالة ضرورة، ولكن محكمة العدل الدوليَّة لم تستجب لهذه الحجة؛ حيث إنَّها اعتبرت أنَّ حالة الضرورة تشكل سببًا يعترف به القانونُ الدولي العرفي، ولا يُمْكِن التذرُّع به إلَّا استثناءً، وضمن بعض الشروط المُحددة بصورة ضيِّقة والتي يجب توفرها جميعًا، وقد خلُصَت محكمةُ العدل الدوليَّة إلى عدم توافر شروط حالة الضرورة من أجل بناء الجدار، حيث نصَّت في الفتوى رقم 137 على الآتي: "وخلاصةُ القول: إنَّ المحكمة غير مُقتنعة من المواد المُتاحة لها، بأنَّ المسار المُحدد الذي اختارته إسرائيل للجدار أمر يقتضيه تحقيق أهدافها الأمنية، فالجدار على امتداد الطريق المُختار، والنظام المُرتبط به يشكلان انتهاكًا خطيرًا لعدد من حقوق الفلسطينيين المُقيمين في الأرض التي تحتلها إسرائيل، والانتهاكات الناشئة عن ذلك المسار لا يمكن تبريرها بالضرورات العسكرية أو بدواعي الأمن القومي أو النظام العام، وتبعًا لذلك فإن تشييد جدارٍ من هذا القبيل يُشكِّل إخلالًا من جانب إسرائيل بالتزامات شتى واجبة عليها بمُقتضى القانون الإنساني الدولي الساري وصكوك حقوق الإنسان". للمزيدِ من التفاصيل عن فتوى محكمة العدل الدوليَّة بشأن الجدار العازل. انظر: أنيس مصطفى القاسم (محررًا) وآخرون" الجدار العازل الإسرائيلي.. فتوى محكمة العدل الدوليَّة- دراسات ونصوص"، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، بيروت، حزيران/ يونيه 2007، مشار إليه في: د. هشام بشير وإبراهيم عبدربه إبراهيم، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 2019م، ص77.
[20] للاطلاع على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يمكن الاطلاع على مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، موقع الأمم المتحدة، https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights (تاريخ الدخول الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024م).
[21] بوبكر مصطفاوي، مبدأ الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي وفي القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص26.
[22] انظر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ الأساسيَّة للقانون الدولي الإنساني، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم 2، 2008م، ص6.
[23] يقوم القانونُ الدولي الإنساني على أساس الموازنة بين مُتطلِّبات الضرورة العسكريَّة والاعتبارات الإِنْسَانيَّة، فالضرورةُ العسكريَّة تتطلَّب استخدامَ القوة العسكريَّة بالقدرِ اللازم لتحقيقِ ميزة أو تَفَوق عسكري، بينما تتطلَّب الاعتبارات الإِنْسَانيَّة أنْ يتم تحقيق هذه الميزة بأقل الخسائر في الأرواح والمُعدَّات وبأكثر الوسائل والأساليب. انظر: جان بكتيه، القانونُ الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، معهد هنري دونان، جنيف، 1984م، ص46.
[24] انظر: حيدر كاظم عبد علي مالك عباس جيثوم، القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، ع: 2، السنة الرابعة، ص161.
[25] انظر: د. حامد سلطان، الحربُ في نطاق القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون الدولي، القاهرة، ع: 25، 1969م، ص18.
[26] د. هشام بشير وإبراهيم عبدربه إبراهيم، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص75.
[27] انظر: د. أحمد عبد الونيس، الحمايةُ الدوليَّة للبيئة في النزاعات المُسَلَّحة، المجلة المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون الدولي، القاهرة، ع: 52،، 1996م.، ص76 وما بعدها.
[28] مصاب مصطفى: مبدأ الضرورة العسكرية في القانون الدولي، محامو الأردن في 10 سبتمبر 2021م، https://jordan-lawyer.com/2021/09/10/principle-of-military-necessity/ (تاريخ الدخول الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024م).
[29] حالة الدفاع الشرعي منصوص عليها في المواثيق والقواعد القانونية والاتفاقيات المختلفة، ومن ذلك نص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
[30] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ الأساسيَّة للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص6.
[31] د. هشام بشير وإبراهيم عبدربه إبراهيم، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص76-77.