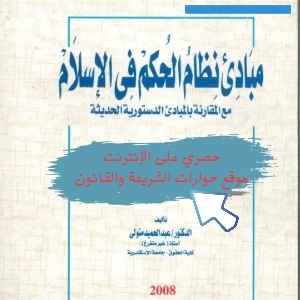نشر مركز نهوض للدراسات والبحوث ملفًا بحثيًا جديدًا بعنوان “الأخلاق الإسلامية في عصر ما بعد الأخلاق”، ويضم الملف 15 مادة بحثية متنوعة في أربعة محاور، إيمانًا منه بضرورة الإسهام في النقاش الأخلاقي المعاصر، عبر تأطير المفاهيم، وتحليل طبيعة التحديات المعاصرة، وفحص مدى كفاية الدرس الفلسفي الأخلاقي المعاصر في الاستجابة لهذه التحديات.
وفيما يلي مقدمة الملف التي تبرز محتويات المادة العلمية بداخله:
“لقد تآكلت في هذا العصر القِيَمُ الدينية التقليدية، التي عرفتها المجتمعات والحضارات آلافًا من السنين، وتعرّضت المنظومات الأخلاقية الكبرى إلى تحديات نظرية وعملية هائلة منذ صعود التقنية والتصنيع وظهور النُّظُم الاجتماعية الحديثة وما صاحبها من صيغٍ علمية تطورية وطبيعانية، وصولًا إلى التحولات المتسارعة في مجالات الطب والجينوم والتواصل والفضاء والحروب وغيرها، والتي باتت تهدِّد المفاهيم الأساسية للتصورات الإنسانية (كالفطرة، والطبيعة البشرية، والهوية الإنسانية، والروح، والعلاقة بالأرض)، وتشكِّك في الأسس التي تقوم عليها النظريات الأخلاقية (المسؤولية، والإلزام، والحساب)، ولهذا وُصِفَ هذا العصر بأنه عصرُ “ما بعد الأخلاق”.
إن أسئلة ما بعد الأخلاق تتضمَّن داخلها ارتيابًا من الأخلاق المعيارية التي ينحصر دورها في تعيين قيمة الأشياء والأفعال انطلاقًا من مقولات: الخير والشر، أو المحمود والمذموم، إنها -أي ما بعد الأخلاق- لغة خَلْفَ اللغة الأخلاقية، ونزولٌ إلى أعماق المبادئ الأولى لإنارتها ومُكَاشَفتها.
إن العالم اليوم يشهد عصرًا جديدًا لم تعرفه الحضارة الإنسانية من قبل، فقد يصدق عليه أنه عصرُ ما بعد الواجب الذي جاء بنمطٍ أخلاقيٍّ مغايرٍ تمامًا للقيم الأخلاقية التي كانت تحكم المجتمعات البشرية، إنها أخلاق السعادة الفردانية التي تُعَدُّ المولود الشرعي لثقافة ما بعد الواجب التي جاءت مُعلِنةً عن انهيار الأخلاق المتعالية ومُبشِّرةً بأفول الواجب، وكان السبب المباشر لتجاوز هذا الواجب هو إعادة الاعتبار للذات البشرية، فبعد أن كانت تقوم بالواجب لأجل شيء ما بات يجب أن تقوم به لأجل ذاتها وفقط، وبعد أن كان الواجب يشكِّل إلزامًا وإكراهًا ونكرانًا للذات، حلَّت محلَّه حرية الاختيار، وباتت الذات معيار الواجب وَفق ما تمليه رغباتها، وكأن الأخلاق مجرَّد بحث عن الغايات السعيدة. فكل نظرية أخلاقية ربطت الخير باللذَّة أو السعادة أو المنفعة وأهملت جانبًا مهمًّا من جوانب الأخلاق، أَلَا وهو جانب الإلزام أو الواجب، وهذا ما أحدث الأزمات الأخلاقية التي يعيشها الإنسان المعاصر في عالم التطور التكنولوجي والصناعي، الذي ألغى أهمَّ معالم الإنسانية في بُعدها الأخلاقي والنفسي والاجتماعي، وأدخلها في دوامة أزمة حقيقية تسودها الفوضى والعبثية بإبعاها عن كينونتها الحقيقية. وقد كان لهذه الأزمات انعكاسات سلبية جعلت الإنسان مجرَّد كائن استهلاكي يعيش غربة وكآبة وخوفًا لم يعرفه من قبل، الأمر الذي يحتم علينا محاولة إيجاد حلٍّ لهذه الأزمة عن طريق البحث عن أخلاق إنسانية والوصول إلى “المجتمع السويّ”.
وفي ظل هذه السياقات، اهتمَّ مركز نهوض للدراسات والبحوث بضرورة الإسهام في النقاش الأخلاقي لعالم اليوم، عبر تأطير المفاهيم، وتحليل طبيعة التحديات المعاصرة، وفحص مدى كفاية الدرس الفلسفي الأخلاقي المعاصر في الاستجابة لهذه التحديات، وعبر العودة إلى مصادر الذات العميقة وتراثها الأخلاقي لاستنطاق مضامينه، وإبراز عناصره الأساسية، وتصوراته النظرية، وتجسُّدها في مسالك العيش التي عرفها المسلمون في حضارتهم وصاغوا بها ذواتهم، ثم الإقدام بجرأةٍ على معالجة هذه التحديات الأخلاقية، والبحث عن حلول ناجعة لها، ومعرفة ما يمكن أن يُحدثه التراث الإسلامي الأخلاقي والروحي أن يقدِّمه لنا نحن المسلمين، وللحضارة المعاصرة. فإذا كان البعض يرى أن الحضارة المعاصرة تعيش حالةً من التيه القِيمي، وتفتقد إلى أساس صلب للبنيان الأخلاقي، فإن في الإسلام (نصًّا وتاريخًا) نظامًا قيميًّا عميق الجذور، وإن كان يعاني التعطيل وعدم التفعيل في أجندة الحوار الأخلاقي المعاصر.
ومن ذلك كله جاءت دعوة المركز للباحثين للإسهام في الملف البحثي المعنون: “الأخلاق الإسلامية في عصر ما بعد الأخلاق“. فلطالما اعتبر سؤال الإنسان من القضايا المحورية والأساسية في الوقت ذاته التي شغلت بالَ المفكرين والفلاسفة والباحثين في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية، نتيجة الأبعاد الرئيسة التي يطرحها هذا المفهوم على الصعيد العالمي في ظل الرهانات الجديدة التي يعيشها العالم اليوم.
وفي هذا السياق، اقترح المركز جملةً من المحاور البحثية التي تجاوب معها الباحثون، فجاء المحور الأول بعنوان: “النظرية الأخلاقية الإسلامية: المفاهيم والأصول“، ليتناول تأطير العائلة المفاهيمية لسؤال الأخلاق المعاصر: ماذا يعني مفهوم ما بعد الأخلاق؟ وما صلته بالمفاهيم المستجدَّة في النقاش الأخلاقي المعاصر؟ كما يهدف هذا المحور إلى البحث عن جذور المشكل الأخلاقي في الفلسفة الحديثة وما بعد الحديثة، من خلال تفحُّص أصول النظريات الأخلاقية لعصرنا ومدى كفايتها في التأسيس الأخلاقي على المستويين: الأدنى (العدل)، والأعلى (الإحسان)، وذلك عبر الإجابة عن سؤال: إذا كان الدين هو الأساس المتين للنظرية الأخلاقية، فهل هناك أساس ما بعد ديني للأخلاق في الفلسفة الغربية المعاصرة؟ وهل يمتلك هذا الأساس ما تحتاج إليه النظرية الأخلاقية من ثبات وقدرة على الإلزام وتوجيه السلوك الإنساني؟ ويهدف هذا المحور إلى البحث في مضامين النظريات الأخلاقية في التراث الإسلامي، واستنطاق أبرز مفاهيمها وتصوراتها عن النَّفْس والمجتمع والوجود، وذلك عبر إجراء حوارات فلسفية وأخلاقية داخل التراث الأخلاقي الإسلامي وبين أعلام تراثنا الأخلاقي والروحي وبين النقاشات الأخلاقية المعاصرة. فالبحث في التيارات والمدارس الإسلامية وتصوراتها عن الأخلاق من شأنه أن يُبرز تنوُّع المنظورات الأخلاقية الإسلامية وغناها، وتنوُّع مشاربها مع اتحاد أصولها، وأن يُبرز خريطة الحقل الدلالي للأخلاق الإسلامية ومفرداته المركزية، كما من شأن المقارنة عبر الزمان والمكان مع التصورات الأخلاقية الحديثة أن تُبرز راهنية الأخلاق الإسلامية وتجيب عن سؤال مدى قدرتها على التجدُّد والعطاء في عالم اليوم.
كما يتناول هذا المحور الاستجابات الأخلاقية (النظرية والتطبيقية) لعلاج الإشكال الأخلاقي المعاصر، ومناقشة أبرز الأطروحات النقدية والتأسيسية المعاصرة فيما يمكن تسميته بمحاولات التغلُّب على الأزمة الأخلاقية التي ضربت البنى الأصلية الدينية والبنى الفرعية العقلية أيضًا.
وانتظمت في هذا المحور ست ورقات، فجاءت الورقة الأولى بعنوان: “الأخلاق الإنسانية: ماهية أم هوية؟” للدكتورة سوسن العتيبي التي تناولت في البحث جدوى وضع الأخلاق تحت مقولتي الماهية أو الهوية، وما يتصل بهما من تبيين مفهومي الماهية والهوية وخصائصهما ومحل اتفاقهما ومحل اختلافهما، ودلالة الأخلاق في المجال التداولي الإسلامي، والتحقُّق من صحَّة رصف الأخلاق تحت الماهية أو الهوية، ومن ثَمَّ الخلوص لمعنى “الأخلاق” المتجاوز لمقولتي الماهية والهوية، باعتباره المجلّي للثوابت القيمية والأفعال الإنسانية المبتغاة.
أما الورقة الثانية فبعنوان: “أسس النظرية الأخلاقية في الفكر الإسلامي المعاصر: سؤال المرجعية النظرية للأخلاق عند محمد عبد الله دراز” للأستاذ عيسى بن بها، الذي تناول تحديات الفكر الإسلامي المعاصر المعقَّدة في مجال الأخلاق، التي تمثَّلت في تراجع القوة التأثيرية للأخلاق في حياة الانسان، ودخول الحياة الأخلاقية في حقبة جديدة توصَف بـ”ما بعد الأخلاق”. وقد جاء هذا البحث ليقارب سؤال أُسس النظرية الأخلاقية في الفكر الإسلامي المعاصر، وتحديدًا نظرية دراز القرآنية، وهي مقاربة ذات سياق مزدوج، تهدف إلى إخراج الفكر الأخلاقي الإسلامي من الجمود، وإلى إثبات قدرة الفكر القرآني على تأسيس نظرية أخلاقية متماسكة الأركان.
وجاءت الورقة الثالثة في هذا المحور بعنوان: “الأبعاد الأخلاقية للدرس المقاصدي المعاصر: طه عبد الرحمن أنموذجًا” للأستاذ ربيع رحومة، الذي تتبَّع لحظة مهمة من مسيرة الدرس المقاصدي المعاصر مثَّلتها جهود البروفيسور طه عبد الرحمن؛ إذ قدَّم إسهامًا إبستيمولوجيًّا جادًّا في علم المقاصد يهدف إلى تأسيسه على قواعد فلسفته الائتمانية، فكان إسهامًا ذا أبعاد أخلاقية واضحة في مختلف تفاصيله، مرتبطًا بالتراث الأصولي وينقد الحداثة ويتجاوزها، منشغلًا بالهاجس المنهجي، قاصدًا بذلك كلِّه محاولةً تأسيسيةً يضربها في عمق الدرس المقاصدي.
وأما الورقة الرابعة في هذا المحور فكانت ورقة مترجمة للدكتور عمر فرحات، بعنوان: “الزمان والخيار اﻷخلاقي في علم أصول الفقه الإسلامي“، وترجمها الباحث خالد أبو هريرة. وقد تناولت الورقة كيفية تقديم الشريعة الإسلامية لمفاهيمها الخاصة حول الزمان، كون الدراسات الحديثة حول الشريعة لم تُولِ اهتمامًا كبيرًا لمثل هذه المفاهيم. وتجادل هذه الورقة بأن علم أصول الفقه الإسلامي قد فهم الزمان من زاوية أخلاقية، وليس كوعاء محايد أو مجرد خلفية للأفعال، وإنما كسلسلة من الفرص التي يجري التعبير فيها عن سلطة الوحي الإلهي والتفكير الأخلاقي الإنساني.
وجاءت الورقة الخامسة في هذا المحور بعنوان: “عودة التنوير الراديكالي والتحول ما بعد الأخلاقي: نقد عربي إسلامي ديكولونيالي للإبادة الأخلاقية” للدكتور رشيد بن بيه، الذي استند فيها إلى منظور ديكولونيالي تحرُّري عربي إسلامي لدراسة موضوع ما بعد الأخلاق، وانطلق من عصر التنوير لفهم جذوره، وحاجج بأن ما بعد الأخلاق ليست إلا استنباتًا لمنظور التنوير الراديكالي للأخلاق. وفسَّرت الدراسة الظروف المسؤولة عن التحوُّل ما بعد الأخلاقي، وتوقفت بالتحليل عند مواقف مفكرين وصفوا حالة المجتمع ما بعد الأخلاقي بتوصيفات لا ترسم حدودًا واضحة بين الخير والشر. وبيَّنت أن ما بعد الأخلاق لا تعني لدى المفكرين الأخلاقيين العرب والمسلمين إلغاء الأخلاق الدينية، وإنما تعني النظر أبعد من أخلاق الحداثة.
واختتم هذا المحور بالورقة السادسة التي جاءت بعنوان: “الأخلاق الإسلامية في عصر ما بعد الأخلاق: رؤية ديكولونيالية” للأستاذ المولدي بن عليّه، الذي تناول فيها نقد تيار التقليدية الجديدة للأخلاق الحداثية وما بعد الحداثية كما أرساها رينيه غينون وطوَّرها لاحقًا سيد حسين نصر. وترصد الاستتباعات الإبستيمولوجية لهذا النقد على منهجية العلوم الاجتماعية والإنسانية. وتبيِّن أن هذا النقد يفرض تصورًا جديدًا للأخلاق الإسلامية وللعلاقة بين ما هو تقليدي وما هو حداثي على قاعدة الاختلافات الحضارية، وهي علاقة يتضمَّنها موقف إبستيمولوجي طريف، بلوره على نحو عميق سيد حسين نصر في جُلِّ كتاباته.
أما المحور الثاني فجاء بعنوان: “في أخلاق الذات والتواصل“. وقد تناول هذا المحور محاولة إيجاد صيغٍ للعيش المعاصر في عصر التواصل الفائق ومعالجة الإشكال الأخلاقي والقِيمي في ألصق وجوهه بالإنسان وتجربته المعيشة. فمنذ صعود التقنية الصناعية، بدأت أمارات النزعة الفردانية بالنموِّ في المدن الحديثة، التي فصلت الإنسان عن محيطه الطبيعي والاجتماعي، وأحالت علاقته الوجاهية والتكافلية إلى علاقات تعاقدية مؤطّرة القانون (اللاشخصي). وإذا كان النقد الأخلاقي والفلسفي قد تناول هذه الظاهرة في تأثيرها في قدرة الإنسان على التأمُّل والتسامي والإحسان الأخلاقي، فإن تسارع التطور التقني، وتزايد إيقاع الاستهلاك الرأسمالي، ومستجدات تقنيات التواصل الاجتماعي (وآخرها الميتافيرس)، قد أفرزت صيغًا ما بعد إنسانية من التواصل مع الآخر ومع الذات.
واخترنا في هذا المحور دراستَيْن، الأولى بعنوان: “سؤال النقد الأخلاقي التواصلي والتعارفي في عصر ما بعد الأخلاق” للدكتور عبد الرحمن العضراوي، وتتلخص فكرة هذه الدراسة في اتخاذ منهج المقاربة التحليلية للنقد الأخلاقي المتعلِّق بنظرية الأخلاق التواصلية الهبرماسية، وبنظرية الأخلاق التعارفية القائمة على الميثاقية التكاملية الإشهادية والاستئمانية والإرسالية. وتأتي نظرية الأخلاق التواصلية في سياق نقدي يعمل على تجاوز فلسفة كانط الأنوارية والحداثية، وذلك بإخراج النقد الأخلاقي من بُعده الذاتي إلى بُعده الاجتماعي، وجعله في قضايا الثقافة والعلم والمجتمع.
وأما الدراسة الثانية في هذا المحور فبعنوان: “المأزق الحداثي وفقدان البوصلة الأخلاقية: في الحاجة إلى أخلاق إحسانية” للدكتور عبد الرحيم الدقون، الذي تناول محاولة الخوض في بعض المسائل الأخلاقية المعاصرة من منظور مقارن، حيث توقف عند النقد الفلسفي الغربي لبعض ملامح التوعكات التي أصابت الحداثة في عمقها الأخلاقي، وفي مقدمتها الفردانية والإذلال الذي ما برح يتعرض له الفرد في المجتمعات المعاصرة. وفي هذا الإطار، تقترح الدراسة الانفتاح على البُعْد الإحساني الحاضر في الأخلاقيات الإسلامية، متجليًا في أخلاق الإحسان مثلما بلورها العز بن عبد السلام.
ثم يأتي المحور الثالث في هذا الملف ليتناول الأخلاق الاجتماعية والسياسية، ويهدف هذا المحور إلى محاولة الإجابة عن علاقة الأخلاق بالسياسة وإمكانية القبول ببعض القواعد التي تحكمها في حقلٍ تكاد أدبياته ووقائعه أن تستبعد الأخلاق جملةً وتفصيلًا من اعتبارها. فقد دأبت جُلُّ مدارس علوم السياسة والاجتماع والعلاقات الدولية على تدبير شؤون الاجتماع بين البشر، أفرادًا وجماعات وأممًا، عبر النظر في آليات إدارة الصراع الحتميِّ بين الفاعلين المتنافسين على الموارد والنفوذ والمصالح، وأخذت النظريات الواقعية والبنائية تضع “المصالح المجرَّدة” فوق كلِّ اعتبار لصياغة السلوك السياسي “العقلاني” للدول والفاعلين السياسيين، في الوقت الذي انحسرت فيه القيم الأخلاقية لتصبح ورقةً في الدعاية السياسية. ومن المفيد التأكيد هنا على أنه عند الحديث عن العلاقة بين الأخلاق السياسية، فنحن لا نستند على الأخلاق الفردية بل الأخلاق الاجتماعية، ويضمُّ هذا المحور خمس دراسات:
جاءت أولاها بعنوان: “علمنة التجربة الأخلاقية الإسلامية: بين الإمكان والاستحالة: قراءة في مقاربة وائل حلاق” للدكتورة نزهة بوعزة، التي تناولت فيها النموذج الحداثي الغربي باعتباره نموذجنا الإرشادي في تحقيق نهضة إسلامية، وهي تبعية ولَّدتها الحركات الاستعمارية، ومن ثَمَّ استوطن في فكرنا ضرورة استلهام الحداثة الغربية، متناسين مسألة السياق التاريخي الحداثي الغربي، وكذا خصوصية التجربة الإسلامية. لكن الأزمنة الحداثية التي كانت مشعلًا لتحقيق نهضتنا تعيش اليوم على وقع تراجعٍ مهولٍ في القيم الأخلاقية؛ إذ أنتجت عملية تهميش الجانب الديني وإرجاع الوازع الأخلاقي للإنسان فراغًا قيميًّا. وخلصت الباحثة إلى أهمية عودة القيم الأخلاقية في الفكر المعاصر، وهي مسألة تناولها العديد من الفلاسفة المعاصرين، ويُعَدُّ وائل حلاق -في رأي الباحثة- أبرز مفكر استطاع أن يعيد ما جرى تهميشه إلى الصدارة.
وجاءت الدراسة الثانية في هذا الملف بعنوان: “لا أخلاقية عقوبة السجن في الفكر الإسلامي: مقاربة بين المفكر الباكستاني جواد غامدي والحقوقية الأمريكية أنجيلا ديفيس“، وهي ورقة مترجمة للبروفيسور عدنان ذو الفقار ترجمها الباحث جابر محمد، تناول فيها الطبيعة الخاصة للسجون في النظام الجنائي الأمريكي التي أضحت محلَّ نقاشٍ حادٍّ خلال السنوات القليلة الماضية، والتي طالت السجون خلالها سمعة سيئة للغاية. ولذا لقيت حُجَّةُ إلغاء السجون ترحابًا واسعًا، وأصبحت موضوعًا للنقاش في العديد من الحوارات العامة، والكثير من المقالات العلمية. وتركِّز معظم هذه المناقشات على تشخيص أسباب الاعتماد المبالغ فيه على عقوبة السجن. وتحاول هذه الورقة البحثية أن تستكشفَ أحدَ هذه الانتقادات التي تمثِّل مسارًا في التفكير الداعي إلى إلغاء منظومة السجن في الفقه الإسلامي. فإذا كان الخطاب الأمريكي منشغلًا بحملة إلغاء السجون كعلاج لتضخم منظومة السجن، فإن الخطاب الإسلامي لم ينشغل بهذا المقصد، بل انتقد مؤسسة السجن لذاتها.
أما الدراسة الثالثة فبعنوان: “قيمة إفشاء السلام في التحول الذهني للإنسان المعاصر” للمهندس عبد الحكيم السلماني بوعيون، الذي تناول فيها تأصيل الصياغة العلمية لقيمة “إفشاء السلام” (كفعل نفسي واجتماعي) وأثرها في التحول الذهني للإنسان، حيث يعيش الإنسان المعاصر تحت وابلٍ من القصف الدعائي لأحادية تفسير الفعل الاجتماعي المبني على آليات تدبير الصراع والعقلانية المقتصرة على إشباع الرغبات المادية. ويركِّز التحليل على حاجتين أساسيتين: “الرغبة في التنافس” و”الرغبة في التعاون”، ثم يتطرق للتصرفات النفسية-الاجتماعية من حيثُ كونها استراتيجيات مختلفة لتلبية الرغبات الأساسية، ومدى تأثير المناخ الثقافي العام في التحوُّل الذهني للفرد لتحديد اختياراته وتفاعلاته الاجتماعية.
وأما الدراسة الرابعة فدراسة مترجمة للأستاذ الدكتور أنيس أحمد بعنوان: “نحو أخلاق عالمية لِعالم العولمة“، ترجمها الدكتور حمدي الشريف. وتطرقت الدراسة إلى أن الأخلاق الإسلامية تعترف بدور الحدس والعقل والعادات والتقاليد، طالما أن الأخيرة تستمدُّ شرعيتها من المبادئ الإلهية، ولعل أهم ما يميِّز الأخلاق الإسلامية أنها تدعو -أولًا وقبل كل شيء- إلى مبدأ التماسك والوحدة والتآلف في الحياة. أما المبدأ الأخلاقي التأسيسي الثاني، الذي تدعو إليه فيتمثَّل في الأمر بالعدل، أو القسط والإنصاف والإحسان في الحياة. ثم يأتي احترام الحياة وتعزيزها كمبادئ تالية مرتبطة ومقترنة بالمبادئ السابقة.
وأما الدراسة الأخيرة في هذا المحور فكانت بعنوان: “التأريخ كرهان أخلاقي: علم التاريخ وإنتاج الذوات الأخلاقية” للأستاذ محمد البشير رازقي، الذي تناول فيها التاريخ بوصفه علمًا، ورأى أنه العلم الأفضل والأمثل والأكثر تأهيلًا لفهم زبدة الممارسات الأخلاقية للجنس البشري، خاصةً في عصر “ما بعد الأخلاق” لا فقط دراستها وتأريخها، بل قدرة هذا العلم على توريثها وإعادة إنتاجها، وخاصةً بناء الكائنات/الكينونات الأخلاقية. إذا لا يمكن لنا أن نشكِّل الذوات الأخلاقية اليوم بمعزِلٍ عن علم التاريخ.
وجاء المحور الرابع والأخير في هذا الملف بعنوان: “في أخلاق الجسد والفطرة“، ليتناول التحديات التي تواجه منظومة الأخلاق التقليدية في مجالات تطبيق الأخلاق، أو في إحلال منظومات أخرى محلّها، كون التحدي بات يمسُّ الأُسس والتصورات العميقة التي يقوم عليها البنيان الأخلاقي نفسه. إذ لا يستطيع المتأمِّل في أسئلة الأخلاق المعاصرة أن يتجاهل ما تنادي به المساعي العلمية من إعادة تشكيل الطبيعة البشرية تشكيلًا جديدًا. لقد غدت قضايا الأدوار الجندرية وتغيير الجنس وطبيعية الميول المتعدِّدة قضايا مفروضةً على أجندة الحقوق العالمية. فإذا كانت الأسرة في الإسلام -وفي غيره من الأديان أيضًا- تقع في قلب الرؤية الأخلاقية عن المجتمع، فإن مفهوم الأسرة بات مُهدَّدًا بألوان هجينة من الأُسر. لقد باتت الافتراضات البنائية مهيمنةً على ساحة النقاش الأخلاقي الغربي؛ إذ لم تعُد لمفاهيم “الفطرة” أو “الروح” صلاحية “علمية”، في وجه النزعات القائلة بإمكانية التشكيل الاجتماعي المستمرّ للذوات.
ويتكوَّن هذا المحور من دراستين جاءت الأولى بعنوان: “الأخلاق الإسلامية والجينوم من منظور اللاهوت العملي” للدكتور معتز الخطيب، الذي تناول فيها مفهوم الأخلاق وصلته بالدين من منظور اللاهوت العملي (practical theology)، أي إنه يرصد أبعاد التداخل بين مفهومي الأخلاق والدين على مستويين: المستوى النظري المتمثِّل بما بعد الأخلاق (meta-ethics) ومفاهيم مركزية أخرى، والمستوى التطبيقي الذي يرصد النقاشات الفعلية لأشكال الممارسة الصالحة أو المُبرَّرة أخلاقيًّا ودينيًّا. وقد جاءت معالجة الموضوع من خلال مسألة حديثة ومعقَّدة هي “التجيين” (geneticization)، أي ظاهرة المقاربة الجينية للجسد الإنساني بما تشتمل عليه من تدخلات (التدخل الجيني).
وجاءت الدراسة الثانية في هذا المحور بعنوان: “النقد الائتماني للنموذج الثقافي الحديث: نحو عصر أخلاقي” للدكتور عادل الطاهري، الذي تناول فيها أزمةَ العصر الحديث في القيم التي نجمت عن تنحية المقدَّس الديني واتخاذ منظومات قيمية جديدة تدين بمرجعيتها للعلم الوضعي أو للفلسفات المختلفة، وما قدَّمه الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن من نقد لهذه النظريات الحديثة المجافية للحِس الأخلاقي في شقيها العلمي والفلسفي الثقافي، من منطلق المسؤولية الفكرية والأخلاقية للفكر الإسلامي المعاصر.
وأخيرًا، نختم هذا الملف بحوار نقديّ مع الدكتور عبد الرزاق بلعقروز، الأستاذ المحاضر في فلسفة القيم والمعرفة في جامعة سطيف 2، الجزائر، حيث تطرقنا إلى جملة من أعماله في مجال فلسفة الأخلاق، التي تناول فيها جذور أزمة القيم المعاصرة ومظاهرها والاجتهادات الفلسفية لدرء آفاتها، وآفاق الاستفادة من التراث الروحي والأخلاقي الإسلامي لعلاج الأعطاب الأخلاقية للحداثة.
وفي الختام، يأمل مركز نهوض للدراسات والبحوث أن تُسهم هذه المقاربات -على تنوّعها، وعلى اختلاف مآلاتها ونتائجها- في الوصول إلى إجابات عن الأسئلة التي طرحها هذا الملف، ونكون قد رسمنا من خلاله خريطة لأبرز التحديات والحلول لبعض ما فَرَضته أجندة ما بعد الأخلاق على الأديان عامَّة، وعلى الإسلام خاصَّة. ونتمنَّى أن نكون قد شخَّصنا المشكلة بعمقها، وصحَّحنا بعض التصورات عنها، وقلَّلنا من حالة التِّيه القِيمي المعاصر من أجل تحصين مجتمعاتنا وتوليد مسارات فكرية وتربوية بديلة، وفتحنا آفاقًا للحوار الأخلاقي العالمي.”
رابط مباشر لتحميل الملف