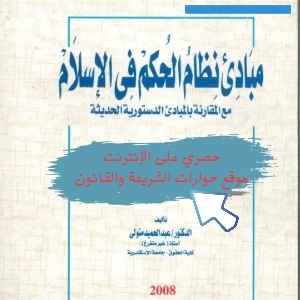صدر عن مدارات للأبحاث والنشر بالقاهرة في مطلع العام الحالي 2023 كتاب:
«الفصل بين الدين والدولة في الإسلام المبكر» لمؤلفه أيرا م. لابيدوس، ونقله إلى العربية وقدَّم له وعلَّق عليه الدكتور أحمد محمود إبراهيم مدرس التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وفيما يلي نبذة المترجم عن الكتاب:
“يتألَّف هذا الكتاب من ثلاث دراسات متواشجة للمستشرق الأمريكي أيرا م. لابيدوس (Ira M. Lapidus). ومدارُ هذه الدراسات الثلاث على تحقيق علاقة الدِّين بالدولة في الممارسة التاريخية عند المسلمين، وبيان أثر هذه العلاقة –من عدمه- في بناء الدولة القومية الحديثة.
أما الدراسة الأولى -والمعنونة بـ «العصر الذهبي: المفاهيم السياسية للإسلام»- فيذهب فيها لابيدوس إلى أن الدور الذي يؤديه الإسلامُ خلال العصر الراهن في ميدان السياسة بالشرق الأوسط ليس استمرارًا للنماذج التاريخية المطردة، ولكنه إعادةُ إنتاج لها؛ ففي عصر ما قبل الحداثة كان ثمة نموذجان إسلاميان مطردان: يتألَّف أحدهما من دولة ومجتمع متكاملين موحَّدين تحت قيادة سياسية وأخلاقية يتمتع بها معلِّمٌ دينيٌّ ذو شخصية كاريزمية، في حين كان النموذجُ الآخرُ عبارة عن مجتمع ينقسم إلى دولة ومؤسسات دينية ونُخَب سياسية ودينية متمايزة، وكان المنتسبون إلى هذه الفئة الأخيرة حُرَّاسًا للإسلام الصحيح. ولقد هيَّأ ذلك الموروثُ الثاني متسعًا لظهور بعض المفاهيم المـَلَكية العلمانية المحضة، وأفضى إلى نشأة ثقافة سياسية علمانية. ولم يكن للنماذج الإسلامية التاريخية في العصر الحديث إلا أثرٌ ضئيلٌ على تشكُّل الدولة [القومية]، بل إن الدول الإسلامية التي جاهرت بطابعها الإسلامي لا تلوذ بالماضي، ولكنها تُمَثِّلُ في معظم الأحيان دولاً قوميةً معاصرةً تستند إلى مفهوم جديد لإسلام الدولة القومية.
وأما الدراسة الثانية –والموسومة بـ «الدين والدولة في المجتمعات الإسلامية»- فيناقش فيها لابيدوس ما شاب دراسة العلاقة بين الدين والدولة في الإسلام من التباس وسوء فهم أحاط بهذه القضية من أطرافها المختلفة، واجتهد في تقديم وجهة نظر تاريخية أكثر إحكامًا، هادفًا إلى استقصاء التاريخ الإسلامي للشرق الأوسط، وتقديم تفسير لظهور الأنماط الإسلامية الرئيسة في مسألة العلاقة بين الدين والدولة؛ حتى ندرك على نحو أفضل -وبغير تحيز ثقافي أو سياسي أو الوقوع في أخطاء تاريخية- تاريخ العلاقات بين الدين والدولة في البلاد الإسلامية. ويقرر لابيدوس أن ثمة تباينًا ملحوظًا بين الدولة والمؤسسات الدينية في المجتمعات الإسلامية، خلافًا للرأي المتعارف عليه.
وتبيِّن الأدلة التاريخية أنه ليس ثمة نموذج إسلامي وحيد للدول والمؤسسات الدينية، وإنما نماذج عديدة متنافسة، وكل نموذج منها تتغشاه أوجه غموض تتصل بتوزيع السلطة، وماهية الوظائف والعلاقات بين المؤسسات. وثمة أخيرًا فروقٌ واضحةٌ بين النظرية والتطبيق. ومن شأن هذه الدراسة أن تبرز ما آل إليه أمر المناقشة حول هذه القضية بين المتخصصين، وأهمُّ من ذلك أن تمنح القراء غير المتخصصين فهمًا حسنًا لمسألة على قدر كبير من الأهمية لا في كثير من البلاد الإسلامية فحسب، ولكن من حيث الطريقة التي يتصور الأوربيون من خلالها علاقاتهم بهذه البلاد أيضًا.
وأما الدراسة الثالثة والأخيرة فقد جاءت بعنوان: «الفصل بين الدين والدولة في تطور المجتمع الإسلامي المبكر».
وقد حاول لابيدوس أن يجيب فيها على ثلاثة أسئلة:
ما العلاقة بين الدين والدولة في الإسلام؟ وكيف كانت هذه العلاقة في الأزمنة الإسلامية الكلاسيكية، على وجه الخصوص؟ وما هو ميراث الإسلام المبكر بالنسبة للمجتمعات الإسلامية فيما تلا ذلك من عصور؟
وإذا كان مدار الرأي الغالب بين الإسلاميين على أن المجتمع الإسلامي الكلاسيكي لم يفرِّق بين الجوانب الدينية والجوانب السياسية للحياة في المجتمع، وكانت الخلافة رئاسةً دينية وسياسية لأمة المسلمين، وهي الأمة التي ينتسب آحاد مؤمنيها وعموم رعاياها إلى نظام يحدده الولاء الديني، فإن لابيدوس يرى أن المجتمع الإسلامي تطور بطرائق غير إسلامية، وأن الحياة الدينية والسياسية قد استحدثت مجالات متمايزة لها قيمها وزعماؤها وتنظيماتها المستقلة. ومنذ منتصف القرن العاشر الميلادي، انتقلت السيطرة الفعلية على الإمبراطورية العربية الإسلامية إلى أيدي القادة العسكريين، ورجال الإدارة، والولاة، وأمراء الأقاليم، وفقد الخلفاء السلطة السياسية الفعلية على نحو تام. وأمست الحكومات منذ هذا التاريخ فما بعده سلطنات وأنظمة علمانية، يأذن بها الخلفاء نظريًّا، ولكنها تستمد شرعيتها في واقع الأمر من الحاجة إلى النظام العام. ومن الآن فصاعدًا، صارت الدول الإسلامية كيانات سياسية متباينةً بالكلية، وتفتقر إلى أي صفة دينية حقيقية، على الرغم من أن هذه الكيانات كانت تتسم بالولاء للإسلام على الصعيد الرسمي وتتعهد بالدفاع عنه”.
وذكر كذلك:
“ولا ريب أن فشل الدولة القومية في نُسْختها العلمانية، وعجزها عن الوفاء بتطلعات مواطنيها -سواء على صعيد الحرية السياسية واستقلال القرار الوطني، أم على صعيد النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية- قد دفع عددًا غير قليل من المسلمين إلى اللياذ بالماضي، والتفتيش في زواياه عن حلٍّ يمكن أن ينقذهم من بؤس الحاضر الذي صنعته الدولة القومية، ولم يكن هذا الحلُّ إلا طوبيا الخلافة أو الدولة الإسلامية “المتخيَّلة” التي غدت هي الخلاص النهائي في أنظار هؤلاء.
ولئن كانت الحداثةُ العلمانية في الغرب قد عوَّضت غياب الدين بعمق الفكر والثقافة، على نحو أثمر في النهاية نزعة إنسانية يحتل فيها الإنسانُ القيمة العليا، فإن الحداثة السياسية في جُلِّ المجتمعات الإسلامية المعاصرة “أبقت على الاستبداد والحُكْم الفردي، مع زيادة الآليات الحديثة في قمع المجتمع ومراقبته”. ويمكن القول بعبارة أخرى: إن هذه الحداثة السياسية المزعومة استبطنت منطقًا قروسطيًّا يقوم على التغلُّب والقهر، وإن حاولت أن تستر سوأة هذا المنطق بديباجات جوفاء عن الحرية والديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وتداول السلطة … إلخ.”.