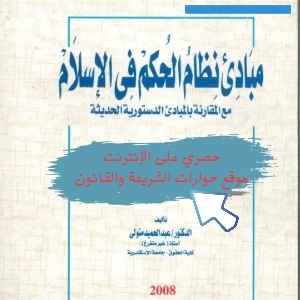المؤسسة في اللغة:
جمع مؤسسات، وهي صيغة جمع المؤنث لمفعول أسَّسَ.
وهي منشأة تؤسس لغرض معين، أو لمنفعة عامة ولديها من الموارد ما تمارس به هذه المنفعة، كدار المسنين أو السجن ونحوهما: مؤسسة علمية/دستورية/خيرية …، أو مؤسسات الجامعة وما يتبع لها من كليات ومعاهد ومكتبات ومراكز بحوث.
المؤسسة في الاصطلاح:
تُعرّف المؤسسة بأنها “كل هيكل تنظيمي مستقل ماليًا، ويخضع لكل من الإطار القانوني والاجتماعي، وهدفها دمج جميع عوامل الإنتاج من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج، أو تبادل السلع، أو تبادل الخدمات المختلفة، وأن المؤسسة باعتبارها منظمة تعتبر في ذات الوقت هيكلًا اجتماعيًا واقعيًا ومتعاملًا اقتصاديًا، وتتبع خصائص تنظيم متكامل”.
والمؤسسة (بالإنجليزية: Institution): منظمة تم تأسيسها من أجل تحقيق نوع ما من الأعمال، مثل تقديم الخدمات وفقًا لمعايير تنظيمية خاصة في مجال عملها، وتعرف المؤسسة أيضًا بأنها تسعى إلى تحقيق هدف ما، سواء أكان تعليميًا، أو وظيفيًا، أو اجتماعيًا.
ومن التعريفات الأخرى للمؤسسة: “هي إنشاء وتأسيس مكان خاص، أو عام من أجل تطبيق برنامج مُعيّن، أو فكرة ما، ومن الأمثلة على ذلك: مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة”.
ويُعِّرف المفكر الفرنسي موريس هوريو Maurice Hauriou المؤسسة بأنها “فكرة عمل أو مشروع يتحقق ويدوم قانونيًا في وسط اجتماعي، ولتحقيق هذه الفكرة يفترض إيجاد سلطة لديها أجهزة تمكنها من عملية الضبط والتنفيذ، كما يفترض أن تتولد مظاهر تقارب بين أعضاء المجموعة الاجتماعية المعنيين، توجهها أجهزة السلطة وتنظمها أصول وقواعد”.
المؤسسة في القانون:
لا يرتبـط مفهـوم المؤسسـة فـي لغـة القانـون بموضـوع ثابـت؛ لأنـه مفهـوم متحـرك يعـرف بالنظـر إلـى فـرع القانـون الـذي يتواجـد فيـه، فتعريفهـا بالنظـر إلـى القانـون التجـاري يختلـف عنه فـي قانـون العمـل، حيـث تعتبـر فـي القانـون التجـاري وحـدة اقتصاديـة تقـوم علـى مجموعـة مـن الأجهـزة بهـدف الإنتـاج أو التوزيـع، بينمـا ينظـر إليهـا فـي قانـون العمـل علـى أن الأشـخاص -وهـم الأجـراء- يمارسـون نشـاطًا مأجـورًا تحـت سـلطة شـخص آخـر يُدعـى المسـتخدم.
يرتبــط تحديــد الوجــود القانونــي للمؤسســة بظهورهــا بأحــد الأشــكال القانونيــة، كالمؤسســة ذات الشـخص الوحيـد مثـلا، ومـع هـذا لا يتحقـق هـذا الظهـور دائمـًا لأن المؤسسـة قـد تكـون عبـارة عـن نشـاط مصغـر أو مقاولـة حـرة، وقـد تأخـذ المؤسسـة شـكل الشـركة التجاريـة كمـا يمكنهـا أن تنشــأ دون الاعتبار للشــكل التجــاري، وهنــا قــد يرجــع الأمــر لحجمهــا ونــوع النشــاط الــذي تمارســه. وعليــه لا يغطــي مفهــوم الشــركة فــي المقابــل وبالضــرورة مفهــوم المؤسســة فيمكــن للمؤسسـات أن تنشـأ دون أن تأخـذ شـكل الشـركة التجاريـة.
علـى العكـس مـن ذلـك يمكـن أن نجـد عنـد تطبيـق قانـون العمـل مجموعـة مـن الشـركات تحمـل اختلافـات كثيـرة ومـع ذلـك تسـمى مؤسسـة، لكـن بتوظيـف تعريـف المؤسسـة فـي قانـون العمـل أو مـا يعـرف بالهيئـة المسـتخدمة.
ويصعــب إعطــاء تعريــف قانونــي للمؤسســة لســبب بســيط كــون أن المؤسســة هــي مفهــوم اقتصــادي أكثــر منــه قانونــي، ومــع ذلــك يســاعد تصنيفهــا بالنظــر إلــى الأشــكال القانونيــة التــي تظهــر بهــا أو الطابــع الاقتصادي الــذي يغلــب علــى نشــاطها أو طبيعــة ملكيتهــا علــى تحديــد مفهومهــا، وفــي كل الأحــوال يختلــف تعريفهــا بحســب النظــام الاقتصادي المُتبع.
وتصنــف المؤسســة بالنظــر إلــى الشــكل القانونــي )إلي مؤسسات فردية أو شركات تجارية للأموال أو الأشخاص، في حين تصنف بالنظـر إلـى الطابـع الاقتصادي إلـى صناعيـة، فلاحيـة، تجاريـة، خدماتيـة أو حرفيـة لتشـترك فـي مجملهـا فـي اعتبارهـا وحـدة منظمـة أو مهيكلـة تقـوم علـى تجميـع وسـائل بشـرية وماديـة مـن أجـل الإنتـاج أو التوزيـع أو تقديـم الخدمـات، أو حتــى القيــام بنشــاط الاستيراد، بينمــا تقســم بحســب طبيعــة الملكيــة فيهــا إلــى مؤسســات عامــة ومؤسسـات خاصـة، وإذا كانـت المؤسسـة الخاصـة لا تطـرح إشـكالًا مـن حيـث الطابـع الاقتصـادي والإطــار القانونــي، فــإن الأمــر لا يبــدو كذلــك علــى الأقــل بالنســبة للإطــار القانونــي للمؤسســة العموميـة.
المؤسسة في المجال العام:
أما المؤسسات في المجال العام حديثا؛ فإن التنظيمات الحديثة تنتهي إلى تحديد جهات ثلاثة يتوزع بينها العمل العام أو النشاط العام، بحيث يكون من يصدر القرار أو يصوغ الإرادة العامة غير من ينفذ هذه الإرادة غير من يشرف على صحة تطبيقها.
فالمؤسسة الأولى التشريعية: وهي مصدر القرار العام وهي تتكون بطريقة تمكنها من أن تقوم بهذه الوظيفة، إذ يكفل لها أسلوب اختيار أعضائها أن تكون على علاقة مباشرة بقوى الرأي العام الموجودة في المجتمع، وتمارس عملها بإجراءات تتيح لها أن تكون بقدر الإمكان جهازًا متصلا بالرأي العام وخارجها، عن طريق اتصال أعضاء هذا الجهاز بالمؤسسات ذات الشأن في المجتمع.
والمؤسسة الثانية: هي المؤسسة التنفيذية، وهي تتعلق بالإدارة والتنفيذ، وتخضع في عملها للسياسة التي تقررها الهيئة التشريعية، فهي أداة لتنفيذ هذه السياسة وأداة لإدارة العمل اليومي. ومؤسسة التنفيذ تُبنى بطريق هرمي، رئاسي، حيث تقوم رئاسة مفردة أو قليلة من حيث عدد الأشخاص، وتقوم باختيار الأشخاص في الوظائف الأدنى نزولا من قمة الهرم إلى أسفله وقاعدته العريضة، وحركة الدفع ترد من أعلى إلى أسفل، فالسياسات ترسم في المستويات الأعلى كما أن الإشراف والرقابة يأتيان من المستويات الأعلى للمستويات الأدنى منها وهكذا. وهذا هو أسلوب التشكيل الذي يتلاءم مع الوظيفة التنفيذية التي تأتي بعد اتخاذ القرارات ورسم السياسات. ولذلك تعتمد على إصدار الأوامر للتنفيذ، وهذا هو شأن الوزارات والمصالح المختلفة وهو كذلك الشأن بالنسبة لأجهزة الضبط كالشرطة والجيش.
والمؤسسة الثالثة: هي “القضاء” وتختلف نظمنا القائمة في طريقة تعيين القضاة ولكن يبقى أنه جهاز يراقب الشرعية ويقضى بها، سواء في تعاملات الأفراد أو في عقاب المجرمين أو في رقابة نشاط السلطات العامة. وهو يتكون من وحدات متماثلة في الأساس يتوزع العمل عليها حسب التوزيع المحلى للأعمال (في المناطق المختلفة) أو التوزيع النوعي الذي تنشأ به محكمة لكل من أنواع القضايا المدنية والجنائية والتجارية… وهكذا. والقضاء الآن جهاز محصور النشاط في تطبيق القوانين والقرارات التي تصدرها جهة التشريع، وفى الإشراف على سلامة تطبيق تلك القرارات على الوقائع والأنشطة المختلفة، وهو يمارس عمله في النظم القائمة الآن وفقا لمجموعة كبيرة من الإجراءات المحددة سلفا، والتي نظمتها القوانين المختلفة.
أما المؤسسات في المجال العام من المنظور الإسلامي؛ فقد فصل في شرحها المستشار طارق البشري، حيث ننقل عنه تفصيلاً ما أورده حول هذا الأمر لأهميته في هذا المقام، وذلك على النحو الآتي:
الشائع أن النظام الإسلامي لم يعرف تعدد المؤسسات في المجال العام التي توزع عليها السلطة، ومرد ذلك أن أسس النظام الإسلامي تختلف اختلافًا جذريًا عن أسس النظام السائد الآن من حيث إن النظام الحديث نظام وضعي لا يعترف بشريعة أو شرعية للحكم منزلة من السماء، في حين أن النظام الإسلامي يبدأ من مقولة أساسية هي مصدرية السماء لتشريع الأرض وانعكس ذلك على شكل المؤسسات وتوزيع السلطات. فالهيكل التشريعي في النظم الإسلامية كان يصدر عن هيئات جد مختلفة عما تخيلته النظرة الوضعية العلمانية في توزيعها للسلطة. وأن الهيكل التشريعي كان في النظر الإسلامي أكثر بعدًا عن هيمنة السلطة التنفيذية.
أما بالنسبة للمؤسسة القضائية فإن النظام الإسلامي يتصور الوظيفة القضائية جزءًا من الولاية العامة التي يمارسها «الإمام» وذلك حسبما نعرف من وقائع النظم الإسلامية وحسبما يثبت فقهاء «الأحكام السلطانية»، وقد كان الخلفاء الراشدون يقضون بأنفسهم فيما يتنازع فيه الناس من أمور. كما أن للإمام أن يعين القضاة وله أن يسمح للولاة والأمراء في الأقاليم أن يعينوا القضاة في الأقاليم التي يتولون عليها. وهذا الوضع ما يثير الكلام حول شمولية الحكم الإسلامي وأن القضاء تابع لسلطات الحكم التنفيذي، بحسبان أن القاضي إنما يستمد ولايته من إنابة الأمير أو الوالي له. كما أن التصور الفقهي في الإسلام جعل الإمام صاحب السلطة التنفيذية، وأن مهمة التشريع بعيدة عن مجال هيمنته وإشرافه وليست خاضعة له. وذلك لا يجرى بموجب توزيع السلطة كما يرسمه النظام الوضعي، ولكن بموجب سابقة الإقرار بأن التشريع منزل من الله سبحانه وتعالى بالقرآن والسنة. وسلطة الحاكم مقيدة ليس فقط بموجب التوازنات بين المؤسسات المختلفة، إنما هو قيد يستمد من الأصل العام المعترف به في المجتمع الإسلامي وهو الخضوع للشريعة، وأن الحاكم لا يملك تغيير هذا القانون وأن ليس لأية مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تعدله. والقاضي في هذا التصور وإن تولى وظائفه بالإنابة من الإمام أو من الوالي، فهو لا يخضع لمن عينه عندما يستقى أحكامه مباشرة من القرآن والسنة وباجتهاده من هذين المصدرين.
إن المؤسسة التشريعية في النظم الغربية تعرف وظيفتين، الأولى: أنها المؤسسة التي تصدر التشريعات والقوانين في المجتمع والوظيفة الثانية: أنها المؤسسة التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية ولها عليها وجه إشراف ونوع سطوة تختلف في حجمها ونوعها حسب الدول والمجتمعات. وقد أشرنا إلى الوظيفة الأولى وما يقابلها في النظم التي عرفها التاريخ الإسلامي، وتبقى الوظيفة الثانية وقد أشرنا من قبل إلى دور مؤسسة القضاء كرقيب على الشرعية، سواء “الشرعية الوضعية” المعروفة في النظم الغربية، أو “الشرعية الإسلامية” المستمدة من أصول التشريع الإسلامي. ولكن الرقابة التي يكفلها الجهاز القضائي في أي من النظامين لا تكفي؛ لأن الجهاز القضائي حسب الأصل الغالب فيه لا يتحرك إلا إذا قام نزاع يعرض عليه وهو لا يتحرك حسب الغالب أيضًا إلا في صدد ارتكاب الجرائم أو انتهاك الحقوق.
أما ما يتصل بحسن أعمال السياسات المختلفة أو سوئها وما يتعلق بالحض على المعروف ومنع المناكر بعامة ومراعاة المصالح للجماعة والأفراد. فهذه دائرة أوسع كثيرا من اختصاص الجهات القضائية وفى النظم الغربية توجد المؤسسة التشريعية التي تقوم بالدور الرقابي بالنسبة لسياسات الحكومات. كما توجد أجهزة أخرى لرقابة النشاط الإداري الجهاز الدولة في الأعمال اليومية المرسلة التي يقوم بها، وهي أنواع رقابة تتنوع في كل نظام، فمنها الرقابة الذاتية التي تنشئها أية مؤسسة بداخلها لتراقب عمل رجالها، ومنها إيجاد أجهزة لرقابة مركزية على مستوى الدولة كلها لتراقب أجهزة الدولة التنفيذية على تنوعها وتعددها، فتكون أجهزة لرقابة الشؤون المالية أو لمراقبة الشرعية في سلوك عمال الدولة ومنها أجهزة رقابة خارجية أي تراقب أجهزة التنفيذ وتنتمي إلى سلطة بعيدة عن السلطة التنفيذية. وفي هذا الصدد هناك نوعين من هذه الرقابة مما عرفه تاريخ التنظيمات الإسلامية. أحدهما يشكل داخل الجهاز الحاكم ويشكل قمة الرقابة الذاتية السلطة الدولة. والثاني: له وجه اتصال بالحركة الشعبية مما يمكن أن يقوم بدور رقابة خارجية على جهاز الدولة وعلى حياة المجتمع كلها والأول هو ديوان المظالم، والثاني هو نظام الحسبة.
ومن الملاحظ أن التدوين الفقهي والتاريخي قد نقل إلينا تلك التقسيمات العامة في المؤسسات والمناصب التي توزع عليها عمل الدولة التنفيذي، مثل الإمامة وزارة التفويض وزارة التنفيذ، الإمارة (الولاية على إقليم)، إمارة الجيش القضاة المظالم، المحتسب … إلخ. ونجد الفقه يعتني ببيان شروط التولية لكل من هذه المناصب، وبما لكل من صلاحيات في العمل، ولكننا لا نجد تحديد العلاقات بين كل من هذه المناصب والآخر، كما لا نجد رسما للعلاقات التي تنشأ وراء كل منصب منها، ذلك أن أيًا من هذه المناصب لا يتصور أن يمارس فرد واحد كل صلاحياته لضخامتها وسعتها. والمؤكد أن كل من يلى واحدا من هذه المناصب، إنما يستعين بأفراد آخرين ينوبون عنه في بعض المهام ويعينونه فيما يقوم أعمال، بمعنى أن كلا من هذه المناصب لابد أن ينشأ له مؤسسة أو جهاز يقوم به، ويقف صاحب الولاية على رأسه هذا الجهاز، كما لا نجد أن الفقه اعتنى ببيان طريقة بنائه والسمات العامة لتوزيع الأعمال بداخله والعلاقات المتبادلة بين العاملين فيه وبينهم وبين رؤسائهم وطريقة تعيينهم وغير ذلك، كما أننا نقرأ عن أهل الحل والعقد، وأحيانًا عن أصحاب أو أهل الشورى، وأحيانا يتكلم البعض عن “المجتهدين” ، ولكننا لا نصادف أي بيان لتكوين تنظيمي لأى من هذه الأعمال، ولا نجد أن مجلسًا أنشئ على وجه الاستمرار للقيام بعمل منها، أو أن نظامًا اتبع في استطلاع آراء أي من هذه الجماعات في أي من الأوقات. ويبدو أن الأمر كان يجرى بأسلوب تلقائي، وأنه كان يتم بالتحري الشخصي أو جمع من يتيسر جمعه ممن يعتبرون أهل الحل والعقد لاستطلاع آرائهم وفق المشيئة الفردية للحاكم وحسبما يراه مناسبًا وحسب ما يتعارف عليه الناس في كل زمان أو مكان بالنسبة لمن يعتبر من ذوي الرأي أو ذوي المكانة الاجتماعية، بمعنى أنه لم يرد على هذا النوع من الأعمال العامة شيء من الضبط الفقهي أو التكوين المؤسسي التنظيمي الذي يوجد هيئة معينة مكونة من أشخاص تبين صلاحياتهم وتحدد طريقة عملهم معا. إن الفقه الإسلامي في مجال القانون الدستوري والإداري؛ لم يعن ببحث تكوين المؤسسات والكيانات التنظيمية ذات الصفة الثابتة نسبيا. ولا نجد جهة حددت تشكيلها من عناصر متعددة إلا ديوان المظالم. ولم يكن هذا النقص عيبًا تتسم به أعمال الفقهاء، ولكنه كان سمة ظاهرة في أسلوب تنظيم الأعمال الإدارية بعامة على مدى تاريخي طويل جدا، حيث كانت الوظيفة أو المنصب يندمج في شخص القائم به، وكانت العلاقات بين الرئيس والمرؤوس تندمج في علاقة تنطوي على نوع من التبعية الشخصية، وتمارس من خلال هذه العلاقات الشخصية ونقصد بالعلاقات الشخصية هذا النمط من العلاقات الذي يجرى بأسلوب عفوي طليق من الضوابط الموضوعية المرسومة التي السلطة تحدد أسلوبه وإجراءاته. وكثيرا ما تكون أدوات العمل كالمقار التي يتم فيها والأوراق وغير ذلك مما يقع في حوزة العامل شخصيًا. كما أن الأعمال الإدارية الصغيرة كانت أقرب للحرف التي يمارسها الشخص ويدرب عليها أبناءه وعادة ما يتولونها من بعده، مثل أعمال «الصرافة» أي جمع الضرائب، وأعمال مسح الأراضي وتنظيمها وغير ذلك. وعرفت أعمال الإدارة العليا أيضا نوعا من التوارث من الآباء إلى الأبناء بشرط اعتماد الوالي بطبيعة الحال. ولم تعرف كثيرا فكرة تقسيم العمل الواحد إلى عديد من العناصر التي توزع على أفراد متخصصين في كل من هذه التقسيمات.
أما الفكر الإداري الحديث فقد عرف أسلوبًا آخر في العمل، هو الأسلوب غير الشخصي وهو الأسلوب المؤسسي المتجرد من الشخصنة، وهو يستند في بدايته على تجريد المنصب أو الوظيفة عن شخص العامل بها، فهو يرسم خريطة للوظائف وللمهام المطلوبة في أي عمل، ثم يختار لكل منها من يقوم بها من العاملين حسب مؤهله وتخصصه. والوظائف بهذه الكيفية تحدد وتوزع على أسلوب نوعي يتعلق بنوع العمل المطلوب تأديته، وأسلوب محلى يتعلق بالإقليم المطلوب أداء المهام به. وأسلوب رأسي بين رئيس ومرؤوسين. وترسم مستويات للعمل تعلوها مستويات أخرى للتوجيه والإشراف، وهكذا، وكل ذلك يتخذ شكله في صورة تنظيمات وقرارات مكتوبة وتعتمد الإدارة الحديثة بعامة، على الوثائق المكتوبة التي تحفظ أصولها، وبهذا ينفصل العمل الوظيفي عن النشاط الشخصي للقائم به، فتصير المعلومات اللازمة للقيام بالعمل، والخبرة التي تتراكم بشأنه، يصير كل ذلك مودعا في جهة وليس حبيس التجربة الشخصية للموظف. وبهذا يمارس العمل وفق أصول موضوعية أو شبه موضوعية وفي إطار سلطة مقيدة لمن يقوم به، وتنفصل أدوات العمل ومنشآته وأماكن مزاولته عن الملكية الخاصة بمن يقوم به. كما يقوم النظام الحديث على أساس تميز علاقة المرؤوس عن الرئيس، فهو يعين وفقا الضوابط ومعايير معروفة سلفا، وعلاقاته بجهة العمل محددة سلفا من حيث صلاحيات العمل وحجم الراتب وأسلوب زيادته من حيث طريقة ترك العمل. ولم يعد عزل التفويض يعنى عزل من كان عينهم في أعمالهم كما يذكر في كتب الأحكام السلطانية.
ومن هذه الملاحظات يتبين أن أسلوب العمل ممارسة، وطريقة السلطة قد تغيرت عن الوضع القديم من جانبين:
أولًا: تقسيم العمل الواحد عبر العديد من الأجهزة والهيئات.
ثانيًا: حلول القرار الجماعي بهذه الهيئات محل قرار الفردي.
وهذا مما يعبر عنه بحكومة الهيئات والمؤسسات في مقابل حكومة الأشخاص التي عرفتها النظم السابقة. وهذا الوجه من وجوه التنظيم للعمل العام هو ما يتعين إثراء النظام الدستوري والإداري الإسلامي به.
_______________________________
المصادر:
– طارق البشري، منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، 2007، ص:53-80.
– عبد الله قادية، الإطار القانوني للمؤسسة العمومية في الجزائر كعون اقتصادي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 16، العدد 1، يونيو 2019، ص: 611-612.
– تعريـف المؤسـسة وخـصائـصها، المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، 11 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://www.almerja.com/reading.php?idm=186353. – محمود حديد، المؤسسة، الموسوعة العربية: الفلسفة وعلم الاجتماع والعقائد، المجلد 20، ص 11، https://arab-ency.com.sy/ency/details/10544/20.