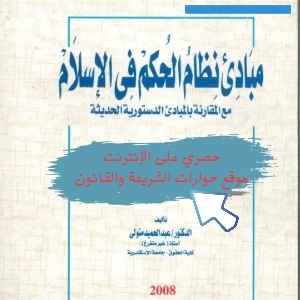باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثاني من ربيع الأول سنة 1443هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 30 قضائية "دستورية"*.
المقامة من:
عبد الجليل محمد أحمد عبد العليم
ضــــد:
1- رئيس الجمهورية 2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل 4- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
5- الممثل القانوني للهيئة القومية للبريد
6- داليا عبد الجليل محمد أحمد عبد العليم
7- دعاء عبد الجليل محمد أحمد عبد العليم
الإجـــراءات
بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند "هــ" من المادة (502) من القانون المدني، فيما تضمنه من اعتبار الهبة لذي رحم محرم مانعًا من الرجوع في الهبة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى كان قد أقام الدعوى 1360 لسنة 2006 مدني كلى، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية، ضد المدعى عليهم الخامس والسادسة والسابعة في الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم باعتبار الهبة كأن لم تكن، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بما فيها إلغاء التوكيل العام رقم 370/هــ لسنة 2005 توثيق بورسعيد. وقال بيانًــــا لدعواه، إنه وهب لنجلتيه المدعى عليهما السادسة والسابعة نصيبه في تركة زوجته –والدتهما- سعاد أحمد حسن عطية، ويشمل حصة في شقتين بالعقار المبين بصحيفة الدعوى، ومبلغًـــــا ماليًا بدفتر توفير لدى الهيئة القومية للبريد، وشقة يمتلكها بالعقار ذاته، وحرر لهما توكيلًا بالتصرف في تلك الأموال، إلا أنهما قد أغضبهما زواجه من أخرى، أنجبت له ولدين، فقدمتا ضده عدة بلاغات كيدية، كما أقامتا دعوى قضى فيها بإلزامه بأن يؤدى لهما نفقة شهرية، فضلًا عن أنه ملتزم بالإنفاق على زوجته وولديه، وكذا نفقة ومصروفات علاج شقيقه، مما أرهق كاهله، بعد أن زادت التزاماته المالية، الأمر الذي يوفر له العديد من الأعذار للرجوع في هبته، فأقام دعواه بالطلبات السالفة البيان. وأثناء نظر الدعوى بجلسة 29/1/2008، دفع بعدم دستورية نص البند "هـــ" من المادة (502) من القانون المدني، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (502) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أنه "يرفض طلب الرجوع في الهبة، إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(أ) ............ (ب)........... (ج) ............ (د) ...........
(هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم ..................".
وحيث إن من المقــــــرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية –وهي شرط قبولها– أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى يبتغى من دعواه الموضوعية الترخيص له بالرجوع عن هبته لابنتيه، لقيام موجبات ذلك في حقه. وكان نص البند "هــ" من المادة (502) من القانون المدني يحول دون تحقيق مبتغاه، الأمر الذي يوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على هذا البند في مجال سريانه على هبـــــــــــة أي من الوالدين لولده، وبها يتحـــــدد نطـــــاق هذه الدعـــــوى، دون سائر ما انطوى عليه نص هذا البند من أحكام لطبقات أخرى من ذوي رحم محرم.
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفة أحكام المادتين (2، 40) من دستور سنة 1971، المقابلة لأحكام المادتين (2، 53) من دستور سنة 2014، لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية، التي حضت على البر بالوالدين وعدم عقوقهما، وأكدت معظم مذاهبها على أحقية الوالد في الرجوع عن هبته لولده، دون أية أعذار، فضلًا عن انطواء النص على تمييز غير مبرر، بأن منع الواهب لولده من الرجــــوع في الهبة، حــــال أن غيره مــــن الواهبين يجــــوز لهم الرجــــوع في الهبة إذا توافر عذر يبيح لهم ذلك.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلًا -على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًـــــا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعى للنص المطعون عليه –في النطاق السالف تحديده– تندرج تحت المناعي الموضوعية، التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي معين لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي. ومن ثم، فإن المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه –الذي مازال ساريًا ومعمولًا بأحكامه– من خلال أحكام دستور سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
وحيث إن القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، قد خصص الكتاب الثاني منه للعقود المسماة، وأورد في الباب الأول منه العقود التي تقع على الملكية، وأفرد الفصل الثالث منه لعقد الهبة، في المواد من (486) حتى (504)، مبينـــًا فيها أركان الهبة، وآثارها، والرجوع فيها، وموانع الرجوع، معرفـــًا في المادة (486) الهبة بأنها عقد يبرم بين الأحياء، بموجبه يتصرف الواهب في ماله دون عوض، مع جواز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين. ووفقـــًا للمادة (487)، لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. ومن خصائص الهبة –على ما أوردت الأعمال التحضيرية للنص المطعـــــون فيه والتنظيم التشريعـــــي للهبة– أنه يجـــــوز الرجوع فيها رضـــــاءً أو قضاءً إذا وجد عذر ولم يوجد مانع، وقد نظمها المشرع مراعيًا هذا الأصل، فأكد في المادة (500) من القانـــــون المدني على أنه "يجـــــوز للواهب أن يرجـــــع الهبـــــة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل، جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. وتأكيدًا على جواز الرجوع في الهبة، وضع المشرع في المادة (501) من القانون ذاته أمثلة لهذه الأعذار، تيسيرًا على القاضي، كما حدد في المادة (502) من ذلك القانون، حصرًا لموانع الرجوع في الهبة، ومن بينها حالة الهبة لذي رحم محرم، ومن ذلك هبة أي من الوالدين لولده. ومؤدى العبارة الواردة بصدر نص تلك المادة من أن "يرفض طلب الرجوع في الهبة"، نهي القضاة عن التعرض لموضوع الرجوع، أيـــًا كانت الأعذار التي بنى عليها، إذا توافر أحد موانع الرجوع الواردة في تلك المادة، عملًا بقاعدة جواز تقييد القاضي بالزمان والمكان والأحداث والأشخاص. وشرط صحة تلك القاعدة أن يكون النهى مؤسسًـــا على أسباب موضوعية، ترتبط بالغاية المتوخاة منه.
وحيث إنه عن نعى المدعى مخالفة النص المطعون عليه –في النطاق السالف تحديده- لمبادئ الشريعة الإسلامية، ونص المادة الثانية من الدستور، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، طبقًا لنص المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971، بعد تعديلها بتاريخ 22/5/1980 –وتقابلها المادة الثانية من الدستور الحالي الصادر سنة 2014– لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصــــدر بعد التاريخ الذي فُـرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطــــــــوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إعمال حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها، لصدورها فعلًا من قبله، في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا، واجب الإعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية، وهو القيد الذي يبقى قائمًا وحاكمًا لتلك التشريعات، بعد أن ردد الدستور الحالي الصادر سنة 2014، الأحكام ذاتها في المادة الثانية منه.
وحيث كان ما تقدم، وكان نص البند (هـ) من المادة (502) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 لم يلحقه أي تعديل بعد تاريخ 22/5/1980، مما كان لزامه عدم خضوعه لقيد الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، والمادة الثانية من الدستور، إلا أنه بالرغم من ذلك، وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني، فقد استقى المشرع الأحكام الموضوعية للهبة من أحكام الشريعة الإسلامية. وفى شأن مدى جواز الرجوع في الهبة، أخذ بمذهب الفقه الحنفي، الذي أجاز الرجوع في الهبة إذا توافر العذر المبرر، وانعدم المانع، ويشمل عدم جواز الرجوع في الهبة لذي رحم محرم، ومن ذلك هبة الوالد لولده، على سند من أن الغاية من الهبة في هذه الحالة صلة الأرحام، وقد تحققت بصدور الهبة. وإذ كان الرأي الذي تبناه المشرع في هذا الشأن لا يخرج عن كونه اجتهادًا في الفقه الحنفي فقد ذهب مالك والشافعي وابن حنبل وعلماء المدينة إلى جواز رجوع الوالد في هبته لولده، وهو ما يعرف باعتصار الهبة، أي أخذ المال الموهوب قسرًا عن الابن، مستدلين في ذلك بحديث طاووس من أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده"، وفى رواية أخرى "لا يحل للرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة ويرجع فيها إلا الوالد فيما يهب لولده"، وفى رواية ثالثة "لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده". وقد دل الفقهاء باختلافهم هذا على عدم وجود نص قطعي الثبوت أو الدلالة، أو بهما معًــا في مبادئ الشريعة الإسلامية، يحكم هذه المسألة، ومن ثم تعتبر من المسائل الظنية التي يرد عليها الاجتهاد، وتلك المسائل بطبيعتها متطورة، تتغير بتغير الزمان والمكان، وإذا كان الاجتهاد فيها وربطها منطقيًّــا بمصالح الناس حقًــا لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق لولي الأمر، ينظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دومًــا واقعًــا في إطار الأصول الكلية للشريعة لا يجاوزها، ملتزمًــا ضوابطها الثابتة، متحريًــا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلًا صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلزمًــا في ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقًــا لولي الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما، ما لم يكن إثمًــا، وكان واجبًــا عليه كذلك ألا يشرع حكمًــا يضيق على الناس أو يرهقهم في أمرهم عسرًا، وإلا كان مصادمًــا لقوله تعالى "مَا يُرِيدُ اللًّه ليَجعَلَ عَلَيكُم في الدين من حَرَجِ".
وحيث إن نص البند (هـ) من المادة (502) من القانون المدني، منع الرجوع في الهبة لذي رحم محرم، وقد ورد هذا النص بصيغة عامة ومطلقة، ليشمل هبة أي من الوالدين لولده. واستقى المشرع هذا المانع من المذهب الحنفي، منتهجًــا بذلك نهجًــا مخالفًــا لاجتهاد باقي المذاهب الإسلامية، معللًا ذلك المانع بتحقق غاية الواهب من الهبة، ممثلة في صلة الرحم. وقد صدَّر المشرع نص تلك المادة بعبارة "يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية ....."، مما مؤداه نهى القضاء عن بحث الأعذار التي قد تحل بالوالد الواهب وتستدعى رجوعه في الهبة، وإن كانت تلك الأعذار من بين الأمثلة التي ورد النص عليها في المادة (501) من ذلك القانون، ومن ذلك: "أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودًا كبيرًا من جانبه، أو أن يصبح الواهب عاجزًا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير". ومؤدى ذلك أن النص المطعون فيه، وإن وقع في دائرة الاجتهاد المباح شرعًــا لولى الأمر، إلا أنه –في حدود نطاقه المطروح في الدعوى المعروضة– يجعل الوالد الواهب في حرج شديد، ويرهقه من أمره عسرًا، ويعرضه لمذلة الحاجة بعد أن بلغ من العمر عتيّا، إذا ما ألمت به ظروف أحوجته لاسترداد المال الموهوب، وامتنع الابن عن إقالته من الهبة، إضرارًا به، مستغلًا في ذلك المانع الوارد بالنص المطعون فيه، الذي يحول بين الوالد والحصول على ترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة، ضاربًــا عرض الحائط بالواجب الشرعي لبر الوالدين، والإحسان إليهما، وصلتهما، وطاعتهما في غير معصية، والامتناع عن كل ما يفضى إلى قطيعتهما. فضلًا عن أن ما توخاه المشرع من ذلك المانع، بالحفاظ على صلة الأرحام، ينافيه مواجهة حالة جحود الأبناء، وعقوقهم لوالديهم. ومن ثم يكون منع القضاء من الترخيص للوالد بالرجوع في هبته لولده، ولو كان هناك عذر يبيح له ذلك، مصادمًــا لضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، ومخالفًا بذلك نص المادة (2) من الدستور.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القيم الدينية والخلقية لا تعمل بعيدًا أو انعزالًا عن التقاليد التي تؤمن بها الجماعة، بل تعززها وتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، ومن أجل ذلك جعل الدستور في المادة (10) منه، قوام الأسرة الدين والأخلاق والوطنية، كما جعل الأخلاق والقيم والتقاليد، والحفاظ عليها والتمكين لها، التزامًــا على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة، والمجتمع ككل، وغدا ذلك قيدًا على السلطة التشريعية، فلا يجوز لها أن تسن تشريعًــا يخل بها، ذلك أنه، وفقًــا لنص المادة (92) من الدستور، وإن كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق والحريات أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم فيما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته اختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظيم للحقوق، لا يجوز أن يصل في منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو الانتقاص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لا تكفل فاعليتها. الأمر الذي يضحى معه النص المطعون عليه، فيما تضمنه من رفض طلب رجوع الوالد في هبته لولده، إذا وجد مانع، مخالفًــا أيضًا – نصي المادتين (10، 92) من الدستور.
وحيث إنه عن النعي بإخلال النص المطعون عليه –في النطاق السالف تحديده– بحق الواهب لولده، دون غيره مــــن الواهبين لغير ذي رحم محرم، في الحصول على ترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة عند توافر العذر، فإن ما نص عليه الدستور في المادة (97) من أن "التقاضي حق مصون ومكفــــول للكافــــة"، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته، من الحقوق العامة المقررة للناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال النفاذ إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها ولتأمين مصالحهم التي ترتبط بها، مما مؤداه أن قصر مباشرة حق التقاضي على فئة من بينهم أو الحرمــــان منه في أحــــوال بذاتها، أو إرهاقــــه بعوائــــق منافية لطبيعته، إنما يُعــــد عملًا مخالفًا للدستور الذي لم يجــــز إلا تنظيم هذا الحق، وجعل الكافة ســــــواء في الارتكان إليه، ومن ثم، فإن غلق أبوابــــــــه دون أحدهم أو فريق منهم، إنما ينحل إلى إهداره، ويكرس بقاء العدوان على الحقوق التي يطلبونها، وعدم حصولهم على الترضية القضائية باعتبارها الغاية النهائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على تلك الحقوق.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور الحالي، ورددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وقيدًا على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، التي لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية.
وحيث إن الأصـــــل في كل تنظيم تشريعي أن يكـــــون منطويًا علــــى تقسيم، أو تصنيف، أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو عن طريق المزايا، أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعًا محددًا، عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها، بالوسائل المؤدية إليها، منطقيًـــا، وليس واهيًـــا أو واهنًــا، بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًا. ومرد ذلك، أن المشرع لا ينظم موضوعًا معينًا تنظيمًا مجردًا أو نظريًا، بل يبغيا بلوغ أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها إطارًا لمصلحة عامة لها اعتبارها، يقوم عليها هذا التنظيم، متخذًا من القواعد القانونية التي أقرها، مدخلًا لها، فإذا انقطع اتصال هذه القواعد بأهدافها، كان التمييز بين المواطنين في مجال تطبيقها، تحكميًا، ومنهيًا عنه بنص المادة (53) من الدستور.
وحيث كان ما تقدم، وكان الواهبون لأموالهم، على اختلاف حالاتهم، وأغراضهم منها، في مركز قانوني متكافئ، وقد أجاز المشــــرع –على ما سلف بيانه– للواهب الرجوع في الهبة إذا ألمت به ظروف وأعذار تستدعى هذا الرجوع، وامتنع الموهوب له عن إقالته من الهبة، وناط المشرع بالقاضي سلطة تقديرية في شأن بحث جدية الأعذار التي يبديها الواهب في هذا الشأن، ويقضى على ضوء ذلك، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل، وأورد حالات لمنع الرجوع في الهبة، ضمنها نص المادة (502) من القانون المدني، من بينها هبة الوالد لولده، مانعًــا القضاء من بحث الأعذار التي يسوقها الوالد في هذا الشأن، الأمر الذي يحول بينه والحصول على الترضية القضائية، لمجرد توافر هذه القرابة بينه والموهوب له. فضلًا عن أن الغاية التي توخاها المشرع من ذلك المنع، وهي الحفاظ على صلة الرحم، لم يراع فيها مواجهة عقوق الابن الموهوب له، إذ امتنع طواعية عن إقالة والده من الهبة في هذه الحالة، بما يزكى هذا العقوق، حال أن المشرع أجاز في المادة (501) من القانون المدني الترخيص للواهب بالرجوع في الهبة إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودًا كبيرًا من جانبه. ومؤدى ذلك أن المانع الوارد بالنص المطعون فيه، فضلًا عن عدم ارتباط الوسيلة التي أوردها في ذلك النص، بالغاية المتوخاة منها، فإنه يخل بمبدأ المساواة بين الواهبين المتماثلة مراكزهم في الحصول على الترضية القضائية، وذلك لغير سبب موضوعي، بالمخالفة لنصى المادتين (53، 97) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (هــ) من المادة (502) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
لتحميل ملف حكم المحكمة
________________________
* نقلا عن الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا، عبر هذا الرابط: https://2u.pw/0E1hhQ
وقد علق المحامي والباحث أ. وائل أنور بندق على هذا الحكم في صفحته الشخصية بالفيسبوك تعليقا مهما ننقله عنها على طوله:
حكم حديث وهام وخطير للمحكمة الدستورية العليا بشأن الرجوع في الهبة
(م 502 بند هـ من القانون المدني):
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا هامًا بعدم دستورية الفقرة (هـ) من المادة 502 من القانون المدني في مجال سريانها على هبة أيٍّ من الوالدين لولده. وقد صدر الحكم بتاريخ 9/10/2021، واتصلت المحكمة الدستورية العليا بالدعوى بناءً على دعوى موضوعية، ملخصها أن رجلًا كان قد وهب إلى ابنتيه نصيبه في ميراث زوجته (والدتهما)، ولما تزوج بعد ذلك وأنجب ولدين، قامت ابنتاه بتقديم بلاغات كيدية ضده ورفع دعاوى نفقة عليه، مما رآه مبررًا للرجوع في الهبة، فأقام عام 2006 دعواه أمام محكمة بورسعيد الابتدائية.
ولما كان البند (هـ) من المادة 502 يمنع الرجوع في الهبة إذا كانت لذي رحم محرم، ومنها هبة الوالد لولده، فقد دفع بعدم دستورية النص، وقدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامها بالفعل عام 2008، وها هو الحكم قد صدر عام 2021!!
ونود أن نشير إلى عدد من النقاط الهامة في مجال توضيح الحكم والتعليق عليه:
أولًا: عقد الهبة هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مالٍ له دون عوض.
ثانيًا: يجوز للواهب الرجوع في الهبة رضاءً إذا قبل الموهوب له الرجوع، كما يجوز الرجوع في الهبة قضاءً بشرط أن يتوافر عذر يبيح الرجوع في الهبة، وأن تنتفي موانع الرجوع فيها. وقد ضرب المشرع أمثلة على العذر المبرر للرجوع في الهبة بما يلي:
(أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحدٍ من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودًا كبيرًا من جانبه.
(ب) أن يصبح الواهب عاجزًا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولدًا يظل حيًا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولدٌ يظنه ميتًا وقت الهبة فإذا به حيّ.
ثالثًا: يمتنع الرجوع في الهبة في عدة حالات عددتها المادة 502، حتى لو توافرت الأعذار، ومن هذه الحالات ما ورد في البند (هـ)، وهي الهبة لذي رحم محرم، إذ لا يجوز الرجوع فيها عن طريق التصريح من القضاء، بما يعني أنه يمتنع في حالتنا على الأب أن يلجأ إلى القضاء للتصريح له بالرجوع في الهبة.
رابعًا: يُلاحظ أن إصدار الحكم قد تأخر كثيرًا، وهو ضرر فاحش بفكرة العدالة؛ فقد رفع الأب الدعوى الموضوعية عام 2006، ورفع الدعوى الدستورية عام 2008، وصدر الحكم عام 2021!! أي أن المسألة استغرقت أكثر من خمس عشرة سنة، وهي مدة طويلة جدًا تُعد إنكارًا فاحشًا للعدالة في حق الأب رافع الدعوى.
صحيح أن القضاء الدستوري قضاءٌ عيني يستفيد منه الجميع، سواء أكان من رفع الدعوى أم غيره؛ إلا أن رافع الدعوى هو أولى الناس بالرعاية. ويذكرني هذا الحكم بحكم المحكمة الدستورية بشأن إنهاء عقود الإيجار (القديم) المبرمة للأشخاص المعنوية، والذي صدر بعد عشرين عامًا من رفع الدعوى الدستورية.
خامسًا: يمكن القول إن الحكم قد بُني على سببين:
أولهما: مخالفة النص لمبدأ المساواة، إذ أجاز لمن توافر له العذر الرجوع عن الهبة، ومنعه عمن منح الهبة لذي رحم محرم، حتى لو توافر له العذر، مما يشكل تمييزًا بين المراكز القانونية المتماثلة.
ثانيهما: أن النص وضع عائقًا ومانعًا من موانع التقاضي، إذ حرم الواهب لذي الرحم المحرم من اللجوء إلى القضاء للتصريح له بالرجوع في الهبة عند توافر العذر.
وأخذًا بهذين السببين، كنا نتمنى على المحكمة الدستورية العليا أن تقضي بعدم دستورية البند (هـ) كاملًا، لا بقصره على هبة أيٍّ من الوالدين لولده، لأن الأسباب التي وردت في الحكم تنصرف إلى البند كاملًا.
سادسًا: كنا نتمنى ألا تخوض المحكمة الدستورية في مسألة رأي الفقه الإسلامي بشأن جواز الرجوع في الهبة لذي الرحم المحرم، والخلاف بين الأحناف والجمهور، لأنها تتدخل بذلك في السلطة التقديرية للمشرع في شأن اختيار الرأي الفقهي الملائم. لا سيما أن هناك أسبابًا أخرى توصلت بها المحكمة إلى النتيجة التي أرادتها، فضلًا عن أن المحكمة ذاتها قد أخرجت هذه المادة من نطاق قيد الالتزام بالشريعة الإسلامية الوارد في المادة الثانية من الدستور، وفقًا للتفسير المستقر عليه من المحكمة، وهو أن القوانين السابقة زمنيًا على نص المادة الثانية من الدستور تفلت من حكمها. وبغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع هذا التفسير لنص المادة الثانية من الدستور، إلا أنه قد أصبح التفسير المستقر عليه.
سابعًا: من أهم المبادئ العامة التي وردت بالحكم أن الرقابة الدستورية تتم في إطار الدستور القائم دون غيره، وهو دستور 2014، حتى لو كانت الدعوى قد رُفعت في ظل دستور سابق، وهو دستور 1971، لأن الرقابة الدستورية تستهدف صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
ثامنًا وأخيرًا: مفاد هذا الحكم في النهاية ليس حق الوالدين في الرجوع عن الهبة بشكلٍ مطلق، وإنما حق كلٍّ منهما في الرجوع إلى القضاء للتصريح بالرجوع في الهبة عند توافر العذر.
وائل أنور بندق
هذا التعليق يعبر عن وجهة نظر كاتبه، وينشر ضمن إطار إثراء النقاش القانوني حول الحكم.