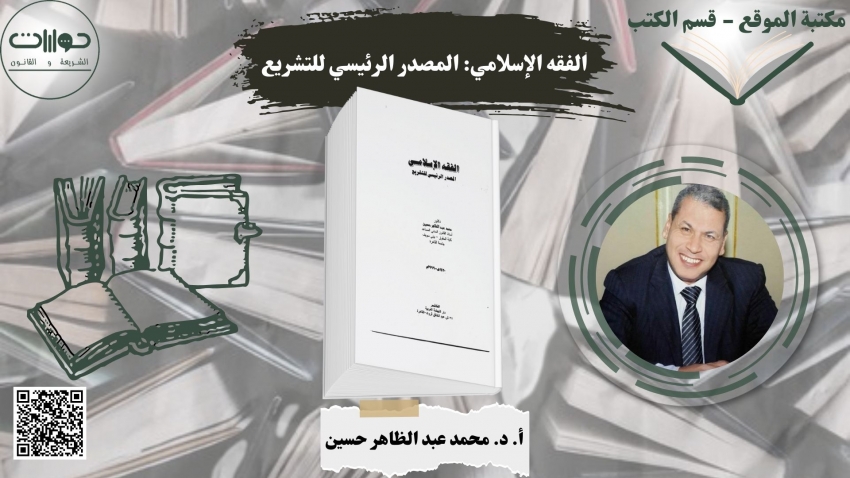يمثل هذا الكتاب دراسة منهجية تحليلية لمدى صلاحية الفقه الإسلامي ومكانته في أنظمة التشريع الحديثة، ويتضمن الكتاب إيضاحًا للمفاهيم الأساسية للشريعة والفقه، كما يستعرض التيارات المختلفة في شأن تطبيق التشريع الإسلامي، وكذلك يشتمل على دراسة تجارب عملية في تقنين الأحكام في بعض الدول، وطرح سبل تهيئة المجتمع لقبول وإعمال التشريع الإسلامي، مع مراعاة الأدلة الشرعية ومنهجية فقهية نقدية. ويمكن اعتبار الكتاب جسرًا بين المرجعية الشرعية والبحث عن آليات تطبيقية قابلة للتقنين والتطبيق العملي، ويخاطب الباحثين وصانعي القرار والمهتمين بالعلاقة بين الشريعة والقانون.
يبدأ الكتاب بتقديم واضح لأهدافه، حيث يؤكد الباحث أن الفقه الإسلامي قادر على أن يكون إطارًا متكاملًا للتشريع في المجتمع العربي والإسلامي إذا أعيد إليه دوره عبر تصور علمي واضح يحدد العلاج والحدود وآليات التطبيق. وفي تقديمه للكتاب أشار الأستاذ الدكتور عبد الغفار إبراهيم صالح إلى أن البحث وضع "الإطار، والتصور، والعلاج، والحدود، والمستقبل" لتطبيق الفقه الإسلامي في مناحي الحياة المختلفة بحيث يمكن تخليص المجتمع من صور الانحراف والتخلف وتحضير الأمة لاستقبال الألفية الثالثة على طريق الأصالة والتقدم.
تتجلى في مقدمة المؤلف للكتاب رؤيتان محوريتان: الأولى التشديد على حق تقرير المصير للشعوب المسلمة، الذي يشمل قدرة الدولة على وضع تشريعات تتلاءم مع عاداتها وقيمها وترتيباتها الاقتصادية والاجتماعية، والثانية نقد مرحلة الاستقلال السياسي التي غاب فيها استعادة البعد التشريعي الحقيقي للشعوب الإسلامية بسبب استمرار تأثير القوانين الأجنبية وثقافاتها في بنى التشريع المحلية. يعرض المؤلف كيف أن قضايا فصل الدين عن الدولة وفصل الفقه عن الحياة الاجتماعية والسياسية كانت من أهم العوامل التي أبعدت أحكام الشريعة عن الممارسة التشريعية الحقيقية، وما أدت إليه من تهميش لدور الفقه ومجتمعاتها في مواجهة أفكار وقيم مخالفة.
كما تتناول المقدمة مشكلات التبادل الثقافي والاستعمار وتأثيراته في تشريد الوعي القانوني الإسلامي، مع إشارات إلى قضايا المرأة ومعالجة بعض الشبهات التي استخدمت أحيانًا كذريعة لفصل أحكام الشريعة أو لتبرير تغييبها. ويؤكد النص أن الشريعة ليست خاصة بقوم أو زمن، بل جاءت للناس كافة وأحكامها صالحة لتنظيم العلاقات داخل الدول الإسلامية وحل مشكلاتها، شريطة أن يعمل الفقه رؤيةً متكاملة ومتجانسة.
تتوزع محتويات الكتاب على أربعة فصول:
الفصل الأول يعرف المقصود بالتشريع الإسلامي ويستعرض مفاهيم الشريعة والفقه، والأدلة على وجوب تحكيم التشريع الإسلامي، ومبادئ الفقه في القرآن الكريم والأحاديث النبوية.
الفصل الثاني يعالج الاتجاهات المختلفة حول كيفية إعمال التشريع الإسلامي، فهناك من يقول بضرورة تطوير التشريع الإسلامي (من منطلقات مثل نظرية النسخ والنظر إلى تاريخية بعض النصوص)، وهناك من يقول بتطبيق بعض الأحكام دون بعضها الآخر، وهناك من ينكر صلاحية التشريع الإسلامي كمصدر للقانون، وأخيرًا يبين المؤلف موقفه من التطبيق الكامل للتشريع وسبل تحقيقه عبر التقنين.
الفصل الثالث مخصص لدراسة تجارب تقنين التشريع الإسلامي في بعض البلاد الإسلامية، مع معالجة تطور دور التشريع الإسلامي في مصر ومحاولات التقنين في الكويت كمادة وصفية وتحليلية لمشروعات وتجارب عملية.
أما الفصل الرابع فيركز على محاور تهيئة المجتمع لتطبيق التشريع الإسلامي، ويعرض أدوار الأسرة والتعليم في مراحله الأولى، ومسئولية الإعلام، ودور كليات الحقوق والشريعة في إعداد الكوادر اللازمة لاستقبال تطبيق تشريعي سليم.
يمكن القول إن هذا الكتاب يمثل محاولة منهجية للرد على التيارات الفكرية التي سعت إلى تهميش الفقه الإسلامي، وهو يدعو إلى إعادة الفقه إلى مكانته الطبيعية ضمن منظومة التشريع، مع توفير شروط اجتماعية وثقافية وقانونية تساعد على هذا الإعمال. ويظل هذا الكتاب مرجعًا مفيدًا للباحثين والطلاب وصانعي القرار الذين يهتمون بمسألة العلاقة بين الشريعة والتشريع الحديث، خصوصًا في السياقين المصري والكويتي اللذين خصهما المؤلف بدراسة تطبيقية.
لتحميل ملف الكتاب
* محمد عبد الظاهر حسين، "الفقه الإسلامي: المصدر الرئيسي للتشريع"، صدر عن دار النهضة العربية بالقاهرة عام 1420ه/1999م.
** الدكتور محمد عبد الظاهر حسين أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، تقلَّد سابقًا منصب رئيس قسم القانون المدني. كما أسهم بفعالية في الحياة الأكاديمية والتدريبية، فكان مشرفًا على دورات متخصصة في مجالات مثل التحكيم القانوني، كما نُقل عنه تعليقات وأراء قانونية في الإعلام المصري. وإلى جانب ذلك، يمتلك العديد من المؤلفات القانونية المعتمدة، منها دراسات فقهية في القانون المدني مثل "الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد"، و"المسؤولية التقصيرية للمتعاقد" وغيرها.