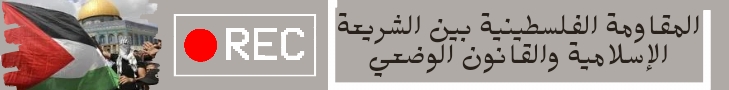20
مراعاة الحقوق الطبيعية في الاشتراع ومعاملة الناس
الأمة الإسلامية بحكم المهمة التي عهد الله بها إليها، وهي جعل كلمته هي العليا في الأرض، قدر لها أن تتبسط في البلاد، وأن تخالط الأمم، وأن تمد رواق سلطانها على شعوب كثيرة تخالفها أصلاً ولغةً ودينًا وعادات. وهذه الشعوب كلها كان لها نظم مقررة وقوانين محترمة وتقاليد خاصة، فإخضاعها جميعًا لشريعة واحدة تطمئن إليها، وتهدأ نوائرها تحت ظلها، لا يعقل أن يكون إلا إذا كانت تلك الشريعة بالغة أرقى ما يدركه العقل من معنى العدل، وما تطمح إليه النفس من نعمة المساواة، وتتطلع إليه الطبيعة البشرية من الحرية الصحيحة، وهذا ما لا سبيل إليه إلا إذا كان أساس تلك الشريعة الحقوق الطبيعية، لا الحقوق التي تمليها المصالح المادية، وتحدها الأثرة القومية، وتتحيفها العوامل المحلية.
أجل: فإن تلك الشعوب لأجل أن تدخل في الوحدة التي فُرضت عليها فرضًا يجب أن لا تجد في الحالة التي تدخل فيها ما يثير حميتها، وبهيج أنفتها، ويجرح كرامتها، ويدفعها دفعًا إلى التخلص مما وقعت فيه ولو استنفدت في سبيله قواها وثروتها. لأنه متى تأثر كل شعب بمثل هذه الروح من التمرد، نتجت من ذلك فتوق يتعذر على قاهريها رتقها، فيضطرون للإيغال فيها قتلاً وسلبًا، ثم يلجؤون إلى أحد أمرين: إما الإمساك بمخنقها مهدديها بالحديد والنار، وإما تركها وشأنها أشبه بجثة هامدة يؤول أمرها إلى ما يؤول إليه.
هذا كان شأن الأمم الضعيفة عندما كانت تقع تحت براثن أمة فاتحة. وهذا نفسه كان حال الشعوب التي حملت نير استعمار الرومان، وهى الأمة التي كانت لها الزعامة في الأرض قبل المسلمين مباشرة. فقد كانت الشعوب تخضع لها رهبًا لا رغبًا، وكانت كثيرًا ما تثور عليها فتحدث بين الفريقين معارك تسيل الدماء فيها أنهارًا. فلما أدرك الدولة الرومانية الوهن، انفصلت تلك الشعوب عنها مُكِنّة في أعماق قلبها أقسى ضروب الحقد عليها، حتى إنه لما داهمتها القبائل المتوحشة التي كانت نازلة في أطرافها من الهونيين والفنداليين والبلغار وغيرهم، لم تمتد إليها يد بمعونته، ولا أمدها قلب بعاطفة. وكان التاريخ أقسى عليها قلبًا من الناس، فقد جاء في دائرة معارف لاروس الكبرى عند ذكرها نظم الرومانيين:
"ماذا كانت نظم الرومان على وجه الإجمال؟ كانت الوحشية والقسوة بعينيهما مرتبتين في صور قوانين. أما من جهة فضائل رومية مثل الشجاعة والمكر والتبصر والنظام والإخلاص المطلق للجماعة، فهي بعينها فضائل قطاع الطرق واللصوص. أما وطنيتها فكانت مكتسية لباس الوحشية، فقد كان لا يرى فيها إلا شره مفرط للمال، وحقد على الأجنبي، وتجرد من عاطفة لرحمة الإنسانية. أما العظمة في رومية والفضيلة فيها فكانتا مرادفتين لأعمال السوط والسيف في العالم، والحكم على أسرى الحروب بالتعذيب أو بالأسر، وعلى الأطفال والشيوخ بجر عربات النصر" انتهى.
قارن هذا بحكم علم القرن العشرين في المسلمين، قال العالم الكبير جوستاف لوبون في كتابه تاريخ العرب: "لم تر الأرض فاتحين أبر وأرحم من المسلمين". على أن لسان الحوادث في هذا الشأن كان أبلغ من لسان التاريخ، فإن هذه الشعوب التي خضعت لحكم المسلمين فضلاً عن أنها لم تثر عليهم، ولم تبطن نية النكاية بهم، قد تهافتت على الدخول في دينهم، فأصبحت بلادها معاقل للإسلام، ولم يمض عليها غير سنين معدودة حتى نبغ فيها حفظة للغته، وأئمة لشريعته، مما لم يحدث له مثيل في أي عهد من عهود البشر. فهل عهد في تاريخ أمة أن ينتدب التحرير لسانها، وبناء قواعده وجمع شوارده أعاجم لا تجمعهم والعربية أقل صلة؟ ألم يكن إمام الحفاظ اللغويين أبو عبيدة فارسيًا، وواضعَا أصولها وقواعدها سيبوبه والخليل بن أحمد فارسيين أيضًا، ومهذبي نثرها وشعرها عبد الحميد وابن العميد وبشار وأبو نواس ومروان بن أبي حفصة وغيرهم فُرسا ومن أجناس شتى؟ ولا أعد لك أصحاب الأقوال الفقهية، ومفسري الكتاب الكريم، وحفظة السنة النبوية، فإن كثرتهم من أهل تلك الممالك التي فتحها الإسلام وضمها إلى حوزته.
فما سبب هذا الأمر الجلل الذى لم تر البشرية ما يشبهه منذ تدوين التاريخ إلى اليوم؟
سببه سمو الشريعة الإسلامية سموًا أذهل الشعوب عن قومياتها وتقاليدها وموروثاتها، فألقت بنفسها بين يديها تستمدها روحًا تحيا بها، وتنعم بالوجود تحت سلطانها. ولم يكسب هذه الشريعة هذا السمو إلا قيامها على أساس الحقوق الطبيعية المجردة عن كل صبغة قومية وجنسية، الرئيس والمرؤوس فيها سيان، والقوي والضعيف عندها متكافئان، والسري والصعلوك فيها صنوان.
لم يحدث في تاريخ العالم الإنساني أن أمة توخت العدل المطلق في سن شريعتها فنظرت إلى الناس من حيث هم أمثال في الإنسانية لا فضل لواحد منهم على آخر لأي اعتبار من الاعتبارات حتى ولو كان أجنبيًا عنها يخالفها أصلاً ودينًا ولونًا ولغًة. لم توجد أمة سلكت هذا المسلك في وضع شريعتها حتى ولا بالنسبة لآحادها المؤلفين لمجموعها إلا في أخريات القرن الثامن بعد الثورة الفرنسية وإعلانها حقوق الإنسان، ومحوها الطبقات الاجتماعية.
فقد كانت الأمم تنقسم إلى طبقات، لكل طبقة حقوق تمتاز بها على من دونها، حتى ينتهى الأمر إلى الدهماء، وهم السواد الأعظم من الأمة فكانوا يعتبرون في حكم العجماوات، حتى كان أصحاب الأملاك يبيعون أراضيهم بمن عليها من العمال، فيصبحون ملكًا خالصًا لمن اشترى الأرض التي هم عليها. وكان السيد يقتل الصعلوك فلا يعاقب على ما فعل، فإذا تعقبته الحكومة لسبب من الأسباب تخلص مما فعل ببذل مال نزر لأسرة المقتول.
فلما أعلنت الثورة الفرنسية حقوق الإنسان، وشاعت هذه المبادئ في العالم المتمدن، فسر كل منها الإنسان بأنه المعدود من جماعتها لا الإنسان أيًا كان، فأصبحت بذلك الحقوق الطبيعية مقيدة بالقومية في كل مكان. فانفردت الشريعة الإسلامية بميزة التعميم، فهي تعتبر الإنسان من حيث هو إنسان لا من حيث هو خاضع لسلطانها أو داخل في ملتها. وهذه من أدل الأدلة على أنها وحي إلهي لا وضع بشرى، فقد دل الاستقراء على أن الارتقاء في إقامة العدل لم يبلغ لدى البشر إلى حد أن يعاملوا الأجانب عنهم معاملتهم لأنفسهم، ولا أن يسروا عليهم أصول الحقوق الطبيعية التي أدركتها عقولهم. ولكن الإسلام سبق العالم أجمع إلى تطبيق هذه الحقوق الطبيعية على الكافة، ولم تستثن أحدًا حتى الأرقاء والأجانب عنه وعن جماعته، فكان المثل الإلهي الأعلى الذي سينتهي إليه الناس كافة حين يبلغون من معارج الرقى إلى ذروتها العليا، فقال الله تعالى يوصي المسلمين باتباع هذه الطريقة في معاملة الناس أجمعين: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ ومعناها يأيها المؤمنون كونوا جادين في القيام بتطبيق أصول العدل، وأدوا شهاداتكم فيما تستشهدون فيه مراعين وجه الله، ولو على أنفسكم أو والديكم أو أقاربكم، وإن يكن المشهود عليه غنيًا أو فقيرًا فلا تمتنعوا عن أداء الشهادة محاباة له لغناه، ولا رحمة به لفقره، فالله أولى بالنظر إلى حالي الغني والفقير منكم، فلا تتبعوا أهواءكم كراهة أن تعدلوا، وإن تلووا ألسنتكم محاولين إخفاء معالم الحق، أو تمتنعوا عن تأدية الشهادة فإن الله خبير بما تعملون، يجازيكم عليه بما أنتم أهله.
وقد بين الله تعالى في آية خاصة بأن مراعاة أصول هذا العدل المطلق تشمل الخلق كافة إلا الذين يقاتلون المسلمين من أجل دينهم، ويعملون على إخراجهم من ديارهم اضطهادًا لهم وعدوانًا عليهم، فقال: ﴿ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾.
فهو في هذه الآية لا يوصي بمعاملتهم بالعدل المطلق فحسب، ولكن يوصى أيضًا ببرهم والبر هو أوكد الصلات التي تربط الناس الصادقة بعضهم ببعض، وتوجد بينهم المحبة الصادقة والعطف، وينتهى أمرها بالتوحيد بينهم في الوجهة والغاية. وهذا أقصى ما يرمي إليه الفلاسفة والمصلحون من الأحلام الاجتماعية. وقد أصاب الإسلام هذا المرمى فكانت نتيجة ذلك أن انقلبت الأمم التي كانت تقاتله إلى أمم صديقة له، بل إلى أمم مؤمنة به، فشهد العالم لأول مرة في تاريخه تطورًا لم يحدث له شبيه في نفسيات الشعوب المتباينة أصولاً ولغات وتقاليد، إذ تحولت كلها إلى أمة واحدة مؤلفة أكبر إمبراطورية عالمية تجرى وراء غاية واحدة هي المثل الأعلى لوجود إنساني كريم يحقق خلافة الله في الأرض. بدليل أن هذا الجثمان الاجتماعي الضخم لم يستخدم قواه الهائلة في تجريد الأمم من طيباتها، ولكنه استخدمها في حمل أعباء العلم والمدنية فنشر لواءهما عاليًا في كل بقعة امتد سلطانه إليها، فأدى رسالته التي نديه الله لها على أكمل وجه. وقد شهد أعداؤه له بهذه الميزة، فلم ينكر عليه واحد منهم أنه كان منقذ العالم من جهالة مطبقة، وجاهلية متغلبة، ومن حالة لو لم يتداركها الله به لا ستعصى وعز عليها الشفاء.
كل هذا كان بفضل العدل المطلق الذى جعله الحق أساسًا لشريعته العامة الخالدة. فانظر كم كانت تنجو الأمم، لو عممت تطبيق هذا العدل، من ثورات أهلية، ومن كوارث استعمارية، وكم كانت تقتصد من أموال لا تصرفها اليوم إلا على التسلح خشية أن يبغى بعضها على بعض؟
إذا أجدت الروية في هذا الأمر تبين لك أن الفيلسوف الانجليزي برناردشو لم يغل في قوله: إن أوروبا لا تتماثل من علتها التي تكاد تودى بها إلا إذا أخذت بأصول الإسلام وعملت بها.
ومن أعجب العجائب أن يتخيل بعض متعصبة الكتاب الأوربيين أن الإسلام قام على ظبى السيوف، هذا زعم يكذبه الواقع المحسوس وسنن الوجود نفسها، فإن كل ما قام على السيوف احتيج في حفظه إلى السيوف ثم آل أمره إلى الانهيار، ولكن الإسلام قام على أساس دعوة إصلاح عامة للأمم كافة، وقد أثمر المرات التي تنتظر منها فأحدث انقلابًا عالميًا نقل به الإنسانية من حال تحجر كانت فيه إلى حال حياة وحركة تأدت بها إلى ما تأدت إليه من الرقي والحضارة المتوثبة إلى أبعد الغايات، وأكمل النهايات.
ولست أنكر أن السيف قد لعب دورًا في إحداث هذا الانقلاب، ولكنه لم يكن السبب الرئيسي فيه. وهذه سنة كل انقلاب إصلاحي في الأرض حتى بين الأمة الواحدة. فالأمة الانجليزية لم تصل إلى ما وصلت إليه من التكامل الاجتماعي والدستوري، والأمة الفرنسية لم تستطع أن تعلن حقوق الانسان بمجرد الدعوة دون اللجأ إلى السيف، فإذا كانت هذه حالة الأمة الواحدة في الانتقال من حال لحال، أفتريد أن يحدث الإسلام انقلابًا عالميًا عامًا دون أن يلجأ فيه إلى السيف كأداة من الأدوات الضرورية لإحداثه معاصاة لسنن الوجود ونظامه!
وهل يغيب عن أحد أن المسيحية نفسها - وهي التي تحرم استخدام السيف - لم يستتب لها السلطان الذي وصلت إليه إلا باستخدامه؟
وإذا ذكرنا أن الإنجليز والفرنسيين لجأوا إلى السيف في أدوار من تاريخهم فليس معناه أن هاتين الأمتين كانتا تتناحران تحت دوافع وحشية بحتة، ولكن معناه أن أشياع التقدم فيهما اضطرت إليه لحماية كلمة الاصلاح من عبث العابثين بها. كذلك المسلمون لم يدفعهم إلى الحرب أي غرض غير حماية الدعوة الإسلامية من كيد الكائدين لها، وقد أمروا أن ينشروها في مشارق الأرض ومغاربها، لأنها رسالة عامة إلى البشر كافة، في حين كانت الأمم فيه أحوج ما تكون إليها. وقد دلت الحوادث على أنها كانت خيرًا وبركة على العالم كله، واتفق أنصارها وخصومها على أنه لولاها لتأدت البشرية إلى أسوأ منقلب.
الخلاصة أن الإسلام لم يمد رواق سيادته على الأمم التي تدين به اليوم إلا ببركة العدل المطلق الذي أوصى شيعته بالقيام عليه، فوجدت تلك الأمم فيه ما تحلم به من حياة اجتماعية لا تشوبها شوائب الجنسيات المتنافرة، والعصبيات المتناظرة، والطبقات المتحاقدة، بله ما آنسته في أصوله من مطابقة العقل، ومسايرة الدليل، وفي آدابه من سمو ليس بعده غاية، ولا وراءه مذهب، فألقت بنفسها في جماعته، ورأت الخير كل الخير في مناصرته، والذود عن بيضته.
ولا تزال الدعوة الإسلامية باقية ما بقيت السموات والأرض، ولا يزال ولن يزال الدليل قائمًا على أن قبولها هو الدواء الشافي لأدواء الأمم.
رابط مباشر لتحميل المقال