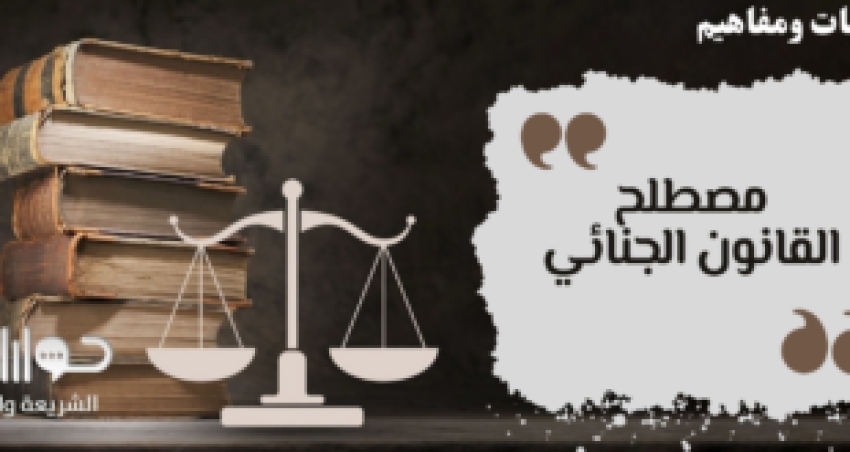تعريف القانون الجنائي:
القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة على مرتكبيها.
وقانون العقوبات هذا يحوي بدوره نوعين من القواعد القانونية الموضوعية:
أ. قواعد عامة: وتضم القواعد التي تخضع لها جميع الجرائم والعقوبات على اختلاف أنواعها، وتسمى مجموعة هذه القواعد “قانون العقوبات- القسم العام”.
ب. قواعد خاصة: تضم القواعد التي تحدد كل جريمة على حدة من حيث بيان أركانها الخاصة وعقوبتها والظروف الخاصة بها، وتسمى مجموعة هذه القواعد “قانون العقوبات- القسم الخاص”.
تسمية القانون الجنائي:
تكاد الدول العربية تجمع على تسمية القانون بـ “قانون العقوبات” أخذًا بالتسمية الدارجة في القانون الفرنسي حيث يستعمل مصطلح القانون العقابي “Le droit pénal” إلا أن المشرع الكويتي استعار تعبير المشرع العثماني فأطلق على القانون “قانون الجزاء”. وقد بقي أثر هذه التسمية في قوانين أخرى، فكل من قوانين العقوبات في لبنان وسوريا والأردن يستعمل مصطلح “القانون الجزائي” أو “الشريعة الجزائية”، وفي تونس يطلق علي قانون العقوبات “المجلة الجزائية التونسية” وقانون الدعوى العمومية يسمى “قانون أصول المحاكمات الجزائية” في العراق ولبنان وسوريا والأردن، أو “قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية” في الكويت أو “قانون الإجراءات الجزائية” في الجزائر. وقيل في تبرير ذاك إن التعبير بقانون العقوبات لا يشمل التدابير الاحترازية.
وكلمة “الجزاء” ذات معنى عام، فهي تشمل رد فعل مخالفة أي فرع من فروع القانون، بيد أن كلمة “العقوبة” تفصح عن أشد جزاءات القانون، وهى المقررة للجرائم، ومنها جاء اصطلاح “قانون العقوبات” وهو الاصطلاح الأنسب للتعبير عن القانون الجنائي باعتباره يعبر عما يهدد مرتكب الجريمة من جزاءات تتفق في شدتها مع الإخلال بالأمن والنظام.
تطور القانون الجنائي:
قسّم العلماء التطور الخاص بالقانون الجنائي إلى عدّة مراحل بناءً على الحقبة التي مرت بها المجتمعات، وهذه المراحل هي:
- مرحلة الانتقام الفردي: فقد شملت هذه المرحلة القبائل المتنقلة، والتي كانت تعتبر أي اعتداء على أحد من أفرادها اعتداءً على القبيلة بأسرها، فكان أفراد قبيلة المجني عليه يتجمّعون لغزو قبيلة الجاني، والتي تعدّ المسؤولة بالتضامن مع الجاني، فتقوم حربٌ بين القبيلتين، وذلك بهدف الانتقام، وهذا الانتقام يكون لإرضاء عائلة المجنيّ عليه أو من أجل التوصّل إلى حلّ لمصالحة الطرفين المتخاصمين على شروط أن يتفقوا عليه. أمّا داخل القبيلة فكانت توزع المسؤوليات على رئيس القبيلة، والذي يباشر سلطته على قبيلته، فله صلاحية تأديب أفراد قبيلته من ضرب بسيط مرورًا بالقتل أو الطرد، وبعد أن تطوّر المجتمع ظهر نظام القصاص ونظام الديّة، وأصبح تطبيق هذه الأنظمة إجباريًّا بعد نشوء الدول، بالإضافة إلى ظهور مجموعةٍ من الأنظمة الأُخرى؛ كنظام نفي الجاني، ونظام التخلي عن الجاني لأهل المجني عليه، ونظام تحريم القتل في أوقات معينة.
- مرحلة الانتقام للدولة: بدأت هذه المرحلة منذ نشوء الدولة، والتي أصبحت السلطة التي تصدر العقاب وتمارسه نيابةً عن الأفراد، فقد كان هذا الحقّ مقصورًا على الجرائم التي تمسّ أمن الدولة، إلّا أنّها قد شملت جميع الجرائم فيما بعد، وفي هذه المرحلة كان العقاب قائمًا على أساس التكفير، فكان يقع العقاب من أجل إرضاء الآلهة بالانتقام لها، وبعد ذلك أصبح العقاب يقع على المجرمين للانتقام للجماعة، حيث كان تنفيذ العقوبات بدرجةٍ عاليةٍ من الحزم والصرامة دون طرح فكرة إصلاح المجرم، والجدير بالذكر أنّ الحكم بين الناس لم يكن قائمًا على أساس العدل، بل بالنظر إلى مراكزهم الاجتماعية في الدولة.
- مرحلة الإنسانية: وتسمى كذلك بالمرحلة الفلسفية، وأساسها تغيير نظام العقوبة من نظام انتقاميّ إلى نظامٍ أكثرَ تسامحًا وإنسانية، وقد بدأت هذه المرحلة في القرن الثامن عشر مع ظهور بعض المصلحين، ومنهم:
- (مونتسكيو (بالإنجليزية Montesquieu)) الذي ألّف كتاب روح القوانين، وانتقد فيه نظام العقوبات السائد.
- (روسو) صاحب كتاب العقد الاجتماعي، والذي نادى إلى تخفيف العقوبات إلى الحدّ الأدنى لحماية المجتمع من المجرم، ومنعه من إيذاء غيره. سيزاري بيكاريا صاحب كتاب الجرائم والعقوبات والذي رأى أنّ أساس قانون العقوبات هو حماية مصلحة الجماعة في أن تحيا وتحافظ على كيانها، وبالتالي فإنها من الضروري أن تملك حق العقاب للدفاع عن مصالحها، وذلك بأن يتمّ تحديد هدف العقوبة في منع المجرم من العودة إلى حياته الإجرامية ومنع الناس من الاقتداء به.
- المرحلة الحديثة: بعد ازدياد انتشار الجريمة في منتصف القرن التاسع عشر، ظهرت نظريةٌ جديدةٌ في إيطاليا، سمّيت بالمدرسة الواقعية، وكان أساس هذه النظرية هو الاهتمام بالجاني بالمقام الأول، ومن ثم تأتي الأفعال المادية بالمقام الثاني، وقد أنكرت هذه النظرية مبدأ حرية الاختيار، وأخذت بمبدأ الإجبار، حيث إنّ السبب وراء قيام الجاني بجريمته هو توفّر عوامل داخلية متعلقة بالجانب النفسي للمجرم، وعوامل خارجية متعلقة بظروف معيشته وبيئته، وقد أوضحت هذه النظرية أنّه يمكن التنبؤ بخطورة الشخص الإجرامية قبل ارتكابه للجريمة، وعليه يمكن اتّخاذ تدابير وقائية لتلافي حدوثها. وقد نادى أصحاب هذه النظرية بضرورة دراسة الأسباب النفسية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى تنفيذ المجرم لجريمته، وعلاج هذه الأسباب قبل حدوثها.
أهداف القانون الجنائي:
- تحقيق العدالة: يعزز توقيع العقوبات على الجناة شعور الأفراد بالعدالة ويعزز شعور الرضا لدي المواطنين، حيث إن العقوبة التي وقعت علي الجاني تساوي المكاسب التي حققها، وعند توقيع العقوبة لن يكون هناك حقد بين المجني عليه والجاني.
- تحقيق الأمن في المجتمع: عندما يعلم كل فرد في المجتمع ان هناك قوانين رادعة ستطبق علي الجميع بدون تمييز عند مخالفة القوانين، سوف يتحقق الأمن والأمان في المجتمع.
- حماية الفرد والأسرة والمجتمع: القانون الجنائي يحمي الفرد عن طريق تجريم أي فعل يهدد حق الفرد في الحياة مثل القتل ويحمي الفرد ضد السرقة والابتزاز ويحمي القانون الجنائي المجتمع عن طريق سن القوانين التي تحمي الأسرة مثل قوانين للحماية من أضرار المخدرات ويحمي القانون الجنائي الدولة عن طريق سن القوانين التي تعمل علي حماية الدستور وحماية الدولة ضد التجسس.
خصائص القانون الجنائي:
- التحديد الدقيق: فالقانون الجنائي محدد على عكس القانون المدني الذي يتسم بصفة عمومية، يراعي المشرع فيه الدقة والوضوح ولا يحتمل تفسيرات واجتهادات، ولو كان هناك شك دائما نرجع للقاعدة المشهورة “الشك دائمًا في صالح المتهم”.
- المساواة: ان القانون الجنائي يجب أن يحمل صفة المساواة؛ أي وجوب تطبيقه على كافة المخالفين له من دون اعتبار لشخصية مرتكب المخالفة الجنائية أو مركزه الاجتماعي.
- عدم جواز القياس عليه: بالنسبة للدول التي تعتبر النظام الفرنسي يجب أن تكون جميع القواعد مكتوبة وواضحة، فعند عدم تضمن القانون لنص صريح يجرم فعلًا معينًا فلا يجوز الرجوع لسوابق قانونية لتجريم الفعل أو الامتناع عن الفعل، وهذا للحفاظ على مبدأ الشرعية والاستقرار القانوني وتأكيد سيادة القانون (طريقة القياس في الحكم والاعتماد علي السوابق القانونية يتم تطبيقها في بريطانيا).
- العقوبة الجنائية: من بين خصائص القانون الجنائي أنه يضع في نصوصه عقوبات جزائية يتم فرضها على كل مخالف لنصوصه، وهذه العقوبات تعتبر تهديدًا لأي فرد يحاول مخالفة القانون، وبالتالي يكون هذا التهديد إجراءً وقائيًا.
أهمية القانون الجنائي:
يستمدّ القانون الجنائي أهميّته من الغاية التي وُضع من أجلها، ويمكن تلخيص أهميته فيما يلي:
- حماية المصالح الجماعية والفردية: فلو تُرك الأمر دون قانون يحمي مصلحة الفرد لسادت الاضطرابات بين الناس وضاعت مصالحهم.
- توفير الأمان والطمأنينة لأفراد المجتمع: فالأفراد يقدمون على أعمالهم دون خوف من أن يُحاسبوا على فعل غير مجرّم، وذلك لأنَّ قانون العقوبات جمع الأفعال التي تُعتبر من الجرائم، ووضع لها عقوبات مسبقًا، وهذا من شأنه أن يُشعر الأفراد بالطمأنينة وعدم الخوف مِن وقوع أي ظلم عليهم، وحتى لو وقع فإنهم على علمٍ بأنّ الفاعل لن يفرّ من العقاب.
- · نشر العدالة بين الناس: إنَّ الناس أمام القانون سواسية، يُطبَّق عليهم دون أي اعتبارات، وذلك لأنّ القانون حدّد الأفعال المجرّمة مسبقًا؛ بحيث لا يمكن أن يعاقب الفرد ما لم يقترف أيّ فعلٍ من هذه الأفعال، وفي حال ارتكابها فإنّه سيُعاقَب مثل غيره من الناس الذين ارتكبوا الجرائم قبله.
- · مكافحة الجريمة: إنَّ أهمية القانون الجنائي تتمثل في مكافحة الإجرام، ومحاولة منع الجرائم قبل وقوعها عن طريق التدابير الاحترازية والوقائية.
مصادر القانون الجنائي:
إنَّ مصادر القانون الجنائي تختلف من دولة إلى أُخرى، ولا يمكن حصرها بمرجع واحد، فعلى سبيل المثال يَعتبر التشريعُ الجنائيُّ الإسلاميَ؛ القرآنَ والسنّةَ أساسَ أحكامه، ويعتمد كذلك على اجتهادات الفقهاء وإجماعهم، وقياسهم، وعليه فإنَّ القانون الجنائيّ يستمد قواعده من عدّة مصادر يمكن تقسيمها إلى مصادر مباشرة وغير مباشرة، ويمكن تلخصيها على النحو الآتي:
- القوانين الجزائية المتعلقة بالتجريم والعقاب: فإنَّ السلطة التشريعية وحدها هي التي تملك الحقّ في إصدارها، وقد تصدر على شكل قواعد عامّة مجردة، وتُعتبر المصدرَ الأساسيَّ لقانون العقوبات، فيحدد المُشرِّع الأفعال التي يُعاقَب عليها، والجزاءات التي تقع على مرتكبيها، وعليه فإنّه لا تتمّ معاقبة أحد على أفعاله ما لم يكن منصوصًا على تجريمها في القانون، وهذا ما يُعرف بمبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ”.
- الأنظمة الإدارية الجزائيّة: بالرغم من أنّ الأصل هو صدور القوانين الجنائية من السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، إلا أنَّه يمكن أن يتمّ إعطاء صلاحيات السلطة التنظيمية لرئيس الدولة، أو للسلطات الإدارية كالوزارات، والإدارات المركزية أو العامة؛ حيث يُسمح لها بإصدار قرارات أو مراسيم مُلزِمةً، وتُعتبر مخالفتُها جريمةً تستحقُّ العقابَ عليها.
- العرف: وهو رأي الجمهور حول قضية معينة، إلا أنَّ التشريع الجنائي يعتمد بالمقام الأول على التشريع المكتوب، لذلك يُعتبر العرف من المصادر غير المباشرة للقوانين الجنائية، وقد وُجدت أحكامٌ عديدةٌ في قانون العقوبات راعت أعراف المجتمع وعاداته بما يتناسب مع المجتمع نفسه.
- القانون الدولي العام: يعتمد القانون الجنائي في بعض أحكامه على القانون الدوليّ العام، وذلك في تحديد القوانين الواجب تطبيقها لمعاقبة المجرمين سواء كانوا مواطنين، أم أجانب، داخل الدولة أم خارجها، وفي تحديد الأقاليم البحرية والجوية للدولة، وفي قضايا تسليم المجرمين وغيرها من الأمور.
القانون الجنائي في الإسلام:
التشريع الجنائي جزء من التشريع الإسلامي، وهذا من كمال الإسلام وصلاحيته للأزمان والأمكنة والظروف المختلفة، فالإسلام ليس للوعظ وحده، ولكن كما قالوا: “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”، فهناك حالات لا ينفع فيها إلا العقوبة، ولا سيما إذا كانت الجرائم مجبرة ومتعمدة، فالشريعة حينها تمنع الإفلات من العقاب، فلا بد لكل جريمة من عقوبة، إلا أن الشريعة جاءت بعقوبات محددة وقليلة جدًا، وتركت العقوبات للتقدير التشريعي والقضائي، لأن الجريمة نفسها قد يكون لها حجم معين من الخطورة والفساد والضرر، وهي نفسها في ظروف أخرى يصبح لها شأن آخر، ومن شخص إلى شخص، ومن قصد إلى قصد؛ فالذي يقتل في شجار، ليس كالذي يقتل في تدبير وترصد وإعداد.
هناك جرائم تركت للتعزير في الإسلام، بينما للعقوبات المحددة جدًا هناك القصاص، والقصاص له مخارج؛ كالعفو والدية، ويمكن يكون أو لا يكون، وهناك 6 عقوبات منصوصة في الشريعة، والشريعة لا تشجع على تطبيقها إلا إن كانت هي الحل الأفضل الذي يزيح مشاكل عديدة، فمثلًا في الحدود تشدد الشريعة في إثباتها، من خلال طلب الشهود والشهود لا يكون فيهم شك وبهم ثقة، وفي إثبات الزنا هناك تشدد كبير جدًا، لأن هذا يضر بالعائلة بأكملها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجل الحكم، رغم أن اعتراف الزاني سيد الأدلة، “لعله كذا وكذا”، يلتمس النبي المخارج كي لا يطبق العقوبات. فهذه العقوبات على شدتها فإن الشارع لا يريد تطبيقها، إلا بعد إجراء التحريات والبحث عن حلول أخرى، فالشريعة الإسلامية هي الأقل اعتمادًا على العقوبات، لذلك تجد في العالم أن القانون الجنائي ينص على العديد من العقوبات، والغرامات، بينما الإسلام عقوباته مضيقة والباقي تعازير فيها إمكانية العفو. كما أن العقوبات أحيطت بترسانة ضخمة جدًا من التحريات، فأسندت لجهة معينة وهي جهة الدولة والقضاء، فهي التي تقوم بتنفيذ هذه العقوبات لا جهة أخرى، ثم أحيطت بشروط قاسية وصارمة لإثبات هذه العقوبة، وإذا وقعت شبهة صغيرة جدًا في هذه العقوبات فإنها لا تطبق.
العقوبات الشرعية كما وردت في الكتب الفقهية؛ ثلاثة عشر عقوبة وهو يرتبها من الأدنى إلى الأعلى: التوبيخ، الزجر، التشهير، النفي أو التغريب، الحبس، الجلد، قطع اليد اليمنى، القطع من خلاف، قصاص ما دون النفس [قطع بعض أعضاء الجاني أو جرحه أو فقئ عينه إذا تعمد إيذاء شخص بمثلها]، القتل وهو على ثلاثة أصناف (القتل قصاصا، القتل رجما، القتل صلبا). وعلاوة على تلك العقوبات المحددة المنصوص عليها هناك عقوبات تكميلية أخرى في الشريعة وعددها يسير كعقوبة القاذف الذي لا تقبل شهادته. وهناك أيضا ما يسمى “التعزير” وهي عقوبة مخولة للقاضي في حال تعذر إثبات التهمة بوسائل الثبوت الشرعي المعتادة، أو في حال ارتكاب جرم لا تنطبق عليه تعريفات الجريمة الشرعية، وعندئذ يحق للقاضي اختيار عقوبة من العقوبات السالفة وتوقيعها على المذنب، ويذكر بيترز أن الجلد كان أكثر العقوبات توقيعا من جانب القضاة، وأن القتل تعزيرا يعد من المسائل الخلافية لكن جميع المذاهب قد أجازته في نهاية الأمر لمن تكررت منهم الجرائم، وللجرائم الخطيرة كالسحر واللواط، والتجسس لصالح العدو.
التشريع الجنائي الإسلامي في عصور الحداثة:
في عصور الحداثة برزت مسألة التغييرات القانونية التي أدخلت على التشريع الجنائي الإسلامي منذ القرن التاسع عشر بفعل عملية التغريب التي قادتها بعض النخب المحلية واستلزمت تبني القوانين الأجنبية، والاستعمار الغربي للبلدان الإسلامية، فقد اعتبر الموظفون الاستعماريون أن التشريع الإسلامي تشريع متعسف وأنه بحاجة للإصلاح، ومجمل انتقادهم يتعلق بباب التعازير الذي هو باب فضفاض لا يضم تعريفا محددا للجريمة وأوصافها، وعقوباته غير موضوعية لأن بعضها يمكن إبطاله بالصلح بين الخصوم ودفع تعويض مالي (الدية)، ومن جانب آخر فإن العقوبات الشرعية غير متساوية، فربما عوقب شخص بأكثر من شخص آخر رغم أن الجرم واحد.
ويمكن رصد التطورات التي لحقت بالتشريع الإسلامي في القرن التاسع عشر، واجمالها في تطورات ثلاثة:
الأول: الإلغاء الكامل للتشريع الجنائي الإسلامي وإحلال القوانين الغربية محله، وقد اتبع في معظم الدول الواقعة تحت الاستعمار كما هو الحال في الجزائر على يد الفرنسيين.
الثاني: إدخال تعديلات تدريجية على بعض جوانب التشريع الجنائي الإسلامي، وهذا النهج اتبعه الإنجليز في الهند وفي نيجيريا حيث تم المزج بين القوانين الغربية وقوانين الشريعة في حزمة واحدة، لكنه ألغى التشريع الجنائي الإسلامي في نهاية المطاف.
الثالث: الجمع بين التشريعين الجنائيين الإسلامي والوضعي، وهو النهج الذي سارت عليه الدول المستقلة كمصر والدولة العثمانية، وذلك بمحاولة تقنين الفقه، وإنشاء محاكم مدنية إلى جوار المحاكم الشرعية.
الاختلافات الأساسية بين القانوني الجنائي الإسلامي والوضعي:
تختلف طبيعة الشريعة عن القانون الوضعي بصفة عامة، من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن القانون من صنع البشر، أما الشريعة فمن عند الله، وكلٌّ من الشريعة والقانون يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع البشر ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم، ومن ثمَّ كان القانون عرضة للتغيير والتبديل، أو ما نسميه التطور، كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة أو وجدت حالات لم تكن منتظرة. فالقانون ناقص دائمًا ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يوصف بالكمال، ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون وإن استطاع الإلمام بما كان. أما الشريعة: فصانعها هو الله، وتتمثل قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وما هو كائن؛ ومن ثمَّ صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في الحال والاستقبال حيث أحاط علمه بكل شيء، وأمر جل شأنه ألا تغير ولا تبدل حيث قال: ﴿لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ﴾ [يونس: ٦٤]؛ لأنها ليست في حاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان وتطور الإنسان.
الوجه الثاني: أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شئونها وسد حاجاتها. فهي قواعد متأخرة عن الجماعة، أو هي في مستوى الجماعة اليوم، ومتخلفة عن الجماعة غدًا، لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة، وتستوجب التغير كلما تغير حال الجماعة. أما الشريعة فقواعد وضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شئون الجماعة، فالشريعة تتفق مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة. ولكن الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة ولا تقبل التغيير والتبديل.
الوجه الثالث: أن الجماعة هي التي تصنع القانون، وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها، والأصل في القانون أنه يوضع لتنظيم شئون الجماعة، ولا يوضع لتوجيه الجماعة، ومن ثم القانون متأخرًا عن الجماعة وتابعًا لتطورها، وكان القانون من صنع الجماعة، ولم تكن الجماعة من صنع القانون. وإذا كان هذا هو الأصل في القانون من يوم وجوده، فإن هذا الأصل قد تعدل في القرن الحالي، وعلى وجه التحديد بعد الحرب العظمى الأولى، حيث بدأت الدول التي تدعو لدعوات جديدة أو أنظمة جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، وقد كان أسبق الدول إلى الأخذ بهذه الطريقة روسيا الشيوعية، وتركيا الكمالية، ثم تلتهما إيطاليا الفاشيستية وألمانيا النازية، ثم اقتبست بقية الدول هذه الطريقة، فأصبح الغرض اليوم من القانون تنظيم الجماعة وتوجيهها الوجهات التي يرى أولياء الأمور أنها في صالح الجماعة. أما الشريعة الإسلامية فقد علمنا أنها ليست من صنع الجماعة، وأنها لم تكن نتيجة لتطور الجماعة وتفاعلها كما هو الحال في القانون الوضعي، وإنما هي من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه. وإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة، فإن الجماعة نفسها من صنع الشريعة.
وقد انعكس هذا الاختلاف بدوره على طبيعة التشريع الجنائي في كل الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.
___________________________
المصادر:
- قواعدٌ وشبهات حول التشريع الجنائي والعقوبات في الإسلام، عمران، 11 مايو 2020، https://2u.pw/X7oEL9Z.
- فاطمة حافظ، الجرائم والعقوبات في الشريعة، إسلام أونلاين، https://2u.pw/RZfvG50.
- عبد القادر عودة، كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 17-22.
- تعريف القانون الجنائي وأهم مبادئه وأقسامه وخصائصه وأهدافه وتاريخه، واحة القانون، أكتوبر 2022، https://2u.pw/wCY5g2e.
- هايل الجازي، تعريف القانون الجنائي، موضوع، 7 أبريل 2022، https://2u.pw/D2kMuYa.
محمود طاهر، النظام الجنائي في الإسلام، نقابة المحامين المصرية، 8 أبريل 2020، https://2u.pw/oi5opkb.