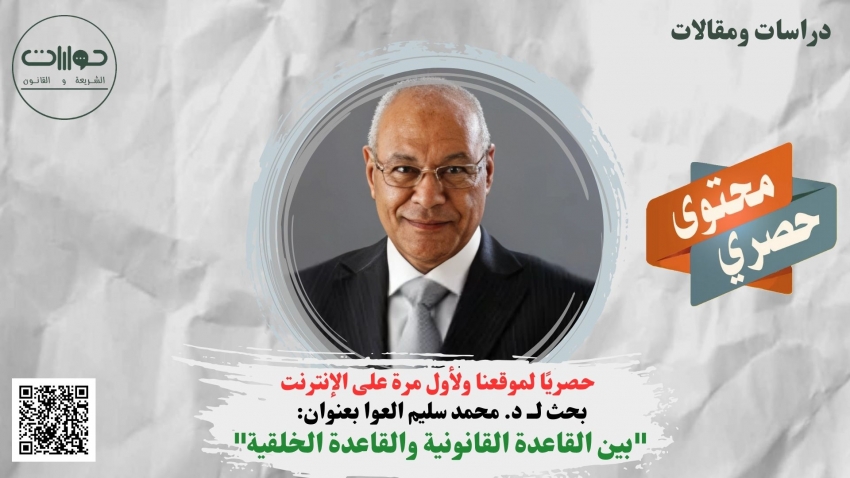- تمهيد: القاعدة القانونية والقاعدة الخلقية:
إن مشكلة العلاقة بين القانون والأخلاق تعد إحدى المشكلات الفلسفية البالغة التعقيد، والتي يثور حولها جدل مستمر بين المشتغلين بالفلسفة، والمشتغلين بالقانون، وهذا الجدل يضرب بجذوره في الزمن إلى البدايات الأولى للفكر الفلسفي المعاصر، ولكنه اكتسب حيوية متجددة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بوجه خاص، في ربع القرن الأخير، نتيجة توالي صدور قوانين تسبغ الإباحة الوضعية على أفعال كانت محلًا للتجريم، وكان تجريمها يجد سندًا له في تنافيها مع تعاليم الأخلاق، فلما انتصر –سياسيًا- مذهب القائلين بأن الدائرة التي يجب أن يحميها القانون بالتجريم والعقاب يمكن -بل يجب- ألا تتطابق والدائرة التي تظلها الأخلاق بمظلة الاستهجان، فقد تجريم تلك الأفعال سنده، وانتهى الأمر بها إلى الإباحة([1]).
ويتمثل أوضح تعبير عن رأي القائلين بضرورة الفصل بين دائرتي القانون والأخلاق -فيما يتصل بالحماية التي يسبغها القانون على القيم الخلقية- في العبارات الآتية:
- "إن الغرض الوحيد الذي يجوز أن تستعمل من أجله القوة -بحق- ضد أي عضو في مجتمع متمدين، على الرغم من إرادته، هو منع الاضرار بالآخرين"([2]).
- "إنه بينما تمثل قواعد الأخلاق الحد الأقصى للكمال، تمثل قواعد القانون حده الأدنى، وتمثل قواعد القانون الجنائي الشق الأساسي من هذا الحد الأدنى"([3]).
- "ما لم تكن هناك محاولة متعمدة يقوم بها المجتمع، متخذًا من القانون أداة له، للتسوية بين دائرتي، الجريمة والمعصية، فإنه يجب أن يترك نطاق للأخلاق الخاصة، يكون فيه ما هو أخلاقي وما ليس كذلك أمرًا وراء دائرة عمل القانون"([4]).
وفكرة الفصل بين القيم الخلقية الشخصية، أو الخاصة، وبين الأخلاق العامة -PRI VATE MORALITY AND PUBLIC MORALITY.
هي الفكرة التي يقوم عليها إلى اليوم منهج التشريعات الجنائية الأوربية - والتشريعات المتأثرة بها خارج أوربا في إسباغ الحماية الجنائية، أو عدم إسباغها، على الأفعال المنافية لما توجبه قواعد الأخلاق من سلوك.
وعلى الرغم من شيوع هذا الاتجاه وغلبته تدريجيًا منذ الحرب العالمية الثانية، إلى أن بلغ مداه في أواسط الستينيات من هذا القرن الميلادي، فإن اتجاهًا آخر مضادًا له لا يزال يجد له أنصارًا في عديد من دول أوربا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى أنصار هذا الاتجاه أن التفرقة بين ما يعد من القيم الخلقية شخصيًا، وما يعد عامًا، تفرقة مصطنعة، وأن القانون في أي مجتمع متحضر يجب أن يتدخل دائمًا ليشمل بحمايته القدر المتعارف عليه اجتماعيًا من القيم الخلقية، وذلك بتجريم السلوك المنافي لهذه القيم. وفرض العقاب الملائم عليه، وإنزاله بمرتكبه([5]).
- التشريع الإسلامي وحماية القيم الخلقية:
إنه إذا كان موقف جمهرة الفلاسفة والمشتغلين بالقانون -وعلى الأخص القانون الجنائي- هو ما قدمنا من القول بضرورة الفصل بين دائرتي القانون والأخلاق، بحيث لا يبسط الأول حمايته على شيء مما تهتم الثانية به، إلا على ما كان أساسًا بالمجتمع ممثلاً فعلًا ضارًا أو فعلًا خطرًا ذا طبيعة عامة، فإن المشتغلين بالنظام القانوني الإسلامي لا يستطيعون أن يتخذوا موقفًا مماثلًا. ذلك أن النظام القانوني الإسلامي يحفل إلى أبعد حد بحماية القيم الخلقية التي يجب أن تسود المجتمع الإسلامي، والتي يجب أن يلتزمها الأفراد فيه.
بل إنه إذا كان القائلون من القانونيين والمفكرين الغربيين بضرورة توسيع نطاق الحماية الجنائية لتشمل السلوك المنافي للقيم الخلقية بالتجريم والعقاب يعبرون عن هذه القيم بأنها "القدر المتعارف على قبوله من القيم الخلقية في المجتمع"، فإن الفكر القانوني الإسلامي يعبر عن موقف مختلف تمام الاختلاف يتمثل في شمول القاعدة الجنائية الإسلامية بحمايتها للقيم الخلقية التي يجب -في تشريع الاسلام- أن تسود المجتمع.
والفارق بين الموقفين أن الأول -موقف المفكرين الغربيين- يكتفي بحماية ما يرى المجتمع -عرفًا- حمايته من القيم الأخلاقية. وحين تتغير النظرة الاجتماعية إلى قيمة ما، أو مجموعة من القيم، فإنها تخرج من نطاق القيم المشمولة بالحماية القانونية، أو التي يجب أن تشمل بها.
أما الفكر القانوني الإسلامي فإنه يفرض -من خلال القواعد الدينية- مجموعة من القيم، تمثل النظام الخلقي، ويفرض الحماية الجنائية لهذا النظام كله، ليحمل المجتمع دائمًا على احترامه، بفرض العقاب على صور السلوك التي تمثل إخلالاً به.
ويبدو ذلك واضحًا في نظام التعزيز الذي هو نظام بمقتضاه يمتد سلطان القاعدة الجنائية الإسلامية ليشمل كل معصية -أي مخالفة لنظام القيم المقرر إسلاميًا- لا حد فيها -أي عقوبة مقررة من الشارع- ولا كفارة([6]).
وللتعزير أهمية خاصة في الفقه الجنائي الإسلامي إذ لا تتجاوز جرائم الحدود أربعًا -في أضيق الأقوال- وسبعًا -في أوسعها- ولا تتناول جرائم القصاص والدية سوى جرائم الاعتداء على الأشخاص بالقتل أو الجرح أو الضرب، ويأتي خارج إطار هذه الجرائم نظام التعزير الذي يتيح تجريم كل فعل مخالف للمصلحة الاجتماعية، أو مناف للقيم الإسلامية، ومن ثم فإن النصوص الإسلامية المحدودة العدد -أو المتناهية بتعبير الفقهاء- لا تقف حائلاً دون مراعاة المصالح غير المتناهية أو المتجددة.
- التشريع المصري وحماية القاعدة الخلقية:
لا يختلف موقف التشريع المصري من حماية القاعدة الخلقية بتقرير جزاء جنائي يلحق مرتكب السلوك المخالف لما توجبه عن موقف التشريعات الغربية، فلا يحمي القانون الجنائي المصري من القيم الخلقية إلا ما تعلق من مخالفة هذه القيم بالأخلاق العامة، أي أن العقوبة الجنائية التي تقررها بعض النصوص ذات الصلة بقواعد الأخلاق المقررة في المجتمع، لا تقررها لأن السلوك الذي تعاقب عليه منهي عنه خلقيًا، وإنما تقررها لأن في ممارستها بالطريقة التي يعاقب عليها النص -علانية مثلاً، أو في مكان معين كمنزل الزوجية- إخلال بمصلحة اجتماعية أخرى -غير حماية القاعدة الخلقية- تتمثل في الحياء العام، أو العلاقة الزوجية أو غير ذلك.
وهذا الموقف للمشرع المصري يتفق مع خطة المتابعة الدقيقة التي انتهجها التشريع الجنائي المصري للتشريعات الأوروبية وعلى الأخص للمدونة الفرنسية([7]). ولكنه لا يتلاءم مع التعديلات الدستورية التي تضمنها الدستور المصري لسنة ۱۹۷۱ م وتعديلاته. بل إنه ليس ببعيد أن يقال إن نصوص قانون العقوبات سنة ۱۹۳۷م -وهو القانون المعمول به إلى الآن- تتعارض مع الدستور في موقفه من القيم الأخلاقية، وهي في هذا الخصوص غير دستورية لتعارضها مع نص الدستور الخاص باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا، أو المصدر الرئيسي، للتشريع. ولأهمية هذه النصوص الدستورية، نفرد لها الفقرة التالية.
- الشريعة الإسلامية والقيم الخلقية في الدستور المصري:
ينص الدستور المصري في مادته الثانية على أن:
"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وتنص المادة التاسعة من الدستور نفسه على أن: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يشتمل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري".
وتنص المادة الثانية عشرة من الدستور على أن: "يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها".
وبعض عبارات هذه النصوص ترديد لعبارات أصبحت تقليدية في الدساتير المصرية، مثل عبارات: "الإسلام دين الدولة"، و"الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية"، والتزام الدولة بالسلوك الاشتراكي ....
غير أن في عبارات هذه النصوص جديدًا ذا مضمون غير تقليدي يتعين الوقوف عنده وتقرير دور المشرع العادي إزاء ما أوجبه المشرع الدستوري بهذه النصوص([8]).
ومن ذلك: النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والنص على التزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها. فهذه النصوص موجهة في المقام الأول إلى المشرع المصري، توجب عليه النظر في التشريعات المصرية جملة وتعديلها في اتجاه توسيع دائرة حماية القيم الخلقية، إعمالًا للنصيين الدستوريين اللذين يقضيان باتباع مبادئ الشريعة الإسلامية وبالتزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها. فمبادئ الشريعة الإسلامية تشمل بالحماية الجنائية القواعد المكونة لنظام القيم الخلقية الإسلامية كافة، ولا معنى لالتزام المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها إلا أن تبسط تشريعاته جناح الحماية الجنائية على القيم الخلقية المرعية في المجتمع المصري([9]).
وفي ضوء هذه الحقيقة الدستورية يتعين علينا أن نقوِّم موقف المشرع المصري في علاجه للجرائم الخلقية الماسة بالأسرة.
- موضوع البحث ومنهجه:
تتضمن مدونة قانون العقوبات المصري عددًا من الجرائم المضرة بالأسرة، وحين قيدنا موضوع هذا البحث بالجرائم الخلقية الماسة بالأسرة، كان اتجاهنا منصرفًا إلى قصر نطاق البحث على الجرائم التي تعد اعتداء على التنظيم الاجتماعي للحياة الجنسية، أو ما يسميه الباحثون الغربيون: "الأخلاق الجنسية" SEXUAL MORALITY.
ويرمي التنظيم الاجتماعي للحياة الجنسية إلى تحقيق غرضين: هما توجيه الحياة الجنسية إلى غرضها الاجتماعي باعتبارها باعثًا على الزواج ثم على إنشاء الأسرة التي هي نواة المجتمع وأداته للبقاء والنماء، وتفادي شيوع الفوضى الجنسية التي تحمل معها الفساد الخلقي والانحلال الاجتماعي وما لا يحصى من الأمراض النفسية والبدنية([10])، وما حديث العالم كله عن انهيار المناعة لدى الشاذين جنسيًا ببعيد عن الأذهان، وهو ليس إلا إحدى النتائج التي عرفناها للمجتمع المتحرر، بل المتحلل: PERIMSSIVE SOCIETY.
وسوف نهتم في هذا البحث أيضًا بجرائم البغاء والدعارة من حيث هي ماسة بالأسرة مساسًا مباشرًا، ومن حيث هي انتهاك في صورة واضحة للقيم الخلقية الحاكمة في مجال الحياة الجنسية.
وليس في هذا التحديد لنطاق البحث أي ادعاء بأن غير هذه الجرائم لا تمس الأسرة، أو أنها ليست انتهاكًا لقيم خلقية، وإنما هو اختيار رمى إلى تحقيق غايات علمية بحتة، من أهمها تبين خطورة هذه الجرائم على كيان الأسرة، وإيضاح الفارق بين التنظيم القانوني في مصر والدول العربية لموضوع هذه الجرائم، وبين التنظيم الذي تفرضه الشريعة الإسلامية للموضوع نفسه، وأخيرًا التنبيه إلى الواجب الذي يتقاعس المشرع عنه حتى الآن، ذلك الواجب المتمثل في إسباغ المشروعية الوضعية على الأحكام القانونية الإسلامية الخاصة بالجرائم موضوع البحث -بل على الأحكام القانونية الإسلامية كافة- تنفيذًا للنصوص الدستورية الموجبة لذلك.
وتأسيسًا على ما تقدم فسوف نشير في هذا البحث إلى بعض الجرائم التي خصصت لها مدونة قانون العقوبات المصري الباب الرابع من الكتاب الثالث المعنون بـ "هتك العرض وإفساد الأخلاق" وإلى الجريمة المنصوص عليها في المادة ۳۰۸ من مدونة قانون العقوبات.
ولن تتعرض دراستنا هذه للتفاصيل التقليدية لهذه الجرائم وبيان أركانها وما تثبت به وما تنتفى، فموضوع ذلك الكتب الدراسية الجامعية المخصصة لدراسة القسم الخاص في قانون العقوبات. ولكننا سنكتفي بعرض النصوص القانونية الخاصة بكل جريمة لتستبين ماهية الفعل المعاقب عليه، وعلة التجريم أو المصلحة التي يحميها النص، ونشير إلى مدى شيوع الفعل المجرم في المجتمع المصري مستندين إلى أحدث إحصاء نشرته وزارة الداخلية سنة ۱٩٨٥، ثم نعرج على حكم هذه الجريمة في النظام القانوني الإسلامي، لنبين مدى التوافق أو التنافر بين الحكم الوضعي والحكم الشرعي، وبذلك تتحدد دعوتنا الموجهة إلى المشرع في تأكيد مواطن التوافق، والقضاء على صور التنافر بين الحكمين.
- جريمة الاغتصاب:
قرر المشرع المصري جريمة الاغتصاب بنص المادة (٢٦٧) من مدونة قانون العقوبات، وهو النص الذي يقضي بأن: "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها، أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة"([11]).
وتتضمن التشريعات الجنائية العربية نصوصًا مقاربة في مضمونها لنص القانون المصري سالف الذكر. فقانون العقوبات الليبي يجرم الاغتصاب (أو المواقعة) في المادة (٤٠٨) من ذلك القانون، ويخالف النص الليبي النص المصري في انطباقه على اللواط (إتيان الذكر للذكر) بينما لا ينطبق النص المصري إلا على إتيان الذكر للأنثى([12]). وقانون العقوبات القطري (قانون عقوبات قطر) ينص على الجريمة نفسها في مواده (۱۹۷) و(۱۹۸) و(۱۹۹)، ونصوصه كنص القانون المصري لا تتسع إلا لمواقعة الذكر للأنثى. ولا يعتبر رضاء الأنثى التي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها رضاء صحيحًا في القانون، وفق نص المادة (۱۹۷) من قانون عقوبات قطر. وليس في النص المصري حكم مماثل، لذلك يميز الفقه بين رضاء الصغيرة غير المميزة، فلا يقيم له وزنًا في نفي قيام الجريمة، وبين رضاء الصغيرة المميزة ومع وجوده ينتفي الاغتصاب، وتقتصر مسؤولية الجاني على هتك عرض غير مصحوب بقوة أو تهديد، إذا لم تكن المجني عليها قد أتمت الثامنة عشرة من عمرها([13]). على أن جانبًا من الفقه المصري يرى ضرورة التفرقة بين رضاء الصغيرة المميزة ذات الخبرة التي تمكنها من تقدير خطورة الفعل الذي تقدم عليه، ورضاء الصغيرة التي لا خبرة لها، ولا تستطيع تقدير أثر الفعل الذي تقدم عليه على سمعتها ومستقبلها، فيكون رضاء الأولى نافيًا لفعل الاغتصاب بينما لا يكون رضاء الثانية كذلك([14]). ويعاقب المشرع البحريني على الاغتصاب بموجب أحكام المادتين (١٥٣) و(١٥٤) من قانون عقوبات البحرين لسنة ١٩٥٥م.
ولا عبرة في القانون البحريني برضاء من لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها، فإن كانت المجني عليها بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة اقتصر أثر رضاها على النزول بالعقوبة من الحبس مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبعقوبة الغرامة من حد أقصى مقداره عشرة آلاف روبية إلى حد أقصى مقداره ثلاثة آلاف روبية. ولا يتسع النص البحريني لغير مواقعة الأنثى، شأن النصين المصري والقطري.
ويتضمن قانون الجزاء الكويتي نصوصًا تجرم الاغتصاب هي نصوص المواد (١٨٦) و(۱۸۷) و(۱۸۸). ويقتصر مجال إعمال هذه النصوص على الحالات التي يكون المجني عليه فيها أنثى، شأن التشريع المصري، ولا يعتد المشرع الكويتي برضاء من لم تبلغ التاسعة من عمرها، فإن بلغت التاسعة ولم تبلغ الثامنة عشرة كان تأثير رضاها مقتصرًا على تخفيض الحد الأقصى لعقوبة الحبس من خمس عشرة سنة إلى سبع سنوات، ولعقوبة الغرامة من خمس عشرة ألف روبية إلى سبعة آلاف روبية.
ويذهب القانون العراقي إلى التسوية بين اغتصاب الأنثى واغتصاب الذكر، فيقضي نص المادة (393/1) من قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ بأن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من واقع أنثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو رضاها".
ولا عبرة في القانون العراقي برضاء من لم يتم الخامسة عشرة من عمره في نفي الجريمة، وإنما يقتصر أثر هذا الرضا على النزول بالحد الأقصى لعقوبة السجن من خمس عشرة سنة إلى عشر سنين، وإلى سبع سنين إذا كان عمره فوق الخامسة عشرة ودون الثامنة عشرة (م / ٣٩٤). وينص الفصل رقم (٤٨٦) من القانون الجنائي المغربي على أن: "الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
فإن كانت سن المجنى عليها تقل عن خمسة عشر عامًا، فإن العقوبة هي السجن من عشر سنين إلى عشرين سنة".
وتتضمن قوانين البحرين وقطر والمغرب والكويت نصوصًا خاصة بالعقاب على الشذوذ الجنسي. (م / ١٦٩ بحريني، وم / ۲۰۰ قطري، وف / ٤٨٩ مغربي، وم / 193كويتي).
- علة التجريم أو المصلحة المحمية:
من المتفق عليه أن النص الجنائي قد يشمل بالحماية الجنائية مصلحة واحدة، وقد يشمل بها مصالح متعددة([15]). ومن أمثلة النصوص الجنائية التي تحمي مصالح متعددة نص المادة (٢٦٧) عقوبات مصري، فعلة التجريم هنا هي الاعتداء على العرض، وهذه العلة تضمنت عددًا من المصالح التي يحميها النص الجنائي بتقرير العقاب: ففي الجريمة اعتداء على الحرية العامة للمجني عليها، وفيها اعتداء على حصانة جسمها، وهي قد تضر بصحتها النفسية أو العقلية، وهي اعتداء على شرفها، وقد يكون من شأنها تقليل فرص الزواج أمامها -إن لم تكن متزوجة- أو المساس باستقرارها العائلي -إن كانت متزوجة- وقد تفرض عليها أمومة غير شرعية فتصيبها بأضرار مادية ومعنوية([16]).
واشتراط النص أن يكون ارتكاب الفعل المكون للجريمة بغير رضاء المجني عليها لا يعني أن يكون الفعل مصحوبًا دائمًا بإكراه مادي أو معنوي، بل إن حالات ارتكاب الجريمة تتسع لتشمل جميع حالات الاتصال الجنسي بغير رضاء صحيح من المرأة، والرضا غير الصحيح هو الرضا غير المعتبر قانونًا، وهو يشمل رضاء المرأة فاقدة التمييز، والرضاء الصادر تحت تأثير غلط أو تدليس، ويشمل الفعل المجرم كذلك حالة ارتكابه على أنثى عاجزة عن التعبير عن إرادتها قبولاً للموقعة أو رفضًا لها([17]).
- جرائم الاغتصاب في الاحصاءات الجنائية:
في تقرير الأمن العام الذي أصدرته وزارة الداخلية في أبريل ١٩٨٥ متضمنًا الإحصاءات الجنائية لعام ۱٩٨٤ تندمج جرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض بوجه عام تحت بيان إحصائي واحد. وبمطالعة هذا التقرير نتبين أن جنايات الاغتصاب وهتك العرض المبلغ بها كانت سنة ١٩٨٣م مائة وإحدى وستين جناية، وارتفعت في سنة ١٩٨٤م إلى مائة وتسع وثمانين جناية بزيادة مئوية مقدار ١٧٪ في عام واحد. وكان نصيب مدينة القاهرة من الجنايات (٤٢) جناية، ونصيب مدينة الاسكندرية (۲۷) جناية([18]).
وإدماج جنايات الاغتصاب في بيان إحصائي واحد مع جنايات هتك العرض -على الرغم من التمييز التشريعي بينهما- من شأنه أن يضيف إلى الغموض الإحصائي الذي تشتهر به هذه الجرائم غموضًا آخر. ويرجع هذا الغموض إلى أن ما يصل إلى علم السلطة العامة من هذه الجرائم يقل كثيرًا عن عدد، ما يرتكب منها فعلاً. ويرد بعض الباحثين ذلك إلى الرغبة في التستر وتجنب الفضيحة وخوف المجني عليها من ظهور دورها فيما وقع من جرم([19]).
وذلك الغموض العددي أو الإحصائي له -على خلاف العادة- دلالة موجبة لا سالبة، لأنه ناتج عن زيادة عدد الجرائم التي ترتكب في الواقع عن تلك التي يبلغ ذوو الشأن فيها السلطة العامة، وتظهر من ثم في البيانات الإحصائية. فإذا أضفنا إلى البيانات الإحصائية التي قدمناها أن نسبة جنايات الاغتصاب وهتك العرض بلغت عام ١٩٨٣م ١٠,٥٪، من مجموع الجنايات المرتكبة، وكانت عام ١٩٤٥ لا تجاوز ۳,۱۱٪([20]) من مجموع الجنايات، وأن نسبة زيادتها في مدينة القاهرة وحدها كانت 50٪ عام ١٩٨٤ مقارنًا بعام ۱۹۸۳ وفي مدينة الإسكندرية كانت نسبة الزيادة ۱۷٪([21]) إذا أضفنا ذلك إلى البيانات الإحصائية السابقة استطعنا أن ندرك أن هذه الجرائم في ازدياد مطرد -منسوبة إلى العدد الإجمالي للجرائم المبلغ عنها- وهو ما يقتضي، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى، النظر في تقويم سياسة المشرع المصري في تجريم الاغتصاب، بل في تجريم أفعال العدوان على الأعراض بشكل عام. وذلك ما سوف نحاوله في ختام هذه الدراسة بعد استعراض الجرائم الأخرى الماسة بالأسرة والمتضمنة انتهاكًا للأخلاق.
- هتك العرض:
عُرف هتك العرض بأنه الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه([22]).
وفي القانون المصري نصان مخصصان لهتك العرض، أولهما هو نص المادة (٢٦٨) من مدونة قانون العقوبات وهو خاص بجناية هتك العرض بالقوة أو التهديد، والثاني هو نص المادة (٢٦٩) الخاص بهتك عرض الصغير الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر دون قوة أو تهديد (وهذه جنحة) أو هتك عرض من لم يبلغ السابعة من عمره وهتك العرض الواقع من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو من خادم عند المجني عليه أو عند واحد من هؤلاء، (والجريمة في هذين الفرضين جناية).
ويكفي لقيام جريمة هتك العرض وقوع فعل يمس بصورة ما جسم المجني عليه وينطوي على إخلال جسيم بحيائه، ولا عبرة بشخص المجني عليه، فقد يكون رجلاً أو امرأة، وكذلك الجاني في هتك العرض قد يكون رجلاً وقد يكون امرأة.
وهذان الأمران يميزان هتك العرض عن الاغتصاب، ففي الاغتصاب لا تقع الجريمة (وفق النص المصري) إلا من رجل على أنثى، ولابد لتمامها من اكتمال الاتصال الجنسي غير المشروع، وكلا الأمرين لا يشترط في هتك العرض([23]).
وتعاقب التشريعات العربية على هتك العرض في خطة قريبة من خطة المشرع المصري، فيخصص المشرع الكويتي لذلك المادتين (۱۹۱) و(۱۹۲) من قانون الجزاء (١٩٦٠)، ويخصص المشرع العراقي لهتك العرض المادتين (٣٩٦) و(٣٩٧) من قانون العقوبات (١٩٦٩)، ويعاقب المشرع القطري على هتك العرض (يسميه ارتكاب فعل فاحش على جسم شخص) بموجب المادة (۲۰۲) من قانون عقوبات قطر، ويعاقب المشرع المغربي على هتك العرض بمقتضى الفصلين (٤٨٤) و(٤٨٥) من قانون العقوبات المغربي.
- علة التجريم في هتك العرض:
يحمي المشرع بالعقاب على هتك العرض حقٌّ المجني عليه في اختيار الطرف الذي يشاركه متعته الجنسية، وهو ما يعبر جانب من الفقه المصري عنه (بالحرية الجنسية)([24]) ذلك أن الفعل المخل بالحياء على نحو جسيم (وهو ما تقوم به جريمة هتك العرض) ليس إلا تمهيدًا لاتصال جنسي (في المجرى المعتاد للأمور) وهو اتصال لا يرغب فيه المجني عليه، أو هو لا يعارضه ولكن عدم اعتراضه عليه أو رضاءه به غير معتبر قانونًا لصغر سنه. وتنطوي جريمة هتك العرض بالإضافة إلى ذلك على مساس بالشرف، وبحق المجني عليه في حصانة الجسم، وحقه في الحرية بصفة عامة([25]).
- هتك العرض في الاحصاءات الجنائية:
سبق أن بينا تداخل جنايات هتك العرض وجنايات الاغتصاب في بيان إحصائي واحد، الأمر الذي زاد -على ما بينا- من الغموض الإحصائي الذي يكتنف المعلومات الخاصة بهذا النوع من الجرائم. وهذا الغموض يصدق أيضًا على جرائم هتك العرض التي تعتبر جنحًا وفقًا للمادة ٢٦٩ من قانون العقوبات بل إن الغموض قد يكون هنا أشد لحرص العائلات في العادة على عدم الإبلاغ عما يتعرض الصغار له من أفعال مخلة بالحياء تجنبًا لشيوع قالة السوء عن الصغيرة أو الصغير، وخشية امتدادها إلى سمعته في كبره، بل إلى سمعة الأسرة كلها.
وعلى الرغم من ذلك فإن الإحصاءات المنشورة عن السنتين الآخرتين ١٩٨٣ و١٩٨٤ تبين أن جنح هتك العرض المبلغ بها قد زادت بنسبة ١٠٪ خلال عام واحد.
وبالإضافة إلى الأثر غير المنكور الذي يحدثه وقوع هذه الجرائم على أسرة المجني عليه، وعلى أسرة الجاني، من حيث شعور الأسرة الأولى بفقدان الأمن وانعدام الثقة في الآخرين وانهيار الأخلاق في المجتمع، وما يتبع ذلك من توخي جانب المبالغة في الحرص والحذر، والتضييق من مجالات العلاقات خارج الأسرة، مما قد يستتبع انطواء غير محمود، مصحوبًا بخوف وترقب لدى الصغار المنتمين إليها. ومن حيث شعور الأسرة الثانية بغصة الازدراء والاحتقار اللذين يواجه المجتمع بهما مرتكب هذه الجريمة، وقد يبلغ الأمر حد التعيير بذلك بين الجيران والمعارف، وآثار ذلك على الصحة النفسية وعلى السمعة التي تشيع عن الأسرة لا تخفى؛ -بالإضافة إلى هذه الآثار- تبين لنا الإحصاءات مدى مساس هذه الجرائم بالأسرة حين نتبين أن عدد من وقعت عليهم جنايات هتك العرض ممن لم يتموا ثماني عشرة سنة كان في مدينة القاهرة وحدها عام ۱۹۸٤ ثمانية وعشرين شخصًا من أصل (٤٣) هو عدد المجني عليهم في جنايات هتك العرض بها، وكان في مدينة الإسكندرية عشرين شخصًا من أصل (۲۷) مجني عليه. وأن عدد المتزوجين من المجني عليهم كان (۱۷) شخصًا في مدينة القاهرة، وكان (٥) أشخاص في مدينة الإسكندرية، فإذا استبعدنا من لم يتموا الثامنة عشرة من العمر وجدنا أن من جاوزها من المجني عليهم كانوا جميعًا في مدينة القاهرة من المتزوجين وكان ۷۱٫٥٪ منهم في الإسكندرية من المتزوجين([26]).
- زنـا الأزواج:
يعاقب القانون المصري على الزنا الذي يرتكبه أحد الزوجين حال قيام الزوجية بينهما. وقد خصصت مدونة قانون العقوبات لهذه الجريمة المواد ۲۷۳ و٢٧٤ و٢٧٥ و٢٧٦ و٢٧٧.
وتنطبق هذه النصوص بجريمتين لا بجريمة واحدة: فزنا الزوجة جريمة أيًا كان المكان الذي ارتكب فيه، أما زنا الزوج فقد تطلب المشرع ركنًا خاصًا لا تقوم الجريمة دونه: هو ارتكاب الفعل المكون لجريمة الزنا في منزل الزوجية.
وجريمتا الزنا تقعان في نطاق جرائم الجنح إذ يعاقب عليهما بالحبس. على أن المشرع يميز بين الجريمتين في العقوبة، بعد أن غاير بينهما في الأركان، فعقوبة الزوجة الزانية الحبس سنتين، وعقوبة الزوج الزاني الحبس ستة شهور. ومهما قيل في تسويغ هذه التفرقة، فهي لا تقوم في نظرنا على أساس مقنع بل لعل الزوج الذي يزني في منزل الزوجية أجدر بتشديد العقاب عليه من الزوجة التي تزني في غير منزل الزوجية([27]).
ويفرق المشرع كذلك بين الجريمتين إذ يتيح للزوج العفو عن جرم زوجته الزانية في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد الحكم عليها نهائيًا بالإدانة، بينما يقتصر حق الزوجة في ذلك على العفو قبل صدور حكم نهائي بالإدانة. (م / ٢٧٤).
ومن ناحية أخرى فإن المشرع يمنع من سماع دعوى الزوج إذا كان قد سبق له ارتكاب جريمة الزنى في منزل الزوجية (م /٢٧٣).
وأخيرًا فإن الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنى فيقتلها هي ومن تزني معه يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في القانون للقتل العمد (م / ۲۳۷).
وقد جرمت القوانين العربية زنا الأزواج، إذ شددت العقوبة عليه عما قدره المشرع المصري.
وقد عالج هذه الجريمة المشرع العراقي في المواد ۳۷۷ - ۳۸۰ من قانون العقوبات (١٩٦٩)، وعالجها المشرع الكويتي في المواد 195 - ۱۹۷ من قانون الجزاء (١٩٦٠)، وعالجها المشرع القطري في المواد ٢١١ - ٢١٤ من قانون عقوبات قطر، وعالجها المشرع المغربي في الفصول ٤٩١ - ٤٩٣ من قانون العقوبات.
- علة التجريم في زنا الأزواج:
يحمي المشرع بالعقاب على زنا الأزواج العلاقة الزوجية باعتبارها الطريق الذي شرعه القانون لتنظيم إنشاء الأسرة، وهي نواة المجتمع كله. فالحماية الجنائية موجهة في الواقع إلى الأسرة باعتبارها تنظيمًا قانونيًا لا باعتبارها علاقة شخصية بين طرفين هما الزوج والزوجة.
ويقوم موقف الشارع المصري في قصر العقاب على الزنا الذي يرتكبه شخص متزوج على أساس من نظرته إلى العلاقات الجنسية التي اعتبر الأصل فيها الإباحة ما دامت تتم بالرضا بين أشخاص بالغين.
ففي ضوء هذه النظرة لا تعد العلاقة بين غير المتزوجين علاقة يعاقب عليها القانون، بل إن العلاقة بين رجل متزوج وامرأة غير متزوجة إذا تم الاتصال الجنسي فيها خارج منزل الزوجية لا تعد زنا مجرمًا وفق نصوص القانون المصري.
ولا شك أن هذه النظرة، وما ترتب عليها من أحكام تعتبر من أكثر الأسباب إثارة للانتقاد الموجه إلى المشرع المصري في علاجه للجرائم الماسة بالأسرة. وسيأتي مزيد بيان لذلك بعد قليل.
وتمضي جل التشريعات العربية في مجموعها في خطة مباينة أساسًا لخطة التشريع المصري إذ تعتبر العلاقة الجنسية خارج إطار عقد الزواج علاقة غير مشروعة توجب العقاب، فمن ذلك نص الفصل رقم (٤٩٠) من قانون العقوبات المغربي: " كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تُكَوّن جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
ونص المادة (۲۱۲) من قانون عقوبات قطر: " كل من واقع امرأة غير زوجته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معًا".
"فإذا كان الجاني متزوجًا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنين". والمشرع القطري يشترط في الإثبات شهادة أربعة شهود عدول، فهو يستعير نظام الإثبات المتشدّد المقرر في الشريعة الإسلامية لتوقيع عقوبة لا تقاس من أي وجه بالعقوبة المقررة في تلك الشريعة، وهذا الحكم يقتضي إعادة النظر في النص القطري..
ونص المادة (١٩٤) من قانون الجزاء الكويتي، وهو يشترط ضبط الجاني حال تلبسه بارتكاب الجريمة([28]).
- زنـا الأزواج في الاحصاءات الجنائية:
إن كل ما سبق بيانه عن غموض الأرقام الإحصائية لجرائم الاغتصاب وهتك العرض ينطبق بصورة أكبر على جرائم زنا الأزواج. فالرغبة في الستر وتجنب الفضيحة وتجنيب الأولاد وعائلتي الزوجين مغبتها أقوى وأفعل في جرائم الزنا منها في جرائم الاغتصاب وهتك العرض.
والغالب أن تنتهي هذه الجرائم بانفصال الزوجين دون أن يبلغ عنها، أو بصفح أحدهما عن الطرف الآخر رغبة في الإبقاء على رابطة الزوجية، وحماية للأولاد، وحفاظًا على كيان الأسرة من الانهيار.
وتبين الإحصاءات المنشورة سنة ۱۹۸٥ أن عدد جرائم زنا الأزواج المبلغة إلى الشرطة عام ۱۹۸۳ كان (١٣٤) جريمة، وأصبح سنة ۱۹۸٤ (۱۲۸) جريمة بنقص مقداره ٤٪.
- جرائم البغاء([29]):
يعالج القانون المصري جرائم البغاء بنصوص القرار بقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١.
ولا يبدو مساس جرائم البغاء بالأسرة إلا بمراجعة الإحصاءات الجنائية التي بينت في دراسة أجراها المدير العام السابق للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي([30]) ضد الجريمة، وقام بعمليات البحث فيها وأشرف على فريق العمل الذي نفذها مدير معهد تدريب ضباط الشرطة([31])، حول إجرام النساء، الحقائق الآتية:
- ٤٥٪ من العينة التي شملتها الدراسة (ممن يمارسن البغاء) سنهن بين ١٦ سنة و١٨ سنة. والسبب الرئيسي لانحرافهن هو غياب العائل أغلب فترات اليوم عن المنزل أو طلاق الأم أو انفصال الأب عنها.
- ٤٥٪ من المنحرفات متزوجات.
- ٨٥,٣٤٪ من المنحرفات غير متمسكات بالقيم الدينية.
- ٣٨,٥٧٪ من المنحرفات حكم عليهن بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر أو أقل.
- وأخيرًا تبين تلك الدراسة أن ٧٦,٣٦٪ من المنحرفات لا ينوين التوبة عن سلوك طريق الرذيلة.
وتبين إحصاءات وزارة الداخلية لعام ١٩٨٤ أن هناك ۱۱۳ جنحة اتجار بالبغاء واستغلاله، و٦٠٨ جنحة ممارسة للبغاء على سبيل الاعتياد، وأن نسبة ما ضبط من بيوت البغاء في محافظتي القاهرة والإسكندرية إلى مجموع القضايا في المحافظات كافة كانت ٥١٪.
ولا تحتاج دلالة هذه الإحصاءات في خطورتها على الوضع الخلقي العام، وفي تأثيرها على الأسرة إلى بيان كبير. كما أنه من الضروري التنبيه إلى أن جميع هذه الجرائم لا يظهر فيها الرجل إذ التجريم مقتصر على المرأة التي تمارس البغاء أو تحترفه، لا يمكن الجزم بعدد الرجال المتزوجين الذين يقبلون على ممارسة الزنا مع البغايا المحترفات.
- الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات:
تنص المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ۱۷۱ طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معًا في الحدود المبينة في المواد ۱۷۹ و۱۸۱ و۱۸۲ و٣٠۳ و٣٠٦ و٣٠٧ على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى ولا يقل الحبس عن ستة شهور".
وقد قضت محكمة النقض في حكم قديم لها بأن "الطعن في أعراض العائلات معناه رمي المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو غير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة يفرطن في أعراضهن، أي يبذلن مواضع عفتهن بذلاً محرمًا شرعًا أو يأتين أمورًا دون بذل موضع العفة ولكنها مخالفة للآداب مخالفة تنم عن استعدادهن لبذل أنفسهن عند الاقتضاء وتثير في أذهان الجمهور هذا المعنى الممقوت..."([32]).
وقد استقر في الفقه والقضاء، بناء على هذا الحكم والأحكام المماثلة، أن المقصود من الطعن في العرض هو رمي المجني عليه رجلاً كان أو امرأة بما يفيد أنه يفرط في عرضه، أما خدش سمعة العائلات فيشمل كل ما يمس شرفها أو كرامتها سواء أكان ذلك موجهًا إلى شخص معين أم غير موجه إلى شخص معين منها. وسواء أكان متصلاً بالعرض أم لم یكن([33]).
وهذه الجريمة بالمعنى الذي استقر عليه الفقه والقضاء المصري للطعن في الأعراض ليست سوى جريمة القذف التي عرفتها الشريعة الإسلامية بأنها: رمي المحصن بالزنا أو نفى نسبه من أبيه([34]). وقد فرضت الشريعة الإسلامية لهذه الجريمة عقوبة من عقوبات الحدود ومنعت قول شهادة القاذف وجعلته بنص القرآن في عداد الفاسقين.
والجريمة المنصوص عليها في المادة ۳۰۸ من قانون العقوبات تمس الأسرة بنص القانون ذاته، والعقوبة المقررة لها وهي صورة من صور تشديد العقاب على جريمة القذف المقررة بنص المادة ۳۰۲ و۳۰۳ من قانون العقوبات. ويأخذ التشديد صورة وجوب الحكم بالحبس والغرامة معًا، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإحدى العقوبتين دون الأخرى، فإذا كان ارتكاب الجريمة قد وقع بطريق النشر في الصحف أو ما في حكمها فإن المحكمة تلتزم بألا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى لها وألا يقل الحبس عن ستة شهور. وهذا تشديد زائد يتمثل في رفع الحد الأدنى للعقوبة.
- ملاحظات ختامية:
تناولنا فيما سبق من فقرات هذه الدراسة الجرائم الخلقية الماسة بكيان الأسرة أو استقرارها أو سمعتها، مما نص على عقابه المشرع المصري في قانون العقوبات وفي قانون مكافحة الدعارة، وما نص عليه في بعض التشريعات العربية، ونأتي إلى مرحلة إبداء ملاحظاتنا على هذه الجرائم، أو بعبارة أدق على منهج الشارع في التجريم والعقاب فيما يتصل بمدى تحقيقه الحماية الواجبة للأسرة في مواجهة ما قد يعصف بها، أو يؤثر على استقرارها وأمنها، من أفعال منافية للقيم الخلقية. ونظرًا لتنوع هذه الملاحظات فإننا نفرد لكل منها فقرة مستقلة.
- السياسة التشريعية:
جنح المشرع المصري في معالجته للجرائم الخلقية الماسة بالأسرة -بالمعنى الذي حددناه لها في مطلع هذه الدراسة- إلى اتجاه أساسه الاعتراف للأفراد بالحرية الجنسية، فجعل ممارسة هذه الحرية نوعًا من النشاط المشروع -بحسب الأصل- لا تشترط لإباحته صلة قانونية من أي نوع بين أطراف العلاقة الجنسية، ولا فرق في ذلك بين الأفعال المتنوعة التي يعد أي منها نشاطًا جنسيًا. ومن ثم فإن نطاق التجريم ينحصر في ظل القانون المصري في الأفعال التي تعد اعتداء على الحرية الجنسية، وهي الأفعال التي ترتكب دون رضاء صحيح قانونًا من المجني عليه، أو التي تعد اعتداء على تنظيم إجماعي أو على الحقوق التي يرتبها هذا التنظيم لأطراف العلاقات التي تحكمها قواعده القانونية([35]).
وهكذا لا يتجه المشرع المصري إلى حماية العلاقات الجنسية من أي ممارسة غير مشروعة، وانما يقصر حمايته لهذه العلاقات على منع الممارسات غير المشروعة التي تتم ضد إرادة المجني عليه أو دون أرادته([36]).
ولنا على هذه الخطة التشريعية مآخذ نجملها فيما يلي:
19/1. مجافاة العرف الاجتماعي:
إن المجتمع المصري بطبيعته مجتمع متدين، يلتزم أفراده -عادة- بجوهر تعاليم الأديان، ويحرصون على ممارسة شعائرهم، حتى وإن خالفوا في ظاهر مسلكهم بعض الأوامر الدينية. أو أتوا بعض المناهي.
والأخلاق الفاضلة أهم مصادرها الدين، وليس هناك دين يبيح لأتباعه كل نوع من العلاقات الجنسية ما دام الفعل المكون لهذه العلاقات يتم بين شخصين بالغين راضيين.
من هنا فإن المشرع المصري، منذ صدرت أولى مدونات قانون العقوبات، قد خالف العرف الاجتماعي حين اتخذ الخطة التي أسلفنا بيانها في معالجته للجرائم الخلقية الماسة بالأسرة. فلا زالت جميع أشكال العلاقة الجنسية خارج إطار عقد الزواج تلقى استهجان المجتمع المصري بوجه عام، ولازال هذا المجتمع يعتبر الحفاظ على الفضيلة مقومًا أساسيًا من مقوماته.
فإذا انتقلنا من العموم إلى الخصوص، وجدنا مجتمعنا يدين القسم الأكبر من أبنائه بالإسلام الذي توزن فيه الأعمال والتصرفات كافة بميزان الأخلاق قبل أي ميزان آخر([37])، والذي يقوم نظامه القانوني قبل كل شيء على إقرار الأخلاق الفاضلة ومنع الممارسات المنافية لها، حتى ليقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق"([38]).
وحجر الزاوية في التنظيم الاجتماعي الإسلامي هو نظام الأسرة، وأحكام الإسلام الاجتماعية تقوم على حياطة هذا النظام بأقوى سياج ممكن من عوامل الاستقرار والطمأنينة.
فكيف ساغ للمشروع المصري، وهذه المعاني كلها قائمة عند وضع نصوص قانون العقوبات، ولا تزال قائمة حتى اليوم، أن يبني خطته في معالجة الجرائم الخلقية الماسة بالأسرة على نحو ما بيناه من جعله أساسها حرية العلاقات الجنسية؟ إننا نقرر بكل اطمئنان أن هذا لم يكن إلا أثرًا من آثار التقليد غير الواعي للغرب المستعمر أو المسيطر. وهو أثر تخلصت منه التشريعات الجنائية التي صدرت في دول عربية بعد التشريع المصري (كالمغرب والكويت وقطر وغيرها، وإن كان هذا التخلص ما زال جزئيًا) ويجب على المشرع -في تقديرنا- أن يبادر إلى الاقتداء بها في تغيير أساس خطته التشريعية سالفة البيان إلى أساس متسق مع العرف الاجتماعي المصري.
19/2- عدم الاستجابة للتعديلات الدستورية:
نقلنا في صدر هذه الدراسة نصوص المواد ۲ و۹ و۱۲ من الدستور المصري الصادر سنة ۱۹۷۱، وهي النصوص التي تجعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وتوجب على الدولة رعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين لها وتجعل أساس المجتمع الأسرة، وتحدد قوام الأسرة بالدين والأخلاق والوطنية.
ولئن كان مسلك المشرع المصري في علاج الجرائم محل البحث هنا قبل صدور هذا الدستور مجافيًا للواقع الاجتماعي، مجافاة كان يتعين ألا تقع أصلاً، إلا إنه الآن يمثل تحديًا للنصوص الدستورية سالفة الذكر يتيح لأي ذي مصلحة الطعن بعدم دستورية نصوص قانون العقوبات لمخالفتها للنصوص الدستورية([39]). وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 4/5/١٩٨٥ في القضية رقم ۲۰ لسنة قضائية دستورية (الجريدة الرسمية العدد ٢٠ في ٢٦ شعبان ١٤٠٥ الموافق ١٦ مايو 1985) قد حصَّنت القوانين السابقة في الصدور على الدستور من الطعن فيها بعدم الدستورية للأسباب التي تضمنها حكمها، فإنها قررت في الحكم نفسه أن ذلك "لا يعفي المشرع من تبعة الإبقاء على التشريعات السابقة رغم ما قد يشوبها من تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وإنما يلقي على عاتقه من الناحية السياسية مسئولية المبادرة إلى تنقية هذه التشريعات من أية مخالفة للمبادئ سالفة الذكر، تحقيقًا للاتساق بينها وبين التشريعات اللاحقة في وجوب اتفاقها جميعًا مع هذه المبادئ وعدم الخروج عليها".
ولا شك أن هذا التدخل المطلوب يكون أوجب إذا أضيف إلى مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية -كما هو الحال هنا- مخالفة العرف الاجتماعي ومجافاته. إذ يخرج القانون الجنائي في هذه الحالة عن كونه حارسًا للقيم الاجتماعية مانعًا من الخروج عليها، إلى كونه فارضًا قيمًا لا علاقة للمجتمع بها، بل تأباها قواعد العلاقات الاجتماعية السائدة فيه.
ولا يُرَدُ على هذا النظر بالاستمساك بنص المادة ٤١ من الدستور الذي يقضي بأن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ...." لأن الحرية المرادة هنا -بدليل مورد النصر وسياقه- هي الحرية السياسية في مواجهة السلطة، لا الحرية الاجتماعية أو الخلقية أو غيرها في مواجهة مبادئ الدين، ولا الحرية في مواجهة قواعد العرف الاجتماعي المقبول.
- الأحكام التفصيلية:
لقد قادنا النظر في الأحكام التفصيلية التي تضمنتها نصوص قانون العقوبات المصري للعقاب على الجرائم الخلقية الماسة بالأسرة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية إلى إثبات الملاحظات الآتية على تلك الأحكام:
أولاً: فيما يخص جريمتي الاغتصاب وهتك العرض بالقوة أو التهديد:
إن جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد المنصوص عليها في المادتين ٢٦٧ و٢٦٨ من قانون العقوبات المصري تقعان داخل إطار النموذج القانوني لجريمة الحرابة في النظام الجنائي الإسلامي، فهذه الجريمة تقع من كل من استعمل القوة -فردًا كان أم جماعة- لقطع طرق المواصلات بين المدن والقرى، أو الاعتداء على أموال الناس أو أرواحهم أو أعراضهم أو ظهار سطوته واستخفافه بسلطان الدولة وسلطاتها([40]).
بل إن نصوص الفقه الإسلامي لتتسع لتشمل بالعقاب المقرر للحرابة في القرآن الكريم كل من استعمل الحيلة أو الخديعة، أو التهديد أو استعان بسقي المجني عليه -أو عليها- مادة منومة أو مخدرة([41]).
وتأسيسًا على ذلك نص المشروع المعدل لقانون العقوبات في الكويت على أنه:
"يعد مرتكبًا لجريمة الحرابة كل من أرهب الناس داخل المصر أو خارجه مع عدم إمكان الغوث، سواء كان ذلك بقصد الاعتداء على المال أو العرض أو النفس، أو لمجرد إظهار سطوته. ويستوي في ذلك أن يكون المحارب فردًا أو أكثر".
وعلى الرأي الفقهي القائل بأن الحاكم -الإمام أو القاضي- مخير بين عقوبات الحرابة يوقع أيها شاء([42]) فإنه لا تثريب على المشرع أن هو قرر الإعدام عقابًا على الاغتصاب وهتك العرض بالقوة أو التهديد، سواء قرره عقابًا وحيدًا، أم خير القاضي بينه وبين الأشغال الشاقة باعتبارها، من حيث هي حبس، صورةً من صور النفي الجائزة في الفقه الإسلامي([43]).
ثانيًا: فيما يخص هتك العرض دون قوة أو تهديد:
قدمنا أن هتك العرض دون قوة أو تهديد ليس إلا تمهيدًا لاتصال جنسي غير مشروع لا يرغب فيه المجني عليه. وتجرم الشريعة الإسلامية كل اتصال جنسي غير مشروع لا تكتمل فيه العلاقة الجنسية بالوطء تحت اسم "مقدمات الزنا" أو "الوطء فيها دون الفرج" بحسب نوع الفعل ودرجة جسامته.
والعقوبة التي تقررها الشريعة لهذا الفعل هي عقوبة تعزيرية يترك تقديرها للسلطة المختصة في الدولة. ومأخذنا -من ثم- على المشرع المصري في هذا الصدد أن نطاق التجريم الذي فرضته المادة ٢٦٩ في جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد ضاق عن أن يشمل الأفعال الجنسية الرضائية بين البالغين، وهي ملحوظة ألصق بالسياسة التشريعية -في واقع الأمر- منها بالأحكام التفصيلية لهذه الجريمة. ونعتقد أنه يتعين على المشرع عند إعادة النظر في النصوص الخاصة بالجرائم الخلقية أن يأخذ بعين الاعتبار شمول التجريم كل الأفعال الجنسية خارج إطار الزواج الصحيح، وهي الخطة التي تلتزم بها الشريعة الإسلامية.
ويلحق بهذه الجريمة سائر الجرائم الجنسية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، فهي جرائم تعزيرية لم تفرض لها الشريعة الإسلامية عقوبة محددة، بل تركت الباب في تقرير العقاب عليها وتقديره مفتوحًا لاعتبارات الملاءمة التي تقدرها السلطة المختصة في الدولة في ظل الظروف السائدة وقت التشريع.
ثالثًا: فيما يخص زنا الأزواج:
إن نصوص قانون العقوبات المصري في خصوص الزنا تتناقض تناقضًا تامًا مع نصوص الشريعة الإسلامية.
فالزنا في الشريعة الإسلامية يشمل كل صور الاتصال الجنسي المتضمن جماعًا بين رجل وامرأة لا تجمعهما رابطة الزواج الشرعي.
والشريعة الإسلامية حددت للزاني المحصن عقوبة أشد من تلك التي حددتها للزاني غير المحصن.
ولا تجيز أحكام الشريعة العفو عن الزاني لأي شخص، ولا لأي سلطة من سلطات الدولة، باعتبار الجريمة من جرائم الحدود التي لا يدخلها العفو ولا تقبل الإسقاط([44]).
وعلى خلاف ذلك كله، لم يجعل القانون الصلة الجنسية غير المشروعة معاقبًا عليها إلا إذا كان أحد طرفيها متزوجًا وأباح للرجل المتزوج أن يزني خارج منزل الزوجية بلا عقاب، وحين فرض عقوبة على الزنا الذي يرتكبه الرجل داخل منزل الزوجية جعلها عقوبة تافهة لا تناسب قط الجرم المرتكب.
بل إن من عجائب التشريع المصري أن العقوبة التي تنال الزاني في منزل الزوجية -على ما يتضمنه فعله من طعن المرأة في كرامتها، والأسرة في شرفها وسمعتها- هي نفسها العقوبة التي تناله إذا لم يدل بالبيان الصحيح عن حالته الاجتماعية أو عنوان زوجته عند توثيق زواجه، أو إذا لم يوثق إشهاد الطلاق لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق([45]).
فكيف ساغ للمشرع أن يسوي بين هذه الأفعال في مقدار العقوبة ونوعها؟ أو ليس ذلك خللاً في التشريع يشينه بعيب عدم الاتساق بين الجرائم والعقوبات؟
وقد سبق للفقه الجنائي المصري أن وجَّهَ انتقادات متعددة لنصوص قانون العقوبات الخاصة بزنا الازواج في ناحيتيها الموضوعية والإجرائية([46])، وذلك كله يقتضي من المشرع النظر من جديد في هذه النصوص ليسبغ على العلاقة الزوجية، وعلى الرابطة الأسرية الحماية الجنائية التي هما جديرتان بها، لا هذه الحماية المتهافتة القائمة في التشريع بوضعه الحالي.
كذلك فإنه مما ينبغي أن يشمله التجريم، بنصوص صريحة، أفعال الشذوذ الجنسي التي تتم رضائيا بين البالغين ذكورًا كانوا أو إناثًا، والمخادنة، أو اتخاذ خليلة، وهي العلاقة غير المشروعة التي لها صفة الاستمرار بين رجل وامرأة لا تربطهما رابطة الزواج الشرعي، وتتميز بالإضافة إلى عنصر الاستمرار بقيام الرجل -في العادة- بالإنفاق على خليلته.
وحين يستجيب المشرع إلى ما اقترحناه من تعديلات في سياسة التجريم والعقاب، وفي تفصيلات الأحكام الخاصة بالجرائم التي تناولناها، فإنه يستجيب في واقع الأمر لما ألزمته به النصوص الدستورية من اتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولما يوجبه المنطق القانوني من اتساق أحكام التجريم والعقاب مع القيم السائدة في المجتمع، لا اتخاذها أداة لتغيير هذه القيم أو الانحراف بها.
ولله الحمد رب العالمين
لتحميل ملف البحث
______________________
الهوامش:
* بحث منشور بحولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة قطر، ع: 5، 1407هــــ/ 1987م، ص 189- 219.
** الأستاذ بجامعة الملك سعود (سابقًا).
(1) أنظر في تفصيل ذلك:
Martin Golding, Philosophy of Law Jersey, 1957.
Friedman, Law in Changing Society, London, 1972, Hart.
Law Liberty and Morality, London, 1969.
وكتابنا: في أصول النظام الجنائي الإسلامي، الطبعة الثانية، دار المعارف، ١٩٨٣ ص51 وما بعدها، والمراجع المشار إليها فيه. وأهم الأفعال التي أباحتها التشريعات المتعاقبة منذ سنة 1961 هي الإجهاض والبغاء، والشذوذ الجنسي بين الذكور إذا كان الطرفان بالغين راضيين، وارتكب الفعل في غير علانية ونشر المواد الإعلامية الفاضحة التي لا تتضمن تحريضًا صريحًا (!) على الفجور.
(2) John Stuart Mill, On Liberty, p.15.
(3) رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ۱۹۷۱، ص ۱۳۱.
(4) Report of the committee on Homesexual offences and Prostitution (Cmnd 747,1957) S. 61.
وقد مضى في الطريق نفسه مشروع القانون الجنائي النموذجي الذي أصدره معهد القانون الأمريكي سنة ١٩٦٢ فأباح الشذوذ الجنسي الرضائي بين البالغين. ولكن هذه الإباحة لم تجد طريقها إلى قوانين جل الولايات المتحدة. انظر:
Wolfgang Friedmann, Law in Changing Society, London, 1972, P.201.
(5) من أقوى مؤيدي هذا الرأي تعبيرًا عنه وعرضًا له:
Lord Devlin, The Enforcment of Morals, London, 1965.
Basil Mitchell, Law, Morality and Religion, London 1970; Abrahams, Morality and the Law London, 1971.
وقد تردد القضاء البريطاني (مجلس اللوردات) في موقفه من حماية القيم الخلقية بتجريم صور السلوك المنافية لها، فبعد أن اتخذ موقفًا واضحًا في أن ذلك هو الرأي الذي يؤيده، في قضية SHAWV.D.P.P، عاد فعدل عن هذا الرأي حين رفض القول بأن من سلطته مَدّ نطاق القانون الجنائي ليشمل بحمايته القيم الخلقية، وذلك في قضية: (۱۹۷۳) Knuller V.D.P.P.
(6)العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص ٢٥٩ وما بعدها.
(7) انظر: علي راشد، القانون الجنائي، ١٩٧٤، ص ٩٠ - ٩٤.
(8) Hart, Law, Liberty and Morality, P.5.
(9) Hart, Law, Liberty and Morality, P.5.
(10) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، القاهرة، ۱۹۷۸، رقم ۳۳۳ ص ۳۲۸.
(11) تسمية هذه الجريمة اغتصابًا هو الشائع في الفقه المصري، ويسميها الاستاذ الدكتور عوض محمد عوض جريمة المواقعة لأسباب بينها في بحثه: الجاني والمجني عليه في جريمة المواقعة: دراسة مقارنة للتشريعين المصرين والليبي، بنغازي (دون تاريخ).
(12]) عوض محمد عوض، المصادر السابق، ص ١٦ - ٢٢.
(13)محمود نجیب حسني، المرجع السابق، رقم ٣٥٣، ص ٣٥٤ - ٣٥٦.
(14)هذا هو الرأي الذي يذهب إليه الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني، وهو رأي يقوم في نظرنا على اعتبار واقعي صحيح لذا نراه جديرًا بالتأييد.
(15) حسنين عبيد، فكرة المصلحة في قانون العقوبات، المجلة الجنائية القومية عدد يوليو ١٩٧٤ (العدد الثاني - مجلد ١٧)، ص ٢٥٠.
(16) محمود نجيب حسني، المصدر السابق، رقم ٣٤٢، ص ٣٣٩. وقارن: محمد أبو عامر: الحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر، ص ١٤٩ – ١٥١، حيث يرى أن المصلحة التي أراد المشرع حمايتها بهذه الجريمة هي حماية العرض فحسب، بل يرى أن المشرع المصري لم يشغل نفسه بالأغراض المستهدفة من تقرير جريمة الاغتصاب، (ص ١٤٩) وهو رأي جدير بالتأمل.
(17) أنظر في تفصيل ذلك كله: محمود نجيب حسني، المصدر السابق، أرقام ٣٥٠ - ٣٥٥، ص 350-360.
(18) تقرير الأمن العام لسنة ١٩٨٤ وزارة الداخلية المصرية، جدول رقم ٤ ص ٧، وجدول رقم ٢ ص ٤.
(19) محمد أبو عامر، المصدر السابق، ص ١٣٦ - ١٣٧.
(20) تقرير الأمن العام، المصدر السابق، جدول (٤)، ص ۷، وجدول (۱)، ص ۳.
(21) تقرير الأمن العام، جدول رقم ٧٥، ص114.
(22) محمود نجیب حسني، المصدر السابق، رقم ٣٦٨، ص ١٣٦٧.
(23) المصدر السابق، رقم ۳۷۱ و۳۷۳، ص ۳۷۰ - ۳۷۱.
(24) محمود نجيب حسني، المصدر السابق، رقم ۳۷۰، ص370.
(25) المصدر السابق، الموضع نفسه. وقارن: محمد أبو عامر، المصدر السابق، رقم ۲۳، ص ۷۱ - ۷۳. حيث يرى وقوف الحماية القانونية عند صيانة الجسد من كل ممارسة جنسية غير مشروعة تقع عليه من الغير برغم إرادته أو دونها.
(26) تقرير الأمن العام، المصدر السابق، جدول رقم ۸۰، ص ۱۲۰. وجدول رقم ٧٧، ص ١١٦.
(27) أورد ما قيل من اعتبارات لتسويغ التفرقة بين عقوبة الجريمتين، وانتقدها بحق: محمود نجيب حسني، المصدر السابق، رقم ٤٦٤، ص ٤٥٩ – ٤٦٠.
(28) ولذلك لا يعتبر هذا النص مطابقًا للنصوص السابق إيرادها المجرمة لمجرد الاتصال الجنسي بين غير الأزواج.
(29) يتعين لمن أراد التوسع في دراسة جرائم البغاء مراجعة رسالة الدكتور محمد نيازي حتاته: جرائم البغاء، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، ١٩٦١.
(30) الدكتور عبد الوهاب العشماوي المحامي الآن بالقاهرة وهو الذي أعطاني مشكورًا نسخة من تلك الدراسة القيمة التي أجريت على عدد من المحكوم عليهن نزيلات سجن النساء بالقناطر.
(31)اللواء سيد أبو مسلم في أكاديمية الشرطة. وكان عنوان الدراسة: إجرام النساء.. ظاهرة اجتماعية اقتصادية.
(32) نقض جلسة 16/1/١٩٣٣ الطعن رقم ٨٦٣ س ٢ ق مجموعة ربع القرن ص ٧٤٢.
(33) مصطفى الشاذلي، الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب، الإسكندرية، (دون تاريخ)، ص229- ۲۳۰.
(34) الكمال بن الهمام، فتح القدير، جـ ٤، ص ١٩٤.
(35) محمود نجیب حسني، المصدر السابق، رقم ٣٣٤، ص ٣٣٠.
(36) محمد زكي أبو عامر، المصدر السابق، ص ۷۲ – ۷۳.
(37) العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، المصدر السابق، ص227.
(38) هذا النص هو الذي رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، الموطأ عبد الباقي، ص ٥٦٤. وقد أخرج الحديث أيضًا بلفظ مختلف الإمام أحمد في مسنده، راجع مشكاة المصابيح، ط المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، جـ ٢، ص ٦٣٢.
(39) هذا الرأي هو الذي نراه، وليس هنا موضع تفصيل حججه وأسانيده، ولكن المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أنه لا يعد مخالفًا للدستور، بحيث يحكم بعدم دستوريته، إلا نصوص القوانين الصادرة بعد بدء العمل بالدستور دون النصوص التي سبقت في صدورها الدستور ذاته. ولكنها -على كل حال- لم تعف المشرع من واجب الإسراع إلى تعديل تلك النصوص الأخيرة لتتوافق مع النصوص الدستورية على ما بيناه في المتن- وهو عين ما نطالب به.
(40) انظر في تفصيلات ذلك: العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، ص ۱۸۹ – ۲۰۸.
(41) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، جـ ۲، ص ۲۸۳ وهذا هو ما رآه القرطبي وابن العربي في تفسيريهما لآيتي الحرابة رقم ٣٣ و٣٤ من سورة المائدة.
(42) للتفصيل راجع: العوا، المصدر السابق، ص ١٩٥ - ١٩٦ و١٩٩.
(43) أنظر في تفصيل الآراء الفقهية في هذا الشأن، المرجع السابق، ص ٢٠٠ - ٢٠١.
(44) تفصيل ذلك في: العوا، المصدر السابق، ص ١٢٧ و٢١٦ وما بعدها.
(45) أنظر المادة ۲۳ مكرر من القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥.
(46) أنظر على سبيل المثال: محمود نجيب حسنى، المصدر السابق، أرقام: ٤٦٤، ص ٤٥٩ و١٣١ ص ۱۳۳ و٤٩٨ ص ٤٩٢.