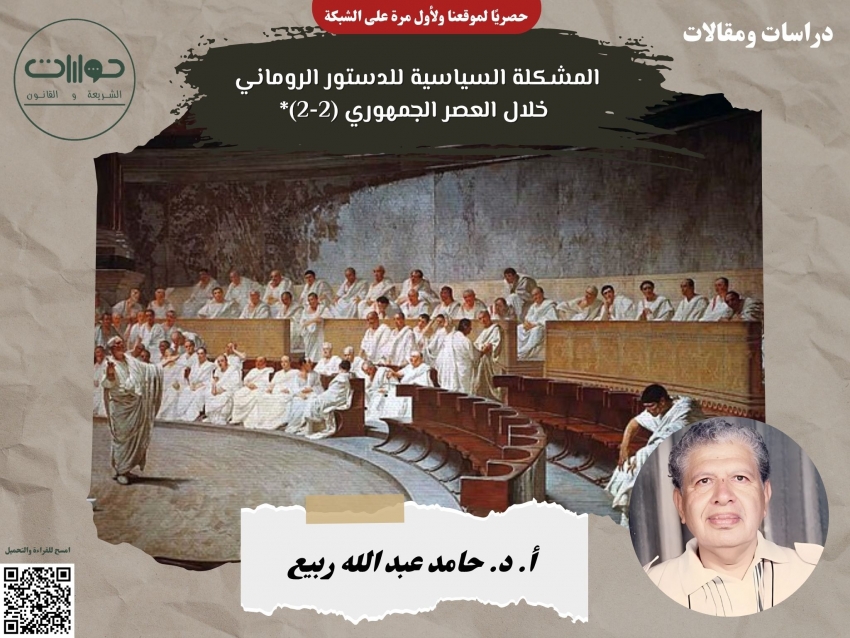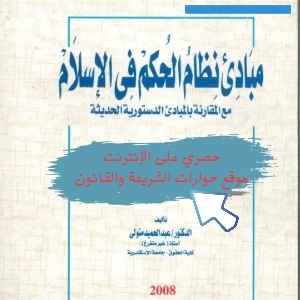الفرع الثاني
النزاع بين حزبي الأخيار والشعب وأثره في التطور الوظيفي للدستور الروماني
الخلاصة: انقسام القوى السياسية بين حزب الأخيار وحزب الشعب خلال النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد- التعريف بالحرية وتفسيراته المتعددة- التعريف بالبرنامج السياسي للحزب الديمقراطي: مبدأ السيادة الشعبية وفكرة قدسية النظم الدستورية- العناصر الأيديولوجية في خطابات ساللوست وعقيدة كاتيلينا- البرنامج السياسي لحزب الأخيار: النظرية الأرستقراطية للديمقراطية الرومانية– بوليب ونظرية الدستور المختلط- شيشرون وخلاصة أفكاره السياسية– انتهاء النزاع بين القوى السياسية بالقضاء على النظام الجمهوري الروماني.
8- انقسام القوى السياسية بين حزب الأخيار وحزب الشعب خلال النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد:
الاتجاه السائد هو أن روما لم تكن تعرف فكرة الحزب السياسي كما نفهمه اليوم. وترتب على ذلك أن النزاع بين حزبي الأخيار والشعب لم يكن يعبر عن برنامج سياسي معين، وإنما كان نزاعًا بين قوى سياسية متعددة لا تربطها سوى علاقات شخصية وتحالفات تجمعها فقط رابطة وثيقة من الدم والصداقة[1].
هذا التفسير لا يمكن قبوله إلا بشيء كثير من الحذر.
فمما لا شك فيه أن فكرة الحزب في صورته النظامية المعاصرة لم تكن تعرفها الجمهورية. وهل عرفتها الجماعة الحديثة حتى نهاية القرن الماضي؟ على أن فكرة الحزب بمعنى تجمع للقوى في صورة أفقية لا رأسية، حول برنامج معين، لا شك أن روما الجمهورية قد عرفتها. بل ونضيف إلى هذا أن كلمة حزب سياسي كانت تتضمن أيضًا معنى المذهب السياسي كما نفهمه اليوم في فقهنا المعاصر، ذلك أن كلمة factio إنما كانت تعبر لا عن فريق معين من الشعب pars فقط، وإنما عن اتجاه معين credo إزاء المشكلة السياسية[2].
فلنحاول أن نحدد العناصر التي دار حولها النزاع بين القوى السياسية المتعارضة.
9- التعريف بالحرية وتفسيراته المتعددة:
كلمة الحرية لم يُقصد بها في خلال التاريخ الدستوري الروماني منذ طرد الملك توليوس سوى معنى واحد: النظام الجمهوري[3]. فالحرية إذن لم تكن سوى تعبير شكلي مرادف لصورة معينة للنظام السياسي. لم تكن تعني تلك الكلمة كما عرفتها الحضارة اليونانية أي حق للفرد داخل الجماعة. حتى في تلك الاستثناءات المحدودة حيث نجد النصوص تتحدث عن حرية الشعب، كلمة الحرية Libertas تُستعمل بطريقة معينة بإضافة وتخصيص يكادان يصيران كلمة جديدة[4]. على العكس نجد جميع النصوص تقدم ذلك الاصطلاح بمعنى أنه يعبر عن نظام مخالف للنظام الملكي الذي يعني العبودية.
في خلال الحروب المدنية، ومنذ فترة لا نستطيع تحديدها على وجه التحقيق سوى أنها تتذبذب بين نهاية القرن الثاني وأوائل القرن الأول، بدأت تتسلل في العقلية الرومانية فكرة جديدة عن الحرية: فكرة تسعى إلى المعنى الحقيقي للاصطلاح، إلى العناصر الذاتية التي تتكون منها فكرة الحرية، ومن ثم تربط بين فكرة الحرية وبين الشخصية الفردية. منذ تلك الفترة يبدأ تطور أيديولوجي حول تلك الكلمة سوف يُقدَّر له بالانتهاء خلال القرن الأول بعد الميلاد بتحويل كامل في معنى الحرية، فتصير هذه معبّرة لا عن صورة نظامية معينة وإنما عن حق الفرد داخل الجماعة المنظمة في قسط أدنى من الطمأنينة المشروعة. ومن ثم تصير كلمة Libertas مرادفة للكلمة Securitas[5].
هذه الفكرة، فكرة الحرية لا كمرادف لكلمة الجمهورية وإنما كمعبر عن رُخَص معينة لصيقة بالفرد، كانت وليدة التطور الأيديولوجي الذي أصاب الجماعة الثائرة على الدستور الروماني. وقد رأينا أن معضدي "جراكوس" لم يكونوا يريدون أكثر من إعادة تقوية النظام الحاكم والعودة إلى المبادئ القديمة التي عرفتها روما الجمهورية في الفترة الأولى. أما هنا، وفي دوائر حزب الشعب، تبدأ تظهر فكرة جديدة للحرية يُعبر بها عن حق طبيعي للفرد: certe ego liberatem, quae mihi a parente meo tradita est experiar، وهي تعني الكفاح المسلح ضد الطبقة الأرستقراطية في سبيل تأكيد الحكومة الصالحة التي ترعى المصالح المتعارضة موفقة بينها، وخالقة نوعًا من الانسجام concordia هو أساس كل حكومة مشروعة[6].
ورغم أن تحديد معنى الحرية في هذه الفترة يثير الكثير من اللغط بين المؤرخين والمعاصرين، إلا أنه مما لا شك فيه أن فكرة الحرية كما دافع عنها الحزب المحافظ، حزب الأخيار، إنما كانت تعبر عن تقليد مستقر بصفة خاصة منذ النصف الثاني من العصر الجمهوري، الذي يجعل من فكرة الحرية إحدى خصائص الشعب الروماني، ومن ثم فهي فكرة غامضة استخدمها ممثلو حزب الأخيار للتمويه على الجماعات وخداع الجماهير[7].
۱۰- التعريف بالبرنامج السياسي للحزب الديموقراطي: مبدأ السيادة الشعبية وفكرة قدسية النظم الدستورية: العناصر الأيديولوجية في خطابات «ساللوست» وعقيدة «كاتيلينا»:
هذا التعارض في تفسير كلمة الحرية إنما كان يعبر عن برنامجين مختلفين: برنامج ديمقراطي وبرنامج محافظ. الأول يجد أصوله البعيدة في محاولة "جراكوس"، ويتميز بمحاولة تحديد سلطة مجلس الشيوخ وتطوير سلطة الهيئات الشعبية في مواجهة القناصل بصفة خاصة والحكام بصفة عامة.
في هذا البرنامج تبرز بشكل واضح فكرتان جديدتان: الأولى فكرة السيادة الشعبية، والثانية فكرة احترام النظم الدستورية. فالرومان لم يعرفوا مبدأ السيادة الشعبية كقاعدة عامة. لم يجعل النظام الدستوري الروماني في أي مرحلة من مراحل تطوره من مبدأ السيادة الشعبية قاعدة تبرر النظام السياسي وتحدد إطاره الوظيفي[8]. هنا لأول مرة نجد هذا المبدأ يتسلل في العقيدة الرومانية محددًا صورة جديدة للنظام السياسي أساسها تقوية سلطة ممثل الشعب: Tribun.
أما العنصر الثاني فهو الاتجاه العام لمقاومة كل قواعد استثنائية الغاية منها إيقاف الضمانات الدستورية حمايةً للمواطنين، وبعبارة أخرى يمكن القول إن فكرة جديدة للشرعية تغلغلت في عقيدة حزب الشعب، أساسها من حيث التبرير القانوني مبدأ السيادة الشعبية، ومن حيث حدود تطبيقها العمومية التي لا تقبل استثناءات بغض النظر عن مبرراتها[9].
مما لا شك فيه أن تحديد أفكار ممثلي الحزب الديمقراطي من الصعوبة بمكان، بسبب أن المصادر التي وصلت إلينا جميعها تقريبًا مغرضة، إذ تعبر عن وجهة النظر المحافظة. على أن الحديث الذي نقله إلينا المؤرخ الروماني «ساللوست» منسوبًا إلى «ميميو» أحد زعماء الحزب الديمقراطي، وكذلك بعض الفقرات التي تحمل أنباء عن كاتيلينا، تسمح لنا بتحديد المبادئ العامة التي يدور حولها النظام الديمقراطي كما تخيله زعماء وممثلو الحزب الشعبي[10].
على أننا نسرع منذ الآن فننبه إلى أمرين: الأول هو ألا نخلط بين أولئك الذين مثلوا بحق هذا الحزب الشعبي وعبروا عن أفكاره ودافعوا عن مثله الأعلى أيضًا بقوة السلاح، وبين أولئك الذين استغلوا فرصة وجود هذا الحزب ودفعتهم قوته المتطورة فانضموا إليه بقصد استغلال تلك الفرصة والوصول إلى الحكم[11]. فكاتيلينا نفسه لم يكن إلا نبيلًا أصابه الفقر، فرأى في هذه الفرصة وسيلة لأن يصل إلى مرتبة القنصل حيث أخفق عن طريق استناده إلى أصله القديم. ونفس قيصر لم يصل إلى الحكم على أكتاف الحزب الشعبي إلا ليحقق غاية شخصية دفع ثمنها بحياته.
الأمر الثاني أن الفكرة الشعبية اختلطت بنوع معين من الاضطرابات والفوضى، تذكر لنا النصوص الكثيرة وقائعها وما صاحبها من اغتيالات واعتداءات على الحريات الفردية. كان شيشرون مثلًا موضعًا للاعتداء من جانب ممثلي خصمه فحرقوا منزله ودمروا ضيعته. ويذكر أنه في عام ٥٢ ق.م، فريق من ممثلي الشعب يدافع عن كلوديوس هاجم مجلس الشيوخ وحرق الكثير من حجراته وقضى على بعض أعضائه، وكان السبب في ذلك أن خصم كلوديوس -أي ميلون- كان قد دفع جماعة من أعوانه إلى قتل هذا الزعيم الشعبي[12].
هذه الصعوبات المتعددة تلقي الكثير من الغموض حول النظام الديمقراطي الذي أراد حزب الشعب تنفيذه، حتى إن بعض المؤرخين ينكر على هذا الحزب أنه كان يملك مذهبًا سياسيًا معينًا. على أن الواقع يخالف ذلك، ومصدرنا بصفة خاصة خطابات ساللوست التي تعبر عن أفكار حزب الشعب بشكل واضح. وهي تذكر لنا، خصوصًا لو أكملناها بمرافعة شيشرون دفاعًا عن «مورينا»، أن الحركة الديمقراطية كانت ترى في الدولة حقيقة تستند إلى جسدين: أحدهما ضعيف يعبر عنه رئيس غير قوي، والآخر قوي لا يملك رئيسًا، وهم يريدون بذلك أن يقولوا إن الدولة الرومانية تتكون من طبقتي النبلاء وغير النبلاء، الأولى يرأسها مجلس الشيوخ، والثانية لا تملك أي تعبير سياسي عنها.
مما لا شك فيه أنه يستحيل القول إن الجماعة الرومانية بلغت مبلغًا يجعلها تربط بين الديمقراطية السياسية والكفاف الاقتصادي. ولكن الأمر الذي لا شك فيه أيضًا هو أن مجرد كون الحركة الشعبية تستمد مصادرها المباشرة من محاولة جراكوس تحديد الملكية، يعني أن حزب الشعب كان يجعل من الإصلاح الاجتماعي عنصرًا من عناصر نظامه السياسي. ويؤكد هذا بصفة خاصة ثورة «سيرتوريو» التي اندلعت في إسبانيا في عام ٧١ ق.م. والواقع أن هذه الثورة، التي تستمد مبادئها ومثلها السياسي الأعلى من المبادئ التي كانت سائدة في حزب الشعب، زعيمها أحد أنصار ماريو هرب إلى إسبانيا خوفًا من سيلا الذي كان قد أقام ديكتاتوريته مدافعًا عن مبادئ حزب الأخيار[13]. وهناك جمع حوله الكثير من المعارضين للنظام السياسي، واستطاع في خلال فترة قصيرة من الزمان أن يوطد أركان نظام سياسي جديد على أساس إثارة الشعوب المحكومة ومحاولة خلق حكومة عالمية تجمع بين جميع عناصر الإمبراطورية الرومانية وترفض استبداد الرومان القائم على أساس سياسة عنصرية معينة، مدخلًا في هذه الصورة الجديدة من صور النظام السياسي عنصر اللامركزية السياسية، جاعلًا من أفراد الأقاليم أساسًا مباشرًا في الاشتراك في حكم الجماعة سواء من الناحية الإدارية أو من الناحية السياسية.
ولنتذكر بهذه المناسبة أن النظام الروماني لم يكن يسمح لأي عنصر من عناصر الأقاليم المحتلة أن يتدخل في الإدارة المحلية لتلك الأقاليم أو في التمثيل السياسي بروما لهذه الشعوب. أفكار سيرتوريو إذن كانت أفكارًا ديمقراطية متقدمة، حتى إن المؤرخ الألماني «مومسن» يعلق عليه فيقول: «هكذا انتهت حياة واحد من أعظم الرجال، إذا لم نقل أعظم الرجال إطلاقًا الذين عرفتهم روما، رجل لو أنه عرف ظروفًا خيرًا من تلك التي عرفها لكان قد قُدّر له أن يكون مجددًا لأمته». وهو يريد أن يشير بهذا إلى أن سيرتوريو، الذي لم يستطع أحد أن يهزمه في قتال حربي، قد قُدّر له الفناء عن طريق قتله من أنصاره خيانة[14].
۱۱- البرنامج السياسي لحزب الاخيار: النظرية الارستقراطية للديمقراطية الرومانية:
يقوم حزب الأخيار على نظرية أرستقراطية لفكرة الديمقراطية، والمصادر التي تحدد لنا عناصر تلك العقيدة كثيرة، وبصفة خاصة ما أرسله إلينا شيشرون من خطب خلال حياته كقنصل ثم في الفترة اللاحقة مباشرة على ذلك قبل أن يبتعد عن الحياة السياسية بعد نفيه من روما. فالحزب المحافظ لم يكن يرفض فكرة الديمقراطية ولا فكرة الحرية. وكذلك عرفت عقيدة حزب الأخيار فكرة العدالة، ولكنها قيدت كل هذه القيم بنظام تصاعدي أساسه أن المساواة المطلقة ليست من المبادئ التي يستطيع نظام سياسي يزعم الكمال أن يدافع عنها[15].
والواقع أن البرنامج السياسي لحزب الأخيار، رغم أنه كان يعبر أساسًا عن الدفاع عن نظام سياسي قائم أكثر من الدفاع عن مثل أعلى، حيث إن هذا النظام السياسي القائم إن هو إلا تمثيل قانوني لمصالح الطبقة الأرستقراطية، إلا أنه بفضل فيلسوفين، أحدهما ذو أصل يوناني وهو بوليب، والآخر روماني ولكنه من الطبقة الوسطى، شيشرون، استطاع حزب الأخيار أن يكسب برنامجه السياسي صورة من المثالية تعكس طبيعة الخبرة النظامية التي اكتسبتها الجماعة المعاصرة بطريق غير مباشر عن الحضارة الرومانية[16].
من حيث الأسس العامة التي يقوم عليها البرنامج السياسي لحزب الأخيار يمكننا أن نلخصها في الآتي:
أولًا: تحديد فكرة المساواة بالطبقة الاجتماعية.
ثانيًا: التمييز بين درجات متعددة من الحرية.
ثالثًا: التمسك بالسلطات المطلقة للحكام ورفض إخضاعها لرقابة الهيئات الشعبية.
فالجماعة الأرستقراطية لم تكن تقبل أن المساواة تعني حق كل فرد في أن يدّعي جميع الحقوق المسلَّم بها للآخرين. فالمواطن تتحدد حقوقه تبعًا للطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، ويعني ذلك أنه إن وُجدت مساواة فإنما تكون بين جميع أفراد نفس الطبقة. ومما يخجل أي روماني محاولة المساواة بينه وبين الشعوب المغلوبة. الروماني ينظر إلى نفسه بإعجاب ولا يهتم لذلك إلا بتاريخه، ذلك التاريخ الذي لم يترددوا في تشويهه وملئه بالأكاذيب. والروماني الذي ينتمي إلى طبقة النبلاء لا يستطيع أن يسمح لغير تلك الطبقة بالادعاء بنفس الحقوق ونفس الوظائف في الجماعة.
وقد بلغ الأمر في ذلك التحجر الهرمي أنه في لحظة معينة من لحظات الجمهورية الرومانية لم يكن من حق أي فرد من أفراد مجلس الشيوخ أن يجلس في الصفوف الأولى الأمامية في الاحتفالات العامة أو في نفس مجلس الشيوخ[17]. وبعبارة أخرى، إنه في داخل الطبقة الممثلة بداخل مجلس الشيوخ حدث نوع من التوزيع الطبقي كان من نتيجته أن طبقة معينة كانت تعتبر طبقة النبلاء داخل النبلاء، وأن هذه الطبقة وحدها كان لها حقوق أكثر اتساعًا من حقوق باقي أعضاء مجلس الشيوخ. ولم تقتصر هذه الحقوق على أن تكون مجرد مجاملات شكلية، بل تعدتها لنفس الحقوق الدستورية كحق النقد وحق الاقتراح.
وكان من الطبيعي أن يتردد صدى هذه العقيدة بالنسبة لحق الحرية، فنجد aeque libertas، وبين ما تصفه النصوص بأنه تمييز واضح بين ما يسمى la dignitas[18]. فإذا كانت الأولى، التي تعني قسطًا معينًا من الحقوق، عنصرًا من عناصر الشخصية القانونية بالنسبة لكل مواطن، فإن الثانية، التي تعطي صاحبها الحق في الاشتراك في أمور الجماعة والوصول إلى المناصب العامة، ليست إلا من حق طبقة معينة هي طبقة النبلاء.
هذه العقيدة مثّلها «سيلا» بإصلاحاته قبل أن يعبر عنها شيشرون في مؤلفه عن الجمهورية. ورغم أن بعض المؤرخين لا يزال حتى الآن يناقش في صحة النظرية التقليدية من أن سيلا لم يكن إلا ممثلًا للطبقة الأرستقراطية مدافعًا عن حقوقها بدعوى أنه أول من حاول استغلال اختلال التوازن بين القوى السياسية لخلق نظام قيصري مطلق، إلا أنه لا يمكن الشك في أن العقيدة التي دافع عنها سيلا -كما نستطيع أن نتلمسها عن طريق إصلاحاته- لم تكن إلا ترديدًا لمصالح الطبقة الأرستقراطية ودفاعًا عن مثلها الأعلى[19].
ويؤكد هذا طبيعة الإصلاح بالنسبة لمجلس الشيوخ فيما يتعلق بإضافة ثلاثمائة عضو جديد، وموقف سيلا بخصوص انتخاب «شينا»، وتصرفات سيلا ذاتها إزاء التقاليد الدستورية. كذلك كان من بين العناصر الأساسية في برنامج حزب الأخيار معارضة كل محاولة لتضييق سلطات الحكام حساب المجالس الشعبية.
والغريب أن الطبقة الأرستقراطية كانت قد وجدت خلال ذلك وسيلة فيها الكثير من التحايل لإقامة نوع من أنواع الديكتاتورية، أي حكم الفرد الواحد مع سيطرة مجلس الشيوخ. ففي حالات الخطر كان يعلن مجلس الشيوخ إيقاف الحرية الدستورية بأن يصدر قرارًا باسم (senatus consultum ultimum) يخوّله اتخاذ أي تدابير استثنائية بدعوى حماية المصلحة العامة، بما فيها قتل أولئك الذين يعتبرهم مجلس الشيوخ خطرًا على الجماعة[20].
۱۲- بوليب ونظرية الدستور المختلط:
أول من دافع عن مصالح الطبقة الأرستقراطية الرومانية هو المؤلف اليوناني الأصل الذي عاش في روما خلال أعظم فترات ازدهار الجمهورية. وصل إلى روما «بوليب» وهو في سن الأربعين بعد أن أُسِرَ في إحدى حروب روما في اليونان كرهينة بوصفه أحد كبار الطبقة الأرستقراطية اليونانية، وهو مشبع بأفكار أرسطو وبصفة خاصة بفكرته عن أنواع الدساتير وعن قانون التطور في النظم الحكومية. وصل إلى روما فوجد بها كل ما كان مثله الأعلى قد استطاع في مخيلته أن يحدده: طبقة حاكمة قوية تمثل طبقة أرستقراطية تجمع بين المال والنبل، وتتركز في مدينة ضخمة مستندة إلى تنظيم رهيب تدعمه قوة السلاح ويشد أزره إيمان عميق بضرورة احترام تقاليد مقدسة فيها رجولة وعصبية.
بوليب ينقلب بحكم هذه الظروف فإذا به يدافع عن الدستور الروماني ويصفه بأنه مثل أعلى للكمال[21]. على أنه يقدم لذلك تبريرًا تتردد فيه بعض عناصر الفكر اليوناني. فلندع بوليب يحدثنا بلسانه عن خصائص الدستور الروماني: «جميع الصور الثلاث للحكم يتضمنها الدستور الروماني. جميع هذه الصور اختلطت بعضها مع البعض الآخر حتى إن الرومان أنفسهم ما كانوا مستطيعين أن يحكموا بما إذا كان دستورهم في مجموعه دستورًا أرستقراطيًا، ديمقراطيًا أم ملكيًا، وذلك طبيعي، فلو نظرنا إلى الدستور الروماني من حيث القناصل لَخُيِّل إلينا أننا إزاء نظام ملكي. ولو نظرنا إليه من حيث سلطة الشعب فإن هذا الدستور إن هو إلا تعبير عن الصورة الديمقراطية للحكم»[22].
وبوليب يريد بهذا أن يدافع عن أن خير النظم هي النظم المختلطة التي لا تعرف فكرة واحدة معينة، وإنما تحاول أن تجمع بين عناصر متعددة تتقاص وتتعادل فيما بينها. فخير الصور هي تلك التي توفّق بين مختلف الأنظمة في معايير وبمقادير تسمح بنوع معين من الانسجام. (ليس فقط المنطق بل وأيضًا الخبرة -يضيف بوليب- تعلمنا أن خير الصور للحكومات هي التي تتكون من عناصر ثلاثة: حكم الفرد، حكم الأقلية، حكم الجماعة) [23].
وبوليب لا يقتصر على أن يدافع عن نظام روما الدستوري، بل يحاول أن يقنع الشعوب المحكومة بأن تندمج وتتعاون مع روما الفاتحة، لأن هذه الأخيرة هي التي استطاعت أن تحقق تلك الصورة من صور الحكم التي لا تقبل الانحلال. فإذا كان أرسطو قد علمنا أن كلًّا من صور الحكم الثلاث المعروفة تحمل عناصر الفساد لتنتقل إلى الصورة التالية ولتعود بعد دورة كاملة إلى نقطة البدء، فإن هذه الصورة المثالية التي تعرفها روما، التي تضمنت توازنًا بين السلطات على أساس النفوذ المتماثل والرقابة المتبادلة، لا يمكن أن يُقدَّر لها الفناء[24].
والغريب أن هذه النظرية التي دافع عنها بوليب عاصرت الفترة التي قُدِّر فيها لروما الجمهورية أن تواجه أخطر اضطراب دستوري لها، أي الاضطراب الذي نشأت منه مأساة جراكوس، وبالتالي كل المشكلة السياسية للجماعة الرومانية.
۱۳- شيشرون وخلاصة أفكاره السياسية:
أهمية شيشرون في فلسفة السياسة لا ترجع إلى أفكاره بقدر ما ترجع إلى كون شيشرون تعبيرًا حقيقيًا عن المثل العليا التي سادت في الطبقة الأرستقراطية خلال القرن الأول ق.م. على أننا في تفسيرنا لشيشرون يجب أن نتذكر أمرين: الأول أن شيشرون تطوّر في فكره السياسي تطورًا خطيرًا، منتقلًا من حزب الشعب الذي عرفه مناصرًا له في أول حياته إلى حزب الأخيار، حيث استطاع عن طريق تأييده له أن يصل إلى القنصلية، إلى تلك الفترة التي امتنع فيها تقريبًا عن أن يشترك بطريقة مباشرة في النزعات السياسية، محاولًا أن يعيد في روما صورة جديدة لديموستين اليوناني[25]، تجلّت بصفة خاصة في مرافعاته المشهورة باسم (الفيليبكية). ولذلك فالحكم على شيشرون من حيث تفكيره السياسي حكم عام، كذلك الذي يمكن أن نقرأه في مؤلف سابين[26]، يتضمن نوعًا من الخطأ والمغالطة التاريخية من حيث إنه يعمّم في حكم هو في حاجة إلى التخصيص.
الأمر الثاني الذي يجب أن نلاحظه لفهم شيشرون هو أن هذا الخطيب لم يكن فقط مفكرًا بل كان أيضًا رجلًا سياسيًا، وفي كثير من الأحيان خضع فكر شيشرون لاعتبارات الاستراتيجية السياسية أكثر من خضوعه لاعتبارات المنطق أو الفكر السياسي. على أن ما يميز شيشرون وما يعطي لفكره ذاتية مستقلة أمران: أولهما فكرة التوافق بين المصالح، وثانيهما فكرة الأمير معيد الحريات.
شيشرون يقدم لنا في مؤلفه عن الجمهورية صورة لذلك الذي يسميه خير الحكومات optimus Status civitatis وخير المواطنين optimus civis، وهو يصل من هذا إلى تحديد الصورة المثالية للحاكم أو الأمير الذي يجمع بين العلم والحكمة، بين القوة والتواضع، بين الصفات الفردية الأصيلة والتمثيل الضميري للوعي الاجتماعي. إنه أول الجماعة لأنه خيرها، وهو وحده الذي يستطيع أن يقودها ويعبر عن وعيها ومثلها العليا[27]. وهو بهذا يتأثر بعاملين هامين: أولهما الفلسفة اليونانية، وبصفة خاصة الفلسفة التي عرفتها الحضارة اليونانية في عصرها الإمبراطوري، حيث تحددت بفضل الفلسفة الرواقية (Stoicisme)، فعبادة النظام الملكي بفضل تأثير العادات الشرقية أدت إلى ما يسمى بالنظرية الإلهية للسلطة. ظهر هذا في حمل الصفات التي كانت الفلسفة السياسية تسندها إلى الدستور، في الحضارة اليونانية، إلى شخص الحاكم. كان الدستور والقانون مصدر حماية المدينة، فأضحى الملك هو الذي يحمي الجماعة، ومن ثم فإن سلطته تقوم على رضًى مزدوج (euonia): يعني من جانب الإخلاص نحو الحاكم بالنسبة للشعب، والإخلاص نحو الشعب بالنسبة للحاكم. وهذا لا يكفي، فإن ذلك الحاكم يجب أن يكون شخصًا مختارًا وأقرب إلى الآلهة، يجمع بين جميع الصفات التي تعبر عن الصورة المثالية لذلك الفرد الذي لا يمت إلى البشر لأنه يعلوهم[28].
ثانيهما ذلك الشعور العام بالاستياء نتيجة استمرار الحروب المدنية في روما وما أعقبها من اضطرابات متعددة. لم يعد المثل الأعلى الذي يقود الجماعة الرومانية، وبصفة خاصة طبقة الفرسان التي ينتمي إليها شيشرون، إلا فكرة النظام والطمأنينة. إن ذلك الذي يعني الجماعة ويعني الفرد ليس هو أن يكون هناك نظام سياسي يسمح بحقوق متسعة أو محدودة للشخصية القانونية، وإنما أن يحمي تلك الشخصية وأن يمكّنها من وجود ثقة مشروعة. وتتم هذه الحماية وتتحقق هذه الطمأنينة عن طريق ذلك الأمير العادل (Moderator) الذي يعرف كيف يرتفع عن الحزازات الفردية وقت اللزوم ليحقق التوازن بين القوى المتعارضة في الجماعة[29]. وهكذا يصل شيشرون إلى التعريف بالدولة من أنها ذلك النظام السياسي الذي يسمح بإقامة التوافق والانسجام بين القوى (Concordie ordinum):
الواقع أن الرغبة في التوفيق بين الأفكار المتعارضة، بين النظم المتعارضة، بين الحقائق المتعارضة، هي ميزة شيشرون. فهو يحاول أن يجمع بين واقعية بوليب ومثالية «بانيتسيوس». وهو يحاول أن يدافع عن المثل الأعلى الجمهوري لروما القديمة وما يعنيه من إعطاء حق الاشتراك الفعلي لكل روماني يستطيع أن يقول إنه ينتمي إلى الطبقة صاحبة degnitas، أي بعبارة أخرى الديمقراطية الأرستقراطية. ولكنه في الوقت نفسه يقبل حكم الأمير ويسميه vindex libertatis، الذي يعني القضاء على حكم الأقلية. وهو أخيرًا يدافع عن العدالة، ولكنه لا يقبل بل ويرفض باحتقار المساواة[30].
رغم أن بعض الشراح يحاول أن يحدّ من قيمة أفكار شيشرون في التطور السياسي الذي أصاب الجماعة الرومانية بعد قتل قيصر، إلا أنه يكفي للتأكد من عكس ذلك أن نقرأ خطبة قيصر نفسه، حيث يعرض لزملائه أعضاء مجلس الشيوخ الصورة المثالية للحكم كما يراها. بعبارات واحدة في بعض الأحيان نجد أن أفكار شيشرون تتردد على لسان قيصر، معبّرة عن تلك الصورة المثالية وواصفة إياها بأنها إن لم تكن نظامًا ملكيًا فهي على الأقل نظام فردي (Monocratie)[31]. ويزداد هذا الإيمان لو قارنا أيضًا وصية أغسطس بمؤلف شيشرون عن الجمهورية، حيث نجد نفس عبارات شيشرون تعود مرة ثانية لتعبر عن نفس الصورة المثالية للحكم التي قدمها لنا الخطيب الروماني: حكومة أرستقراطية تسعى في الوقت نفسه إلى رفع مستوى الأفراد وإلى تحقيق نوع من الطمأنينة والثقة، دون أن يعني هذا أي مساواة بين الشعب والطبقة المختارة[32].
من الطبيعي أن أفكار شيشرون تختلف عن الأفكار اليونانية، ذلك أن روما كانت تسعى لأن تؤكد أنها شعب ينتصر فقط، بل وأيضًا أنها أمة مختارة. ومنذ تلك اللحظة سوف تختفي كلية من الجماعة الرومانية أي فكرة للحرية، أو كما يقول «تاسيت» (Tacite) إن الحرية قد هربت إلى الغابات الجرمانية[33].
١٤- انتهاء النزاع بين القوى السياسية بالقضاء على النظام الجمهوري الروماني:
لا يعنينا ذكر الوقائع التي انتهت بذلك النزاع إلى القضاء على النظام الجمهوري الروماني، ولكن يكفينا أن نتذكر أن ذلك كان نتيجة مراحل متعددة لا يمكن تحديدها على وجه الدقة إلا في بحث طويل مستقل[34]. كانت الخطوة الأولى، وهنا لا يستطيع المؤرخ المحايد أن ينكر مسئولية شيشرون أمام الأجيال القادمة، عندما أمر الخطيب الروماني الذي كان في الحكم كقنصل بأن يتتبع كاتيلينا وأعوانه، وفعلا استطاع أن يقضي على هذا الأخير وأن يشتت حزب الشعب. عقب ذلك حدث تحالف بين «بومبيو» و«قيصر» و«كراسو»، ثلاثة قواد عسكريين، من مقتضاه أن أيًّا منهم لا يستطيع أن يتخذ قرارًا سياسيًا دون استشارة الآخرين والموافقة على ذلك القرار[35]. وكان هذا بدء المأساة، إذ استطاع قيصر بالكثير من الدهاء، وبصفة خاصة بسبب ضعف أعدائه، أن يصل إلى الحكم ويحطم خصومه. بدأ أول خطوة بأن دفع بومبيو لأن يقبل الحكم كقنصل دون زميل[36]. نتذكر أن إحدى القواعد الأساسية للنظام الجمهوري هي تعدد القناصل، وكانت الغاية من هذه القاعدة هي بالذات منع التحكم الاستبدادي الذي ميّز الملكية في فترة حكم توليوس الأخير.
لم يلحظ بومبيو الأغراض البعيدة التي كان يرمي إليها قيصر من اقتراحه، وفعلا وقع في الفخ إذ جلب على نفسه أولًا عداء الحزب الأرستقراطي المحافظ الذي كان يرى في مثل هذا التعيين كقنصل وحيد دون زميل له اعتداءً على تقاليد الجمهورية[37]. كما أنه بذلك أيضًا خلق أول تقليد من حيث إمكان الحكم بشخص واحد دون أن يوصف هذا بأنه ديكتاتور. منذ هذه الفترة تبدأ النهاية الحقيقية للحكم الجمهوري، وسوف تعقبها الضربات المتتالية، بصفة خاصة عندما يتجدد النزاع بين قيصر ومجلس الشيوخ، حيث يطالب هذا الأخير بحل قوات الأول ورفض الثاني لهذا الإجراء[38]. وهكذا نصل إلى اليوم الخالد، كما يقول مومسن Mommsen، في تاريخ الحضارة الرومانية حيث ينتهي نهائيًا النظام الجمهوري. فالطبقة الأرستقراطية كانت تريد أن تُكره قيصر على أن يبتعد عن قواته العسكرية قبل الانتخابات، ويؤيدها في ذلك بومبيو. وإزاء موقف قيصر وتعنته لم يتردد «كوريوني» Curione في أن يقترح على مجلس الشيوخ إعلان قيصر «عدو الشعب» hostis rei publicae إن لم يتنازل عن سلطته العسكرية imperium. على أنه في اللحظة الأخيرة عدل كوريوني اقتراحه وطلب من مجلس الشيوخ أن يجعل هذا التنازل شاملًا لكل من قيصر وبومبيو[39].
وهنا نعود إلى الوراء لنتذكر أمرين: الأول أن القاعدة التي عرفتها الحضارة الرومانية وظلت تمتد خلال جميع التطورات الجمهورية هي أن القائد العسكري كان يجب أن يتخلى عن جيشه قبل دخوله روما، وأنه حتى في أعظم لحظات انتصاره، ما أن يصل إلى روما حتى يصير فردًا عاديًا لا فرق بينه وبين أي مدني آخر. هذه القاعدة التي ظلت الجماعة الرومانية محافظة عليها بشكل مطلق مكنت السلطة المدنية من ألا تسمح لأي سلطة عسكرية بأن تطغى عليها[40]. حتى شيبيون الأفريقي في أوج عظمته لم يستطع إلا أن ينحني أمام مجلس الشيوخ وينسحب ليموت في عزلة مطلقة. الأمر الثاني أن بومبيو كان قنصلا محتفظًا بقواته، ولكن خارج روما.
وهكذا تلاعب قيصر بموقف بومبيو محاولًا أن يتخذ منه وسيلة للوصول إلى غايته، أي للوصول إلى القنصلية ومن ثم إلى الحكم المطلق.
نعود إلى الوقائع. عقب اقتراح كوريوني وافق مجلس الشيوخ بأغلبية عظمى: ثلاثمائة وسبعين ضد اثنين وعشرين. وهنا كانت الخطوة الفاصلة من جانب بومبيو، إذ دعا مجلس الشيوخ وطلب منه اعتبار قيصر عدو الشعب والسماح له بالقضاء عليه. على أن مجلس الشيوخ أظهر نوعًا من التردد اضطر إزاءه بومبيو أن يعلن بصراحة أنه إن لم يوافق مجلس الشيوخ على إعطائه السلطات المطلقة لحماية الجمهورية، فإنه سيضطر إلى التصرف دون الحصول على موافقة مجلس الشيوخ[41].
وبعد مناقشات طويلة انتهى قرار مجلس الشيوخ بأن دعا بومبيو لإنقاذ الجمهورية إزاء رفض قيصر الخضوع لتقاليدها الدستورية. غير أن بومبيو حاول أن يتصل بقيصر لإيجاد نوع من التوفيق بين الوجهات المتعارضة[42]. وهكذا أخطأ مرة ثانية، معطيًا لخصمه الفرصة للتلاعب في ظل عدم ثقته بنفسه، وإلى أي مدى يستطيع الاستناد إلى القوى الأرستقراطية. ترك قيصر بومبيو دون أن يطلعه على وجهة نظره، وغادر روما ليلحق بقواته، مصممًا -على ما يبدو- على أن يجعل السلاح هو الحَكَم بينه وبين بومبيو.
على أن قيصر، مثبتًا بهذا أصالة استراتيجيته السياسية، أراد أن يجعل من تباعده محاولة للتفريق بين بومبيو والطبقة المعتدلة من مجلس الشيوخ[43]. وهكذا أرسل خطابًا إلى مجلس الشيوخ عن طريق كاسيو، يذكّر فيه المجلس بما فعله من أجل الجمهورية وعظمة روما الخالدة، وبأنه على استعداد لتسريح قواته والتنازل عن القيادة بشرط أن يفعل ذلك أيضًا بومبيو، مضيفًا أن موقفه إنما هو خوفًا على حياته إن ترك قواته، حيث سيصير تحت رحمة أعدائه. وهكذا أحدث مرة ثانية نوعًا من الاضطراب بين أعضاء مجلس الشيوخ، الأمر الذي دعا بومبيو إلى تذكير المجلس بأنه إن لم يُصمِّم على الدفاع عن الجمهورية في الحال، وإن لم يتخذ موقفًا حازمًا من قيصر، فإنه لن يتدخل بعد ذلك في النزاع بين الجانبين[44].
وهكذا صدر قرار جديد يمنح بومبيو حق القيادة، محرومًا منه قيصر من أي صفة عسكرية، معلنًا أنه إن لم يُعِد قيصر سلطاته العسكرية إلى الجمهورية خلال فترة محدودة فإنه يصير عدوًا للجمهورية، ومن ثم يحل دمه. وقيصر، مرة ثالثة، يتلاعب بالطرفين، فيرسل إلى مجلس الشيوخ أنه على استعداد لتنفيذ طلباته بشرط أن يظل محتفظًا بفرقتين من قواته وفي جزء من بلاد الغال، وذلك فقط حتى الانتخابات القنصلية، ليترك للشعب الفصل في النزاع بين الطرفين[45].
وهنا يقف المؤرخون حائرين، يتساءلون عن مدى حسن نية قيصر في هذا الاقتراح. غير أن من يلمّ بحقيقة الاستراتيجية التي اتبعها قيصر للوصول إلى الحكم والقضاء على الجمهورية لا يجد صعوبة في تفسير موقفه أيضًا في هذه المناسبة. فقد اتبع قيصر دائمًا ما يُسمّى في الاستراتيجية السياسية تحديد الأوضاع المستقلة (في اصطلاحاتنا الفرنسية La détermination des positions indépendantes)، أي بعبارة أخرى أن يدفع خصمه إلى اتخاذ التصرف الذي يود هو حدوثه لأنه يتفق مع مصالحه، مكرِهًا بذلك خصمه على الدفاع في جبهتين. لم يكن قيصر حسن النية، وهو يعلم أن هذا سوف يضعف قضية بومبيو، إذ سيظهر أمام الشعب كعدو لا يقبل أي تغيير في نظام الدستور المتداعي[46]. هذا فضلًا عن أنه كان قد قرر من قبل أن يجعل السلاح الحكم في النزاع بينه وبين بومبيو، وهذا ما حدث بالفعل، إذ اجتمع مجلس الشيوخ وقرر اعتباره عدوًا للجمهورية ومعه كل من انضم إليه، ودعا بومبيو إلى تخليص الجمهورية من عدوها الذي لم يقبل الخضوع لنظمها وقواعدها الدستورية.
وبهذا بدأت الحرب المدنية التي لم يكن يمكن أن تنتهي إلا بالقضاء على الدستور الجمهوري، سواء في حالة انتصار بومبيو أو هزيمته[47]. كان النزاع في حقيقته بين بومبيو وقيصر: أيهما يجب أن يصير صاحب الحكم المطلق؟ قيصر ومن وراؤه حزب الشعب، أم بومبيو مستندًا إلى القوة الأرستقراطية؟ وعلى أي حال لم تكن هذه إلا خطوة أولى تنتهي بتفتيت نفس القوة التي يستند إليها الحاكم المطلق الجديد. وهذا ما حدث منذ أن وصل قيصر إلى الحكم، وما كان من الممكن أن يحدث غيره لو قُدّر لبومبيو النجاح في قتاله مع قيصر.
الفرع الثالث
التراث الروماني
١٥- تحديد مدلول الخبرة السياسية: مدلول الاستراتيجية السياسية وتطبيقها بخصوص النزاع بين قيصر وبومبيو، التعريف بثبات القواعد الدستورية، وظيفة الفلسفة السياسية: إحالة.
ما مدلول الخبرة الرومانية، بعد هذا العرض الموجز للوقائع والأحداث التي انتهت بالقضاء على الدستور الجمهوري؟
الواقع أن هذه الأحداث توجهنا وجهات ثلاث، كلٌّ منها له مغزاه في تحديد القيم التي يقوم عليها التطور الفعلي للوقائع السياسية[48]. الأولى تتعلق بالعلاقة بين الفلسفة السياسية والنظم السياسية. إلى أي حد يجب أن تتحدد تلك العلاقة؟ وما هي وظيفة الفيلسوف السياسي إزاء النظم التي تتحدد وتتطور أمام عينيه؟ هل يجب أن يتدخل بفكره وفلسفته، الأمر الذي يسمح له بأن يتجرد عن المصالح الشخصية التي تدفع ذلك الفريق أو ذلك الفريق الآخر لاتخاذ مواقف معينة إزاء الأوضاع المتطاحنة؟ وإن تَدخَّل، فهل لتدخله حدود؟ وكيف يمكن إقامة تلك الحدود التي يجب أن يراعيها الفيلسوف السياسي حتى لا ينتقل من التفكير إلى الحركة؟ هذا سوف يقودنا إلى الحكم على شيشرون وعلى موقفه وتحديد مسئوليته إزاء انهيار الدستور الجمهوري[49].
الناحية الثانية التي تثيرها الدراسة السياسية لتطور النظام الجمهوري الروماني تتعلق بتحديد معنى ثبات النظم الدستورية. لقد جرت عادة فقهاء القانون أن يُحدثونا عن قدسية النظم الدستورية، والدراسة السياسية تبين لنا كيف أن ذلك الثبات وتلك القدسية يجب أن يتصفا بصفة النسبية. فالدستور يجب أن يتصف بصفة الثبات، ولكن مع ملاحظة أن تلك الصفة يجب أن ندخل فيها عنصر الزمان temps والظروف circonstances = conjoncture. يجب أن تكون قاصرة على الفترة القصيرة، أما إن طالت الفترة، فعلم السياسة يحدثنا بأن الظاهرة السياسية ظاهرة ديناميكية، وأن النظام الدستوري إن هو إلا الغشاء أو الإطار للقوى السياسية، يتسع ويضيق، ويتغير في معالم تحديده تبعًا لتغير القوى السياسية وتطورها التي يضمها ذلك الإطار[50]. وهذا يقودنا إلى إجراء نوع من المقارنة بين الدستور الروماني والدستور البريطاني، أعظم دستورين عرفتهما الجماعات المتطورة، لنتساءل: ما أسباب نجاح الثاني حيث أخفق الأول؟
أما عن تغيير الظروف، فيُقصد بذلك أن الدستور الذي يولد ويتحدد في لحظة من لحظات الظروف الاستثنائية يجب أن يكون مقيدًا بظروف تلك اللحظات الاستثنائية، وسوف نتعلم هذه الحقيقة عن طريق دراستنا لدستور سيلا، لِنلمس عبقرية ذلك الحاكم الروماني الذي استطاع أن يفهم أن دستور الثورة لا يمكن أن يكون إلا مؤقتًا[51].
بقي أن نتساءل: ما مدلول الاستراتيجية السياسية كما يمكن أن نفهمها على ضوء تصرفات قيصر؟ وهذا يقودنا إلى وضع المبادئ العامة التي تحكم نظرية الاستراتيجية السياسية والتمييز بين أنواعها: من استراتيجية مواجهة، واستراتيجية بطريق التسلل، وأخرى بطريق الانسياب واحتلال النقط الضعيفة، والأخيرة بطريق الالتفاف[52].
هذه النواحي الثلاث نعود إليها مستقبلًا، كلٌّ منها على حدة.
لتحميل ملف الدراسة كاملًا
* مستخرج من مجلة القانون والاقتصاد التي يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة -العدد الرابع- السنة الثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة 1960م.
** الدكتور حامد عبد الله ربيع (1925–1989) مفكر وأكاديمي مصري بارز، يُعَدّ من رواد الفكر السياسي والدراسات الإسرائيلية في العالم العربي. جمع بين التعمق في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بحصوله على خمس شهادات دكتوراه من جامعات أوروبية مرموقة، وتولّى التدريس في جامعات مصرية وعربية وغربية. أسس مراكز بحثية وأكاديمية مهمة، وأسهم في إدخال الدراسات الصهيونية إلى الجامعات المصرية. حين قدّم د. حامد ربيع هذه الدراسة كان أستاذًا حرًا في الشرائع القديمة بجامعة روما، وأستاذًا مساعدًا في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وملحقًا بالمركز الفرنسي للأبحاث العلمية. عُرف بتمسكه بالهوية الحضارية الإسلامية مع انفتاحه على دراسة الغرب نقديًا، وترك عشرات المؤلفات في الفكر السياسي، والأمن القومي، والصراع العربي الإسرائيلي. توفي في القاهرة عام 1989 في ظروف وُصِفَت بالغامضة.
[1] كذلك ديمارتينو، المرجع السابق الإشارة اليه، الجزء الثالث، ص 114.
[2] انظر تفاصيل ذلك في مؤلفنا عن فلسفة السياسة، تحت الطبع.
[3] راجع مؤلفنا عن حق الحرية ص ١١٧ وما بعدها.
[4] في مؤلفنا السابق ذكره عرض كامل وتفصيل للنصوص. انظر أيضا (باركر)، من الإسكندر إلى قسطنطين، ١٩٥٦، ص ١٨٥ وما بعدها.
[5] انظر الموسوعة الفلسفية، الجزء الثالث، ص ۱۸ وما بعدها.
[6] قارن "ميسكولين"، سبارتاكوس، ١٩٥٢، ص ۳۷۱ وما بعدها.
[7] انظر تلخيص ذلك في الديمارتينو، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ۱۲۱، وما بعدها.
[8] راجع تفاصيل ذلك في مؤلفنا السابق الإشارة إليه، وانظر أيضا «ستراسبورج»، الأخبار في الموسوعة الكلاسيكية، الجزء الثامن عشر، ص ۷۷۳ وما بعدها.
[9] «فيرسوبسكي»، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ٦٤ وما بعدها.
[10] قارن «باريتي» المرجع السابق الإشارة إليه، الجزء الثالث، من ١٣٩ وما بعدها.
[11] سوف نعود إلى ذلك فيما بعد في المبحث الثالث من الفرع الثالث.
[12] يذكر هذه الواقعة أيضا كروزيه، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ۱۳۱.
[13] انظر تفصيل ذلك في فوكت، الجمهورية الرومانية، الطبعة الألمانية، ص ٢٢٥.
[14] مومسن، تاريخ روما، الجزء الثالث، الطبعة السويسرية، ١٩٥٤، ص ٦٦٦.
[15] يدافع عن شيشرون أستاذنا «بريلو»، تاريخ النظريات السياسية، 1959، ص ۱۱۳ وما بعدها. على أننا أقرب إلى (كاركوبينو) رغم تحامله الواضح. انظر رسالتنا السابق الإشارة إليها ص ۲۲۷ وما بعدها.
[16] انظر مؤلفنا في مقدمة السياسة، ١٩٦١، الكتاب الأول.
[17] انظر سايم في تفصيل ذلك، الثورة الرومانية، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ١٥١ وما بعدها.
[18] راجع أيضا «كليزل»، الحرية، ١٩٣٥، ص ٤٣ وما بعدها.
[19] قارن (انسلين)، الديمقراطية في روما، في المجلة الفيلولوجية الألمانية ۱۹۲۷، ص ۳۲۷ وما بعدها.
[20] قير سوبسكي، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ۱۱۳ وما بعدها.
[21] قارن (توشار)، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ٦٧ وما بعدها
[22] الجزء السادس، الفصل الحادي عشر، الفقرة الرابعة.
[23] الجزء السادس، الفصل الثامن عشر، الفقرة الأولى.
[24] فريتز، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ٨١٤ وما بعدها.
[25] انظر عرضا لذلك بالتفصيل في مؤلفنا السابق الإشارة اليه ص ۲۲۷، وما بعدها.
[26] (سابين)، تاريخ النظرية السياسية، الترجمة الإيطالية، ١٩٥٥، ص ١٣٢ وما بعدها. قارن أيضا «كارليل»، تاريخ الفكر السياسي في العصور الوسطى، الجزء الأول، ۱۹۵۰، ص ٦ وما بعدها.
[27] انظر (ليبوريه)، الأمير في فكر شيشرون ١٩٥٤. ص ٢٧٤ وما بعدها.
[28] الجمهورية، الجزء الأول، الفصل الخامس والثلاثون، الفقرة الرابعة والخمسون.
[29] الجمهورية، الجزء السادس، الفصل الرابع والعشرون، الفقرة السادسة والعشرون.
[30] قارن تاريخ كمبردج القديم، المرجع السابق الإشارة إليه، الجزء التاسع، ص ٣٢٤.
[31] «پريلو»، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ۱۱۹.
[32] (توشار)، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ۷۷ وما بعدها.
[33] قارن (سكولارد)، المجلة الكلاسيكية الانجليزية، ١٩٥٥، ص ٣٠٠.
[34] قارن (قولك مان)، المجلة الألمانية للقانون الروماني، ١٩٥٥، ص ٥٣٩.
[35] سوف نعرض لذلك فيما بعد بالتفصيل، قارن مومن المرجع السابق الإشارة إليه، الجزء الأول، ص ٤٧٨.
[36] Consul Sine collega
[37] انظر (تيت ليف)، الكتاب السابع والثلاثون، الفصل الحادي عشر، الفقرة التاسعة والثلاثون.
[38] قارن تايلور، الاحزاب السياسية في عهد قيصر، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ١٤٩.
[39] قارن تعليق ديمارتينو، المرجع السابق الإشارة إليه، ص ١٧٤ وما بعدها.
[40] قارن (روبنسون)، انيتوكوس ملك العبيد، ۱۹۲۰، ص ۱۷۵ وما بعدها.
[41] انظر تفاصیل (پاریتی)، المرجع السابق الإشارة إليه، الجزء الرابع، ص ۳۹۷ وما بعدها.
[42] قارن (ابيانو)، الجزء الثاني، الفصل الواحد والثلاثون، الفقرة المائة والعشرون.
[43] راجع (ميير) الملكية القيصرية، ١٩٤٧، ص ۲۷۳ وما بعدها.
[44] يذكر ذلك شيشرون في إحدى رسائله إلى أسرته، الجزء السادس، الرسالة السادسة، الفقرة الخامسة ويعلق عليه في رسالته إلى صديقه (أتيكوس)، الجزء الثامن، الرسالة الحادية عشرة، الفقرة الثامنة.
[45] قارن ميير، المرجع السابق الإشارة إليه، ص 309.
[46] سوف نعود إلى ذلك في المبحث الثالث من الفرع الثالث.
[47] هكذا يقول «ديون كاسيوس»، الكتاب الأربعون، الفصل السادس والستون، الفقرة الخامسة.
[48] راجع مقدمة السياسة، المرجع والموضع السابق الإشارة إليهما.
[49] انظر تعليق (جلزر)، قيصر، ۱۹۳۷، ص ۲۱۱ وما بعدها.
[50] قارن مؤقتا پوردو، طرق البحث في علم السياسة، ١٩٥٩ ص ٦٧، وما بعدها.
[51] راجع ديمارتينو، المرجع السابق ذكره، ص ٦٢ وما بعدها.
[52] قارن (تومبسون)، الواقعية السياسية، ١٩٦٠، ص ٩١ وما بعدها.