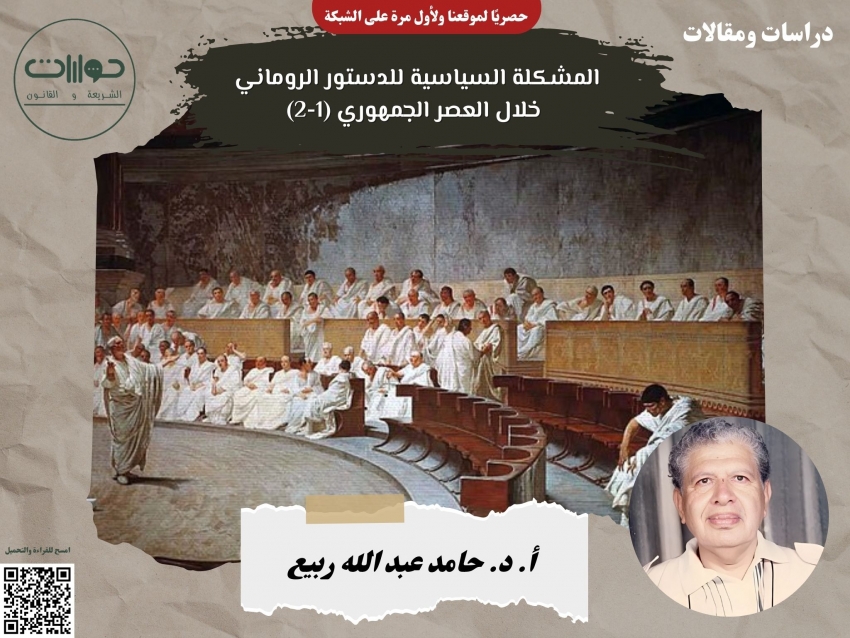الخلاصة - القانون الروماني والتطور المعاصر لدراسته من الدراسة الوضعية للنظام إلى التحديد الفلسفي للخبرة. نتائج الاتجاه المعاصر وأهميته بالنسبة للعلوم السياسية: (أولًا) الإطار النظامي للدساتير الحديثة (ثانيًا) الميدان الواقعي للتطبيق العملي لنتائج الخبرة السياسية- موضوع هذه الدراسة: مثال للتطور الدستوري من حيث علاقته بالقوى السياسية وأثر ذلك في تدهور الصورة النظامية للدولة.
1 - القانون الروماني والتطور المعاصر لدراسته- من الدراسة الوضعية للنظم إلى التحديد الفلسفي للخبرة:
حتى وقت قريب، كانت النظرة إلى القانون الروماني تقوم على أساس التمييز بين ناحيتين، كل منهما مستقلة عن الأخرى تمام الاستقلال: الأولى وضعية، والثانية تاريخية. الأولى تُعنى بدراسة النظم القانونية التي عرفها الرومان، سواء من حيث نشأتها وتطورها أو من حيث صياغتها وتطبيقها[1]. ومصدر هذه النظرة للقانون الروماني هو اعتبارات عملية سادت في فرنسا (بلاد القانون المكتوب)، وكذلك في ألمانيا (حيث عُرف ما يسمى بالاستعمال الحديث للموسوعة usus modernus Pandectarum)، حيث قُدّر للقانون الروماني أن يُطبّق بطريق مباشر[2]. وقد ترتب على ذلك، بصفة خاصة في ألمانيا – حيث ظل القانون الروماني نافذًا حتى نهاية القرن التاسع عشر – أن نشأت وازدهرت تلك الدراسة الوضعية التي كانت تُجرّد القانون الروماني من عنصر التطور، ونتصوره جامدًا، سواء من حيث نظمه أو من حيث كيانه كوحدة تُمحى فيها ذاتية المقومات القانونية.
أما الناحية الأخرى، فهي تتناول القانون الروماني من حيث كونه خبرة سياسية، وترفض – تبعًا لهذا – سواء التحديد الكمي أو الكيفي، أي سواء التحديد من حيث الشطر القانوني أو من حيث المرحلة التاريخية. هذه النظرة ترجع من حيث مصدرها إلى النظرة الإنسانية (humanisme) التي تعود إلى العصور الوسطى، على أنها لم يُقدّر لها الازدهار إلا في خلال النصف الثاني من القرن العشرين[3].
نظرة وضعية إذاً تقابلها نظرة تاريخية: الأولى محددة من حيث الموضوع، والثانية عامة؛ الأولى نسبية، والثانية مطلقة؛ الأولى تبحث عن الصياغة، والثانية تحدد المعنى والجوهر.
على أن كلتا هاتين النظريتين ظلّتا منفصلتين، كل منهما عن الأخرى. وإذا استثنينا بعض المجهودات الفردية، فإن أحدًا لم يحاول أن يجمع بين الدراسة التاريخية والدراسة الوضعية للقانون الروماني[4]. صحيح أن إهرينج حاول، في مؤلف لا يزال خالدًا في علم القانون باسم روح القانون الروماني، أن يبحث عن الأسس العامة التي حكمت التطور التاريخي للنظم الرومانية[5]، إلا أنه لم يتعدَّ في تلك الدراسة المرحلة الأولى من مراحل تطور الحضارة الرومانية. ويمكن القول إن محاولة جمع الناحيتين في دراسة تلخيصية، الغاية منها الكشف عن معنى ومدلول النظم، لم يقم بها في معناها العلمي الصحيح إلا العالم الألماني الأصل شلذ (Schulz) في مؤلف له بعنوان مبادئ القانون الروماني، حيث حاول أن يعرض لنا المبادئ الفلسفية[6] التي حكمت تطور النظم القانونية لدى الرومان، مقدمًا بذلك أصول علم جديد باسم «فلسفة القانون الروماني».
على أن شلذ عندما وضع أسس تلك الدراسة، لم يكن يتصور مدى الأهمية التي سوف تُقدَّر لهذه الصورة الجديدة من صور التطبيق الفكري لدراسة الحضارة الرومانية. فهو لم يكن يقصد سوى التجديد في دراسة القانون الروماني، في فترة لم يكن من الممكن فيها أن تستمر تلك الدراسة على وضعها القديم: عبادة للأصنام في عهد لم تعد فيه العقلية البشرية تستسيغ أو تقبل، بحكم الوعي الاجتماعي، أوضاعًا معينة.
۲ - نتائج الاتجاه المعاصر وأهميته بالنسبة للعلوم السياسية:
(أولًا) الإطار النظامي للدساتير الحديثة. (ثانيًا) الميدان الواقعي للتطبيق العملي لنتائج الخبرة السياسية.
ودون التدخل في التفاصيل الخاصة بنتائج هذا الاتجاه المعاصر سواء من حيث دراسة القانون الروماني[7] ذاتها (حيث تتجه في الوقت الحاضر للاختفاء) أو من حيث مدلول النظم الرومانية[8]. (باعتبار أنها ليست صياغة فقط) فان علم السياسة تأثر بهذا الاتجاه من ناحيتين:
(الأولى) من حيث الإطار النظامي للدساتير الحديثة، ويُقصد بذلك أن هذا البحث الفلسفي[9]، لا يقف عند الصورة النظامية للحقيقة القانونية فحسب، بل يتعداها إلى دراسة المعنى الخفي المستتر خلف الخبرة الوضعية، بعد إلغاء عنصري المكان والزمان. وقد مكّن ذلك علماء السياسة من الوقوف على كيفية تأثر الدساتير الحديثة، في أكثر من مناسبة وبطريقة غير مباشرة، بالحضارة الرومانية.
ويكفي أن نذكر، على سبيل المثال، كيف أن مونتسكيو حين عرض نظريته حول الفصل بين السلطات، كانت ماثلة أمام عينيه صورة النظام الروماني القائم على أساس التعدد، والتمييز النوعي، فضلًا عن التخصص في الهيئات ذات السلطة الواحدة[10].
(الثانية) من حيث تطبيق نتائج الدساتير الوضعية لظاهرة السلطة، وذلك أن الغاية الأساسية من علم السياسة هي استخلاص القوانين العامة التي تخضع لها تلك الظاهرة من حيث نشأتها وتطورها[11]. على أن هذه القوانين، مهما بلغت من دقة، لا بد من قياسها من حيث الصحة والنطاق في المدلول التطبيقي. والحضارة الوحيدة التي يجمع العلماء على أنها تصلح لذلك هي الحضارة الرومانية، وذلك لأسباب متعددة: فمن جانب، هي حضارة متطورة (أي جماعة تملك حضارة تتجه إلى السيطرة civilisation de domination)، ومن جهة أخرى استطاعت منذ أوائل حياتها أن تميز بين الدين والدولة (منذ نهاية العهد الملكي أو على الأقل منذ القرن الرابع قبل الميلاد)، وهي، من جانب ثالث، جمعت بين المتناقضات الحضارية؛ حضارة رأسمالية منذ القرن الثاني قبل الميلاد وحتى القرن الأول بعد الميلاد، وحضارة دينية تتجه إلى الكلية في آن واحد (بصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة من فترات تطورها الإمبراطوري عقب عام 212 بعد الميلاد) [12]. هذا، إلى أن الحضارة الرومانية تمتاز عن غيرها من الحضارات القديمة بأنها تقدم لنا سجلًا كاملًا موثوقًا به من حيث الصحة التاريخية للوقائع التي أثرت في تطور الحياة والقوى السياسية[13].
3- موضوع هذه الدراسة: مثال للتطور الدستوري من حيث علاقته بالقوى السياسية وأثر ذلك في تدهور الصورة النظامية للدولة:
غايتنا من هذه الدراسة هي تقديم مثل لتلك الخبرة الواقعية التي يسعى علم السياسة إلى الكشف عنها وتحديد مدلولها وترجمتها في صياغة علمية يسميها رجال المنطق الارتباط الدالي: correlation fonctionnelle. والسؤال الذي سوف نضعه لنحاول أن نجيب عليه ونحدد عن طريق تلك الإجابة التغيرات المقترنة (variations concomitantes) التي سوف تعيننا على التحديد الصياغي لنتائج تلك الخبرة هو: لماذا أخفق الدستور الروماني خلال الفترة التي تمتد من أوائل القرن الثاني حتى نهاية القرن الأول قبل الميلاد، هذا الإخفاق الذي أدى بالجماعة الرومانية إلى الانتهاء بالنظام الجمهوري إلى الاختفاء والعودة إلى نظام الحكم المطلق[14].
ولنستطيع أن نصل إلى حقيقة الخبرة السياسية لدى الرومان، يتعين علينا أن نعرض لذلك في أقسام ثلاثة: فيجب أولًا أن نتناول دراسة سريعة عرضًا نظاميًا للدستور الروماني، وعن هذا الطريق سوف نحدد المسألة السياسية التي كان على الفكر الروماني أن يواجهها، لنختتم بحثنا بتحديد العلاقة بين التطور النظامي والتطور الواقعي للقوى السياسية ومدى أثر ذلك في القضاء على الدستور الجمهوري[15].
من ثم سوف نتناول هذه المشكلة في أقسام ثلاثة:
(أولًا) الدستور الروماني[16] في كثرة الحروب المدنية خلال القرن الأول قبل الميلاد.
(ثانيًا) النزاع بين حزبي الأخيار والشعب وأثره في التطور الوظيفي للدستور الروماني.
(ثالثًا) تحديد مدلول الخبرة السياسية الرومانية.
الفرع الأول
الدستور الروماني في فترة الحروب المدنية
الخلاصة: التعريف بالدستور الروماني – خصائص تطوره، إحالة – النظام السياسي في العصر الجمهوري، محاولة إصلاح النظام الجمهوري خلال القرن الثاني قبل الميلاد وخصائصه العامة، إخفاقها – انهيار النظام الجمهوري خلال النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد والعودة إلى نظام الحكم المطلق.
4- التعريف بالدستور الروماني- خصائص تطوره، إحالة:
لم يعرف الرومان كلمة الدستور بمعنى وثيقة سياسية تعبر عن آمال شعب معين أو تنظم أوضاعًا معينة لتحدد العلاقة بين الفرد والدولة أو بين السلطات المختلفة داخل الدولة ذاتها[17]. على أن ذلك لم يمنع من وجود مجموعة من القواعد التي كانت تنظم شكل الدولة وتحدد الأوضاع السياسية فيما يتعلق بالسلطات العامة، وصفها الرومان بأنها عادات الآباء (Mores Maiorum)، معبرين بهذا عن صفة القدسية من جانب، والدوام والاستقرار من جانب آخر. ولعل هذا يبرر كيف أنه، رغم التطورات المتعددة في النظام الدستوري من الملكية إلى الجمهورية إلى الإمبراطورية، لا يلحظ المؤرخ أي نوع من أنواع الاضطراب المفاجئ أو الانقلاب الثوري[18].
بطبيعة الحال، لن تحاول في هذه الصفحات القلائل أن تعرض بالتفصيل التطور التاريخي للدستور الروماني، وإنما سوف نحاول فقط عن طريق ذلك العرض أن تحدد المشكلة السياسية التي واجهتها الجماعة الرومانية خلال العصر الجمهوري، وبصفة خاصة خلال الفترة الزمنية التي حددناها من أوائل القرن الثاني حتى نهاية القرن الأول قبل الميلاد.
5- النظام السياسي في العصر الجمهوري وخصائصه العامة:
يمكن القول بأن النظام السياسي لدى الرومان قام على أسس ثلاثة: (أولًا) مبدأ سمو العنصر الروماني[19]، (ثانيًا) مبدأ المحافظة على القديم[20]، (ثالثًا) مبدأ الحرية داخل الإطار القانوني للجماعة[21]. فالروماني يحتقر جميع الشعوب، ورغم أن النظام القانوني للجماعة السياسية اتجه إلى استيعاب الشعوب الأخرى في بعض مراحل تاريخه، فهو لم يفعل ذلك إلا مكرها وتحت ضغط الظروف. والروماني في حقيقة شعوره لا يرى أي شعب آخر جديرًا باحترامه وتقديره، وهو يبالغ في ذلك ويتعدى حتى اليوناني. فإذا كانت الفلسفة اليونانية تحدثنا عن أن الشعب اليوناني توسط بين الشرقي الذكي والشمالي المحب للحرية المطلقة دون أي قيد، فإن الروماني لم يكن يرى في الشرقي إلا عبدًا، وفي اليوناني إلا مفكرًا أجوف، وفي الشمالي إلا متوحشًا لا يصلح للمدنية. وهو أيضًا يرى أن ما تركه الأجداد هو خير ما تستطيع أن تقدمه حضارة كائنة ما كانت، فالتقاليد لديه قوة رهيبة تفسر ذلك التمسك الأعمى بالقديم حتى ولو أضحى عديم المعنى. ولا توجد جريمة يمكن أن توجه إلى سياسي كالقول بأنه يسعى إلى التجديد، لأن هذا معناه في العرف الروماني الثورة على الأوضاع. وهو لهذا يفسر الحرية على أنها خاصية من خصائص الشعب الروماني التي يجب أن تكون مقيدة بالإطار القانوني للجماعة، وهي لذلك حرية شكلية أكثر منها واقعية، تقوم على أساس نوع من الزيف والبهتان أكثر منه من الواقع والحقيقة. وليس ذلك فقط لأن الحضارة الرومانية لم تقبل أن تخلط بين مبدأ المساواة ومبدأ الحرية، بل ولأنها أسمت الحرية بأسماء متعددة تبعًا لمركز كل فرد في الجماعة[22]؛ فهي تارة تسمى باسم libertas، وتارة أخرى تسميها النصوص باسم licentia، ثم تارة أخرى تعبر عنها بلفظ digniteas، وذلك لتضيق منها إن أرادت أو لتوسع من مدلولها إن شاءت.
على أننا إذا تركنا جانبًا تلك المبادئ العامة التي يمكن استخلاصها من التطور العام للدستور الروماني، وحاولنا أن نقصر بحثنا على الأهداف التي حاول أن يحققها الدستور الروماني في بدء مراحله وكيف تطور في تحقيق تلك المبادئ مواجها التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي صادفته الجماعة الرومانية، استطعنا أن نحدد الغايات التي حاول أن يحققها النظام الجمهوري بثلاثة: الأولى إقامة نوع من الرقابة على السلطة واستخدامها بحيث تمنع العودة إلى ذلك التعسف وتلك الإساءة التي عرفتها روما خلال المرحلة الأخيرة من مراحل التطور السياسي للنظام الملكي، الثانية محاولة تحطيم الفوارق العنصرية التي تفصل بين أقسام الجماعة الرومانية، الثالثة الاعتراف بقسط معين من الحماية للفرد إزاء طغيان السلطة الحاكمة[23].
وتأكيد هذه الغايات يتحقق لا عن طريق عرض ما احتواه الدستور الروماني من نظم، بقدر تحديد ما رفضه الدستور من مبادئ سياسية.
فأول فكرة يجب أن تظل راسخة في الأذهان هي أن الجمهورية الرومانية في أي مرحلة من مراحل تاريخها الديمقراطي لم تعرف فكرة التمثيل السياسي، وبصفة خاصة رفضت مبدأ السيادة الشعبية[24]. فالحضارة الرومانية حضارة قوة وسيادة، لم تكن تعترف للجماهير بأي سلطة فعلية في إدارة الدولة أو في توجيه سياستها، ولم تقبل في أي مرحلة من مراحل تاريخها أن تجعل من ذلك الرضاء الضمني أو المفترض أساسًا للسلطة أو للنظام السياسي. وليس علينا إلا أن نذكر بعض النظم لنتأكد من صحة هذا القول. فلم يكن من حق الشعب أولًا في أي هيئة من الهيئات الشعبية أن يناقش حكامه، كان عليه فقط أن يصوت بالإيجاب أو الرفض. أما أن يتدخل في مناقشة تفاصيل ما يُعرض عليه، فهذا ما لم يقبله النظام السياسي الروماني. أضف إلى هذا أن الشعب لم يكن يملك حق الاقتراح، وإنما الحاكم هو الذي كان يملك حق تقديم الاقتراحات التشريعية أو غيرها للشعب مجتمعًا في مجالسه العامة، ومن ثم كان يوصف الحاكم بأنه يملك حق التعامل مع الشعب[25]. ولم يكن يختلف الأمر حتى فيما يتعلق بتعيين الحاكم نفسه، فالحاكم الذي في طريقه إلى مغادرة السلطة هو الذي يقترح على الشعب اسم خلفه ليوافق أو يرفض، ومن ثم يقال: "الحاكم هو الذي يعين الحاكم". وفكرة القانون ذاتها كانت توصف بأنها اتفاق عام، أو بعبارة أخرى أنها اتفاق بين الحاكم وبين الشعب، وهذا يعني أن الشعب لم يكن يملك أي سلطة تشريعية[26].
والواقع أن الجماعة الرومانية ظلت دائمًا قائمة على أساس الاعتراف بالنظام الطبقي. وإذا كانت الجماعة اليونانية قد عرفت هي الأخرى نظام الطبقات، إلا أن الجماعة الرومانية بالغت في تطبيقه سياسيًا ودستوريًا إلى حد القول بأن جماعة أخرى في التاريخ لم تعرف نظامًا مثيلًا للنظام الطبقي الذي عرفته الحضارة الرومانية. وهي لم تكتفِ بأن ترفض فكرة أن الشعب مصدر السلطات، ولم تكتفِ بأن تجعل مبدأ المساواة مقيدًا في تطبيقه بالطبقة التي ينتمي إليها الفرد، فالنظام السياسي نفسه كان قائمًا على أساس تمييز الطبقة التي ينتمي إليها الفرد، محددًا تلك الطبقة بما يملكه كل مواطن[27].
وكذلك تلاحظ أن روما منذ القرن الخامس حتى عام 146 ق.م ظلت محتفظة بنظامها الدستوري القديم الذي عرفته، وهي في شكل المدينة-الدولة: فالمدينة التي اندفعت تغزو شبه الجزيرة الإيطالية لتحطم قرطاجنة، ثم لتحتل اليونان ومقدونيا وآسيا الصغرى، ثم إسبانيا، ظلت، لا من حيث شكلها السياسي فحسب، بل أيضًا من حيث نظامها الدستوري، محتفظة بنفس النظام الذي عرفته وهي مدينة بدائية في أول عصرها الجمهوري، محدودة النطاق ومحدودة المطامع[28]. وإذا كانت روما قد عرفت في تلك الفترة إلى حد ما نوعًا من الديمقراطية السياسية، فإن الهيئة التشريعية لم تكن مكونة، ولم تكن تمثل إلا عددًا محدودًا وضئيلًا من الشعب الروماني. فأهالي الأقاليم لم يكن عليهم إلا أن يخضعوا وينفذوا، وحتى في داخل روما ذاتها كانت فقط طبقة الأشراف هي التي تحكم وتوجه فعليًا سياسة الدولة. صحيح أن هذه الطبقة، طبقة الأشراف، اتسعت رويدًا رويدًا، ولكنها لم تتسع إلا لتضم عناصر جديدة ترى ضرورة استيعابها ورفعها إلى مرتبة الأشراف، لا لأن تنزل المرتبة العامة لتسوى بين الجميع في الحقوق السياسية.
تلك هي الناحية السلبية، فما هي الناحية الإيجابية في خصائص الدستور الروماني؟
حاول النظام الجمهوري أن يحطم التمييز العنصري الذي كان قائمًا بين طبقتي الشعب: طبقة الأشراف وطبقة العامة، الذي عرفته روما خلال العصر الملكي وحتى خلال الفترة الأولى في العصر الجمهوري السابقة على الثورة الكبرى. رغم أن أحدًا لا يعرف سببًا لهذا الانقسام، إلا أنه مما لا شك فيه أن مصدره عنصري بحت؛ وقد قام النظام الجمهوري على أساس محاولة التسوية بين الطبقتين من حيث الحقوق السياسية والحقوق الخاصة. على أن الذي يجب أن تتذكره هو أن تلك المساواة لم تكن تعني المساواة المطلقة[29]، ذلك أن التمييز بين طبقة الأشراف وطبقة العامة كان أساسه الناحية العنصرية، وقد حل محلها في النظام الجديد تقسيم أساسه الناحية الاقتصادية، ويجب أن نتذكر أنه سواء الأشراف أو العامة، كان كلاهما في الداخل يتكون من طبقات. هذا إلى جانب أنه يجب أن نتذكر أن النظام الجمهوري لم يحاول أن يحقق تلك المساواة إلا بعد فترة حكمت فيها فقط طبقة الأشراف عقب طرد الأسرة المالكة، وزعمت هذه الطبقة أن من حقها وحدها أن تكون نوعًا من الأرستقراطية الحاكمة تحل محل الملكية المطلقة، الأمر الذي اضطرت إزاءه طبقة العامة إلى أن تقود حركة ثورية جديدة كان سلاحها الفعال فيه هو الانفصال أو التهديد به، مما جعل الأشراف يسلمون تدريجيًا بالمساواة بين الطائفتين في أغلب الحقوق السياسية. ورغم أن المؤرخين لا يزالون حتى اليوم يقدمون هذه الثورة (أي ثورة عام 510 ق.م، طبقًا للتاريخ التقليدي) على أنها حركة ديمقراطية، إلا أنها من حيث طبيعتها كانت حركة توحيدية، بمعنى تحطيم الفوارق التي تفصل بين الجماعات، لا تحطيم الفوارق التي تفصل بين الطبقات، أو بعبارة أخرى أنها تمثل نهاية الجماعة الرومانية البدائية وبدء الجماعة الرومانية المتطورة[30]؛ الأولى مقسمة إلى جماعات مستقلة، والثانية جماعة موحدة. الأولى لا تحتاج للوحدة، والثانية في حاجة إلى الانسجام العضوي. ومنذ تحقيق ذلك الانسجام بدأ نوع من التحجير الهرمي يغلب على هيكل الجماعة الجديدة، أساسه فقط العامل الاقتصادي.
أما من حيث إقامة نوع من الرقابة، فإن الدستور الروماني لم يعرف فكرة توزيع السلطات، وإنما عرف تعدد الجهات التي تتولى السلطة الواحدة. فالسلطة التشريعية لم تكن فقط ملكًا للهيئات التشريعية. على العكس، كان القاضي أو ما يسمونه البريتور مشرعًا في نفس الوقت. كذلك كانت الهيئات الشعبية لها سلطات قضائية، والواقع أن الصفة الأساسية في النظام الجمهوري هي في ذلك التعدد بالنسبة لأولئك الذين حلوا محل الملك في حكم الدولة. هذا التعدد هو الذي كان يجعل الضمير الروماني يشعر بالارتياح، معتقدًا أنه يخلق نوعًا من الرقابة الدائمة الفعالة. ففي مكان الملك حل قنصلان يحكمان معًا الجماعة، على أنه من الخطأ الاعتقاد أن سلطة القنصل كانت تقل عن سلطة الملك، وفي هذا يقول «تيت ليف» بأن القنصل إنما كان ملكًا غير متوج. والواقع أن قاعدة التعدد هذه، فقط إلى جانب قاعدة القيد الزمني المعروفة، هي التي أوجدت نوعًا من التوازن بين اتساع السلطة من جانب وضرورة وضع قيد للتحكم الفردي من جانب آخر. فالتعدد كان يعني وجود قنصلين في آن واحد، كل منهما له نفس السلطات، وكل منهما يستطيع أن يعترض على قرارات زميله[31].
أما من حيث الحماية القانونية للمواطن، فنجد أن المشرع قد تدخل بإعلان ما يسمى بالحريات المدنية، والتي من مقتضاها أن المواطن من حقه في كل حالة يحكم فيها عليه بالإعدام أو بعقوبة مخلة بالشرف أن يلجأ إلى الشعب مجتمعًا في مجالسه العامة، مطالبًا بإعادة النظر في هذا الحكم، وأن من حق المواطن الذي يتأكد ضده الحكم بالإعدام أن يمنع تنفيذه بالنفي الاختياري[32].
هذه هي النظم التي قام على أساسها الدستور الجمهوري من حيث خصائصه كنظام متعارض مع النظام الملكي. فإلى أي حد حقق من -حيث تطوره التاريخي- الغايات التي أراد تحقيقها؟ من حيث النظام الداخلي، اتجه مجلس الشيوخ إلى خلق نوع من الأرستقراطية الحاكمة التي سبق أن عرفتها روما في نهاية العصر الملكي. مجلس الشيوخ من حيث أصله كان مجلسًا استشاريًا بحتًا يتولى تعيين أعضائه حكام المدينة، مقيدين في هذا بنوع من العرف الذي استقر منذ العهد الملكي، بحيث يدخل مجلس الشيوخ عادة كبار الحكام السابقين بعد أن يتركوا مقاليد الحكم. على العكس، اتجه مجلس الشيوخ إلى أن يسيطر تدريجيًا على جميع مسائل الحكم حتى أصبح هو القوة الحقيقية المسيرة للدولة. وفي داخل مجلس الشيوخ حدث نوع من التنظيم الطبقي بين أفراد مجلس الشيوخ ذاته، حتى إن بعض هؤلاء كان لهم حق المناقشة والكلام، والآخرون لم يكونوا يملكون ذلك. وهذا التقسيم لم يكن مصدره أي تنظيم تشريعي، وإنما نوع من العرف الذي يجد جزاءه في قوة اقتصادية، مردها الوحيد الاتجاه الرأسمالي الذي أصاب الجماعة الرومانية نفسها. وبسبب الحروب الكثيرة التي شنتها روما، قضى تدريجيًا على الطبقة الوسطى، بينما ازدادت غنى الطبقة العليا بحيث كونت أرستقراطية رأسمالية حقيقية بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من معانٍ. ومن ثم فقد أصبح مجلس الشيوخ تمثيلًا سياسيًا فعليًا لطبقة معينة، يدافع عن مصالحها وينفذ سياستها، أو بعبارة أخرى تحول النظام الجمهوري من حيث طبيعته إلى نظام أوليجاركي أو حكم الأقلية.
أما من حيث سياسة الاستيعاب، فنجد أن روما التي كانت قد استطاعت أن تحقق نوعًا من التفتيت للعناصر المتعددة وطحنها لخلق جماعة متجانسة، لم تعد قادرة على أن تؤدي نفس الوظيفة: فروما السابقة التي استوعبت العناصر الأتروسكية، والتي قضت على الفوارق بين طبقة العامة وطبقة الأشراف، في عهدها الجمهوري، وبصفة خاصة في فترة ازدهار النظام الرأسمالي، لم تحاول أن تستوعب العناصر الجديدة داخل نظامها السياسي. بنت سياستها على استبعاد واستغلال هذه العناصر، التي كان مقدرًا لها بسبب سياسة التوسع والفتح أن تدخل في نطاق الجماعة الرومانية، حتى بالنسبة لنفس العناصر التي تشترك مع الجماعة الرومانية من حيث الأصل اللاتيني. وأضحى حكم الأقاليم المفتوحة وسيلة تسمح لكبار الطبقة الحاكمة بالحصول على المال من طريق غير مشروع، أساسه الاستغلال الاستعماري، وكانت نتيجة ذلك أن بدأ النظام الدستوري يتصدع. فهو من جانب وضع ليواجه حاجات روما عندما كانت محدودة الاتساع ومحدودة عدد السكان، ومن جانب آخر لم يكن موضوعًا ليواجه سياسة رأسمالية معينة[33]. واليوم، وقد أصبحت روما دولة كاملة بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من معانٍ، كان عليها أن تجدد في دستورها لمواجهة الحقيقة السياسية الجديدة، ولكن هناك طبقة معينة تجد من مصلحتها الدفاع عن النظام القائم والتمسك به (statu quo) لأنه يسمح لها بتحقيق مآربها. ففي ظل نظام مقفل، من السهل الاستغلال بدعوى المحافظة على القديم، ولو تطور مثل هذا النظام ليقبل عناصر جديدة، تدعي نفس الحقوق، لكان معنى ذلك تسرب قوى جديدة تسمح بتوازن ليس من مصلحة الطبقة الحاكمة وجوده.
6- محاولة اصلاح النظام الجمهوري خلال القرن الثاني قبل الميلاد وإخفاقها:
على أنه لا يصح أن نعتقد بأن الرومان أنفسهم لم يتنبهوا إلى ضرورة إصلاح هذا الوضع الذي ترتب على وجود نوع من الخلف بين الصورة الشكلية للنظام السياسي والقوى الاجتماعية التي تستتر خلف تلك الصورة النظامية. وإذا كانت المصادر تحدثنا عن محاولة الإصلاح من جانب الأسرة الجراكية، فمما لا شك فيه أنه أيضًا قبل تلك المحاولة وجدت فكرة تغيير النظام الدستوري الروماني في دائرة شيبيون الإفريقية. ويذكر لنا بهذا الخصوص شيشيرون كيف وقفت الأرستقراطية الرومانية ضد محاولات قاهر هانيبال خلق إمبراطورية عالمية تعيد الصورة التي عرفتها الحضارة القديمة في عهد الإسكندر الأكبر. وإذا كنا نعلم عن طريق شيشيرون أن الفيلسوف باثيتيوس أثر تأثيرًا ضخمًا على شيبيون، فإننا نعلم أيضًا من أكثر من مصدر أن فكرة إنسانية نبتت وترعرعت في هذا الوسط المتأثر بالحضارة الإغريقية[34]. وقد جرى المؤرخون على أن يروا في محاولة شيبيون رجوعًا إلى النظام الملكي وإلغاء للنظام الجمهوري. ولكن الواقع أن خلف محاولة شيبيون الأفريقي يجب أن تتلمس أول مظاهر إقامة دولة لا ذات نظام مقفل للحكم، وإنما ذات نظام، ولو أنه تصاعدي من حيث السلطة، إلا أنه مفتوح من حيث الوصول إلى السلطة. فالنظام الروماني القائم على أساس حكم الأقلية بدعوى الجمهورية ما كان ليقبل مثل هذا النظام المشبع بالأفكار الإغريقية في صورتها الهيلينية.
على أن المحاولة الحقيقية التي أخذت صورة دستورية، رغم إخفاقها، بدأت (جراكوس الأكبر - تي بريوس) وانتهت بأخيه (بعد قتل هذا الأخير) «كايوس»، الذي صادف بدوره نفس النهاية عام 121 ق.م. كلاهما كان مؤمنًا بأن الدستور الروماني في وضعه الذي وصفه لنا بوليب لم يكن يستطيع مواجهة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أصابت الجماعة الرومانية[35].
بدأت تلك المحاولات «تي بريوس» بقانون تحديد الملكية الزراعية، وكانت الغاية الحقيقية منه إعادة خلق طبقة وسطى لإقامة نوع من التوازن بين الطبقة الأرستقراطية فاحشة الغنى والطبقة الثالثة عظيمة الفقر. لا تعنينا تفاصيل هذا القانون الذي يثير الكثير من نقاط الاستفهام حتى اليوم، ولكن الذي نود أن نؤكده هو أن المبادئ التي قامت عليها حركة الإصلاح لم تكن إلا ترديدًا للمبادئ القديمة التي عرفتها روما الجمهورية في مرحلتها الأولى: مبادئ بطبيعتها محافظة لا تريد إلغاء الدستور الجمهوري، وإنما تجديد النظام الديمقراطي، تجديدًا يعني تقوية الجهاز الحكومي في سبيل الصالح العام وليس في سبيل طبقة معينة وهي الطبقة الأرستقراطية. المثل الأعلى الذي دافع عنه «جراكوس» يذكرنا لا بما سوف نراه فيما بعد من مبادئ متطرفة سوف يقول بها (كاتيلينا)، وإنما هو ترديد لما نعرفه عن «فارون» ومن قبله «ليشينيو». وتحدثت النصوص عن كيف كانت تقبل الجماهير من جميع أنحاء إيطاليا بمجرد أن تسمع باسم هذا الزعيم لتؤيده وتناصره في محاولته الإصلاحية[36]. على أن (جراكوس)، الذي أراد أن يظل في محاولاته أمينًا على النظام الدستوري، انتهى بفقد حياته بعد أن نجح في فرض الإصلاح الزراعي، وحاول أن يضع حدًا للمشكلة الإيطالية، أي لمشكلة اشتراك الإيطاليين في ager publicus[37]. وسرعان ما أعقبه أخوه الأصغر (كايوس)، الذي حاول أن يعتمد على قوة الفرسان لخلق صورة جديدة من الديمقراطية قائمة على أساس القوة الاستعمارية للطبقة المتوسطة. رغم إخفاقه بدوره، إلا أن تلك الحركة توضح بشكل قاطع أمورًا ثلاثة:
أولًا- أن ما نقله إلينا بوليب عن وصف الدستور الروماني خلال تلك الفترة كدستور مثالي، إنما يعبر فقط عن رأي الطبقة الأرستقراطية، قسطه من التملق أكثر من قسطه من الحقيقة.
ثانيًا- أن هذه الحركة أنتجت خلق اتجاهين واضحين في الرأي العام: أحدهما يدافع عن الدستور القائم، والآخر يرفض ذلك الدستور ويطالب بتعديله وإصلاحه. وسوف يكون هذا الانقسام مصدرًا لحزبي الأخيار والشعب، اللذين سوف يتبلوران خلال القرن التالي.
ثالثًا- أن إخفاق الحركة الجراكية سوف يخلق تلك الكارثة التي سوف تنتهي بأن تجعل من الجيش القوة الوحيدة المسيطرة على علاقة التوازن بين القوى السياسية[38].
7- انهيار النظام الجمهوري خلال النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد والعودة إلى نظام الحكم المطلق:
لم تمضِ على قتل «جراكوس» عدة أعوام حتى ثارت إيطاليا بأجمعها على روما، تطالب بالمساواة بين أهالي إيطاليا والرومان، واندلعت الحرب التي استغرقت ثلاثة أعوام كاملة، انتهت بإصدار قانون يتساوى بمقتضاه جميع اللاتينيين من سكان إيطاليا مع روما في التمتع بالجنسية الرومانية. وكان هذا إيذانًا باندلاع قوى جديدة لم تكن حتى تلك اللحظة تشعر بمدى ما تستطيع أن تحصل عليه لو اتحدت فيما بينها[39].
والواقع أن النظام الدستوري الذي كانت قد عرفته الجمهورية الرومانية في أول حياتها لم يكن يستطيع أن يعيش في ظل نظام استعماري إلا إذا قام ذلك النظام على أساس إلغاء الحرية بجميع صورها، سواء كانت واقعية أو شكلية. وقد أبَت الجماعة الرومانية أن تعدل من نظامها لتسمح باستيعاب تلك الجماهير، منتهية بذلك إلى تحطيم حرياتها الدستورية، معيدة نظامًا تعسفيًا باسم حكم الأمير. وبعبارة أخرى، إن روما الأرستقراطية حاولت أن توفق بين مبدأين لم يكن من المستطاع أن توفق بينهما: مبدأ الوحدة بطريق التناسق الذي طبقته حينما أعطت جميع الإيطاليين حق الجنسية، ومبدأ السيادة بطريق الأصل، وهو الذي أرادت أن تحتفظ به عن طريق الدفاع عن الدستور الجمهوري[40].
وكان لابد وأن يُضحى بأحدهما إن أريد للآخر البقاء، على أن الأرستقراطية الرومانية لم تشعر، رغم خطورة الحال، بضرورة مواجهة الأوضاع بشيء من الواقعية التي كانت إحدى خصائص العقلية الرومانية في علاقاتها الخارجية. فالعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أوضحت مدى عمق الكارثة التي تنخر في الجماعة الرومانية ازدادت خطورة، والسياسة الرأسمالية أحدثت تركزًا متزايدًا للثروة في أيدي الطبقة الأرستقراطية في نفس الوقت الذي جعلت فيه الصدام بين الأرستقراطية النبيلة وبين طبقة الفرسان أمرًا لا مفر منه[41]. والمشكلة الزراعية من جانب آخر، التي كان قد واجهها "جراكوس" بالكثير من الحزم، لم تنتهِ بنتيجة فعلية، ومشكلة العبيد لم يقبل أحد أن يواجهها بأي نوع من الواقعية. حتى تلك اللحظة، لم تعرف السياسة الرومانية أي محاولة لتحرير العبيد، وذلك رغم الثورات المتعددة والمتعاقبة التي أبانت خطورة المشكلة: ثورة صقلية عام 104 ق.م، ثم الثورة التي قادها «سبارتاكوس» لم تكن إلا أمثلة لتطور خطير نحو قلب نظام الحكم، أو على الأقل نحو الانفصال عن القوة السياسية المحركة. كذلك المشكلة الإيطالية التي سبق أن رأينا كيف أنها كانت أساسًا محاولة لإقامة نوع من المساواة بين أهالي روما وبين اللاتينيين من أهالي شبه الجزيرة الإيطالية. وإذا كانت الحركة الإيطالية قد استطاعت أن تنتهي إلى إكراه الجماعة الرومانية على منحها الجنسية، فإنها لم تستطع أن تُكره تلك الجماعة على إصلاح الدستور بحيث يحمي الاستعمال الفعلي للحقوق السياسية لطائفة الإيطاليين[42].
لا يعنينا أن نبحث الأسباب التي من أجلها أخفقت الحركات الإصلاحية، رغم تعدد القوى السياسية التي كانت تستطيع بالتحالف بينها إكراه الأرستقراطية الرومانية على قبول إصلاح الدستور الروماني وإعطاء الجماعة صورة جديدة أكثر تطابقًا للقوى السياسية التي تبلورت خلال هذه الفترة. ومن العبث أن نقبل التفسيرات التي لا يزال الكثير من شراح الدستور الروماني يقدمونها، متأثرين بما أرسله إلينا المؤرخ "ساللست"، المعاصر للحروب المدنية، من أن ذلك التدهور لم يكن إلا نتيجة لفقد الجماعة الرومانية لمثلها الأعلى. والواقع أنه إذا صح أن الثورات لا تنجح إلا لضعف خصومها، فإن روما الجمهورية تقدم مثلًا واضحًا لصحة ذلك. فروما الضعيفة المتهالكة على نفسها ما كانت تدق ساعة الخطر، إلا والطبقة الأرستقراطية فيها متحدة متماسكة، لا تعرف التشقق ولا التصدع، بل الوحدة والتفاني في الدفاع عن مصالحها رغم أنانيتها. وهكذا نستطيع أن نفسر دستور (سيللا) كتعبير جديد عن مصالح الطبقة الأليجاركية[43].
على أن مصائب روما لم تنته عند هذا الحد. ففي خلال القرن الأول قبل الميلاد، عرفت روما ولأول مرة في تاريخها الجمهوري ظاهرتين: الأولى، التحايل على الدستور الجمهوري من جانب مجلس الشيوخ، الأمر الذي جعل الدستور الجمهوري يفقد كل قوة مستندة إلى ثقة الرأي العام؛ مثل ذلك إيقاف الدستور لمدة يوم، حتى يستطيع مجلس الشيوخ أن يعين قنصلًا لا تتوافر فيه الشروط اللازمة. والثانية، إنشاء جيش مهني بفضل إصلاح «ماريو»، الذي أوجد داخل الجماعة قوة جديدة متجانسة سوف يقدر لها، بفضل ذلك التجانس، أن تكون القوة الحاسمة في القضاء على نظام الحرية الذي عرفته روما حتى نهاية القرن الأول قبل الميلاد[44].
لتحميل ملف الفرع الأول من الدراسة
* مستخرج من مجلة القانون والاقتصاد التي يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة -العدد الرابع- السنة الثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة 1960م.
** الدكتور حامد عبد الله ربيع (1925–1989) مفكر وأكاديمي مصري بارز، يُعَدّ من رواد الفكر السياسي والدراسات الإسرائيلية في العالم العربي. جمع بين التعمق في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بحصوله على خمس شهادات دكتوراه من جامعات أوروبية مرموقة، وتولّى التدريس في جامعات مصرية وعربية وغربية. أسس مراكز بحثية وأكاديمية مهمة، وأسهم في إدخال الدراسات الصهيونية إلى الجامعات المصرية. حين قدّم د. حامد ربيع هذه الدراسة كان أستاذًا حرًا في الشرائع القديمة بجامعة روما، وأستاذًا مساعدًا في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وملحقًا بالمركز الفرنسي للأبحاث العلمية. عُرف بتمسكه بالهوية الحضارية الإسلامية مع انفتاحه على دراسة الغرب نقديًا، وترك عشرات المؤلفات في الفكر السياسي، والأمن القومي، والصراع العربي الإسرائيلي. توفي في القاهرة عام 1989 في ظروف وُصِفَت بالغامضة.
[1] المرجع الأساسي في هذه الناحية Biondi, Prospettive romanistiche, 1933. قارن أيضا من بين المراجع العديدة التي تتناول مشكلة القانون الروماني من حيث دراسته وتدريسه الجامعي:
Schwarz, Pandekent wissenschaft und hentiges rxomanistische Studium, 1928; Orestano, Introduzione allo studio storico del diritto romano, 1953.
[2] كذلك انظر:
Biondi, Il diritto romano 1958.
[3] Toffanin, La storia dell, umanesimo, 1950
[4] Lanye, Die Verarbeitung Klass. und Nachkl. Lehren in den mitt. Rechtswiss., in Zeitschrift der Savigny Stiftung fur Rechtsgeschichte, Rom. Abtheilung, 1955, Vol. LXXII pp. 211 as.
[5] قارن:
Schulz, Romun legal Science, 1934.
[6] الكتاب كان أصلا مجموعة من المحاضرات ألقاها العالم الألماني بجامعة برلين قبل أن يهاجر إلى بريطانيا العظمى، حيث أعاد نشر المؤلف عام ١٩٣٦؛Schulz, Prinzipien des romischen Rechts, 1934 : وقد ترجم أيضا إلى اللغة الإيطالية تحت اشراف أستاذنا ارانجو رويز عام ١٩٤٩.
[7] قارن:
Vool, Istituzioni di diritto romans, 1954.21.
[8] سبق أن تنبأنا في رسالتنا عام ۱۹۵۰ بعنوان Fasi di Svilippo dell ordina mento guridico romano: Nuovi orientamenti: وقد عدنا عقب ذلك إلى إيضاح موقفنا بتفصيل أكثر بخصوص مناقشة فقهية بمجلة Laboo عام ١٩٥٦ ص٢٣٧ وما بعدها.
[9] انظر أيضا رسالتنا:
Libertas: Rome å le recherche de Sor idéal politique, 1959.
[10] قارن موسكو، علم القانون وطرق البحث في علم القانون، ١٩٥٤، ص١٧ وما بعدها.
[11] في مؤلف لمونتسكيو بعنوان "اعتبارات حول أسباب عظمة وانهيار الحضارة الرومانية" نجد أول محاولة للجمع بين هاتين الناحيتين من نواحي العرض الفلسفي للنظم السياسية.
[12] قارن مؤلف (سبرانجر)، الثقافة، ١٩٢٦، ص۹۷ وما بعدها.
[13] انظر بهذا الخصوص مؤلف (تايلور): الاحزاب السياسية في فترة حكم قيصر، ۱۹۳۹، ص۱۷ وما بعدها.
[14] انظر (مينو)، مقدمة علم السياسة، ١٩٥٩، ص١٦١ وما بعدها.
[15] نفترض في القارئ إلمامًا كاملاً بالوقائع التاريخية. وعلى كلٍ نحيل في هذا الخصوص إلى (كروزيه)، التاريخ العام للحضارات، الجزء الثاني، ١٩٥٦، ص۱۰۲ وما بعدها.
[16] من العبث محاولة تقديم ثبت بأسماء المراجع التي يمكن الإحالة إليها بخصوص دراسة الدستور الروماني. ونكتفي بأن نقدم بعض التوجيهات العامة، تاركين التفاصيل لفرصة أخرى.
أول هذه الملاحظات أن الدراسة العلمية الصحيحة يجب أن تبدأ من المصادر المباشرة. ولدينا بخصوص هذه الفترة مصادر عديدة جديرة بكل تصديق وثقة. يجد القارئ ثبتًا بها وعرضًا نقديًا لها ولِما تضمنته من أخبار ووقائع في المؤلفات التاريخية العامة، وبصفة خاصة في مؤلف دي سانكنس (الجزء الأول)، وباريتو (الجزء الثالث)، وباربا جاللو (الجزء الثاني من تاريخ روما). ويستطيع القارئ أن يلجأ إلى مقال استانا أرانجو رويز التالي ذكره لفهم طبيعة هذه المصادر.
ARAN G10-RUIZ, La costituzione e la Sua Storia, in Gudio allo Studso della civilta romane,
Vol. 1, 1952, pp. 251 SS.
ثاني هذه الملاحظات أن الدراسات الفقهية للدستور الروماني نوعان: أحدهما نظامي، بمعنى أنه يتناول النظم المختلفة ويعرض لها بعد أن يُجرِّدها من إطارها التاريخي، مثل ذلك مؤلَّف مومسن الكلاسيكي عن القانون العام الروماني. والثاني تاريخي، بمعنى أنه يتتبع النظام الدستوري كوحدة كلية تضم المقومات الفرعية، وهذا هو الاتجاه المعاصر بصفة عامة في دراسة الدستور الروماني. مثل ذلك:
MEYER, Röm. Staat und Staate-gedanke, 1949.
آخر هذه الملاحظات أن مُلخَّصًا بالمراجع يمكن أن يُعتبر نقطة بدء كافية يجدُه القارئ في تاريخ النظم لزميلنا الفرنسي إليل:
ELLUL, Histoire des institutions, I, 1958, pp. 347 ss.
[17] كذلك «بيوندی»، القانون الروماني، ۱۹۵۸، ص۷۷ وما بعدها، قارن ص۱۲۸.
[18] انظر تفصيل ذلك في «شلذ»، مبادئ القانون الروماني، الطبعة الايطالية، ص٧٤ وما بعدها.
[19] انظر الإحالات المذكورة في المرجع السابق ص٩٦ وما بعدها.
[20] تناول هذا العنصر بالكثير من الايضاح «كاسر» في مقاله عن عادات الآباء بالمجلة الألمانية للقانون الروماني عام ۱۹۳۹، ص۸۹ وما بعدها.
[21] انظر تفصيل ذلك في رسالتنا عن الحرية في الحضارة الرومانية، ١٩٥٩.
[22] هذا العنصر تختلف فيه النظريات، راجع خلاصة لذلك في تعليق ه موملياني، بمجلة القانون الروماني الأمريكية عام ١٩٥٥، ص١٣٩ وما بعدها.
[23] ما نقوله في هذه الصفحات هو تلخيص القسم الأول من مؤلفنا عن الدستور الروماني، ميلانو عام ١٩٥٥.
[24] قارن (ديمارتينو)، تاريخ الدستور الروماني، الجزء الأول، ١٩٥١، ص١٦٣ وما بعدها.
[25] In's agendi cum populo
[26] انظر تفاصيل ذلك في (دیفرانششی)، تاريخ القانون الروماني، الجزء الأول، 1929، ص۳۲۷ وما بعدها.
[27] هذا هو التفسير الذي قدمناه في مؤلفنا من الحرية في الحضارة الرومانية، انظر أيضًا لمارتيني، تاريخ الدستور الروماني، الجزء الثاني، ١٩٥٥، ص۳۱۱ وما بعدها.
[28] انظر في أسباب اتخاذنا لعام ١٤٦ كحد فاصل بين المرحلتين: «جوارينو» تاريخ القانون الروماني، ١٩٥٤، ص۲۱۰ وما بعدها.
[29] انظر التفاصيل في (بيندر)، طبقة العامة، ۱۹۲۱، ص٤٧٨، وما بعدها.
[30] في هذا المعنى يتفق معنا (كروزيه)، المرجع السابق ذكره، ص۸۱ وما بعدها.
[31] (دیسانکتس)، تاريخ الرومان، الجزء الأول، ١٩٥٨، ص٣٩٨ وما بعدها. قارن جوارينو، تكوين الجمهورية في المجلة الدولية للشرائع القديمة، ١٩٤٨، ص٩٥ وما بعدها. وانظر «مومن»، قانون الدولة، الجزء الأول، ص۷۷ وما بعدها من الطبعة الألمانية.
[32] (بندر)، المرجع السابق الإشارة إليه، ص٥٦٢ وما بعدها. قارن (سيبر)، الاعتراض، في المجلة الألمانية للقانون الروماني، ١٩٤٢، وما بعدها، ص۳۸۱.
[33] (ديماريتنو)، تاريخ الدستور الروماني، الجزء الثالث، ١٩٥٨، ص٣٠، وما بعدها.
[34] (شولد)، مبادئ القانون الروماني، المرجع السابق الإشارة إليه، س ١٦٤ وما بعدها. قارن (جيونجي)، القانون الروماني، المرجع السابق الإشارة إليه، ص٦١٢، هامش رقم ٢.
[35] انظر تفصيل ذلك في مؤلف (فريتز)، نظرية الدستور المختلط في الحضارة القديمة، ١٩٥٤، ص۱۲۳ وما بعدها.
[36] انظر (دیللا كورت)، قارون، ١٩٥٤، ص۱۷۷ وما بعدها. وقارن الموسوعة الكلاسيكية تحت صوت نفس المؤلف.
[37] قارن التفاصيل في (فراکارو)، دراسات حول العصر الجراكاني، ١٩٤٧، ص١٤٥ وما بعدها. وقارن (مونسر) في المجموعة الكلاسيكية الجزء الثاني، ص١٤٢٠ وما بعدها. و(لاست) في تاريخ كمبردج القديم، الجزء التاسع، ١٩٥٤، ص٣٤ وما بعدها.
[38] في هذا المعنى (باريتي)، تاريخ روما، الجزء الثالث، ١٩٥٩، ص٦٢٥ وما بعدها.
[39] يعرض لهذه المشكلة بشيء من التفصيل (فير سوبسکی)، حق الحرية، ١٩٥١، ص۱۲۷ وما بعدها.
[40] انظر عرضا آخر للمشكلة الدستورية في (ايليل)، تاريخ النظم، ١٩٥٨، الجزء الأول، ۳۷۰ وما بعدها.
[41] قارن (مومسن)، تاريخ روما، الجزء الثاني، ص١٦٤ من الطبعة الألمانية.
[42] قارن (ابيانو)، الحرب المدنية، الجزء الأول فقرة ٣٦ وما بعدها... وراجع (نيكوليني)، قوانين الجنسية الرومانية في أعمال الأكاديمية الإيطالية، 1928، ص۱۱۰ وما بعدها.
[43] صورة غامضة في تاريخ الحضارة الرومانية رغم محاولات (ليفى) في مؤلفه عن سيللا، ١٩٢٤، ص۱۳۳ وما بعدها. وكذلك رغم مجهود (باكر) عن نفس الشخصية، ۱۹۲۷ ص۲۷۷ وما بعدها.
[44] انظر تفاصيل ذلك في (مونسير)، الموسوعة الكلاسيكية، الجزء الثاني، ص۱۸۱۲ وما بعدها، والجزء الثالث، ص٢٨٤٩ وما بعدها.