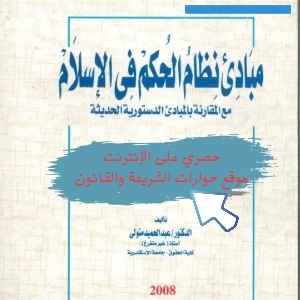حين بدأ الأوروبيون تكالبهم الاستعماري على إفريقيا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، كان الإسلام هو الدين السائد في نصف القارة الشمالي وساحلها الشرقي، وينتشر تدريجيًّا، ولكن بثبات، في اتجاه المناطق الداخلية، خاصة على طول طرق التجارة في شرق ووسط وغرب القارة، وبعد أكثر من نصف قرن من الاستعمار، وتحديدًا في نهاية ثلاثينيات القرن العشرين، ظلت تقديرات المستعمرين أنفسهم تشير إلى أن المسلمين يشكلون نحو نصف سكان القارة، وأنهم ما زالوا يسعون لنشر الإسلام في مناطق وجودهم، وأن تجربتهم المشتركة في العيش تحت حكم الاستعمار زادت من ترابطهم، فكيف تمكن المسلمون من مواجهة تحدي الاستعمار؟
التحدي الاستعماري
يخطئ من يظن أن الاستعمار لم يكن معنيًّا بقضايا الدين في بلاد إفريقيا المسلمة، فمنذ أن وطأت قدم الاستعمار أرض إفريقيا لم يتوقف عن دعم جمعيات التنصير في صراعها السياسي والاقتصادي ضد المسلمين، والذي كثيرًا ما أخذ أشكالًا عرقية ولغوية ومهنية، وحين كان المسلمون يتصدون لتلك الجمعيات، كان المستعمرون يتدخلون ضد المسلمين، ويوظفون ذلك الصراع خدمة لمصالحهم، ومع ذلك ظلت تلك الجمعيات تطلب المزيد وتنتقد سياسات الإدارات الاستعمارية؛ لأنها –في رأيها– لم تقم بما يكفي لمواجهة الإسلام.
ومن جهة أخرى، عمل الاستعمار على تنحية الشريعة الإسلامية، بوصفها الأساس القانوني في بلاد إفريقيا المسلمة، من خلال الإصرار على تطبيق مبادئ القانون الأوروبي في البلاد المستعمرة، والحرص على ألا تتعارض مبادئ القانون في هذه البلاد المستعمرة مع القوانين الأوروبية، في إشارة ضمنية إلى انحطاط الأعراف القانونية الإفريقية، على الأقل بالمقارنة بالمبادئ القانونية الأوروبية.
وقد تأثر بعض الأفارقة بهذا الرأي فظنوا أن تطبيق القانون الاستعماري سيؤدي إلى تحسين أوضاعهم، وتعزز هذا الظن نتيجة عجز الأعراف القانونية الإفريقية بصيغتها التقليدية عن تقديم حلول للمشاكل التي نجمت عن التطور الاقتصادي السريع في ظل الاستعمار، خاصة نظام الاقتصاد النقدي الذي فرضه الاستعمار وجعل الأفارقة يشعرون وكأن ما لديهم من موارد لا يكفي لسد حاجاتهم، وأن مصالحهم دائمًا متعارضة.
ومن جهة ثالثة، زعم المستعمرون أن هدفهم نشر الحضارة والرقي بين الأفارقة، بما كان يعني إزاحة البدائل المحلية، ومن بينها الإسلام، وظل المستعمرون حتى نهاية عهدهم حريصين على "تلميع" صورتهم عند الأفارقة، حتى إن سلطات الاحتلال البريطاني كانت تحظر الكتب والأفلام التي تشوه صورة "الرجل الأبيض"، وتنتج أفلامًا تجارية لا تقدم إلا دعاية سافرة لحكم الرجل الأبيض لإفريقيا، كما استخدمت الإذاعة لتحقيق هذا الهدف الاستعماري.
لقد استجاب المسلمون لتحدي الاستعمار بصور متعددة نتيجة تنوع السياسات الاستعمارية من جهة وتنوع مجتمعات المسلمين الأفارقة من جهة أخرى، والذي أخذ مظاهر عدة مثل انتشار المذهب المالكي بين مسلمي شمال القارة وغربها، وسيادة المذهب الشافعي في شرقها، وشيوع الطرق الصوفية مثل القادرية والشاذلية والتيجانية، وكذلك انتشار العقيدة المهدية، التي تبشر بقرب مجيء المهدي المنتظر، بين كثير من مسلمي القارة.
وبرغم هذا التنوع، فقد ظل المشترك الأساسي بين مجتمعات المسلمين هو الدور المحوري للعلماء والمشايخ، الذين كانوا يفسرون الشريعة ليطبقوا مبادئ الإسلام في حياة الناس اليومية، ويشرفوا على تعليم أبناء المسلمين في الكتاتيب والمدارس.
الجهاد المسلح
حين غزا الأوروبيون بلاد إفريقيا المسلمة، كان كثير من تلك البلاد يعيش في ظل دول أسستها حركات الإصلاح الإسلامي في القارة، فانبرى أهلها للدفاع عن أنفسهم وحفظ دينهم وكياناتهم السياسية، باعتبار أن الجهاد المسلح واجب على المسلمين الذين تعرضت بلادهم للغزو، ونتيجة لذلك، واجه الأوربيون أشرس مقاومة مسلحة في المناطق التي انتظم أهلها تحت قيادة العلماء والمشايخ.
ففي السودان، قادت الدولة المهدية، التي أسسها محمد أحمد المهدي عام 1882، الجهاد المسلح الذي استمر إلى أن سقطت الدولة عام 1898، فانتقلت المقاومة غربًا إلى سلطنة دارفور تحت حكم علي دينار، ولم تهزمها قوات الغزو البريطاني إلا عام 1916.
وفي الصومال قاد الجهاد محمد عبد الله حسن، الذي أطلق عليه المستعمرون لقب "الشيخ المجنون"، ونجح المجاهدون في صد أربع حملات استعمارية بريطانية بين عامي 1900 و1904، ولم ينجح الغزاة في هزيمتهم إلا عام 1920.
وفي ليبيا ومنطقة وسط الصحراء الكبرى، تصدى مجاهدو الطريقة السنوسية للغزاة الإيطاليين والفرنسيين، ولاسيما بعد انسحاب الحامية العثمانية الصغيرة من ليبيا عام 1912، ومحاولات الغزاة المتكررة التوغل إلى الداخل، وقد تصاعدت الحرب الإيطالية-السنوسية بعد وصول الفاشيين إلى الحكم في إيطاليا، حتى تحولت بحق إلى ثورة شعبية باسم الإسلام لتحرير برقة وطرابلس.
وفي شمال المغرب الأقصى أنشأ المجاهدون "جمهورية الريف" عام 1922 تحت قيادة الأمير عبد الكريم الخطابي، ونجحوا في هزيمة قوات الغزو الإسباني، حتى تحالف المستعمرون الإسبان مع الفرنسيين ضدهم، فهزموهم عام 1926.
وفي جنوب المغرب الأقصى أعلن الشيخ ماء العينين، عام 1908، الجهاد ضد الغزاة الفرنسيين الذين بدأ تقدمهم من وادي نهر السنغال، وواصل ابنه وخليفته، الجهاد لتوحيد المغرب والصحراء، ثم قاد محمد المأمون الجهاد عام 1929، وهاجم أتباعه مواقع الجيش الفرنسي، ولم تنجح الحملات العسكرية الفرنسية على مناطق الصحراء في هزيمة المجاهدين حتى عام 1934 – أي قبل خمس سنوات فقط من اندلاع الحرب العالمية الثانية.
وهكذا أصبحت كثير من شعوب إفريقيا، مثل شعب "ماندينكا" في السودان الغربي (مالي حاليًّا)، وشعب "نجيندو" في تنجانيقا (تنزانيا حاليًّا)، تنظر إلى الإسلام كقوة معادية للاستعمار، فانجذبت إليه وتعززت مكانته عندها.
وكان أشد ما أفزع المستعمرين هو محاولات توحيد حركات الجهاد المسلح، خاصة الاتصالات التي جرت بين أتباع المهدي في السودان بعد سقوط دولتهم من جهة، وبعض المصلحين أو مدعي المهدية في مناطق مسلمي إفريقيا الأخرى، ولاسيما في شمال نيجيريا ووسط وجنوب الصحراء، من جهة أخرى. لكن أكبر دفع باتجاه الوحدة الإسلامية أتى من خارج إفريقيا، وتحديدًا من الدولة العثمانية تحت حكم السلطان عبد الحميد الثاني ثم حزب تركيا الفتاة. وحين دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى أصدرت عدة فتاوى تحض المسلمين في كل مكان على قتال الحلفاء، ويمكن النظر إلى التحاق عشرات الآلاف من المسلمين الأفارقة بصفوف المجاهدين في تلك الفترة –حسب المصادر الأوروبية– على أنه في جانب منه استجابة لهذه الفتاوى.
صور أخرى من الجهاد
لم يقف جهاد المسلمين ضد الاستعمار عند حمل السلاح، بل شمل أساليب أخرى لتمكين المسلمين من الحفاظ على هويتهم الإسلامية. وكان ذلك نتيجة طبيعية لإحكام المستعمرين سيطرتهم على بلاد إفريقيا المسلمة، وتمكنهم من إخضاع أهلها بعد هزيمة حركات الجهاد المسلح، وبالتالي كان لابد أن يأخذ الجهاد أشكالًا جديدة.
وكان من بين هذه الأساليب الجديدة، هجرة العلماء والمشايخ وأتباعهم إلى مناطق لم تصلها يد الاستعمار، ومن بينها أيضا الانشغال التام بالدعوة والانسحاب من الحياة السياسية من قبل بعض العلماء والمشايخ، والذين تجاهلوا حقيقة الاستعمار الأوروبي، ومن هؤلاء الشيخ "باي الكونتي"، في منطقة تمبكتو على نهر النيجر، و"فانتا ماضي" في غينيا، والحاج "عمر كراتشي" في ساحل الذهب (غانا حاليًّا)، وكان هؤلاء الزعماء وراء أكبر موجة انتشار للإسلام في مناطقهم في تلك الفترة.
وذهب بعض زعماء المسلمين إلى أبعد من ذلك، فقبلوا التعاون مع المستعمرين الذين فضلوا حكم المستعمرات بطريقة غير مباشرة (أي من خلال الزعامات التقليدية). وبحلول عشرينيات القرن العشرين، كانت معظم الإدارات الاستعمارية قد استعانت بالمشايخ، خاصة من أتباع الطرق الصوفية، وباتت تعتمد عليهم كوسطاء "معتدلين" بينها وبين المسلمين الأفارقة، وقد سعت هذه القيادات لاستثمار ذلك لتحقيق مكاسب للمسلمين.
فعلى مستوى التعليم، نجحت قيادات المسلمين –بالتعاون مع سلطات الاحتلال– في تغيير محتوى التعليم في مدارس المسلمين بحيث يشمل الحساب والهندسة والدراسات المسحية إلى جانب اللغة العربية والشريعة الإسلامية، من أجل تخريج مسلمين قادرين على العمل بكفاءة في أجهزة الدولة ومؤسسات الخدمة المدنية، وذلك بعد أن كان المستعمرون لا يدعمون إلا مؤسسات التعليم التي تشرف عليها جمعيات التنصير، ويوفرون فرص عمل جيدة لخريجيها ويحرمون خريجي مدارس المسلمين من تلك الفرص، باعتبار التعليم الذي يقدمه المسلمون في الكتاتيب والمدارس غير ذي صلة بالواقع.
كما حاول بعض زعماء المسلمين المساهمة في البناء القانوني الجديد في البلاد المستعمرة بحيث يتفق –ولو جزئيًّا– مع شريعة المسلمين ويخدم مصالحهم، برغم أن مجال المناورة في هذا الجانب كان محدودًا ومحكومًا بالأوضاع الجديدة التي فرضها الاستعمار. ومن جهة أخرى، تعاون بعض زعماء المسلمين مع الإدارات الاستعمارية من أجل تقنين الشريعة الإسلامية وتطبيقها في الحدود المقبولة استعماريًّا، وقد أثمرت هذه الجهود توحيد الفتاوى الشرعية في كل مسألة، واتساقها مع بعضها، وتطبيق قوانين الشريعة في مجالات ومجتمعات لم تكن تطبق فيها من قبل، برغم أن هذه الجهود كان لها أيضًا آثار سلبية، إذ جعلت الشريعة تبدو أقل مرونة وتكيفًا مع الظروف المحلية في كل مجتمع من مجتمعات المسلمين– وهي صفة كانت تميز تطبيق الشريعة قبل الاستعمار.
وهكذا تطور نظامان قانونيان وقضائيان متوازيان، أحدهما يستند إلى الشريعة الإسلامية، والآخر يقوم على القانون الأوروبي، وتتضح أهمية هذا التطور بالنسبة للمسلمين في اعتراف المستعمرين أنفسهم بزيادة إقبال الناس على التحاكم أمام قضاة الشريعة خارج النظم القانونية التي أقرتها الإدارات الاستعمارية، إذ فضل المسلمون تسوية قضاياهم خارج إطار تلك النظم؛ لأنها كانت تفرض استئناف أحكام جميع المحاكم الرسمية أمام موظفين إداريين محليين أو إقليمين غير مؤهلين للتعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
انتقادات صحيحة.. ولكن
لقد تعرض الزعماء المسلمون الذين تعاونوا مع الإدارات الاستعمارية لانتقادات شديدة من دعاة الجهاد المسلح باعتبارهم أعوانًا للاستعمار، وكانت هذه الانتقادات مفهومة حين كانت المقاومة واقعًا في حياة المسلمين الأفارقة، ولكن حينًا من الدهر أتى لم تعد فيه المقاومة المسلحة شيئًا مذكورًا، وفقد المسلمون الأراضي التي كانوا ينطلقون منها لمحاربة الاستعمار، فأصبح الجهاد من خلال النظم التي أقامها الاستعمار خيارًا جديًّا، وأصبح استثمار المزاج الاستعماري المتقلب لصالح المسلمين جهاد الوقت. فعلى سبيل المثال، جعلت حالة الكساد الاقتصادي الكبير ونذر الحرب العالمية الثانية في ثلاثينيات القرن العشرين، المزاج الاستعماري البريطاني والفرنسي متوترًا وأكثر حساسية تجاه مطالب المستعمرات، إذ امتدت دائرة الأعداء لتشمل، ليس فقط الاتحاد السوفيتي واليابان، البعيدين عن المسرح الإفريقي، بل وأيضًا إيطاليا الفاشية ذات المستعمرات الإفريقية وحليفتها ألمانيا النازية، وأصبحت بريطانيا وفرنسا مهتمتين بتنمية مستعمراتهما وتهيئتها للاعتماد على الذات حين تندلع الحرب. وفي هذا الإطار بدأت حملة واسعة لمراجعة أهداف الحكم الاستعماري ووسائله، وعينت الحكومة البريطانية لجانا لبحث تطوير إدارة العدالة الجنائية، والأوضاع المالية للحكومات المحلية، ومستقبل التعليم العالي في مستعمراتها جنوب الصحراء، وقدمت هذه اللجان مبررات قوية لتنمية المستعمرات وزيادة موارد حكوماتها، واقترحت تحويل خمس كليات إلى جامعات لإرواء ظمأ الأفارقة للتعليم العالي ومنع الاضطرابات السياسية. بل ورأت الإدارة الاستعمارية البريطانية إقامة اتحاد يجمع عدة مستعمرات في شرق إفريقيا، ولم تنجح هذه الفكرة نتيجة رفض الأفارقة أنفسهم، فضلًا عن معارضة العدد الكبير من الهنود المقيمين في تلك المستعمرات خشية سيطرة المستوطنين البيض على ذلك الاتحاد. ففي هذه الأجواء كانت الإدارة الاستعمارية البريطانية تسعى جديًا وعلى أعلى المستويات للتعرف على آراء الأفارقة والتعاون معهم، فهل كان مقبولًا أن تترك هذه الفرصة دون استغلالها لصالح مسلمي إفريقيا؟
الاستعمار الجديد
تواجه إفريقيا اليوم ظروفًا شبيهة إلى حد كبير بالظروف التي سادتها عشية "التكالب الاستعماري" عليها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، مما دفع بعض الباحثين إلى وصف الحالة الراهنة بـ"التكالب الاستعماري الثاني" على إفريقيا. فالتنافس الأمريكي–الصيني على القارة بات ظاهرًا للعيان، وما الصراعات الدائرة في السودان حاليًّا إلا إحدى تجلياته. وأوروبا الحالمة بعودة نفوذها في القارة تسعى للحاق بالمتنافسين بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا باتجاه وحدتها، والآن تدعو لإقامة اتحاد يجمع دول المتوسط، وتقود فرنسا القاطرة الأوروبية صوب هذا الاتجاه، تارة لخدمة مصالحها ونشر ثقافتها كما كان الحال في عهد الرئيس شيراك، وتارة كجزء من تحالف غربي أوسع يشمل الولايات المتحدة كما هو الحال في عهد الرئيس ساركوزي.
وعادت نبرة الخطاب الاستعماري تعلو، بعد أن كانت حكومات الدول الغربية تبدي –ولو ظاهريًا– في فترة ما بعد استقلال الدول الإفريقية نوعًا من الاحترام تجاه ثقافاتها، ولعل أوضح مثال على لغة الخطاب الاستعماري الحالي هو ما أبداه الرئيس الفرنسي ساركوزي -في خطابه في جامعة شيخ أنتا ضيوف، في أثناء زيارته للسنغال في يوليو 2007- من احتقار للثقافات الإفريقية، حيث اتهم الجنس الأسود بعدم القدرة على الإبداع، وأنه لولا الاستعمار ما حدث تطور في إفريقيا، ويزيد من خطورة الأمر إدراك أن هدف الصراع على إفريقيا ليس فقط مواردها الطبيعية الغنية، وإنما أيضًا عقول أبنائها وقلوبهم، خاصة في زمن الحرب على الإرهاب الذي بات يعني لدى حكومات الغرب "الإسلام المقاوم".
دروس الماضي
ولمواجهة هذا التحدي الخارجي، على المسلمين الاستفادة من دروس مقاومتهم للاستعمار القديم، ومن تلك الدروس استغلال التناقضات بين القوى المتنافسة على القارة، فلعل تدافع هذه القوى من أسباب حفظ الإسلام في إفريقيا. لكن الدرس الأهم في هذا الصدد هو الجمع بين الجهاد المسلح والجهاد غير المسلح، واستحالة الاستغناء بأحدهما عن الآخر. فبلاد المسلمين التي عاد إليها الاستعمار، سواء بجيوشه أو جيوش وكلائه هي أرض خصبة للجهاد المسلح. لكن هذا الأسلوب الاستعماري لم يعد جذابًا لمعظم المستعمرين الذين تنصب جهودهم الآن على استخدام القوة الناعمة لتحقيق أهدافهم في القارة. والقوة الناعمة لا يقابلها إلا الجهاد المدني الذي تتعدد ساحاته بتعدد نشاطات المسلمين، ومنها التعليم والتشريع والقضاء، وهي مجالات برع زعماء المسلمين في ظل الاستعمار في تطويرها خدمة لمصالح المسلمين، فالمهادنة لا تعني الاسترخاء أو التوقف عن السعي لتغيير الواقع.
إن أخطر ما في التحدي الخارجي حاليًّا هو أنه لا يستفز معظم المسلمين بدرجة تدفعهم لمقاومته. أم أن العقل المسلم بات عاجزًا عن إبداع طرق جديدة للمقاومة غير المسلحة؟
* نشر في موقع إسلام أونلاين عام 2008.
** أستاذ زائر وباحث أول، قسم الدراسات السياسية والدولية، جامعة رودس، جنوب أفريقيا.