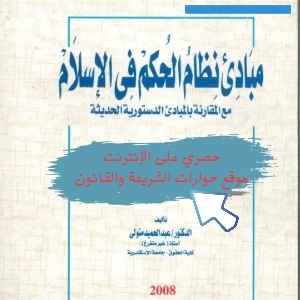أجري الدكتور “عبد الرزاق بلعقروز” رئيس تحرير مجلة “نماء” حوارًا مع الأستاذ الدكتور وائل حلاق… حول منهجه في النظر الفكري ومنظومة مفاهيمه، وأبعاد مشروعه الأبستمولوجية والأخلاقية، وذلك ضمن أعمال “دورية نماء” بالعددين 6 و7، ربيع وصيف 2018م.
ودار الحوار حول نقاط أساسية، منها:
- تعدد المفهومية والشخصيات والمناهج في نصوص “وائل حلاق” عبر كتبه.
- بناء التراث الإسلامي من خلال منهج وطريقة جديدة له، وفهم مقولة الشريعة.
- القيم الأخلاقية في الفكر العربي وتقييم “وائل حلاق” للجهود التي تسائل الأخلاق.
وكان من أهم الأسئلة التي طرحها المحاور على د. وائل حلاق:
- طبيعة التكوين المعرفي الذي ميز د. وائل حلاق بالتعددية سواء كانت مفهومية أم شخصية أم منهجية، وحقيقة التشابكات المعرفية (مفهومية ومنهجية) التي تطبع نصوصه ومؤلفاته؟
- مدي صدقية أن الغرض من نصوصه هو إعادة بناء منهج جديد في التراث الإسلامي، من خلال إعادة بناء وفهم مقولة الشريعة، وما هي الدعامات المنهجية التي يمكن الارتكاز عليها لأجل فهم التراث في سياق منهجيات سائدة تسلك المسلك الاستشراقي في هذا الأمر؟
- مدي مناسبة القول بأن مقالاته التي تنحو المنحى الأخلاقي، أو تراهن على مركزية “النطاق المركزي الأخلاقي” لصلاح حال الإنسان، هي انعكاس لعودة السؤال الأخلاقي في الفكر الإنساني المعاصر؟
وننشر نص الحوار كاملًا على الوجه الآتي:
نماء: الناظر في نصوص وائل حلاق عبر كتبه، يرى بأن ثمة تعددية مفهومية مثل: النموذج والنّطاق المركزي والنظام المعرفي وأيضًا تعددية منهجية مثل: الفيلولوجيا والجينيالوجيا… فضلًا عن تعددية الشخصيات المفهومية: كارل شميث، وجورجيو أغامبين وطه عبد الرحمن، ما هي طبيعة التكوين المعرفي الذي ميزكم بهذه التعددية وحقيقة التشابكات المعرفية (مفهومية ومنهجية) التي تطبع نصوصكم؟
وائل حلاق: بشكل عام، أجد أنه من الصعب جدًا الإجابة على هذا النوع من الأسئلة. هذا لأن التكوين الفكري لا يكون أبدًا شيئًا متعمدًا أو مقصودًا. ولا يسبق مستويات وعي المرء بقيمته الذاتية. فالباحثون والمثقفون يختارون المنهجيات والنظريات التي تناسب أفكارهم أثناء تطويرها. ولذا فإن توصيف التكوين الفكري للفرد هو بالضرورة مسألة تتعلق بما بعد الحدث (بُعد ميتافيزيقي)، وتحليلٌ بعد الفعل. وبالتالي فإن النظر إلى عمل المرء نفسه، بمعنى ما، يبدو مثل النظر إلى عمل الآخرين. وعلى هذا النحو، فربما يمكن الإجابة على هذا السؤال من قبل الآخرين بقدر ما يمكنني الإجابة عليه، إن لم يكن أفضل. لكنك سألتني، وسأحاول الإجابة عليه.
أرى أن اختيار المرء اتباع مسار منهجي أو نظري معين ليس اختيارًا حرًا تمامًا. إنه اختيار يقوم به المرء لكن ضمن قيود معينة. لكن ما هي هذه القيود؟ أعتقد أن القيد الرئيسي الأول هو الموقف الذي يتخذه المرء. أنا لا أدعي أن لدي تفسير لماذا يتخذ أحد المثقفين موقفًا معينًا بينما يتخذ الآخر موقفًا مغايرًا. ولا أعتقد أن أحدًا لديه إجابة على هذا السؤال فضلًا. عن إجابة شاملة بأي حال لماذا دافع ماركس عن نظرياته؟ لماذا دافع فوكو عن النظريات التي ناصرها؟ في بعض الأحيان نعزو هذه الاتجاهات والنزوعات الفكرية إلى التربية وخبرات الطفولة، والخبرات الحياتية، ولكن لا شيء يمكن أن يفسر بشكل مقنع لماذا يصبح الناس مفكرين وباحثين بالطريقة التي هم عليها. لذلك لن أستفيض في الحديث عن هذه المشكلة، لكنني سأفترض أننا نتخذ المواقف لسبب أو لآخر، أو على الأرجح، لمجموعة معينة من الأسباب أو غيرها.
بالنسبة لي، بدأت الأمور معي عندما تخصصت في الشريعة، وقضيت عدة سنوات في دراستها. أول شيء لاحظته هو أنني عندما قرأت مصادر الفقه وأصول الفقه وجدت فجوة بين الدروس التي استخلصتها من هذه المصادر وما قاله الاستشراق عنها. لقد بدأت من الموقف الأصلي القائل بأنه يلزم إجراء تصحيح. لكن بعد بضع سنوات، أدركت أن سوء الفهم وسوء التأويل ليسا من قبيل الصدفة أو الاستثناء؛ بل إنهما يمثلان مشكلة أعمق في الطريقة التي يرى بها باحثو أوروبا وأمريكا العالم ويفسرونه. بمعنى آخر لم تكن الشريعة هي المشكلة بل الطريقة التي قرأها بها قراؤها الغربيون. كحقل دراسي، فإن الشريعة، بالنسبة لي، أبرزت هذه المشكلة. لقد كانت سياقًا غنيًا ظهر فيه التحيزات الغربية بوضوح شديد. لكن في وقت لاحق من مسيرتي المهنية، بدأت أدرك أن مشكلة القراءة الخاطئة للشريعة هي أعمق من ذلك بكثير، فهي تعود إلى البنية الأساسية للمشروع الحديث.
وهنا، في هذه المرحلة، بدأت أبحث عن أطروحات نقدية مختلفة للحداثة يمكن المشكلة هو أن تساعدني في فهم ما يحدث. ولكن بعد أن أمضيت سنوات عديدة في قراءة هذه الأطروحات النقدية، فإن ما وجدته مذهلًا حقًا هو أن شكوكي وظنوني الأولية حول مشكلات الحداثة وأنماطها المعرفية لم يتم تأكيدها فحسب: لقد توصلت إلى خلاصة مفادها أن دراسة الشريعة يمكن أن تساعد في الواقع على فهم المشكلات التي اجتاحت المشروع الحديث. بعبارة أخرى، لم تكن دراسات الشريعة التي أجريتها دراسات تاريخية فحسب بل صارت الشريعة نفسها -باعتبارها نسقًا فعالًا بمنطقها الداخلي ومجتمعها الخاص- مصدرًا لنقدي للحداثة. وبما أن مجال الشريعة هو في الواقع مجال واسع يتسع لأن تصبح الشريعة مجالًا للثقافة كان هناك العديد من الجوانب التي يتعين دراستها. يمكن للمرء التركيز على أنماط العقلانية مقارنة بالحداثة، وهنا يصبح عمل مدرسة فرانكفورت، وكانط، ومنتقديه وطه عبد الرحمن، وغيرهم مفيدًا للغاية. يمكن التركيز كذلك على أبعادها السياسية واستخدام ذلك من أجل نقد مثمر للفكر السياسي الحديث والسياسة، بما في ذلك الدولة. هنا بالطبع أثبتت أعمال شميت وأغامبين وآخرين أنها مثمرة للغاية. ثمة مثال آخر هو نقد الحداثة ودراسة الشريعة من منظور الدستورانية (Constitutionalism)، وهو موضوع الكتاب الذي أعمل عليه الآن. الجدير بالملاحظة هنا هو أن القرآن والشريعة في مشروعي هما مصدران للنقد كما هو الحال مع النقد الغربي للدستورانية الغربية. إن دراسة هذه المجالات الإسلامية لا يقتصر على كشف تاریخها فحسب، بل أيضًا على شحذ نظام نقدي من خلال دراسة منطقها. ولكن يمكن للمرء أن يفعل أكثر من ذلك مع مثل هذه الدراسات. يمكن لدراسة الإسلام بشكل عام، ودراسة القرآن والشريعة على وجه الخصوص، إثراء وتعديل وصقل نظريات العديد من الفلسفات النقدية المنتجة في الغرب. فعلى سبيل المثال، يمكن للمرء استخدام فوكو بطرائق مفيدة جدًا في تطوير ملكة التفكير النقدي، ولكن يمكن للمرء أيضًا أن يُخضع عمل فوكو للنقد كجزء من الحداثة، وعلى أساس معرفة الشخص بالشريعة، وما إلى ذلك. هذا ما فعلته على سبيل المثال، في كتابي الذي نشر مؤخرا، بعنوان «قصور الاستشراق (Restate Orientalism) (من المتوقع صدور الترجمة العربية في هذا العام). في هذا العمل، وجدت أنه من الضروري تعديل وتعميم مفهوم «حالة الاستثناء» عند أغامبين، الذي هو بالفعل تعديل لمفهوم شميت.
نماء: الناظر في نصُوصكم يجد أن الغرض الرئيس هو إعادة بناء منهج جديد في قراءة التراث الإسلامي من خلال إعادة بناء وفهم مقولة الشريعة، فإلى أي مدى يمكن الإقرار بهذه الحقيقة؟ وما هي الدعامات المنهجية التي يمكن الارتكاز عليها لأجل فهم التراث في سياق منهجيات سائدة تسلك المسلك الاستشراقي في هذا الأمر؟
وائل حلاق: أعتقد أنه من الواضح الآن أن مشروعي يبدأ بالشريعة، وكما قلت، ويستخدمها كأساس لنقد الحداثة. أرى أنك محق في وصف المشروع بأنه محاولة لإعادة بناء التراث عن طريق تقديم قراءة جديدة له. ولكن قبل أن أشرح كيف أريد المضي قدمًا في هذا المشروع، يجب أن أوضح نقطة مركزية هنا: ألا وهي أن مفهوم الشريعة الذي أطرحه يجب أن يفهم على أنه يتضمن العديد من الأشياء بخلاف مفهوم القانون. كما أوضحت في كتابي “الشريعة: النظرية، والممارسة والتحولات” (۲۰۰۹)، فمن الإشكالي جدًا رؤية الشريعة كقانون بأي معنى حديث للمصطلح. الشريعة هي بالتأكيد “قانونية” مثل أي نظام حديث، ولكنها أكثر من ذلك بكثير، سواء في مضمونها ومنهجيتها، من جهة، وفي تصوراتها للواقع، من جهة أخرى، لكن عبارة “أكثر من ذلك بكثير”، لا تعني أن الشريعة تتشارك مع الأنظمة الحديثة في بعض السمات وبالتالي يمكن مقارنتها بها بسبب هذا التشابه، وبمعزل عن الاختلافات. هذا خطأ. إن اهتمام الشريعة الواسع بالذات كذات بشرية يمنحها سمات إضافية وهو ما يجعلها مختلفة تمامًا عن القانون الحديث. وأعتقد أنها أفضل من القانون الحديث. وبالتالي، فإن هذه الإضافة، هذا البعد الإضافي، ليست إضافة كمية يمكن أخذها بعين الاعتبار أو صرفها متى شئنا، بل إنها بالأحرى إضافة نوعية تغير حتى ما يعنيه “القانون” في الإسلام.
في حين أن القانون الحديث هو انضباط تقني أو عملي يتناول الإنسان من الخارج (لأنه من اختلاق الدولة)، فإن الشريعة هي انضباط خارجي وداخلي في آن واحد. أود القول بأن الشريعة هي أولًا نظام داخلي واستدخالي، وثانيًا نظام خارجي من الإلزام والانضباط. ثمة طريقتان على الأقل يمكن من خلالهما تكوين الذات: الأولى هي الطريقة القديمة التي تحدث عنها أرسطو والغزالي وفوكو، وهي التقنيات الأخلاقية للذات، وهناك طريقة جديدة وصفها ألثوسير على نحو نموذجي. الاختلافات بين التقنيتين كثيرة، لكن ثمة اختلافان جديران بالملاحظة. الاختلاف الأول هو أن جهاز الدولة الأيديولوجي الذي وصفه ألثوسير يرتكز على أنماط الإنتاج الرأسمالية وعلى مفهوم الإدارة السياسية المتمركز حول الدولة. هذا التكوين، كما جادلت في كتاب “الدولة المستحيلة”، يصر على الفصل بين الأخلاقي والقانوني والأخلاقي والسياسي والأخلاقي والاقتصادي، والأخلاقي والعلمي بعبارة أخرى، لا يهتم هذا النمط من تكوين الذاتية بالأخلاق باعتبارها الشاغل المركزي له. أما الاختلاف الثاني فهو أن مفهوم أرسطو والغزالي وفوكو يحول دون تدخل کیان خارجي تملي شروط تكوين الذاتية بوعي وعن عمد وعلى نحو سياسي وأيديولوجي، بل إنه يستند إلى أفراد بذوات غير مسبوقة، أي إن نطاقه وعمقه يختلفان من شخص إلى آخر. إن الفرد هو الحَكَم الوحيد والأخير فيما إذا كان يجب أن يشارك في سيرورة التكوين الذاتي أم لا، وتحديد إلى أي درجة يتم إجراء هذه المشاركة. وإنه لأمر جوهري أن تكون هذه التقنية سيرورة يعمل فيها المرء على ذاته، فهي تخلق ساحة مستقلة ونسبية للمنافسة.
أعتقد أن هذين الاختلافين بميزان الشريعة عن المفاهيم الحديثة للقانون بطرائق عميقة ومهمة. ولكن هناك في الشريعة ما هو أكثر من هذه الاختلافات الشريعة، كما أعرفها، هي تصوف أيضًا، أي إنه عندما أستخدم مصطلح “الشريعة” (كمصطلح عام وبدون مرجعية محددة)، فما أعنيه ليس فقط أصول الفقه، والفقه والشروح والحواشي، والمدرسة، والوقف والممارسات الاجتماعية-الاقتصادية، وما شابه ذلك، ولكن أيضا الطرق الصوفية لرؤية ومكابدة العالم. الشريعة معنية كذلك بالأدب والفلك والرياضيات وغير ذلك الكثير. إن ارتباطها بالصوفية يجعلها مشروعًا نفسيًا-صوفيًا، وارتباطها بالفلك والرياضيات يجعلها علمية وارتباطها بالأدب يجعلها إنسانية، وهكذا. كل هذا متضمن في الشريعة عندما أستخدم المصطلح بطريقة غير محدّدة، مثلما أتحدث عنها الآن أثناء الإجابة على سؤالك المهم.
إذا أدركنا أن الشريعة كانت مهتمة بنوع من الذات استعصى فهمها على القانون الحديث ولا الدولة الحديثة حتى الآن، فإن لدينا هنا مجال استثنائي من المعرفة يمكن أن يساعدنا في تطوير نقد للحداثة من خارج الحداثة نفسها. الشريعة لديها الكثير لتقدمه كنظرية ومنهج، لكن اسمحوا لي أن أؤكد سريعًا لمصلحة إخواننا وأخواتنا الليبراليين والمتلبرلين الذين لا يستطيعون رؤية أي شيء في عالمنا الكبير هذا غير الغرب وليبراليته: أن الشريعة ليست مجرد مجموعة من القواعد التي يرى العديد من “الليبراليين التقدميين” أنها غير متوافقة مع الحساسيات «الحديثة» و«المتطورة» التفكير في الشريعة من هذه الناحية هو مثل رمي كتاب نفيس في سلة المهملات لأن غلافه قديم ومهترئ. هذا تفكير ضحل في رأيي. إن الشريعة -كما عرفتها- تتناول الكائن البشري من منظور ينشغل بإنسانيته/ إنسانيتها، كعضو في مجتمع ما لديه احتياجاته الخاصة، أو من حيث كونه ضعيفًا وغير معصوم، أو ككائن اجتماعي يكون موقعه الاجتماعي المشترك أكثر أهمية من أي اعتبار آخر. بعبارة أخرى، تعمل الشريعة لصالح المجتمع ومن خلال المجتمع. وعلى النقيض من ذلك، لا تحافظ الدولة الحديثة على التماسك الاجتماعي رغم أنها تدعي ذلك ولا تهتم بالحفاظ على استقامة المجتمع الأخلاقي، بل على الضد تمامًا، فهي تواصل إعادة تشكيل المجتمع والأسرة. وإعادة هندستهم بصورة مستمرة. لقد وصلنا الآن إلى مرحلة أن الأسرة تعاني من أزمات شديدة. ففي الغرب، تتلاشى الأسرة ببطء ولكن بثبات، وهذا سيؤثر حتمًا في العديد من المجتمعات الأخرى، بما في ذلك المجتمعات الإسلامية.
ولكن اسمحوا لي أن أوضح مسألة أخرى ذات صلة هنا. إن توظيف الشريعة في مشروعي لا يفترض إعادة بنائها كفاية أو مرحلة أولى. فإعادة بناء نظام يتبنى مبادئ الشريعة يأتي في المرحلة الثانية في ترتيب أولوياتي، فهو شاغل ثانوي أهتم به لاحقًا. ما هو مهم كخطوة أولى، هو توظيف الشريعة كأداة نقدية، وكنظرية نقدية. ولأن الشريعة تقدم مجموعة من القيم التي تظل مهمة، حتى فيما نسميه العصر ما بعد الحديث، ولأنه يجري تهميشها؛ فهي حقل رئيسي يمكن من خلاله استخلاص نظرية عمل تستطيع أن تقدم نقدًا للممارسات الحديثة. وهنا اسمحوا لي أن أؤكد على القاعدة الأولى بشأن النقد: أن النقد الأصيل والحقيقي يجب أن يأتي مــن خـــارج النظام أو الظاهرة التي يجري نقدها. ولا يمكن أن ينبع من داخل النظام، ولا من منطقه، أو من تصوره، لأن أي حل يأتي من نفس النظام الإبيستمولوجي الذي أنتج المشكلة سيفشل ببساطة، وسيؤدي بالتأكيد إلى مشكلة أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية. ويمكن للشريعة أن توفر هذه النزعة الخارجانية (Externality)، هذه الموضوعية؛ لأنها صارت دخيلًا خارجًا، ولكنها دخيل لديه كلمة الفصل في طرائق تفكيرنا ومعيشتنا. وبمجرد طرح هذا النقد، وبمجرد أن تبدأ طرائقنا في التغيير، ربما ترغب في التفكير في كيفية إعادة بناء شكل من أشكال الشريعة يتناسب مع الحقائق والوقائع التي نواجهها. في الوقت الحالي، الشريعة ليست مجرد «نظام قانوني»، ولا مجرد وسيلة للمسلم لكي يخوض بها غمار الحياة. إن الشريعة، في الواقع، هي تجسيد للنقد.
نماء: هل يمكن القول بأن مقالتكم التي تنحو المنحى الأخلاقي، أو تراهن على مركزية «النّطاق المركزي الأخلاقي» لصلاح حال الإنسان هي انعكاس لعودة السؤال الأخلاقي في الفكر الإنساني المعاصر؟ حيث أن الاتجاه إلى تخليق العالم بات همًا إنسانيًا مشتركًا؟
وائل حلاق: الإجابة المختصرة على سؤالك هي «نعم». أعتقد أنه لا مناص من حتمية الأخلاق والطرائق الأخلاقية للتفكير في العالم. اسمحوا لي أن ألخص المسألة وأُبسط المشكلة التي نواجهها: لطالما كان تاريخ البشرية معقدًا وعنيفًا ومليئًا بالبؤس والشقاء. لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يُشكك في ذلك. لكن الحداثة جاءت لتكثيف كل هذا. فإذا فكر المرء بوضوح وبفكر متفتح حول “مرحلتنا” في التاريخ، نجد أن الحداثة لـم تقدم لنا سوى فائدة واحدة، وإنجاز رئيسي واحد، ألا وهو الوفرة المادية والثروات الدنيوية، وأشكال فوقانية من المعيشة المادية. يمكننا اليوم الوصول إلى المزيد من الأشياء المادية ووسائل الراحة الناتجة عنها أكثر من أي فترة أخرى في تاريخ البشرية. لكنني لا أستطيع التفكير في أي جانب آخر للحداثة يمكن أن يكون إيجابيًا بشكل واضح. لقد دمرت الحداثة البيئة الطبيعية والنسيج الاجتماعي للمجتمع والأسرة، وسلبت الذات قوتها. بوسعنا الآن أن نتحدث عن إجماع علمي بشأن قضايا المناخ والأزمات البيئية. يتجلى ذلك في الخراب الإيكولوجي الهائل، وارتكاب فظائع استعمارية وإمبريالية ساحقة، وتجريد الآخر من الإنسانية (حيونة الإنسان)، وأشكال غير مسبوقة من العنف السياسي والاجتماعي، وإبادة جماعية من كل الأنواع، وبناء هويات سياسية قاتلة ومشوهة، وتسمم الطعام والماء. وإبادة أعداد ضخمة من الكائنات الحية، والتهديدات الصحية المقلقة بشكل متزايد، والتفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء، والانحلال الاجتماعي والمجتمعي، وصعود الفردانية النرجسية السيادية، والزيادة الدراماتيكية في الأمراض الاجتماعية الفردية والجماعية والانتشار الخطير لاضطرابات الصحة النفسية والعقلية، وانتشار وباء الانتحار، وغير ذلك الكثير. لقد أثبتت الحداثة أنها عنيفة تجاه كل شيء تلمسه. وكما يعلم الجميع، فإن القرن العشرين وحده قد تسبب في موت ودمار أكثر مما حدث خلال الألفي سنة التي تسبقه
لذا فالحداثة هي استثناء للقاعدة العامة للتاريخ البشري. إنها قطيعة مع كل ما سبقها. وإذا كنت تتساءل ما هو مصدر أو سبب هذا الانحراف أو التشظي الجذري، فإن المرء يجد صعوبة في العثور على أي شيء آخر سوى ظاهرة واحدة: فصل أوروبا بين الحقيقة والقيمة، “بين ما هو كائن” (ls) و«ما ينبغي أن يكون» (Ought). وقد شرحت ذلك في كتابّي (الدولة المستحيلة، وقصور الاستشراق) ولن أكرر هذا الشرح هنا. لكن من المهم أن ندرك أن هذا الفصل يتعلق بالأخلاق. نحن بحاجة إلى استعادة هذا الارتباط، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لنا لاستعادة إنسانيتنا ومكاننا الصحيح في العالم. نحن في ظل الحداثة، دمرنا كل شيء من حولنا، لأننا لم نعد نحترم أي شيء آخر غير القوة والثروة. إن ارتباطنا بالطبيعة، واهتمامنا بها، هو ارتباط مرضي، ونحن بحاجة إلى علاج هذه المشكلة بسرعة. إذ ليس من المنطقي أن نتمكن من تدمير حوالي ١٥٠ نوعًا من الكائنات الحية كل يوم. هذه الحقيقة وحدها يجب أن تجعلنا نتوقف ونفكر. إنه أمـر صــادم، على أقل تقدير. ثمة شيء خطأ فينا بالأساس. نحن بحاجة إلى تغيير، نحن بحاجة إلى إظهار الاحترام للحيوات الأخرى على كوكب الأرض، ولبعضنا البعض. لا أستطيع التفكير في أي شيء آخر غير الأخلاق التي يمكن أن تتدخل وتصحح هذا الوضع. لقد أكد طه عبد الرحمن أن الأخلاق هي ماهية الإنسانية. وأنا أقول، نحن لا شيء بدون أخلاق. بدون الأخلاق، تكون الحيوانات أفضل منا (وأنا لا أقصد هنـا الحـط مـن قيمة الحيوانات، فهي في الواقع لم تفعل شيئًا خاطئًا).
نماء: تتبنى مجلة نماء منظور التكاملية المعرفية والتركيبية المنهجية بين علوم الوحي والعلوم الإنسانية، وإذا كانت المقالة الأخلاقية في نصوصكم هي جوهرة التاج أو الملمح الجوهري في المشروع؟ فكيف ترى المقالة الأخلاقية التي يتبناها وائل حلاق قضية العلاقة بين علوم الوحي والعلوم الإنسانية؟
وائل حلاق: هذا سؤال في غاية الأهمية، والإجابة المختصرة عليه هي: أن الإنسانوية نوعان على الأقل، نوع علماني وآخر ديني من الخطأ الاعتقاد بأن الإنسانوية هي نطاق العالم العلماني وحده. لكن ثمة فارق كبير بين الإنسانوية الدينية والإنسانوية العلمانية. فالإنسانوية العلمانية تجعل من الإنسان القيمة الوحيدة في العالم وتنزل كل شيء آخر إلى مرتبة أداة أو شيء ما. وحتى إنسانية البشر قد تم حوسلتها (الحوسلة Instrumentaltzation» هي تحويل الشيء إلى وسيلة)، كما يتضح من الطريقة التي عامل بها العلمانيون غيرهم. من أشكال العبودية الساحقة إلى الإبادة الجماعية. لكن حوسلة الإنسان تحدث أيضًا بشكل يومي، كما نرى في الانتهاكات وعبودية العمال التي تبنتها الشركات متعددة الجنسيات التي تحكم العالم الآن بجانب الدول القومية. هذا لأن الإنسانوية العلمانية ترى العالم كمادة أو كشيء يجب استغلاله واستخدامه. لقد صارت الطبيعة شيئًا جامدًا، لكي يُشكلها البشر كما يريدون. لكن هناك رابط هنا يفتقده الكثيرون وهو أن الإنسان جزء من الطبيعة أيضًا. فعندما تخضع الطبيعة لسطوتنا وهيمنتنا، فإننا نخضع ذواتنا لنفس هذا الشكل من السطوة والهيمنة. بدأت هذه السيرورة بشكل جدي مع استعباد الأفارقة وإقصاء الهنود الأمريكيين كجزء من طبيعة يمكن السيطرة عليها وتغييرها. وتعمل الإبادات الجماعية بنفس المنطق فالإبادة الجماعية تهدف إلى تغيير مشهد الإنسانية (أو الطبيعة) تمامًا مثلما تنتزع الأعشاب الضارة من حديقتك (هناك كتاب ممتاز عن هذه المسألة بعنوان “الحداثة والهولوكوست” لزيجمونت باومان). من الخطأ، إذن، الاعتقاد بأن الإنسانوية العلمانية تدور حول قدسية الإنسان، بل إنها معنية بشريحة من البشر تستعبد الآخرين. دعونا لا ننسى أن أوروبا استعمرت العالم باسم الإنسانوية العلمانية على وجه التحديد. علاوة على ذلك، بسبب الانفصال بين هذا النوع من الإنسانوية والطبيعة كعمل لخلق بديع وجليل، لا يمكن للإنسانوية العلمانية أن تظهر أي إحساس بالتواضع أو الامتنان (كما بينت بالتفصيل في كتاب «قصور الاستشراق»).
لكن من المهم أن نفهم أن هروب أوروبا إلى الإنسانوية العلمانية ليس خطوة نحو التقدم أو تحسينًا متعمدًا للوضع/الشرط البشري. لقد لجأت أوروبا إلى هذا النوع الجديد من الإنسانوية لأنه وقع استبدادها من قبل الملوك، والأكثر من ذلك، من قبل الكنيسة المسيحية. وهو ما يعني أن أوروبا عانت من صدمة سببها كيان ادعى التحدث باسم الله. هذا هو السبب في أن كانط يُعرّف “التنوير” على أنه هروب من السلطة الفكرية للآخر؛ لأن فلسفته عبرت عن سخط الأوروبيين من الكنيسة المستبدة. وهكذا عندما حشدت أوروبا كل طاقتها من أجل غزو العالم والسيطرة عليه، فرضت شروطها، وما كانت أوروبا تكرهه صار مفروضًا على الجميع. إذا كانت أوروبا لديها مشكلة مع الدين، فإن الدين سيئ للجميع. هذا ما كان يقصده الأوروبيون عندما قالوا إن كل الناس سواسية: إنهم سواسية في الطريقة التي من المفترض أن يتبنوا من خلالها القيم الأوروبية. خلاف ذلك، لا أرى أي مكان على مدار الأربعمائة سنة الماضية حيث كان الأوروبيون يعاملون الآخرين على أنهم سواسية معهم حقًا، ويستحقون كل الخير الذي يشعرون (أي الأوروبيون) أنهم يستحقونه.
أجد صعوبة في قبول أي حجة ناجمة عن تجربة مؤلمة وصدمة شديدة، وذلك ببساطة لأن أي حجة من هذا القبيل هي رد فعل مَرَضي على الصدمة. ما قامت بـه أوروبا كان الجمع بين تجربتها الصادمة وبين القوة المادية والعسكرية الهائلة، الأمر الذي جعل حجتها الناجمة عن الصدمة تبدو ذات مصداقية. لذا أعتقد أن المسلمين عامة، من بين آخرين، يخلطون بين القوة العسكرية والمادية وجدلية القيمة والحقيقة.
من جهة أخرى، لا تواجه الإنسانوية الدينية المشكلات التي أظهرتها الإنسانوية العلمانية، كما يتضح من التجربة الإنسانية الطويلة عبر التاريخ. لقد كان للإسلام علمانويته الدينية لقرون عدة، حتى لأكثر من ألف سنة، وبالطبع كانت له مشكلاته الخاصة، لكن لا شيء كما رأينا يحصل في القرن العشرين باسم العقل والإنسانوية والأخوة. لكن الأهم من ذلك هو أن الإنسانوية الدينية يمكن أن تطور -بل إنها طورت بالفعل- علاقة أكثر إنسانية وأكثر تعاطفًا وحميمية مع الطبيعة، بما في ذلك الطبيعة البشرية. إن الإنسانوية الدينية مؤهلة تمامًا لإظهار شعور عميق بالتواضع والامتنان وهما من المتطلبات الأساسية للعيش في العالم بأكبر قدر ممكن من السلام. هذه محاججة طويلة، وأنا أحث الأشخاص المهتمين بهذه المسألة على قراءة كتابي “قصور الاستشراق”(Restating Orientalis) (2018) و”إعادة تشكيل الحداثة” (Reforming Modernity) (2019) هذا الكتاب الأخير يتناول طه عبد الرحمن الذي تعتبر أعماله أيضًا شرطًا أساسيًا لفهم العديد من القضايا التي يواجهها المسلمون.
نماء: ثمة اهتمامات بالقيم الأخلاقية في الفكر العربي، منها نص محمد عابد الجابري العقل الأخلاقي العربي ومشروع طه عبد الرحمن الذي انخرط في السؤال الأخلاقي بصورة منهجية واضحة، ما هو تقييمكم لهذه الجهود التي تُسائل الأخلاق؟
وائل حلاق: في الكتاب الذي يتناول أعمال طه عبد الرحمن الذي ذكرته آنفًا، أقدم تقييمًا مفصلًا لعمل محمد عابد الجابري، وأبين كيف أنه عمل غير متسق بل ومتناقض، وأناقش أيضًا تناول طه لعمل الجابري، الذي يُعد تناولًا نقديًا بنفس القدر. أعتقد أن مكانة الأخلاق في الإسلام ملتبسة في ذهن الجابري، ومفهوم «العقل» عنده إشكالي جدًا لأنه مبني على استعارات مربكة من المشهد الفكري الأوروبي، أود القول أيضًا إنه لم يفهم كيف أن الإسلام صقل شكلًا معينا من الأخلاق ينطوي على مكون قوي هو «العمل». برأيي إن عمل طه أكثر رصانة واهتمامًا بخصوصيات الإسلام كنظام للأخلاق، على الرغم من بعض المشكلات التي نأمل أن يحلها في الوقت المناسب. في النهاية أحيل القارئ إلى كتاب “إعادة تشكيل الحداثة” (Reforming Modernity) من أجل مناقشة مفصلة. وآمل أن تظهر الترجمة العربية لهذا الكتاب في عام (2019)، بعد فترة ليست طويلة من نشره باللغة الإنجليزية.
للاطلاع علي مادة حوار نماء مع د. وائل حلاق