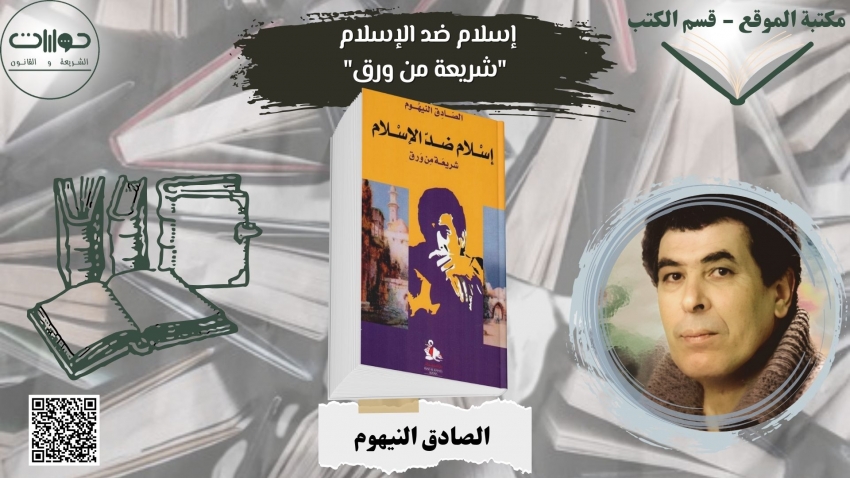صدرت الطبعة الأولى من كتاب "إسلام ضد الإسلام" للصادق النيهوم·، في عام 1991م، ثم صدرت الطبعة الثانية في عام 1995م، وصدرت الطبعة الثالثة في عام 2000م عن دار نشر رياض الريس للكتب والنشر، وهي الطبعة التي ننشرها رفق هذا التقديم.
وهذا الكتاب يعتبر مكملا لكتاب النيهوم الذي نشرنا من قبل "الإسلام في الأسر"، ولذا فهو ينوه في مقدمته للكتاب إلى أنه "للمرة الثانية تعاد التجربة لتبادل الحوار حول دور (الجامع) في نظام الشورى. وللمرة الثانية يجرنا الحوار إلى تفاصيل جانبية خارجة جدًا عن أصل الموضوع، في شهادة واضحة على أننا -رغم لساننا الواحد- لا نتكلم دائما لغة واحدة. فدعونا نجرب أن نفحص المشكلة بالعين المجردة
كيف يأمر الله بالعدل، من دون أن يأمر بسلطة الأغلبية؟
كيف تصبح الدعوة إلى حكم الله فريضة، ما دام الحكم نفسه في يد شخص أو عائلة أو طائفة أو حزب؟
كيف يكلف الله الإنسان بأن يكون مسؤولاً عما كسبت يداه] من دون أن يوفر له الوسيلة الشرعية لحمل هذه المسؤولية؟
كيف يكون الله عادلاً، إذا لم يضمن للناس شرعاً وعملياً؟
ثم يلفت المؤلف النظر إلى حقيقة مهمة –من وجهة نظره- وهي: "إن الدين الذي لا يضمن العدل للأغلبية في نظام إداري محدد ببنود الدستور، لا يستحق اسم الدين، ولا يستطيع أن يجمع الناس حوله إلا بوسائل الوعد والوعيد وغسيل المخ التي يتولى الفقهاء تطويرها لحساب الإقطاع في حلف شيطاني ينتحل لنفسه صفة القداسة بالذات. وهي المشكلة التي عانى منها الإسلام منذ الانقلاب الأموي على الأقل. فالإسلام - من دون سلطة الأغلبية - ليس ديناً، بل جثة دين. إنه مجرد توليفة من الوصايا التي تدعو إلى العدل والخير والصلاح. لكنها وصايا من ورق -مدفونة بين الورق- لا تملك قوة القانون، ولا تستطيع أن الفرض نفسها إلا بقدر ما يسخرها الحاكم في خدمة أغراضه الخاصة. وقد أفرط الحكام المسلمون في استغلال هذه الظاهرة إعلامياً، من تأسيس جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يتولون إجبار المارة على أداء الصلاة، إلى قطع أيدي صغار اللصوص في الميادين الغابة من باب الحرص على تطبيق الشريعة. لكن أحداً من هؤلاء الحكام لم يؤسس أبدأ جماعة المراقبة بنود الميزانية، أو ضمان حرية الصحافة، أو رفع الحصار عن صوت المواطن شبه الأخرس، في شهادة واضحة على أن الدين الذي لا يكفل العدل للأغلبية، يصبح وسيلة لقهر الأغلبية بالذات". الصادق النيهوم في كتابه "إسلام ضد الإسلام".
ومن ثم يركز المؤلف في كتابه هذا على مدى أهمية دور الجامع أو "حزب الجامع" كما أسماه في نظام الشورى، حيث يرى أن تأسيس مثل هذه الحزب من شأنه أن يعيد الوجه الجميل للإسلام، وينقذه من عبودية التاريخ والفلسفة: "إن (حزب الجامع) يستطيع أن يعيد للإسلام وجهه الجميل، وينقذه من عبودية التاريخ والفلسفة، ويكسب المعركة الصعبة ضد الإقطاع والأصولية، ويمنح أمتنا أول تنظيم سياسي قادر على ضمان صوت المواطن شرعًا وعمليًا. وهي منجزات قد تبدو أشبه بالمعجزة في ضوء واقعنا الحرج، لكن الإسلام حقق هذه المعجزة ذات مرة بين قبائل من العرب المعزولين في عتمة القرن السابع، وليس ثمة ما يعوقه عن تحقيقها مرة أخرى بين شعوب عربية متطورة، تتخاطب عبر الأقمار الصناعية على عتبة القرن الواحد والعشرين".
وفي هذا الصدد يشير الصادق النيهوم إلى ضرورة تأسيس (حزب الجامع) الذي سيتوجه لتطوير لقاء يوم الجمعة من مناسبة للصلاة والوعظ، إلى مؤتمر للديمقراطية المباشرة على مستوى القاعدة، ويمتلك بذلك أوسع - وأفضل - برنامج سياسي عرفه العرب طوال تاريخهم بأسره. ثم أشار أيضًا إلى صفات هذا الحزب "حزب الجامع"، وهي على النحو التالي:
الصفة الأولى، لهذا الحزب، أن جميع خلاياه قد تأسست فعلاً، واكتمل تعدادها بالملايين في كل حارة وشارع على امتداد الوطن العربي. وهي خلايا حية، ومستعدة للعمل فورًا، ولا تحتاج إلى استدعاء، لأنها في حالة انعقاد دائم كل أسبوع من كل شهر من كل سنة.
الصفة الثانية، أنه حزب لا يحكم، بل يدعو إلى تحكيم الأمة، فهو لا يمثل مصالح العمال أو أصحاب رأس المال، ولا يهدف إلى أن يكون بديلاً من بقية الأحزاب، بل يهدف إلى حفظ التوازن بين جميع المصالح، بإخضاع القرار النهائي لمصلحة الأغلبية.
الصفة الثالثة، أنه حزب غير فقهي بل إسلامي، وهي فكرة قد تبدو متناقضة، لكنها في الواقع خالية من التناقض؛ فالإسلام شريعة لا تعترف بسلطة الكهنة أو الأحبار أو الفقهاء، ولا تميز بين عقيدة وأخرى، ولا تتقيد بحرفية النص بل بمصلحة الناس على اختلاف طوائفهم وألوانهم. وإذا كانت هذه الشريعة قد خسرت طابعها العالمي الآن، فذلك أمر مرده إلى تغييب صوت الناس وراء فتاوى الفقه بالذات.
تقسيمات الكتاب:
تم تقسيم الكتاب إلى مقدمة وثمانية فصول على النحو التالي:
المقدمة
الفصل الأول: إقامة العدل أم إقامة الشعائر
الردود على الفصل الأول
الرد الأول: الدليل العجيب
الرد الثاني: مجادل بغير علم
الرد الثالث: ما يجحظ العينين
الرد الرابع: التفسير الأحمق
الرد الخامس: من أين لك هذا؟!
الرد السادس: أين الدليل أين الحجة؟!
الرد السابع: لا للمهاترات
الرد الثامن: قرآن عربي لا كلداني
تعقيب المؤلف على ردود الفصل الأول
التعقيب الأول: سلف غير صلح
التعقيب الثاني: زنزانة القرن السابع
التعقيب الثالث: مجرد خدعة سياسية
التعقيب الرابع: جرائم الفقهاء
التعقيب الخامس: تشويه سهل
الفصل الثاني: الحكمة الخفية
الرد على الفصل الثاني.
الرد الأول: عجائز اليهود.
الرد الثاني: كسر جدار التسليم.
الفصل الثالث: الفقه في خدمة التوراة
الردود على الفصل الثالث
الرد الأول: عدو الإسلام
الرد الثاني: الكتابة من البرج العاجي
الرد الثالث: جهل مستفحل
الرد الرابع: ضحية الأفلام المصرية
الرد الخامس: السم في الدسم
تعقيب المؤلف على الفصل الثالث
التعقيب الأول: نفوذ الأسر الحاكمة
التعقيب الثاني: ضحية غسل دماغ
الفصل الرابع: المسلمة لاجئة سياسية
الردود على الفصل الرابع
الرد الأول: أين الشرف العلمي
الرد الثاني: معنى «اضربوهن»
الرد الثالث: الدين لم ينصف المرأة
تعقيب المؤلف على الفصل الرابع
التعقيب الأول: معلومات ناقصة
التعقيب الثاني: النظام الشرعي
الفصل الخامس: الطفل المسحور: وباء الأصولية والتعليم الديني
الفصل السادس: مجازر معصومة: أخطاء وأخطاء في نصوص مقدسة
الفصل السابع: مقالات عامة عن «الإسلام في الأسر»
المقال الأول: في خدمة العسكر محلك سرًا
تعقيب المؤلف: تقول ما لا تعلم
المقال الثاني: من فمك أدينك يا إسرائيل
المقال الثالث: عن «الإسلام في الأسر»
المقال الرابع: نحن في الأسر
المقال الخامس: صوت صارخ في البرية
تعقيب المؤلف: الأبعاد الخفية
الفصل الثامن: ردود عامة
الرد الأول: ماذا أبقيتم للمرحوم هتلر
الرد الثاني: تجني النيهوم
الرد الثالث: حمم البركان
الرد الرابع: العبرة ليست في المكان
الرد الخامس: قاتل الله الفلوس!
رابط مباشر لتحميل الكتاب
- الصادق النيهوم (1937م بنغازي – 1994م جنيف): كاتب وأديب وفيلسوف ليبي، أعدَّ أطروحة الدكتوراه في "الأديان المقارنة" بإشراف الدكتورة بنت الشاطئ جامعة القاهرة، وانتقل بعدها إلى ألمانيا، وأتم أطروحته في جامعة ميونيخ بإشراف مجموعة من المستشرقين الألمان، ونال الدكتوراه بامتياز، وتابع دراسته في جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامين، ودرَّس مادة الأديان المقارنة بقسم الدراسات الشرقية بجامعة هلسنكي بفنلندا من عام 1968 إلى 1972م، وكان أستاذًا محاضرًا في الأديان المقارنة في جامعة جنيف حتى وفاته في عام 1994م. أجاد، إلى جانب اللغة العربية، الألمانية والفنلندية والإنجليزية والفرنسية والعبرية والآرامية المنقرضة. صدرت له مجموعة كتب منها: فرسان بلا معركة، نقاش، من هنا إلى مكة، القرود، الحيوانات، كما صدرت له أشهر وأهم كتبه عن الإسلام والديمقراطية، وهي:
- صوت الناس: أزمة ثقافة مزورة.
- الإسلام في الأسر: من سرق الجامع وأي ذهب يوم الجمعة؟
- محنة ثقافة مزورة: صوت الناس أم صوت الفقهاء.
- إسلام ضد الإسلام: شريعة من ورق.