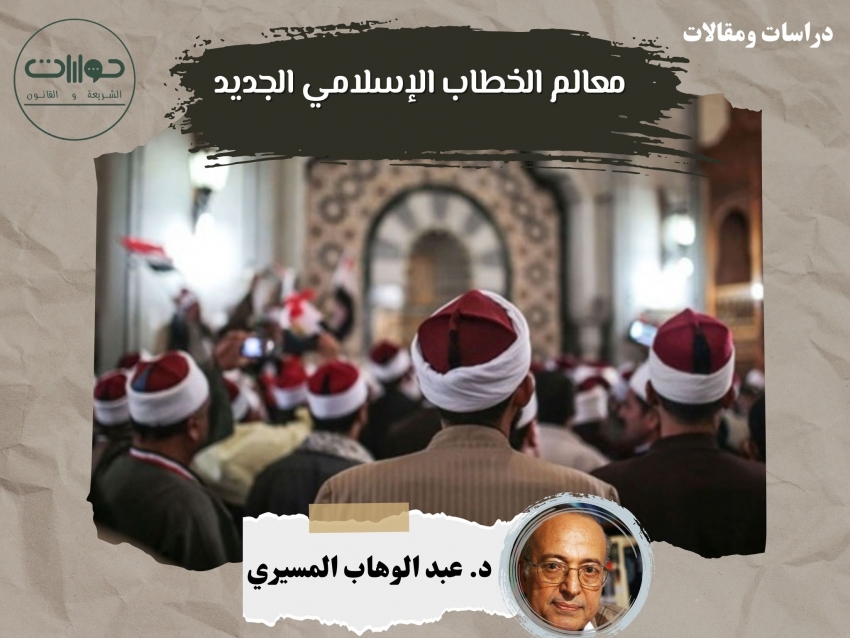يميل البعض إلى تصوير الخطاب الإسلامي باعتباره خطابًا واحديًا، أي ذا بعد واحد. والدين الإسلامي هو ولا شك عقيدة التوحيد، لكن التوحيد لا يعني الوحدانية. فالتوحيد يعنى أن الله الأحد مفارق للإنسان والكون، منزه عنهما، وهو ما يعنى إن الواحد هو الله وحده وما عدا ذلك فكثير والخطاب الإسلامي ليس كلام الله، وإنما هو اجتهادات المسلمين داخل الزمان والمكان، ومن ثم فهو أيضًا متعدد وكثير وتاريخ المسلمين هو تعبير عن هذه الكثرة والتعددية.
ونحن نميل إلى تصنيف مستويات الخطاب الإسلامي على النحو التالي:
- خطاب إسلامي ظهر مع دخول الاستعمار العالم الإسلامي وحاول ان يقدم استجابة إسلامية لظاهرتي التحديث والاستعمار، وقد ظل هو الخطاب المهيمن حتى منتصف الستينيات، وهو ما نشير إليه بالخطاب الإسلامي القديم.
- ظهر خطاب آخر كان هامشيًا ولكن معالمه بدأت تتحدد تدريجيًا في منتصف الستينيات، وهو ما نشير إليه بالخطاب الإسلامي الجديد ونقطة الاختلاف بين الخطابين هو الموقف من الحداثة الغربية (كما سنبين بعد). ولكن إلى جانب هذا التصنيف الثنائي على أساس المرحلة التاريخية، وقد يكون من المفيد أن نشير إلى تصنيف ثلاثي على أساس حملة الخطاب:
- الخطاب الجماهيري أو الاستغاثي أو (الشعبوي) هو خطاب القاعدة العريضة من الجماهير الإسلامية التي شعرت بفطرتها إن عمليات التحديث والعلمنة والعولمة لم يكن فيها خير للأمة ولا صلاح لها. كما لاحظت أن هذه العمليات هي في جوهرها عمليات تغريب، سلبتها موروثها الديني والثقافي ولم تعطها شيئًا في المقابل، بل أدت إلى مزيد من الهيمنة الاستعمارية والاستقطاب الطبقي في الداخل. هذه الجماهير تحاول التمسك والتشبث بالإسلام فهي تعرفه جيدًا وتشرنقت داخله إلى أن يأتي الله بالفرج. فهي تتحرك بموروثها الإسلامي وتستغيث في الوقت نفسه طلبًا للنجدة، ولكنها لا تقدم فكرًا ولا حركة سياسية منظمة. وعادة ما يعبر هذا الخطاب عن نفسه من خلال هبات تلقائية غاضبة ضد أشكال التغريب المتطرف والغزو الاستعماري تارة، وتارة أخرى من خلال «فعل الخير» الفردي (إعطاء الصدقات والاجتماعي (تأسيس مساجد ومستشفيات ومدارس - موائد الرحمن... إلخ). ويعبر الخطاب الجماهيري أحيانًا عن نفسه من خلال أعمال العنف الاحتجاجي. وهذا الخطاب الجماهيري يضم الفقراء بالدرجة الأولى، ولكنه يضم في صفوفه أيضًا الأثرياء ممن يشعرون بأهمية الموروث الديني والحضاري، ومن أدركوا أن في ضياعه ضياعًا لكل شيء.
- الخطاب السياسي: هو خطاب بعض أعضاء الطبقة المتوسطة من المهنيين والأكاديميين وطلبة الجامعات والتجار ممن شعروا أيضًا بالحاجة إلى عمل إسلامي يحمى هذه الأمة. وقد أدركوا أن العمل السياسي هو السبيل إلى هذا، فقاموا بتنظيم أنفسهم على هيئة تنظیمات سياسية لا تلجأ للعنف، تتبعها تنظيمات شبابية ومؤسسات تربوية ويميل بعض حملة الخطاب السياسي إلى محاولة الاستيلاء على الحكم بالقوة، أما بعد عام 1965 (كما سنبين بعد فيلاحظ ان ثمة اتجاهًا عامًا نحو العمل من خلال القنوات الشرعية القائمة، واهتمام حملة هذا الخطاب يكاد ينحصر في المجال السياسي والتربوي.
- الخطاب الفكري: هو الخطاب الذي يتعامل أساسًا مع الجانب التنظيري والفكري داخل الحركة الإسلامية. وهذا التقسيم لا يعنى انفصال مستويات الخطاب الثلاث، فالخطابان الجماهيري والسياسي متداخلان، وقل الشيء نفسه عن الخطابين السياسي والفكري. ورغم انفصال الخطاب الجماهيري عن الخطاب الفكري إلا أن تداخلًا يحدث بينهما من خلال الخطاب السياسي وهكذا. ولكن رغم تأكيد هذه الوحدة الأساسية بين مستويات الخطاب الثلاث نجد أن من المفيد، من الناحية التحليلية، أن نفترض استقلالها الواحد عن الآخر.
وهذه الورقة الأولية ستركز بالدرجة الأولى على الخطاب الفكري الإسلامي، وبدرجة أقل على الخطاب السياسي، وهي تهدف إلى التمييز بين الخطاب الإسلامي القديم والخطاب الإسلامي الجديد على أمل تحديد بعض معالم الخطاب الجديد، فأية حركة فكرية وسياسية يجب أن تتوقف من أونة لأخرى، لتتأمل ذاتها وتجرد بعض الملامح والخطوط العامة لحركتها، حتى يمكنها أن تطور نفسها وإن تعمق أطروحاتها.
ولنبدأ محاولة التمييز هذه من نقطة محورية، أي موقف كل من الخطاب الإسلامي القديم والجديد من الحضارة الغربية، فهذا الموقف هو الذي حدد كثيرًا من ملامحهما وتوجههما وأطروحاتهما. ويجب أن ندرك أن دعاة الإصلاح الأول كانوا يتعاملون مع الحضارة الغربية في مرحلة مختلفة عن المرحلة التي نتعامل نحن فيها مع هذه الحضارة. فرغم أن النموذج العلماني (الشامل) هو النموذج الأساسي في التشكيل الحضاري الغربي الحديث منذ بدايته، ورغم أنه يشغل المركز في وجدان الانسان الغربي الحديث ويشكل رؤيته إلى الكون، ورغم أن الحضارة الغربية الحديثة كانت قد اتضحت هويتها باعتبارها حضارة إمبريالية شرسة، إلا أنها مع هذا كانت تحوي قدرًا كبيرًا من الثبات والإيمان بالقيم المطلقة على مستوى الرؤية، إن لم يكن أيضًا على مستوى الممارسة. كما كانت هذه الحضارة تدعي أنها حضارة إنسانية هومانية متمركزة حول الإنسان، وكانت المجتمعات الغربية مجتمعات لا تزال متماسكة من الناحية الاجتماعية والأسرية، ولم تكن كثير من الظواهر المرضية التي تسم المجتمعات الغربية في الوقت الحاضر قد ظهرت بعد. وقد يكون من المستحسن أن نتصور العلمانية (الشاملة) لا باعتبارها نموذجًا وإنما باعتبارها متتالية أخدة في التحقق تدريجيًا في الزمان والمكان. ويمكننا القول بأن كثيرًا من حلقات هذه المتتالية لم يكن قد تحقق بعد مع نهاية القرن التاسع عشر، فالحياة الخاصة كانت لا تزال بمعزل عن عمليات العلمنة، فكان الانسان الغربي علمانيًا شاملًا في حياته العامة، متدينًا ملتزمًا بأهداف الفضيلة وبالمنظومة الدينية المسيحية في حياته الخاصة، ولذا فالحضارة الغربية لم تكن حضارة علمانية مادية تمامًا، فالقيم الدينية والانسانية كانت تلعب فيها دورًا واضحًا وإيجايًا، منحها قدرًا من التماسك والغائية.
وحينما احتك المصلحون الإسلاميون الأول بهذه الحضارة فهم لم يحتكوا بحضارة علمانية بالمعنى الشامل، وإنما احتكوا بحضارة علمانية بشكل جزئي تمت علمنة بعض جوانب الحياة العامة فيها وحسب، ولم تكن الحلقات الأخيرة من متتالية العلمانية الشاملة قد تحققت بعد، أي أن كثيرًا من الظواهر السلبية التي نلاحظها بأنفسنا ونقرأ عنها في كتبهم وصحفهم ومجلاتهم، والتي أصبحت نمطًا ثابتًا وظاهرة محددة، كانت مجرد حوادث متفرقة لا ظواهر دالة، ومن ثم كان من السهل تهميشها.
علاوة على هذا، لم يكن الخطاب النقدي الغربي للحداثة والاستنارة قد تبلور بعد، رغم تعالي بعض الأصوات فالأدب الرومانتيكي الغربي، على سبيل المثال، هو في جوهره أدب احتجاج على كثير من جوانب الحداثة الغربية، وكتابات المفكر الانجليزي إدموند بيرك وبعض المفكرين المحافظين تحتوي على إشارات لكثير من الموضوعات التي طورها الخطاب النقدي الغربي فيما بعد. إلا أن مثالب الحضارة الغربية، سواء على مستوى النظرية أو على مستوى الممارسة، لم تكن مسألة واضحة بعد لدارسي ومراقبي هذه الحضارة.
أما بالنسبة لحملة الخطاب الإسلامي الجديد فالوضع جد مختلف، فمعظمهم قد تشكل فكريًا في الخمسينيات واحتك بالحضارة الغربية في الستينيات ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية دخلت مرحلة الأزمة في تلك الآونة، وأدرك كثير من مفكريها أبعاد الأزمة والطريق المسدود الذي دخلته منظومة الحداثة الغربية.
إن حملة الخطاب الجديد أدركوا من البداية الجوانب المظلمة للحضارة الغربية الحديثة التي أدخلت العالم في حربين غربيتين يقال لهما «عالمتين» لأنهما جرتا العالم بأسره إلى حلبة الصراع وأتون الحرب، وتزايد انتاج أسلحة الفتك والدمار حتى تبين للجميع أن هذه الحضارة «قادرة على بناء قبر يكفي لدفن العالم». على حد قول (روجيه جارودي). وتزايد تغول الدولة القومية المركزية وتمكنت من الوصول إلى الجميع والتحكم فيهم من خلال أجهزتهم الأمنية والتربوية وتزايد تغلغل الإعلام في الحياة الخاصة للبشر الأمر الذي زاد من تنظيمهم، وتزايدت هيمنة قطاع اللذة على الجماهير وهو أدى إلى تزايد الإباحية، كما تزايدت معدلات الطلاق بشكل لم يسبق له مثيل. وظهرت أزمة المعنى والأزمة المعرفية والأزمة البيئية، ولم يعد الاقتصاد الحر ناجحًا كما كان في الماضي، وفقدت التجربة الاشتراكية مصداقيتها، وظهرت الاتجاهات الفكرية المعادية للإنسان مثل الفاشية والنازية والصهيونية والبنيوية، وهي اتجاهات وصلت إلى ذروتها في فكر ما بعد الحداثة.
ومع منتصف الستينيات تبلور الخطاب النقدي الغربي وأصبحت أعمال مدرسة فرانكفورت متداولة بين الكثيرين فظهرت دراسات كثيرة في نقد فكر عصر التنوير في الغرب. وكان ماركوز، بحديثه عن تنميط الحضارة الغربية والانسان ذي البعد الواحد، يبين أن ثمة خللًا بنيويًا في صميم الحضارة الغربية يتجاوز التقسيم التقليدي المتبع الذي يقسمها إلى حضارتين واحدة اشتراكية والأخرى رأسمالية. وأعاد كثير من المؤرخين المراجعين كتابة تاريخ الحضارة الغربية ليبينوا حجم جرائمها ضد شعوب آسيا وأفريقيا وحجم النهب الاستعماري. وظهرت كذلك كثير من الدراسات التي توجه سهام النقد الجذري إلى نظريات التنمية، وكان لحركة اليسار الجديد إسهام مهم في هذا المضمار؛ ولذا، فسواء على مستوى الممارسة أم على مستوى الفكر، لم يكن من الصعب على حملة الخطاب الإسلامي الجديد من دارسي الحضارة الغربية في منتصف القرن العشرين أن يعرفوا مثالبها، كما لم يعد بوسعهم أن يمارسوا ذلك الإعجاب الساذج بها الذي مارسه كثير من أعضاء الجيل الأول. فالحضارة الغربية التي عرفوها وخبروها مختلفة في كثير من جوانبها عن تلك الحضارة الغربية التي عرفها وخبرها ودرسها جيل الرواد وشتان ما بين الخبرتين.
ويجب أن نؤكد أن كلا الجيلين القديم والجديد، ولم يؤسس منظومته الفكرية انطلاقًا من المنظومة الإسلامية وحسب، وإنما نتيجة تفاعله مع الحضارة الغربية في وقت ذاته. وهذا أمر طبيعي للغاية، فهي الحضارة التي فرضت سيطرتها على العالم، واكتسبت مركزية بحكم الانتصارات العسكرية التي حققتها، وطرحت رؤيتها للكون باعتبارها رؤية كل البشر في كل زمان ومكان، وطرحت معرفتها باعتبارها علومًا دقيقة تصلح للتطبيق في كل المجتمعات، وفرضت نفسها باعتبارها مستقبل البشرية جمعاء، وألقت بالتحدي الذي كان على الجميع الاستجابة له، شاءوا أم أبوا.
وباختلاف نوع التحدي وحدته اختلفت الاستجابة. وقد وجد المصلحون الأوائل جوانب إيجابية كثيرة في هذه الحضارة الغربية، بل أكاد أقول أنهم انبهروا بها، وهذا ما عبر عنه الشيخ محمد عبده عبارته الشهيرة: «لقد وجدت هناك مسلمين بلا إسلام، ووجدت هنا إسلاما بلا مسلمين». ولذا كانت استجابة الجيل الأول للتحدي الغربي هي: كيف يمكن أن نلحق بالغرب؟ وكيف يمكن أن ننقل تلك المنظومة الرائعة إلى حضارتنا مع الاحتفاظ بقيمنا وبشيء من هويتنا؟
ولكن لو كانت خبرة الشيخ محمد عبده مع الحضارة الغربية مثل خبرتنا، لتردد كثيرًا قبل أن يقول قولته هذه، وقبل أن يطرح معالم مشروعه. وثمة واقعه تاريخية توضح النقطة التي أود أن أصل إليها. كان الشيخ رفاعة الطهطاوي يعيش في باريس عام 1830، ومسألة إعجابه بالحضارة الغربية مسألة معروفة لدى الجميع. ولكن في هذا العالم نفسه كانت القوات الفرنسية تدك القري الجزائرية الآمنة دكًا كان الشيخ رفاعة الطهطاوي لا يرى من حوله إلا النور الساطع الذي يغشى الأبصار ولا يسمع سوى الإيقاع المتحضر المدوي (الذي يغطي على كل الايقاعات الأخرى). أما الشيوخ الجزائريون الذين كانوا يجلسون في قراهم البسيطة فكانوا لا يرون إلا ألسنة النيران المندلعة ولا يسمعون سوى قعقعة القنابل.
وتورد إحدى كتب التاريخ أنه قيل لأحد هؤلاء الشيوخ ان القوات الفرنسية إنما جاءت لنشر الحضارة الغربية في ربوع الجزائر. وجاء رده جافًا ومقتضبًا ودالًا؛ إذ قال: «ولم أحضروا كل هذا البارود إذن؟» نحن مثل هذا الشيخ الجزائري، شممنا رائحة البارود، وشاهدنا ألسنة اللهب، وسمعنا قعقعة المدافع، ورأينا سنابك خيولهم وهي تدوس على كل شيء ثم رأينا البارود وهو يزداد انتشارًا، وشاهدنا مقدرته وهي تتحسن في الأداء بشكل مذهل إلى أن أصبح قنابل وصواريخ وأسلحة جرثومية ونووية تخصص لإنتاجها نسب مئوية عالية في ميزانيات الحكومات الغربية (ثم الشرقية والجنوبية والشمالية)، حتى أصبحت صناعة أسلحة الفتك من أهم الصناعات في عالمنا الحديث.
لو كان الشيخ رفاعة أو الشيخ عبده قد شما رائحة البارود كما فعل الشيخ الجزائري وكما نفعل نحن لما تحدث أي منهما عن مسلمين بلا إسلام. ولكن لأن رائحة البارود كانت متخفية وكان النور ساطعًا يعشى الأبصار، أصبحت القضية بالنسبة لكثير من حملة الخطاب القديم (كما أسلفنا) هي كيفية التصالح مع الحداثة الغربية واللحاق بها والتكيف معها وكيفية المزاوجة بين الإسلام والحداثة) هذا هو جوهر مشروع محمد عبده الذي ساد حتى منتصف الستينيات من هذا القرن، وهو ما نشير إليه بوصفه الخطاب الإسلامي القديم.
وهكذا أصبحت المنظومة الإسلامية جزءً من المنظومة العامة التي سادت العالم الثالث منذ بداية القرن الحالي، حين كان الجميع يبذلون قصارى جهدهم في اللحاق بالغرب والتنافس معه على أرضيته. وقد نادي الليبراليون في بلادنا بتبني المنظومة الغربية الحديثة بحلوها ومرها، وتمرد الماركسيون قليلًا وطرحوا إمكانية أن ندخل الحداثة الغربية من خلال بوابات الماركسية والدفاع عن مثل العدالة الاجتماعية، أما الإسلاميون فقد تصوروا إمكانية تبني منظومة الحداثة الغربية ومزجها بالإسلام. ولكن الجميع، رغم اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم، قد حول الغرب إلى المرجعية الشاملة الصامتة (وهذه هي رؤية الكون الكامنة وراء معظم الأيديولوجيات العلمانية والدينية في العالم العربي والإسلامي). وبطبيعة الحال تراجعت المنظومة الإسلامية وتقلصت أبعادها وفقدت شمولها باعتبارها رؤية للكون، وبدلًا من طرح تصورات إسلامية لكل مجالات الحياة، أصبحت القضية هي «أسلمة» بعض جوانب الحداثة. وكانت هذه الأسلمة تأخذ في معظم الوقت شكل «حذف» المحرمات بلا إضافة ولا إبداع، وتأكيد الجوانب «الحلال» في الحضارة الغربية أو البحث عن تلك الجوانب في المنظومة الإسلامية التي لها ما يقابلها في تلك الحضارة الغربية (الأمر الذي يعنى ضمور الجوانب الأخرى التي تشكل صميم خصوصية المنظومة الإسلامية).
حملة الخطاب الإسلامي الجديد لا يشعرون بالإعجاب نفسه تجاه الحداثة الغربية؛ ولذا نجد ان خطابهم ينبع من نقد جذري لها. وهم في هذا لا يختلفون عن كثير من المفكرين والحركات السياسية في العالم الثالث والعالم الغربي في الوقت الحاضر. فالماركسية هي شكل من أشكال نقد الحداثة، نبعت منه مدرسة فرانكفورت التي عمقت هذا النقد والأدب الرومانسي (كما أسلفنا كان احتجاجًا على الحداثة الغربية، ولكن احتجاج الأدب الحداثي كان أكثر عمقا وجذرية، فهو الذي يصور عالم الحداثة المتشيئ، حيث يتحول الإنسان إلى شيء، وتفقد الأشياء معناها، وتنكسر حلقة السببية تمامًا. ومسرح العبث هو جزء من هذا الاحتجاج الغربي على الطريق المسدود الذي أوردتنا إياه الحضارة الغربية الحديثة. وقد ظهرت أخيرًا الأصولية الدينية كامتداد جماهيري شعبوي لهذا الاتجاه الفكري، وفي العالم الثالث نجد أن الفكر القومي هو في جوهره محاولة لدخول عالم الحداثة من بوابات غير غربية، ودون فقدان الخصوصية، أي أنه ثمة إدراك ضمني مفاده أن الحداثة الغربية تنزع الخصوصية عن الانسان وتفرغه من مضمونه الانساني. والخطاب الإسلامي الجديد هو جزء من هذا التيار العالمي الأكبر، وليس مقصورًا علينا بأية حال، فثمة إحساس بأزمة الحداثة الغربية أخذ أشكالًا مختلفة في أرجاء العالم، وأخذ شكلًا إسلاميًا في العالم الإسلامي.
ومع هذا يمكن القول بأن النقد الإسلامي للحداثة يختلف عن أشكال نقد الحداثة في بقية العالم؛ إذ أنه يدرك مدى ارتباط منظومة الحداثة الغربية بالإمبريالية الغربية، ويدرك صعوبة فصل الواحد عن الآخر (والإمبريالية على أية حال كانت هي أول تجربة لنا مع الحداثة، والاستعمار الاستيطاني الصهيوني هو آخرها).
كما أن النقد الإسلامي للحداثة يتسم بأنه متفائل؛ لأنه يطرح حلولًا، على عكس النقد الغربي الحداثة فهو متشائم عدمي.
هذه هي نقطة الانطلاق الأساسية التي تتفرع عنها كل السمات الأخرى التي يمكن أن نوجزها فيما يلي:
- الخطاب الإسلامي الجديد ليس اعتذاريًا، ولا يحاول أن يقول: «نحن سبقنا الغرب في كذا وكذا»، ولا يتحدث عن الأمجاد الغابرة. ولا يبذل دعاته جهدًا كبيرًا في محاولة تحسين صورة الإسلام في الخارج. ومع هذا لا يرفض حملة الخطاب الجديد الغرب بشكل قاطع ولا يصورونه باعتباره مصدرًا لكل الشرور، فموقف الرفض الكامل للغرب، وشأنه شأن القبول الكامل له، يفترض الغرب كمرجعية صامتة.
- ما يرفضه الخطاب الإسلامي الجديد في واقع الأمر هو المركزية والعالمية التي يضفيها الغرب على نفسه (ويضفيها الآخرون عليه). كما يرفض الخطاب الإسلامي الجديد إمبريالية الغرب المرتبطة بادعائه المركزية). وعمليات النهب والقمع التي قام بها في الماضي والتي تأخذ أشكالًا جديدة في الحاضر لا تقل ضراوة عن سابقتها. وهو يرفض الجوانب السلبية في الحداثة الغربية، ويدرك أزمتها تمام الإدراك.
- رغم أن الخطاب الإسلامي الجديد يدرك أزمة الحداثة الغربية ويدرك أيضا أنه لا يوجد أي مبرر لارتكاب أخطاء الآخرين وسلوك الطريق المسدود الذي أدى إلى أزمتهم، إلا أننا لسنا مثل الشيخ الجزائري الذي شم رائحة البارود ولم ير شيئا آخر في الحضارة الغربية الحديثة. نعم لقد قرانا الأرض الخراب لإليوت ومسرحيات بيكيت وروايات كامو العبثية وكتابات دريدا العدمية، ونعرف ان الغرب قد بنى بنيته التحتية من خلال عمليات النهب التي أدت إلى التراكم الإمبريالي وليس إلى «التراكم الرأسمالي» كما يقولون. ولكننا نعرف أيضًا نظريات المعمار الغربية وكيفية استخدام الحاسوب ونظريات الإدارة المختلفة والآفاق الواسعة التي فتحتها الحداثة الغربية. فنحن نعرف مزايا هذه الحداثة، تمامًا مثلمًا نعرف أنها يمكن أن توردنا مورد التهلكة، وندرك أنها منظومة طرحت أسئلة محددة على العالم لا مناص من الإجابة عليها. فعقولنا ليست صفحة بيضاء والبداية الإسلامية لا يمكن أن تكون من نقطة الصفر الافتراضية، ومن هنا ضرورة، بل وحتمية الاشتباك والتفاعل مع الحداثة الغربية واستيعاب ثمراتها دون أن نستوعب في منظومتها القيمية. باختصار شديد، الخطاب الإسلامي الجديد لا يرى أي مبرر لاستيراد الحداثة الغربية بحلوها ومرها، كما لا يدعو لرفضها بحلوها ومرها، فهو يقف على أرضيته الإسلامية ويطور رؤيته للحداثة الغربية ثم ينفتح عليها ويوجه النقد لها ويتفاعل معها، وهذا ما يمكن تسميته بالانفتاح النقدي التفاعلي (على عكس الانفتاح السلبي المتلقي أو الرفض الشامل المصمت الذي يتأرجح بينهما الخطاب القديم).
- الخطاب الإسلامي القديم خطاب توفيقى تراكمي (وهذا نابع من تقبله لكثير من جوانب الحداثة الغربية) فهو يأخذ أجزاء جاهزة من الحداثة الغربية دون ان يدرك علاقتها برؤية الغرب للكون ثم يأخذ إجزاء جاهزة من المنظومة الإسلامية (دون أن يدرك أن الإسلام يقدم رؤية شاملة للكون) ثم «يضيف» هذا إلى ذاك. أما الخطاب الجديد فهو خطاب جذري توليدي استكشافي لا يحاول التوفيق بين الحداثة الغربية والإسلام، ولا يشغل باله بالبحث عن نقط التقابل بين المنظومة الغربية الحديثة ويحاول اكتشاف معالم المنظومة الغربية الحديثة (باعتبارها رؤية كاملة للكون) والإمساك بمفاتيحها مع الاحتفاظ بمسافة بينه وبينها. وهو يعود للمنظومة الإسلامية بكل قيمها وخصوصيتها الدينية والأخلاقية والحضارية ويستنبطها ويستكشفها ويحاول تجريد نموذج معرفي منها، يمكنه من خلاله توليد إجابات على الإشكاليات التي تثيرها الحداثة الغربية وعلى أية إشكاليات أخرى جديدة. ويرتبط بهذا المنهج التوليدي المحاولات الحديثة الرامية لتجديد الفقه من الداخل. فهي لا تنبع من محاولة فرض المقولات التحليلية الغربية على المنظومة الإسلامية، وإنما تحاول أن تكتشف المقولات الأساسية لهذه المنظومة، ويتم التجديد والإصلاح من خلال التوليد منها هي ذاتها. باختصار شديد، الخطاب الجديد، انطلاقًا من أرضية إسلامية، يفتح باب الاجتهاد بالنسبة للمنظومة الغربية والموروث الثقافي الإسلامي.
- الخطاب الإسلامي الجديد لا يقنع باستيراد الإجابات الغربية الجاهزة على الأسئلة التي يطرحها عليه الواقع ويتسم بأنه بالضرورة خطاب شامل. فعلى المستوى الجماهيري يطرح شعار «الإسلام هو الحل»، ولكن على المستوى الفلسفي يطرح الإسلام هو رؤية الكون»، وهو يتعامل مع كل من اليومي والمباشر والسياسي، والكلي والنهائي، أي أن الخطاب الإسلامي الجديد يصدر عن رؤية معرفية شاملة يولد منها منظومات فرعية مختلفة: أخلاقية وسياسية واقتصادية وجمالية فهو منظومة إسلامية شاملة تفكر في المعمار والحب والزواج والاقتصاد وبناء المدن والقانون، وفي كيفية التحليل والتفكير، وفي توليد مقولات تحليلية مستقلة؛ ولذا فالخطاب الإسلامي الجديد لا يقدم خطابًا للمسلمين وحسب، «وإنما لكل الناس» حلًا لمشاكل العالم الحديث، تمامًا مثلما كان الخطاب الإسلامي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام.
- بسبب انفتاح الخطاب الجديد بشكل نقدي تفاعلي على الحداثة الغربية، نجده قادرًا على الاستفادة بشكل خلاق منها دون أن يستوعب فيها، فمقولات مثل الصراع الطبقي وضرورة التوزيع العادل للثروة وقضية المرأة وأثر البيئة على تشكيل شخصية الانسان هي قضايا كانت مطروحة داخل المنظومة الإسلامية، ولكن حساسية الخطاب الجديد وإدراكه المتعمق لها ازداد من خلال احتكاكه بالحداثة الغربية. كما أن حملة الخطاب الجديد لا مانع عندهم من الاستفادة بهذه الحداثة في اكتشاف آليات الحلول أو حتى الحلول ذاتها، طالما أنها لا تتناقض مع النموذج الإسلامي.
- الانفتاح على المنظومة الغربية والتفاعل النقدي معها يجعل الخطاب الجديد مدركًا لأبعاد كان من الصعب إدراكها دون هذا التفاعل. فمسألة مثل العلاقات الدولية والكوكبة والبعد الكوني في الظواهر المحلية وخطورة الإعلام والدولة المركزية وزيادة وقت الفراغ وعمليات التنميط التي تسم الحداثة الغربية هي أمور. لم تكن مطروحة على الانسان من قبل، ومن ثم لم يطرحها الخطاب الإسلامي القديم.
- اكتشف الخطاب الإسلامي الجديد أن الانفتاح على الحداثة الغربية ودراستها بشكل نقدي خلاق قد يفيد في تنمية الوعي النقدي فمن خلال معرفة الآخر والتعمق في معرفته سندرك الطرق المسدود الذي دخله وحجم الكارثة التي يعاني منها، فتزداد معرفة وثقة بأنفسنا إدراكا لذاتنا بكل أبعادها وسيساعدنا هذا الموقف المنفتح النقدي التفاعلي على اكتشاف الإمكانات التوليدية الخلافة داخل المنظومة الإسلامية.
- يدرك الخطاب الإسلامي الجديد أن العلوم الانسانية ليست علوما دقيقة عالمية محايدة (كما يدعي البعض). وأنها تحتوي على تحيزات انسانية عديدة، وتختلف بشكل جوهري عن العلوم الطبيعية، وأنها لا تفقد قيمتها لذلك، بل أنها تزداد مقدرة على التعامل مع ظاهرة الانسان. وينبع الاختلاف بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية من ان الموضوع الأساسي للعلوم الانسانية، أي الانسان لا يمكن رده في كليته إلى النظام الطبيعي / المادي، فالواقع الانساني غير مترادف مع الواقع المادي، رغم وجود الانسان في عالم الطبيعة / المادة؛ ولذا فالخطاب الإسلامي الجديد يحاول أن يؤسس علومًا انسانية لا تستبعد الانسان، ومن ثم هي مختلفة في منطلقاتها وطموحاتها ومعاييرها عن العلوم الطبيعية، ولا تزعم أنها محايدة منفصلة عن القيمة بل تعبر عن المنظومة القيمية الإسلامية (وهذه هي إسلامية المعرفة).
- يدرك حملة الخطاب الجديد ما يسمى «العلم في منظوره الجديد» وهو علم يحتوي على مفاهيم مثل اللاتحدد، ولا يتحرك داخل إطار المفاهيم السببية الصلبة التي كان يتحرك العلم القديم في إطارها.
- يدرك الخطاب الإسلامي الجديد إن مفردات المعجم الغربي ليست جزءًا من معجم لغوي وحسب، وإنما جزء من معجم حضاري متكامل. فكلمات مثل «التقدم» تجسد مفاهيم وتوجد داخل سياق حضاري مركب يحدد مضمونها ومعناها.
- من أهم ثمرات الانفتاح النقدي على الغرب إدراك تركيبية مقولة العقل، والتناقضات الكامنة فيه. فكلمة «العقل» في المنظومة الإسلامية تحمل معنى محددًا وقد تصور الجيل السابق بسبب إعجابه بالحضارة الغربية ولعدم تملكه لناصية خطابها الحضاري) إن كلمة «عقل» في المعجم الفلسفي الغربي الحديث مترادفة مع كلمة «عقل» في المعجم الإسلامي؛ ولذا كان هناك إعجاب عميق بالعقلانية الغربية وبفكر حركة التنوير الغربية. ولكن الخطاب الجديد على علم بالدراسات النقدية الغربية في قضية العقل والتي قامت بتقسيمه إلى عشرات العقول: العقل الأداتي - العقل النقدي - العقل الوظيفي - العقل المجرد.. إلخ. كما تتحدث هذه الإمبريالي - الدراسات عن نفي العقل» و «تدمير العقل» و«تفكيك العقل» و«إزاحة العقل عن المركز»؛ ولذا لم يعد من الممكن افتراض إن كلمة «عقل» كما وردت في المعجم الإسلامي مرادفة لكلمة «عقل» كما وردت في المعجم الغربي الحديث. ومع ظهور النزعات اللاعقلانية والعبثية في الغرب أصبحت المسألة أكثر وضوحًا وتبلورًا.
- يدرك الخطاب الإسلامي الجديد قضية انفصال العلم والتكنولوجيا والإجراءات الديموقراطية عن القيمة والغائية الانسانية. يحاول الخطاب الإسلامي الجديد حل هذه الإشكاليات، فمثلا في حالة انفصال العلم والتكنولوجيا عن القيمة يحاول الخطاب الإسلامي الجديد الاستفادة من العلم والتكنولوجيا وكل ثمرات الحضارة الغربية دون أن يتبنى رؤيتها للكون بحيث تمكن مزاوجة الرؤية العلمية التي تدعي الحياد والمنظومة القيمية الإسلامية. بل ويسري الشيء نفسه على الديمقراطية، فمحاولة التمييز بين الديمقراطية والشورى هي محاولة لاستيعاب الإجراءات الديمقراطية داخل المنظومة القيمية الإسلامية، بحيث لا تصبح الإجراءات الديمقراطية المتجردة من القيمة هي المرجعية وسيلة لا غاية.
- يدرك الخطاب الجديد المكون الحضاري في الظواهر. فالخطاب القديم يقف عند حدود التمييز بين الحلال والحرام فالسيارة والهامبورجر لا شك حلال، واللحم المعلب ان كان لا يحتوي على مكونات الخنزير حلال وهكذا. أما البعد الحضاري الكامن في السيارة وأن السيارة وما حولها هي رؤية كاملة للكون، فهذا ما لم يدركه الرواد (وهذا ما لم يدركه الانسان الغربي نفسه آنذاك). انظر السيارة على سبيل المثال، حينما يدير المرء مفتاح سيارته، فهو لا يتعامل مع مجرد آلة توصله من مكان لآخر، بل يتعامل مع رؤية كاملة للكون يتطلب تسييرها البحث عن البترول وشق بطن الأرض وحمل البترول عبر البحار، الأمر الذي يتسبب عنه تلوث الجو والبر والبحر. ثم تؤسس مدن على أساس ضرورة تعظيم سرعة السيارة فتهدم الأحياء التقليدية والمباني التراثية وتصبح السرعة هي المعيار الوحيد للحكم على مدى صلاحية المدينة أو فسادها، وهكذا. وقل الشيء نفسه عن ساندوتش الهامبورجر والتيك أواي فالكون الحضاري الكامن في هذه السلع، التي تبدو بريئة تمامًا وحلال بشكل قاطع ولا غبار عليها من الناحية الدينية المباشرة مرتبط برؤية للكون تقف على طرف النقيض من رؤية الكون الإسلامية، وهذا ما يدركه دعاة الخطاب الإسلامي الجديد.
- يتضح إدراك الخطاب الإسلامي الجديد لأهمية المكون الحضاري في تقبله للفكرة القومية. فحملة هذا الخطاب لا يجدون أي مبرر للمواجهة مع الحركات القومية ذات التوجه العلماني. فالخطاب الإسلامي الجديد يقبل التنوع الحضاري داخل إطار الوحدة الإسلامية العالمية كما أنه يدرك أهمية التحالف مع العناصر القومية في المواجهة العامة مع الإمبريالية العالمية والنظام العالمي الجديد.
- الخطاب الإسلامي الجديد مدرك تمامًا المشكلة البيئة وأن مفاهيم مثل التقدم الدائم واللامتناهي (وهي مفاهيم محورية في الحداثة الغربية معادية للطبيعة والانسان وللحدود، وفي نهاية الأمر لله، فهي مفاهيم كافرة. ومن هنا بحث الخطاب الجديد الدائب عن مناهج جديدة في الإدارة ونماذج جديدة في تطوير الدولة (وهي تعبير عن اهتمام الخطاب الجديد بالخصوصية). ولعل من أهم القضايا التي تشغل الخطاب الجديد هي نظرية التنمية فالخطاب الجديد يرى أن نظريات التنمية الإسلامية لابد أن تكون مختلفة جذريًا عن نظريات التنمية الغربية التي تروج لها المنظمات التي يقال لها: دولية، والتي أثبتت فشلها في الممارسة، والتي أدت إلى الأزمة البيئية. ويرتبط بهذا نقد الخطاب الجديد للدعوة المستمرة إلى الاستهلاك المتصاعد ثورة التوقعات المتزايدة وإدراكه لمدى خطورته على البيئة والمصادر الطبيعية وكيان الانسان النفسي.
- الخطاب الإسلامي الجديد مدرك للقضية الفلسفية الأساسية في العالم الحديث وهي قضية النسبية المعرفية التي تؤدي إلى العدمية، وهو يطرح في مقابلها ما أسميته «النسبية الإسلامية» التي تذهب إلى أن ثمة مطلقًا واحدًا = وهو الله سبحانه وتعالي، المنزه عن الطبيعة والتاريخ والزمان والمكان والبشر. ومطلقية الإله تعني نسبية كل شيء آخر. ولكن بسبب وجود الإله المطلق خارج الزمان النسبي فإنه يصبح مركز الكون الذي يمنحه الهدف والغاية والمعنى، وهو ما يعني أن العالم لا يسقط في النسبية المطلقة ومن ثم اللامعنى. فالنسبية الإسلامية هي نسبية نسبية. انطلاقًا من هذا ثمة إدراك لتركيبية الحقيقة ونسبية كثير من جوانبها وتغيرها وحركيتها، وثمة إدراك لما يوجد من تداخل بين المطلق والنسبي، وأن الخطاب الانساني هو أولًا وأخيرًا اجتهادات يقوم بها بشر داخل الزمان والمكان في محاولة دائبة لفهم كلام الله.
- كل هذا يعنى الإيمان بفكر التدافع وأن العالم ليس في حالة جمود وإنما حالة حركة والتدافع ليس بالضرورة الصراع، حتى إن أخذ هذا الشكل أحيانًا. وثمة إيمان أيضًا بفكرة التداول، فالثبات الله وحده ونحن لسنا بمفردنا في هذا العالم. كل هذا يعنى في واقع الأمر قبول التعايش مع الآخر واكتشاف الرقعة المشتركة معه. ومن هنا ظهر فقه الأقليات الحديث، سواء الأقليات غير المسلمة في المجتمعات الإسلامية أو الأقليات المسلمة في المجتمعات غير المسلمة، وهذا الفقه يصدر عن مفاهيم العدل والمساواة في الإسلام.
- نجد في الخطاب الإسلامي أيضًا إدراكًا لمشكلات ما بعد الحداثة، والتي تتبدى في شكل الهجوم على كل النصوص الانسانية والمقدسة، بحيث يتحول القرآن على سبيل المثال إلى نص تاريخي أو تاريخاني كما يقولون، أي يمكن تفسره بقضه وقضيضه بالعودة للظروف والمواضعات الزمنية. وأعتقد أن الأستاذ طارق البشري أسهم إسهامًا مهمًا في هذا المجال. فمن خلال دراساته حاول استعادة الثبات للنص المقدس، وبين أوجه الاختلاف بين الفقهاء في كثير من الأحيان لا ينبع من تفسيرهم للنص وإنما من فهمهم للواقعة الانسانية التي يريدون إصدار الفتوى بخصوصها. هذه مسألة مهمة؛ لأنه في إطار ما بعد الحداثة ثمة هجوم على أي ثبات وأية معيارية وثمة انكار لأية ركيزة نهائية.
- أعتقد ان ثمة محاولة لاكتشاف مقولات تحليلية وسطية تميز الخطاب الإسلامي عن الخطاب الحداثي الغربي، الذي يتسم بالتأرجح بين قطبين متنافرين فالخطاب الحداثي الغربي يطلب من المرء إما اليقين الكامل أو الشك الكامل، إما أن يكون هناك عقل مطلق أو لا عقل على الإطلاق، إما أن يهيمن العقل تمامًا أو يفكك العقل، إما أن يكون هناك حضور كامل أو غياب كامل. إنه عقل ينتقل من العقلانية المادية إلى اللاعقلانية المادية. بينما يحتوي الخطاب الإسلامي الجديد - حسبما سمعنا من الأستاذ فهمي هويدي والأستاذ طارق البشري- على إمكانية وجود الفراغات، أو إمكانية التعددية، وإمكانية ألا يكون اليقين مطلقًا وألا يكون الشك نهائيًا. فهناك ما بينهما. إذ ليس مطلوبًا من المرء ان يأتي ببراهين قاطعة مائة بالمائة وأن ترتبط حلقات السببية بشكل كامل صارم (وهو ما أسميته «السببية الصلبة» في الحداثة الغربية) إذ يكفي إن يأتي الانسان بقدر معقول من البراهين والأسباب والقرائن، وإن يربط الأسباب بالنتائج بشكل كاف وليس بالضرورة صارمًا وهذا ما اسميته «السببية الفضفاضة». وكلمة فضفاضة يصعب ترجمتها، إذ ان المفردة التي تقابلها في الإنجليزية هي Loose والتي تعني «منحلة» أو «متفككة» أو كلمة Wide بمعنى «عريض» أو «فسيح» بينما فضفاضة» في العربية تحمل معنى السماحة وعدم الترابط الذي يسمح بالحرية دون ان يسقط بالضرورة في التفكك. والسببية في تصوري - هي جوهر الرؤية المعرفية الإسلامية التي تبين ان ألف لن تؤدي إلى باء حتمًا ومائة بالمائة ودائمًا، ولكنها ستؤدي إلى باء بإذن الله. «بإذن الله» هي المسافة التي تفصل بين الخالق والمخلوق ولكنها هي التي تخلق مجالًا يمارس فيه الانسان حريته ومن ثم يصبح كائنًا مسئولًا حاملًا للأمانة. إنها تأكيد لما الفضفاضة يسمى في الفقه الإسلامي «البينية».
- أشار الأستاذ بشير نافع إلى شيء مهم جدًا حين قال أن الخطاب الإسلامي في المجتمعات الإسلامية التقليدية هو الشريعة، فالشريعة لا تزال هي الخطاب الإسلامي القديم والجديد. ولكن الخطاب الجديد يحاول أن يحل مشكلة ما أسميته «ثنائية المصطلح». فالشريعة كما نعرف منفتحة، قادرة على توليد إجابات على الأسئلة الكلية والنهائية التي يطرحها الواقع على الانسان المسلم عبر تاريخه. ولكن مصطلحات الشريعة بسبب ظروف الانقطاع التاريخي والحضاري الذي سببه الغزو الاستعماري) أصبحت مغلقة بالنسبة للكثيرين. وما يحاوله الخطاب الإسلامي الجديد هو فك شفرة هذا المصطلح، بحيث يمكن استخلاص الحكمة الكامنة فيه الدكتور سيف حين يتحدث عن أن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" هو المصطلح الإسلامي للتعبير عن مشكلة المشاركة في السلطة. هذا لا يعنى أن ثمة ترادفًا بين المفهوم الغربي والمفهوم الإسلامي للقضية. كل ما يرمي إلى توضيحه الدكتور سيف أن هذه القضية الحديثة التي يعبر عنها بطريقة حديثة هي ذاتها القضية التي توجهت لها المنظومة الإسلامية من خلال مصطلحها الخاص. مثل هذا الاجتهاد سيساعدنا على زيادة المقدرة التوليدية للمنظومة الفقهية، كما سيساعد المسلمين على ترسيخ أقدامهم على أرضيتهم العقائدية.
- نظرًا لعزل الشريعة عن واقعنا السياسي والاجتماعي أصبحنا نراها كما لو كانت مجموعة من الأحكام والآراء غير المترابطة، ولكن عملية توليد الإجابات تتطلب إدراك ترابط أجزاء الشريعة وتكاملها، وأنها تعبر عن رؤية للكون، وهذا ما يحاول أن ينجزه الخطاب الجديد. ولا شك في أن مبحث المقاصد التقليدي يتعامل مع هذه القضية، فمن خلاله تمكن التفرقة بين الكلي والجزئي، والنهائي والمؤقت، والجوهري والعرضي، والثابت والمتغير، والمطلق والنسبي، وهذا ما نحتاج إلى تطويره وتعميمه لنصل إلى نموذج معرفي إسلامي نابع من القرآن والسنة، هذا النموذج يأخذ شكل هرم، على قمته شهادة أن لا إله إلا الله، تليها القيم القطب مثل العدالة والمساواة، ثم نأتي بعد ذلك للأحكام الجزئية المختلفة. ومن ثم يمكن توسيع نطاق الاجتهاد دون خوف كبير من الزلل؛ إذ إن الاجتهاد سيتم في إطار النموذج المعرفي الهرمي الذي تم استخلاصه (عبر الاجتهادات المستمرة) من القرآن والسنة، هذا النموذج سيكون هو وحده المعيار الذي يتم من خلاله إصدار الأحكام.
- من السمات الأساسية التي تسم الخطاب الإسلامي الجديد إدراكه لقضية السلطة وآلياتها المتعددة المتداخلة وعلاقة الواقع المحلي بالعلاقات الدولية كما يدرك الخطاب مدى تركيبية الدولة الحديثة وتغولها ومقدرتها على الهيمنة والتغلغل حتى في حياة الانسان الخاصة. والخطاب الجديد يدرك أيضا أن الدولة المركزية الضخمة هي أخطبوط له منطقه الكمي الخاص الذي يتجاوز إرادة القائمين على الدولة إسلاميين كانوا أم ماركسيين أم ليبراليين. فدور البيروقراطية في صنع القرار وتوجيه الحاكم حسب أهوائها وأغراضها مسألة أصبحت واضحة تمامًا. كما يدرك الخطاب الجديد أن الدولة لها أجهزتها «الأمنية» المختلفة الإعلام) - التعليم التي تحكم قبضتها على الجماهير من خلال التسلية والإغراق بالمعلومات المتناثرة والأغاني التي لا تنتهي وإعادة كتابة التاريخ؛ ولذا يصبح الاستيلاء على الدولة ليس هو الحل الناجع لمشاكل المسلمين كما كان يتصور بعض حملة الخطاب القديم، بل تصبح القضية هي ضرورة محاصرة الدولة، وتقليم أظفارها حتى يعود الاستخلاف للأمة، ومن هنا نجد الاهتمام بفكرة الأمة بدلًا من فكرة الدولة، ومن هنا النقد المتزايد لفكرة الدولة المركزية والاهتمام بالمجتمع الأهلي ودور الأوقاف.
- الخطاب الإسلامي الجديد، نظرا لشموله واهتمامه بالجانب الحضاري وبرؤيته للكون، يولى اهتمامًا كبيرًا للعنصر الجمالي والفني فلا يكتفي بمقولتي: حلال وحرام، وإنما يحاول أن يطور رؤية شاملة للفنون الإسلامية تستند إلى الرؤية الإسلامية للكون. ومن هنا ظهرت المحاولات النظرية والتطبيقية الجديدة في مجال المعمار ومختلف الفنون. وهذا الجانب في الخطاب الإسلامي الجديد هو تعبير عن الانفتاح النقدي الخلاق. فكثير من الفنانين الإسلاميين أو المهتمين بالفن الإسلامي في العصر الحديث تعلموا إما في الغرب أو في الشرق على أسس غربية، ومع هذا فإنهم ينسلخون عن المنظومة الغربية ويوجهون لها النقد ويستفيدون من المعرفة التي اكتسبوها في محاولة توليد رؤى فنية تترجم إلى مبان على طراز إسلامي تستجيب لمتطلبات العصر الحديث. ويلاحظ أن هؤلاء الفنانين يدرسون التراث الفني الإسلامي من زوايا جديدة ويعيدون اكتشاف أسسه النظرية، مستفيدين من آليات التحليل التي تعلموها في الغرب. كما أنهم بدأوا يهتمون بالكتابات الإسلامية التراثية في هذا المضمار.
- من أهم جوانب الخطاب الإسلامي الجديد قراءة التاريخ، فثمة رفض لفكرة التقدم الخطي اللانهائي ورفض للمفاهيم الخطية الواحدية - (unil (inear التي تفترض وجود نقطة نهائية واحدة وهدف واحد يتحرك نحوه التاريخ البشري بأسره، الأمر الذي يفترض ضرورة رؤية تواريخ البشر من خلال منظار واحد، والحكم عليها من خلال معيار واحد ولكن هذا المنظار الواحد في الواقع ليس منظارًا عالميًا، كما يُدَّعي، وإنما هو منظار الحضارة الغربية والمعيار هو معيارها. وأعتقد أن الدكتور بشير نافع أعطانا نموذجًا تطبيقيًا لذلك الرفض بأن قدم قراءة للتاريخ الإسلامي من الداخل دون استيراد مقولات تحليلية من خارج النسق. وعملية القراءة هنا هي عملية متعاطفة تفسيرية، ولكنها أيضًا عملية نقدية. لقد قرأ الدكتور بشير الوثائق التي لم يقرأها المؤرخون الغربيون أو قرأوها وقاموا بتهميشها لعدم أهميتها في نظرهم؛ ولذا فقد نجح في تقديم رؤية جديدة، ومن ذلك اكتشافه لدور التصوف والطرق الصوفية الذي يهمله المؤرخون الذين تم تدريبهم داخل المنظومة العلمانية، فهم ينظرون إلى التصوف باعتباره مجرد خزعبلات، بينما يرى الدكتور بشير نافع أن دراسة التصوف والطرق الصوفية مدخل أساسي لفهم التاريخ الإسلامي. وقد بين الأستاذ طارق البشري، في بعض دراساته، أهمية الطرق الصوفية في فهم تاريخ مصر الحديثة.
____________________
المصدر: عبد الوهاب المسيري، معالم الخطاب الإسلامي الجديد، المسلم المعاصر، العدد 86، 10 نوفمبر 1997، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/4ePlAls