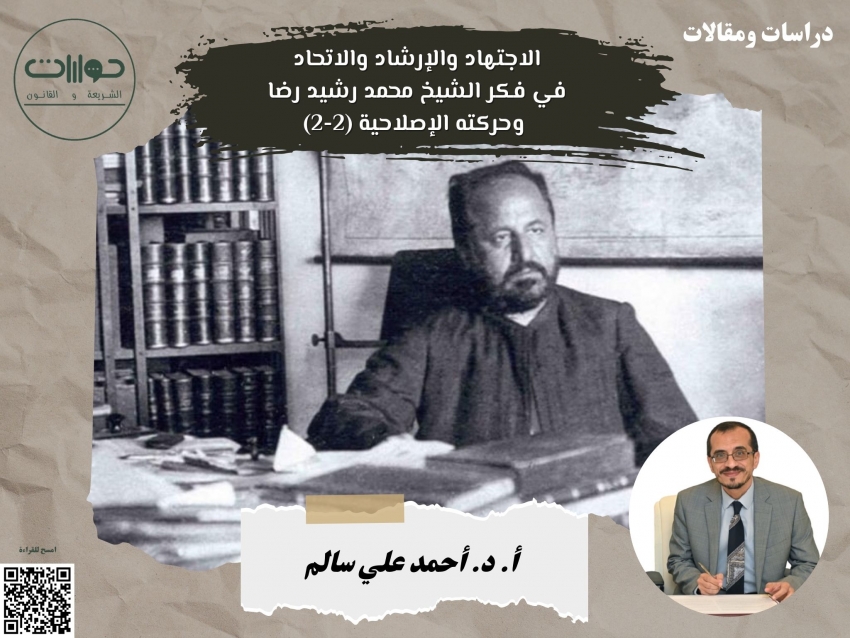الاجتهاد والإرشاد والاتحاد في فكر الشيخ محمد رشيد رضا وحركته الإصلاحية (2-2)*
المبحث الثاني
المحاور الرئيسية لفكر الشيخ رشيد رضا التجديدي وجهوده الإصلاحية
بالإضافة إلى عمل الشيخ رشيد رضا في تحرير مجلة المنار، كان يكتب فيها كثيرًا من المقالات، وقد صرح في أكثر من موضع فيها أنه صاحب جميع المقالات غير المعزوة إلى أحد. وقد جمع الشيخ بعض مقالاته في كتب نشرها لاحقًا، مثل "محاورات المصلح والمقلد". كما أعادت بعض دور النشر طباعة هذه الكتب وغيرها من المقالات التي كتبها الشيخ في مجلة المنار. ومن خلال هذا التراث الفكري، تتميز عدة إسهامات تمثل محاور فكر الشيخ رشيد رضا التجديدي وجهوده الإصلاحية.
أولًا: الاجتهاد بالجمع بين الأصول الإسلامية والأساليب العصرية
يميز الشيخ رشيد رضا بين ثلاث فرق من المسلمين تتنازع أمر الأمة في العصر الحديث،[16] وهي حماة تقليد الكتب المدونة في المذاهب المتبعة، ودعاة الحضارة العصرية والنظم المدنية والقوانين الوضعية الذين يقولون إن الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمان، ودعاة الإصلاح الإسلامي المعتدل الذين يثبتون إمكانية الجمع بين إحياء الإسلام وتجديد هدايته الصحيحة باتباع الكتاب والسنة الصحيحة وهدي السلف الصالح من جانب وأشرف أساليب الحضارة والنظام من جانب آخر. ويقرر الشيخ القواعد المقررة لدى حزب الإصلاح المعتدل الذي ينتمي إليه. ومن أهم هذه القواعد شمول نصوص القرآن والسنة للأحكام رغم تفاوت الأفهام فيها، وأن النصوص الكلية مغنية عن القياس، وأن القياس الصحيح لا يخالف الشرع، فليس في الشريعة شيء يخالف القياس. ويورد الشيخ ما حققه الشوكاني في مسألة القياس، حيث استدل عليه بالقرآن والحديث والإجماع.
فالشيخ يؤيد بقوة إثبات الرأي والقياس وينعى على منكريهما، حيث يبين أن الرأي ثلاثة أقسام: باطل وصحيح وموضع اشتباه. أما الرأي الباطل فهو خمسة أنواع: الرأي المخالف للنصوص، والكلام في الدين بالخرص والظن، والرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله، والرأي الذي أحدثت به البدع، والقول في شرائع الدين بمجرد الاستحسان والظنون. وهذا الرأي الباطل مذموم بالطبع. أما الرأي المحمود فهو أربعة أنواع: رأي علماء الصحابة، والرأي الذي يفسر النصوص، ورأي جماعة الشورى، والاجتهاد الذي أجازه الصحابة فيما لا نص فيه. وما بين الرأيين المذموم والمحمود يقع الرأي موضع الاشتباه. ثم يبين الشيخ الأخطاء التي وقع فيها نفاة القياس ومنكريه وهي أربعة: رد القياس الصحيح، وتقصيرهم في فهم النصوص، وتحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، والاعتقاد ببطلان عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم. كما وضح الشيخ أخطاء وقع فيها مثبتو القياس أيضًا.
ولا يتعارض إثبات القياس مع كمال الدين، فالشيخ يقرر أن الزيادة على نصوص الشارع والتنطع في الدين باستعمال الرأي في العبادات وأحكام الحلال والحرام مخلًا بيسر الإسلام ومنافيًا لمقصده. ويشرح الشيخ عشر مسائل أو مقدمات أساسية للبحث في هذا الأمر، وهي أن الله تعالى قد أكمل دينه، وأن هذا الدين يسر، وأن القرآن هو أصل الدين، وأن الرسول معصوم من الخطأ، وأن الله فوض إلى المسلمين أمور دنياهم، وأن الله جعل الإسلام صراطه المستقيم لهداية البشر في أمورهم الروحية والجسدية، وأن النبي كان يكره كثرة سؤال المؤمنين له، وأن السلف الصالح كانوا يذمون الإحداث والابتداع، وأن الإسلام دين توحد واجتماع، وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ويسهب الشيخ في تفسير آية النهي عن السؤال الواردة في سورة المائدة، ويورد خلاصة أحاديث النبي وأقوال العلماء في كراهة السؤال. ويختتم الشيخ الكتاب ببحث في التزام النصوص في العبادات واعتبار المصالح في المعاملات مع ذكر آراء الإمام مالك والطوفي والشاطبي في المسألة.
ويطرح الشيخ رشيد رضا قضية الاجتهاد في شكل محاورات بين شاب وشيخ،[17] وهي طريقة كانت مألوفة في زمنه لتقديم الأفكار الجديدة، ومن أمثلتها كتاب (علم الدين) الذي روى فيه علي مبارك حياته خلال بعثته في فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر، في صورة محاورات بين شيخ يدعى علم الدين يمثل علي مبارك نفسه والمعترضين على أفكاره الإصلاحية.[18] أما في محاورات الشيخ رشيد رضا فقد كان هو الشاب الذي يدافع عن الاستدلال الصحيح، وبطلان التقليد، ووجوب البصيرة في الدين، واتباع سبيل السلف الصالحين وطريق الوحدة الإسلامية في المسائل الدينية والسياسية والقضائية. فالشاب من مريدي الإصلاح الذاهبين إلى وجوب خروج الأمة مما هي فيه من التقاليد الحادثة في الملة والرجوع بالدين إلى بساطته الأولى بالاقتصار على هدي الكتاب وصحيح السنة وسيرة السلف وحذف كل ما زاده الخلف من الغلو في الدين وتكثير التكاليف وإبرازها بصورة تعتاص على الأذهان. وفي المقابل فإن الشيخ من المحافظين على التقاليد التي عليها الأمة من قرون طويلة، المعتقدين أن الأخذ بالكتاب والسنة مخصوص بالمجتهدين الذين انقرضوا ويستحيل وجود غيرهم، وأن كتب المتأخرين من أموات العلماء خير من كتب المتقدمين وأجمع وأفيد في التحصيل وأنفع.
وقد نشر الشيخ رشيد رضا هذه المحاورات في مجلة المنار تحت عنوان "محاورات المصلح والمقلد"، ونقل فيها الكثير مما كتبه الإمام ابن قيم الجوزية، ثم جمعها في كتاب وألحق بها إجابات أسئلة وردت إليه من باريس في ذات موضوع المحاورات. ويضم الكتاب ثلاث عشرة محاورة تحث على الاعتماد على الدليل وتبين طرق الاستدلال الصحيحة والفاسدة، وتشرح حالة المسلمين العامة وشقائهم في دنياهم بسبب ترك الشريعة. ويناقش الشيخ أيضًا عمر الدنيا وتأثير الاعتقاد بقرب الساعة والأحاديث الواردة في ذلك. كما تذم المحاورات بدع الباطنية حول أسرار الحروف وادعاء معرفة الغيب بطرق متباينة وبطلان ذلك. ويحتد جدل المتحاورين حول قضايا الاجتهاد والتقليد وأثرهما في الوحدة الإسلامية، ثم يتطرقان ومعهما مقلد ثان إلى علاقة التقليد بالتلفيق والإجماع. ويتوصل المتحاوران أخيرًا إلى ضرورة الأخذ بالدليل، حيث نهى الأئمة وأصحابهم عن التقليد لما فيه من خطر على الوحدة الإسلامية. أما "الأسئلة الباريسية" فتدور إجاباتها حول ضرورة الاجتهاد ومضار تعصب المذاهب ومواقف الأئمة من ذلك. والكتاب حجة قوية في الدعوة إلى الاجتهاد كسبيل للوحدة الإسلامية، وفي دحض دعوى أنصار التقليد والتعصب المذهبي.
وتتجلى ممارسة الشيخ للاجتهاد في علمي التفسير والفقه. فقد وضع الشيخ رشيد رضا مع أستاذه محمد عبده تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار.[19] ويوضح الشيخ في مقدمة التفسير وجه الحاجة إليه بالنظر إلى أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل القارئ عن مقاصد القرآن العليا وهدايته السامية بمباحث في الإعراب وقواعد النحو، ونكت المعاني ومصطلحات البيان، وجدل المتكلمين، وتخريجات الأصوليين، واستنباط الفقهاء المقلدين، وتأويلات المتصوفين، وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض، وكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات الإسرائيليات، ومسائل العلوم الرياضية والطبيعية وغير ذلك، كما أن أكثر التفسير المأثور سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب. أما تفسير المنار فتتوجه عنايته إلى هدي القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه، وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح. كما يراعي هذا التفسير مقتضيات هذا العصر في سهولة التعبير ومراعاة أفهام صنوف القارئين وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها. ويصف الشيخ تفسير المنار بأنه تفسير سلفي أثري مدني عصري إرشادي اجتماعي سياسي.
وقد اشترك الشيخان محمد عبده ورشيد رضا في وضع هذا التفسير، فبدأ الشيخ محمد عبده من أول سورة الفاتحة وحتى وفاته عند قوله تعالى (وكان الله بكل شيء محيطًا) من الآية 125 من سورة النساء، وأكمل الثاني التفسير من حيث انتهى الشيخ عبده وحتى وفاته عند قوله تعالى (توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين) من الآية 101 من سورة يوسف.[20] ومع ذلك فإن تفسير الأجزاء الأولى من القرآن لم يكن خالصًا للشيخ محمد عبده، إذ أنه لم يكتب تفسيرًا بل ألقاه إلقاءً في الجامع الأزهر، وكان الشيخ رشيد رضا يكتب أثناء الدرس مذكرات بأهم ما قاله الشيخ عبده، ثم يطلعه على ما أعده منها للطبع في مجلة المنار، فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات. ويؤكد الشيخ رشيد رضا على أن هذا التفسير لم يكن كله نقلًا عن الشيخ عبده أو معزوًا إليه، بل كان من إنشاء الشيخ رشيد رضا نفسه، اقتبس فيه من دروس الشيخ عبده جل ما استفاده منها، فكان لا يرى حرجًا مما يعزوه إليه مما فهمه منه وإن لم يكتبه عنه في مذكرات الدرس، مستندًا إلى أن إقرار الشيخ عبده يؤكد صحة الفهم وصدق العزو.
ويتميز منهج الشيخ محمد عبده في التفسير بالتوسع فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون واختصار ما أبرزوه من مباحث. ويزيد منهج الشيخ رضا بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواءً كان تفسيرًا لها أو في حكمها، كما ينفرد بتحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء، والإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة، والاستطراد في مناقشة المسائل التي تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر أو يقوي حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة أو يحل المشكلات المستعصية على الحل. وقد جاء التفسير كما أراده له صاحبه متميزًا وشاملًا وعصريًا، ولا ينقصه إلا من يتمه على منهج واضعيه رحمهما الله.
أما في علم الفقه، فرفض الشيخ رشيد رضا الالتزام بأحد المذاهب، واجتهد ما وسعه الاجتهاد. ويتضح ذلك بالأخص في مجالي المعاملات المالية وحقوق النساء. إذ جاء كتابه عن الربا والمعاملات في الإسلام تطبيقًا عمليًا جريئًا لدعوى الاجتهاد ونبذ التقليد، حيث اجتهد الشيخ في إحدى أكثر مسائل الفقه تعقيدًا وإثارة للجدل في زمن ادعى فيه البعض أن باب الإجتهاد مغلق، ولم يتهيب من إعلان ما يرى حقًا، متحديًا الرأي السائد لدى الفقهاء المتأخرين المقلدين في المسألة والذي رآه الشيخ غير منسجم مع النصوص واجتهاد السلف وكبار العلماء. وكان هذا الاجتهاد سببًا في اتهام الشيخ بتحليل ما حرم الله من الربا، وهو بريء من ذلك.[21]
والكتاب هو إجابة الشيخ المنشورة في مجلة المنار عن طلب للفُتيا حول الربا والمعاملات المالية في الإسلام نشرته حكومة حيدر أباد الهندية الإسلامية ووزعته على العلماء المشهورين في الأقطار الإسلامية طالبة منهم بيان آرائهم فيه بالدليل الشرعي. وقد أورد الشيخ النص الكامل لرسالة الاستفتاء الهندية بحواشيها وما تضمنته من فتاوى لبعض علماء الهند في المسألة من منظور الفقه الحنفي، ثم أجاب إجمالًا عن المسائل الأربع التي وردت في نهاية الاستفتاء قبل أن يحقق البحث تحقيقًا مفصلًا غير مقيد بمذهب من المذاهب.
وقد ميز الشيخ بين ثلاثة أنواع من المعاملات المالية وهي: الربا القطعي المحرم لذاته، والربا الظني المنهي عنه لسد الذريعة، والبيع والتجارة. وانتقد تكثير الفقهاء لأحكام الربا بالظن والرأي، بينما كان مذهب السلف هو أن الحرام ما حرمه الله بنص كتابه. ويشرح الشيخ ربا الجاهلية المحرم بنص القرآن، ويورد أقوال أئمة الفقه والتفسير والحديث في الربا والبيع، من أمثال ابن عباس وابن جرير والشافعي والحافظ ابن حجر والجصاص والكياالهراسي والطبرسي وابن رشد والشاطبي وابن القيم وغيرهم. ويخلص الشيخ إلى تأييد رأي ابن عباس وغيره من المحققين في حصر الربا القطعي المحرم لذاته والمراد بالوعيد الشديد في ربا النسيئة المذكور في القرآن، أما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع. ويبين الشيخ حكمة النهي عن ربا الفضل في النقدين (أي الذهب والفضة) والقوت الغالبة، معتمدًا على ما حققه ابن القيم في هذه المسألة. ويورد فصلًا في الحيل في الربا، مبينًا معنى الحيلة وأول من أدخلها في الشرع، والخلاف حول اختلاف حكم الحيل باختلاف النيات.
أما حقوق النساء فقد كانت موضوع كتاب رد فيه الشيخ على بعض الشبهات المتعلقة بموقف الإسلام من المرأة. وقد دوَّنه استجابة لدعوة جماعة من مسلمي الهند لوضع رسالة في أهم ما جاء في القرآن والسنة من حقوق النساء والإصلاح الذي يجب عليهن معرفته والمطالبة به.[22] فيبدأ الكتاب ببيان حال النساء في العالم كله قبل البعثة المحمدية وما جاء به الإسلام من الإصلاح لها. ثم يبني حجة الكتاب على قاعدة أن المرأة إنسان وهي شقيقة الرجل، وأن إيمان النساء كإيمان الرجال، وأن جزاء المؤمنات في الآخرة كجزاء المؤمنين. ويبين أن الإسلام يدعو النساء إلى مشاركة الرجال في الشعائر الدينية والأعمال الاجتماعية والسياسية، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويُذَكِّر بأن النبي بايع النساء كما بايع الرجال.
ويُفَصِّل الشيخ في حقوق النساء في التعليم والتأديب، وحقوقهن المالية، وحقهن في الميراث وحكمته. لكنه يخصص معظم الكتاب لبيان حقوق النساء في الأسرة. فيتناول الشيخ حقوق المرأة كزوجة، مؤكدًا على حقها في مهر الزواج وحريتها في ولاية النكاح. ويشير إلى أركان الزواج في الإسلام والمساواة بين الزوجين، ويرى أن رياسة الرجل في الأسرة شورية لا استبدادية، ويفسر ما ذُكِرَ في القرآن من أن للرجال على النساء درجة. ويشرح وظائف كل من الزوج والزوجة، وصفات الزوجات الصالحات، وحكم الزوجات الناشزات، مع الإشارة إلى نشوز الرجل وإعراضه وعلاجه بالصلح.
ويناقش الشيخ قضية تعدد الزوجات وموقف الإسلام منه، مبينًا أصله في جميع الأمم، وهو يرى أن مصلحة الزوجية والإنسانية في التعدد، ويعرض لأقوال بعض فضليات الإنجليز وكبار علماء أوروبا في التعدد. كما يكشف عن الحكمة العامة لتعدد زوجات النبي، ويبين سيرته صلى الله عليه وسلم في معاشرتهن، وتنافسهن وتحزبهن عليه، وغيرة أزواجه وصبره عليهن، ثم مطالبتهن له بسعة النفقة والزينة مما أدى إلى تخييره لهن بين الدنيا والآخرة. كما يتناول تأديب الله لزوجات نبيه، وتوسعة الله عليه في معاملة نسائه، وتحريم النساء عليه بعد ما تقدم، وثمرة هداية القرآن والسنة في أزواج النبي. ويفسر آية حجاب نساء النبي وما يجب على المسلمين من الأدب مع الرسول وأزواجه، وما يقابل ذلك من تسري الفجور عند الإفرنج وتاريخه.
ويتناول الشيخ قضية الطلاق وما في معناه من فسخ وخلع وإيلاء وظهار، ويقارن بين إسراف الإفرنج في الطلاق من جهة وعوائق الطلاق في الإسلام من جهة أخرى، وكيف أنه منع إيقاع الضرر بالمرأة بالطلاق أو الإيلاء أو الظهار، وجعل للنساء الحق في فسخ عقد الزوجية وفي عدة الطلاق ومتعته ونفقته. ثم يشرح آداب المرأة المسلمة وفضائلها، وخاصة الحجاب، والنهي عن خلوة المرأة بالرجل وسفرها دون محرم، ويفسر آيات غض الأبصار وأمر النساء بإخفاء زينتهن، مؤكدًا عدم وجوب ستر وجه المرأة. وأخيرًا يُذَكِّر بتحريم عقوق الوالدين ووصية القرآن بهما مع تفضيل الأم.
والقارئ لاجتهاد الشيخ رشيد رضا في قضايا النساء خاصة يدرك بيسر أن أحد مقاصده هو تقريب الإسلام لمعاصريه من غير المسلمين، لاسيما في بلاد الغرب. إذ كان مقتنعًا تمامًا بأن ما يحول بين هؤلاء والتحول إلى الإسلام هو تقديمه صفيًا نقيًا لهم، لذلك جعل إرشاد العباد إلى الحق محورًا من محاور فكره التجديدي ودعوته الإصلاحية.
ثانيًا: إرشاد الأنام إلى هدي الإسلام
يؤكد الشيخ رشيد رضا اشتداد حاجة البشر إلى هداية الإسلام، ويتوقع أن يترك الإفرنج النصرانية قريبًا نظرًا لاستعداد أحرارهم للدخول في الإسلام، خاصة من يصفهم بالعلماء المستقلين من غير الساسة، لولا الشكوك والشبهات التي يثيرها المستشرقون حول الإسلام. وقد دوّن هذا التوقع في تصدير الطبعة الثالثة من كتابه الوحي المحمدي الذي وضعه لإقامة حجة الإسلام على المستشرقين بالتحدي الذي عجزوا عن معارضته، ولدعوة المسلمين إلى تجديد التحدي بتعاليم الوحي المحمدي وتوجيه دعوة الإسلام إلى العالم المدني.[23]
ويبدأ الشيخ ببيان ارتقاء البشر المادي وهبوطهم الأدبي وحاجتهم إلى الدين، ويفصل الأسباب التي تحجب بين الإفرنج والإسلام عمومًا وفهم القرآن خصوصًا، وهي الجهل ببلاغة القرآن، وقصور ترجماته، وأسلوبه المزجي، وأن الإسلام ليس له دولة. فيتناول الشيخ أسلوب القرآن وتركيبه المزجي وحكمته وإعجازه وما أسماه الثورة التي أحدثها في أمة العرب، مع مقارنة تأثير القرآن في العرب بتأثير التوراة في بني إسرائيل. ويناقش مقاصد القرآن في تربية البشر، وهي عنده عشرة مقاصد هي بيان أركان الدين الثلاثة أي الإيمان بالله وعقيدة البعث والجزاء والعمل الصالح، وبيان جهل البشر بأمور النبوة والرسالة ووظائف الرسل، وبيان أن الإسلام دين الفطرة السليمة والعقل والفكر، وبيان وحدة الأمة والإنسانية والدين والتشريع والأخوة الدينية والجنسية السياسية والقضاء واللغة، وبيان امتياز الإسلام في التكاليف الواجبة والمحظورات، والإصلاح السياسي، والإصلاح المالي، والإصلاح العسكري وإصلاح نظم العلاقات الدولية، وإعطاء النساء كل الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية، وتحرير الرقيق.
ويشرح الشيخ ثلاثة عشرة آية في الوحي المحمدي وما فيها من خطاب عام وآخر خاص بأهل الكتاب، حيث يعرف الوحي لغة وشرعًا، ومعنى النبوة والرسالة وعصمة الأنبياء، ويبين حاجة البشر إلى الرسالة، وأن العقل والعلم لا يغنيان عن هداية الرسل. ويخاطب مثبتي الوحي المطلق من غير المسلمين شارحًا لهم ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وينتقد تعريف الوحي والنبوة عند النصارى، ويبين امتياز نبوة محمد على نبوة من قبله بمقارنتها بنبوة موسى وعيسى. ويرد الشيخ على منكري عالم الغيب ومن يصفون الوحي المحمدي بأنه وحي نفسي، وخاصة شبهات المستشرق درمنغام.
ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يثبتها القرآن وحده، بل الإنجيل أيضًا. لذلك طلب الشيخ رشيد رضا من الدكتور خليل سعادة ترجمة إنجيل برنابا إلى العربية حين أهديت له نسخته الإنجليزية. وكتب الشيخ مقدمة الترجمة العربية، وسارع في نشرها في مطبعة المنار، فكانت هذه أول طبعة عربية لذلك الإنجيل الذي لم يكن معروفًا لدى المسلمين من قبل.[24] وقد رأى الشيخ في هذا الإنجيل فوائد جمة. فهو يحكم في المسائل الثلاث الخلافية بين الإسلام والنصرانية وهي التوحيد، وعدم صلب المسيح، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كما أنه يحتوي على تعاليم إلهية وأدبية ومواعظ وحكم.
وقد انتقد الشيخ بعض الباحثين الذين ادعوا أن إنجيل برنابا من وضع المسلمين في القرون الوسطى، كما انتقد رأي الدكتور سعادة بأن كاتب هذا الإنجيل يهودي أندلسي من أهل القرون الوسطى تنصر ثم دخل في الإسلام وأتقن اللغة العربية وعرف القرآن والسنة حق المعرفة بعد الإحاطة بكتب العهدين القديم والجديد. ومع إيمان الشيخ بأن إنجيل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام هو هديه وبشارته بمن سيأتي بعده ليتم دين الله، فإن الشيخ رجح أن إنجيل برنابا هو أحد تلك الكتب المُسَمَّاة أناجيلًا لاشتمالها على سيرة المسيح وهديه، وأن واضعه هو الحواري برنابا. كما رجح أن في مكتبة الفاتيكان من بقايا الأناجيل والكتب التى كانت ممنوعة في القرون الأولى ما لو ظهر لأزال كل شبهة عن إنجيل برنابا وغيره.
ولعل حسن الظن بعقلاء الغرب هو الذي قاد الشيخ رشيد رضا إلى الرحلة الأوروبية التي قام بها عام 1922 بصحبة ميشيل لطف الله للمشاركة في المؤتمر السوري الفلسطيني الذي انعقد في جنيف لمناقشة ترتيبات ما بعد الانتداب في الشام، وطاف خلالها في أرجاء البلاد الألمانية بصحبة صديقه شكيب أرسلان. ولكن الشيخ لم يكن غافلًا أيضًا عن خبثاء الغرب ومكرهم بالمسلمين. فقد كانت رؤيته للغرب مركبة، فهو لم يكن بالمقلد الأعمى لكل ما يأتي به الغرب، ولا بالرافض المطلق له، بل كان يدعو للانتقاء من بضاعة الغرب والتمسك بالقيم الإسلامية، كما ذهب عماد الدين شاهين في كتابه عن رشيد رضا والغرب.[25] فالشيخ هو ثالث ثلاثة، مع الشيخين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، في مدرسة الإحياء والإصلاح الإسلامي التي ظهرت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين نتيجة المواجهة مع الغرب وكانت تسعى للتوفيق بين القيم الإسلامية والثقافة الغربية. وقد تأثر في ذلك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية التي عاشها وبتكوينه الفكري في سنواته الأولى.
ولبيان رؤية الشيخ المركبة للغرب حلل المؤلف تفسير الشيخ لأسباب تقدم الغرب من جهة ومعضلة التغريب في العالم الإسلامي من جهة أخرى. فقد رأى الشيخ أن الدعائم الرئيسية للحضارة الغربية كما تجلت في بداية القرن العشرين هي الحيوية الاقتصادية، والتقدم الصناعي والتكنولوجي، والديمقراطية السياسية المقيدة للحكام، والموقف من المرأة، والقيم الأخلاقية والاجتماعية، كالتفاني في العمل والتعاون والتنظيم وحب المعرفة وروح البحث والابتكار وفصل العقل عن العاطفة. لكنه رأى أيضًا الوجه الآخر للغرب، فالغرب هو المستعمر الذي تحركه قيم الفردية والقوة والعنصرية والمصلحة الوطنية والقومية والإفراط في إشباع الحاجات المادية، وبذلك يتناقض سلوكه الخارجي مع المبادئ التي ينادي بها في الداخل.
ومع ذلك فقد مال الشيخ رشيد رضا للتصالح مع الاستعمار الأوروبي، خاصة في مصر قبل الحرب العالمية الأولى، دون أن يعني ذلك استسلامه للأمر الواقع. إذ كان يرى كأستاذه المباشر محمد عبده أولوية التغيير الثقافي والتربوي على المقاومة السياسية والعسكرية.[26] كما أدرك أن ضعف المسلمين لم يكن نتاج استعمار الغرب فقط، بل كان أيضًا نتاج تفرقهم وما وقع بينهم من عداوة وبغضاء. لذلك وجه الشيخ رشيد رضا جل حركته الإصلاحية وجانبًا هامًا من تجديده الفكري لإصلاح ذات البين والتقريب بين الفرقاء المسلمين.
ثالثًا: اتحاد المسلمين لحماية الأرض والدين
كانت الرحلة الأوروبية سالفة الذكر هي الرحلة الوحيدة التي قام بها الشيخ رشيد رضا خارج بلاد المسلمين بعد هجرته إلى مصر عام 1897، أما رحلاته السبعة الأخرى فكانت وجهتها كلها حواضر العالم الإسلامي. فقد رأى الشيخ أن الوحدة الإسلامية لا تتحقق فقط بالاجتهاد كما سلف البيان، بل أيضًا بحل الخلافات التي طرأت بين الشعوب الإسلامية. ورغم تعدد أهداف رحلاته، إلا أن المشترك بينها جميعًا هو سعي الشيخ لرأب الصدوع في جسد الأمة الإسلامية، حفاظًا على ما تبقى من وحدتها، وحماية لما تبقى من أراضيها. وقد جمع الدكتور يوسف إيبش سجل رحلات الشيخ كما دونها هو نفسه في أجزاء متفرقة من مجلة المنار.[27]
وكانت "سياحة صاحب المنار" الأولى في سوريا عام 1908 عقب نجاح ثورة جماعة الاتحاد والترقي التركية والعودة إلى العمل بالدستور العثماني. وخلال الزيارة اتصل الشيخ بأهله بعد انقطاع دام إحدى عشرة سنة، وتفقد أحوال البلاد وحض الأهالي على الإخلاص لحكومة الاتحاديين والاستعداد لتطبيق الإصلاح الإداري الذي وعدوا به. ثم قام برحلته الثانية إلى الآستانة عام 1909 للتوفيق بين العرب والترك وإزالة أسباب خلافهم السياسي، تفاؤلًا منه بمستقبل الدولة بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني، وكذلك سعيًا للحصول على إعانات مادية من الحكومة العثمانية لتأسيس مدرسة تابعة لجمعية الدعوة والإرشاد التي أنشأها بمصر عام 1907.[28] لكن الاتحاديين خيبوا ظنه، فقام عام 1912 برحلته الهندية – أو هكذا سماها رغم أنها شملت عمان والعراق بالإضافة إلى الهند. وقد جاءت الرحلة تلبية لدعوة صديقه الشيخ شبلي النعماني رئيس جمعية ندوة العلماء المسلمين، ونجح خلالها في الحصول على إعانة مالية لفتح مدرسة الدعوة والإرشاد.
ويقص علينا الشيخ بإسهاب رحلته الحجازية عام 1916 التي قام خلالها بأداء مناسك الحج وتهنئة الشريف حسين بنجاح الثورة ضد الحكومة العثمانية المتعصبة للأتراك. وقد أكرم الشريف حسين وفادته، لكن الشيخ لم يبايع الشريف حسين، على الرغم من تحريض البعض له للقيام بهذه الخطوة ليتبعه المسلمون. فالثورة العربية كانت بالنسبة للشيخ رشيد رضا ردًا مشروعًا على قمع العرب على يد حكومة الاتحاديين، ولم تكن أبدًا تحديًا لشرعية الخلافة العثمانية.[29] ولما انتهت الحرب العالمية الأولى قام الشيخ برحلته السورية الثانية التي دامت عامين (1918-1920). وخلالها تولى الشيخ رئاسة المؤتمر السوري العام الذي كانت مهمته الأولى هي المطالبة بوحدة سوريا واستقلالها بعد أن احتلتها جيوش الحلفاء في نهاية الحرب. ولم يرجع الشيخ إلى مصر إلا بعد دخول القوات الفرنسية دمشق وفرار الملك فيصل من سوريا.
وفات محقق الكتاب أن يشير إلى رحلتين أخيرتين قام بهما الشيخ: الأولى للحجاز عام 1926 لتهنئة الملك عبد العزيز بن سعود باستيلائه على الحجاز ولحضور مؤتمر إسلامي لمناقشة مسألة الخلافة، والثانية للقدس عام 1931 لحضور مؤتمر إسلامي بدعوة من صديقه وتلميذه الحاج أمين الحسيني لبحث الغزوة الصهيونية على فلسطين وإمكانية إنشاء جامعة إسلامية هناك.
ولم ييأس الشيخ من توحيد المسلمين في خلافة واحدة حتى في أحلك الأوقات حين كانت الخلافة العثمانية تترنح تحت وطأة الهزائم أمام أعدائها في الخارج على يد الاستعمار، وفي الداخل على يد الحركة الوطنية التي تزعمها مصطفى كمال. فكتب الشيخ رسالته عن الخلافة عام 1922، والتي أكد فيها على أن الخلافة هي الأصل الخامس في الإسلام، مع بيان الفرق بينها وبين البابوية أو الرياسة الروحية. وأهدى الرسالة إلى الشعب التركي، داعيًا إياه للنهوض بتجديد حكومة الخلافة الإسلامية بقصد الجمع بين هداية الدين والحضارة لخدمة الإنسانية، لأنه أقدر الشعوب الإسلامية على إحياء مدنية الشرق وإنقاذ مدنية الغرب التى باتت تفتك بها أوبئة الأفكار المادية، والروح الحربية، والإسراف في الشهوات الحيوانية. وحذر الشيخ الأتراك من إحياء النعرة الطورانية، ومن وسائل المتفرنجين لإماتة الدين، ومن طغيان المؤسسة العسكرية.[30]
وبين الشيخ في الكتاب حقيقة الخلافة وأحكامها، وشيئًا من تاريخها وعلو مكانتها، وحاجة جميع البشر إليها، وجناية المسلمين على أنفسهم بسوء التصرف فيها والخروج بها عن موضوعها، وما يعترض سبيل إحيائها، والمخرج منه. ويبدأ الكتاب بالأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة الإسلامية، حيث يُعَرِّف الخلافة ويُبَيِّن وجوبها شرعًا، وسلطة الأمة ومعنى الجماعة، وشروط أهل اختيار الخليفة، والشروط المعتبرة في الخليفة، وصيغة مبايعة الأمة له، وما يجب عليها بالمبايعة، وما يجب عليه للملة والأمة. ويناقش الشيخ قضية وحدة الخليفة وتعدده، مؤكدًا أن وحدة الإمامة بوحدة الأمة، ويشدد على مكانة الشورى في الإسلام، ويناقش قضية التولية بالاستخلاف والعهد وما يخرج به الخليفة من الإمامة، كما يعالج مسألة إمامة الضرورة والتغلب بالقوة، فيؤكد أن طالب الولاية لا يولى، ويفرق بين دار العهد ودار الجور والتغلب، ويفسر كيف سن التغلب على الخلافة تاريخيًا. ويعود لمناقشة مسألة سنة التغلب في خاتمة الكتاب، حيث يبين كيف أفسد الأعاجم حكم الإسلام العربي بها، منتقدًا أساسها النظري وهو فكرة العصبية التي أوردها ابن خلدون حيث اعتبرها مخالفة للإسلام.
ثم يناقش الشيخ مسألة الخلافة في العصر الحديث، فيميز بين ثلاث فرق من المسلمين وهي حزب الإصلاح الإسلامي المعتدل، وحزب المتفرنجين، وحزب حشوية الفقهاء الجامدين، مُبَيِّنًا ما يجب على حزب الإصلاح وأهل الحل والعقد في هذا الزمان في أمر الأمة والإمامة. ويشرح علاقة الخلافة بالعرب والترك، حيث يناقش بتوازن مرجحات وموانع جعل مركز الخلافة في كل من الحجاز وبلاد الترك، ويدعو إلى إقامتها في منطقة وسطى كالموصل المتنازع عليها في ذلك الوقت بين العراق والأناضول وسوريا. ويشير باختصار إلى نموذج من النظم الواجب وضعها للخلافة، مؤكدًا على أن نهضة المسلمين تتوقف على الاجتهاد في الشرع.
وينتقد الشيخ فتاوى مصطفى كمال أتاتورك الدينية التي لم تصدر إلا عن هوى لأن الترك يحتاجون إلى اللغة العربية للاجتهاد في الشرع. ويؤكد أن الإسلام وضع قواعد تشريعية للخلافة، مشيرًا إلى ما بين هذه القواعد وحال الأمة من تباين وتوافق. ونظرًا للدور المؤثر الذي يمكن أن تلعبه الخلافة في إصلاح العالم الإسلامي فإن غير المسلمين عامة ودول الاستعمار خاصة يكرهون إقامة حكومة الخلافة ويثيرون حولها الشبهات، ومنها علاقتها بفكرة الجامعة الإسلامية.
والحقيقة أن قضية الخلافة كانت تحتاج لاجتهاد جديد ومتوازن لم يجرؤ عليه في ذلك الوقت سوى قلة من المفكرين أمثال الشيخ رشيد رضا، وكذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي تعلم في فرنسا وحصل فيها على درجة الدكتوراه في القانون، وعالج في رسالته قضية الخلافة الإسلامية في العصر الحديث، داعيًا المسلمين للانتفاع بخبرة الغرب في إنشاء منظمات دولية لإقامة عصبة أمم شرقية كبديل عن إقامة الخلافة في ظروف دولية غير مواتية، مع تسليمه بأن هذه العصبة نموذج ناقص لدولة الخلافة الإسلامية. فقد رأى السنهوري أن قوى الاستعمار الغربي ترفض أية محاولة لإحياء الخلافة في شكلها التقليدي، لذلك فلا مانع من إقامة عصبة الأمم الشرقية ريثما يتمكن المسلمون من إقامة دولة خلافة على منهاج النبوة.[31]
ولا شك أن هذه التصورات الجادة التي طرحها الشيخ رشيد رضا والدكتور السنهوري تختلف عن رؤى أخرى للخلافة ظهرت في تلك الفترة الزمنية الحرجة ولكنها لم تلتزم بأصول الفقه وقواعد الاجتهاد ومقاصد الشرع، ومنها وحدة المسلمين. ومن أبرز هذه الرؤى ما طرحه الشيخ علي عبد الرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم)، حيث ادعى أن الخلافة ليست مؤسسة إسلامية أصيلة أو نظامًا إسلاميًا للحكم، إذ ليس في الإسلام نظام للحكم. وقد تولى كثير من العلماء والمفكرين الرد على هذا القول في حينه وبعد ذلك، وقررت لجنة كبار العلماء في الأزهر أن الكتاب ضعيف من الناحية العلمية وسحبت من مؤلفه لقب "عالم" وفصلته من جماعة العلماء ومن منصبه كقاضٍ شرعي. واتضحت لاحقًا أدوار المستشرقين والمستعمرين في هذا الكتاب، إذ رأوا أن الفرصة أصبحت مواتية للقضاء على فكرة المؤسسة التي تجسد الوحدة السياسية للأمة الإسلامية للأبد.[32]
خاتمة
هل من علاقة بين المحاور الثلاثة، أي الاجتهاد والإرشاد والاتحاد، في فكر الشيخ رشيد رضا وفي الواقع؟ نعم، هناك أكثر من علاقة بينها. فمن جهة، كان الاجتهاد هو الأساس الذي بنى عليه الشيخ جهوده للإرشاد والاتحاد. بعبارة أخرى، كانت تلك الجهود ثمرة الاجتهاد ومقصده، وكان الاجتهاد شرطها الضروري. فرغم أن التزام الشيخ بالاجتهاد كان التزامًا مبدأيًا نابعًا من وجوب الاجتهاد مع تغير الزمان، فإن الشيخ أحسن توظيفه لبيان جوهر الإسلام النقي الخالي من الشوائب التي لحقت به في أزمنة الركود الأخيرة، وكذلك تقديمه لغير المسلمين ملائمًا للعصر الحديث. كما سعى الشيخ بالاجتهاد لتقريب الطوائف والمذاهب والشعوب بإعلاء قيم الأمة والوحدة والتآخي والتعاون على البر والتقوى باعتبارها الأصل في العلاقة بين المسلمين، بينما الاختلاف طارئ عليهم ويمكن تجاوزه، فضلًا عن وجوب ذلك.
ومن ناحية أخرى، فإن جهود الشيخ رشيد رضا في هذه المجالات الثلاثة كشفت بوضوح عن توافق الاستبداد مع الاستعمار في عداوة الإصلاح والتجديد عند المسلمين. فغياب الشورى في الدولة العثمانية كرس العداوة والبغضاء بين جناحي الأمة، أي العرب والترك، تمامًا كما كرستهما مؤامرات المستعمرين الذين حققوا مكاسب جمة من ورائهما. ورغم الاختلاف الظاهري في موقفي الاستبداد والاستعمار من الاجتهاد، إلا أن جوهرهما ظل واحدًا. فبينما اعتبرت حكومة السلطان عبد الحميد أفكار المنار الإصلاحية خطرًا على استقرارها فمنعتها من دخول السلطنة، وشجعت علمائها المقلدين على مهاجمتها، كان الاستعمار –لاسيما المستعمر البريطاني في مصر– أشد دهاء في التعامل مع الدعوة للاجتهاد. فقد شجع هذه الدعوة في مجالات التعليم والقضايا الاجتماعية بما ساعد على "تحديث" المجتمعات المسلمة على الطريقة الأوروبية، لكنه تركها فريسة للاستبداد في المجال السياسي رغم قدرته على تشجيعها أيضًا. فقد وظف الاستعمار دعوة الاجتهاد لحلحلة الأوضاع الراكدة في مجتمعات البلاد المستعمرة تمهيدًا لإدخال "إصلاحات" تصب في اتجاه تغريب هذه المجتمعات. أما الإرشاد فقد بدا الاستبداد والاستعمار غير معنيين به إلى حد كبير.
وبدلًا من محاربة الاستبداد والاستعمار حربًا مباشرةً، جاهد الشيخ رشيد رضا لمكافحة آثارهما السيئة في بلاد المسلمين. فكانت هذه هي حكمة الشيخ التي اقتدت بها حركات إصلاحية لاحقة.
* دراسة نشرت في مجلة ركائز معرفية، ديسمبر 2014، ص 1-32.
** أستاذ زائر وباحث أول، قسم الدراسات السياسية والدولية، جامعة رودس، جنوب أفريقيا.
[16] محمد رشيد رضا، يسر الإسلام وأصول التشريع العام في نهي الله ورسوله عن كثرة السؤال (مكتبة السلام العالمية، د.ت.)
[17] محمد رشيد رضا، الوحدة الإسلامية والأخوة الدينية وتوحيد المذاهب، إشراف: زهير الشاويش (دمشق وبيروت: المكتب الإسلامي، د.ت.).
[18] لمزيد من التفاصيل، انظر: علي مبارك، الأعمال الكاملة لعلي مبارك، دراسة وتحقيق: محمد عمارة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1979) المجلد الأول، ص 101-120.
[19] محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار (بيروت: دار المعرفة، 1993).
[20] الطبعة المذكورة في الهامش السابق تنتهي عند الآية 52 من سورة يوسف، وهي نهاية الجزء الثاني عشر من القرآن.
[21] محمد رشيد رضا، الربا والمعاملات في الإسلام (القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ت.).
[22] محمد رشيد رضا، نداء للجنس اللطيف: حقوق النساء في الإسلام وحظوظهن من الإصلاح المحمدي العام، تعليق: محمد ناصر الدين الألباني (دمشق وبيروت: المكتب الإسلامي، د.ت.).
[23] محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي: ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب المدنية إلى الإسلام دين الأخوة الإنسانية والسلام (القاهرة: مكتبة القاهرة، الطبعة السادسة، 1960).
[24] خليل سعادة (مترجم)، إنجيل برنابا (القاهرة: مطبعة المنار، د.ت.).
[25] Emad Eldin Shahin, Through Muslim Eyes: M. Rashid Rida and the West (Herndon, VA, USA: the International Institute of Islamic Thought, 1993).
[26] لمزيد من التفاصيل حول هذا الموقف، انظر: فادي إسماعيل، "الإسلام والغرب والسياسة: قراءة في نصوص المنار في سنواتها الأولى"، محمد رشيد رضا: جهوده الإصلاحية ومنهجه العلمي، تحرير: رائد جميل عكاشة (عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2007)، ص 317-343.
[27] يوسف إيبش (محقق)، رحلات الإمام محمد رشيد رضا (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية، 1979).
[28] لمزيد من التفاصيل حول جهود الشيخ رضا للإصلاح بين العرب والترك، انظر: أنيس الأبيض، "رؤية محمد رشيد رضا للإصلاح السياسي في الدولة العثمانية من خلال العلاقة بين العرب والترك"، محمد رشيد رضا: جهوده الإصلاحية ومنهجه العلمي، تحرير: رائد جميل عكاشة (عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2007)، ص 243-253.
[29] حول موقف الشيخ رشيد رضا من الثورة العربية، انظر: أحمد علي سالم، مرجع سابق، 233-235. وانظر رؤية مخالفة في: محمد الأرناؤوط، "موقف رشيد رضا من تيارات التحديث المعاصرة"، محمد رشيد رضا: جهوده الإصلاحية ومنهجه العلمي، تحرير: رائد جميل عكاشة (عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2007)، ص 153-164.
[30] محمد رشيد رضا، الخلافة (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1994).
[31] أحمد علي سالم، "رؤى المسلمين من مواقف الغرب من وحدتهم وأثرها في علاقاتهم به: من الدولة العثمانية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي"، الإسلام والغرب: حوار حضاري (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث والاستراتيجية، 2012) 61.
[32] حول الكتاب والجدل الذي أثاره، انظر: أحمد علي سالم وريهام خفاجي، "الفكر السياسي الإسلامي بين الإصلاح والاستغلال: قراءة فيما أثاره كتاب الإسلام وأصول الحكم من جدال"، رؤى، العدد المزدوج 23-24، 2004، ص 96-101.