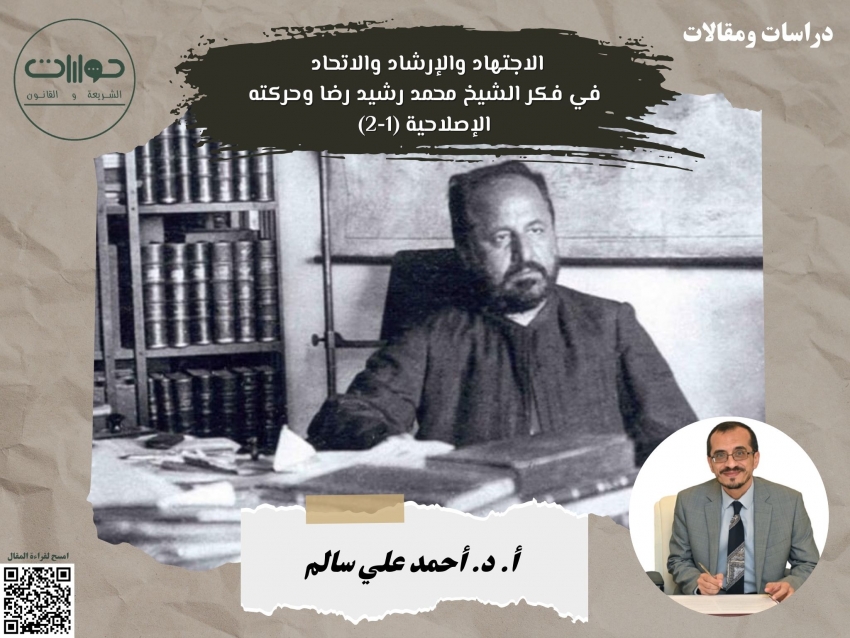الاجتهاد والإرشاد والاتحاد في فكر الشيخ محمد رشيد رضا وحركته الإصلاحية (1-2)*
الإصلاح والتجديد هما معًا الطريق الثالث الذي سلكه فريق من المسلمين لعلاج الخلل في الميزان الحضاري بين المسلمين والغرب منذ بداية العصر الحديث. وقد سبقه تاريخيًا طريقان هما الانكفاء على الذات من جهة والتماهي في الغرب من جهة أخرى. والمتأمل في هذين الطريقين يجدهما في الحقيقة طريقًا واحدًا عماده التقليد، أي الاتباع بغير تدبر: فأحدهما تقليد للسابقين منا، والآخر تقليد للاحقين من غيرنا.
وما كان للتقليد أن يتقدم وقد ذمه الله تعالى في كتابه، وما كان للإصلاح والتجديد أن يتأخرا وقد ذكرهما الله ورسوله ذكر المادحين، فقال تعالى على لسان خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت (هود: 89)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داوود في الملاحم والحاكم في الفتن عن أبي هريرة: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. وقد انشغل بعض الدارسين بتحديد مجدد كل قرن هجري، أخذًا بظاهر هذا الحديث،[1] رغم أن الحديث لا يمنع تعدد المجددين على رأس كل مائة سنة، ولا تكرار بعثة المجددين خلال القرن الواحد، لاسيما وقد تقارب الزمان وأصبحت الأفكار والأشياء تتقادم في العصر الحديث بسرعة فاقت نظائرها في العصور السابقة، وبات من المألوف أن ينظر الناس لما كان جديدًا في بداية القرن على أنه قديم بعد مضي زمن وجيز عليه. ولكن الفهم الضيق لهذا الحديث أدى إلى تراجع اسم الشيخ رشيد رضا في سجل مرشحي مقعد مجدد القرن الرابع عشر الهجري، لحساب مجددين آخرين فاقوه صيتًا وشهرة، لاسيما أستاذيه محمد عبده وجمال الدين الأفغاني.[2]
ولا يهدف هذا البحث لمقارنة أفكار الشيخ رشيد رضا التجديدية وجهوده الإصلاحية بأفكار وجهود مجددين آخرين، وإنما يسعى لإبراز بعض أفكاره التجديدية وجهوده الإصلاحية التي حبذا أن يتعلمها مجددو القرن الخامس عشر الهجري ومصلحوه. وهذه الأفكار وتلك الجهود مبسوطة فيما كتبه هو رحمه الله، وخاصة في مجلة المنار، وكذلك فيما كتبه الباحثون عنه، وهو قليل نسبيًا إذا ما قورن بما كتب عن أستاذيه الأفغاني وعبده،[3] وبعضه غير متوفر الآن إلا في المكتبات الكبرى مثل مكتبة الكونجرس الأمريكي. فهذا البحث هو دراسة للكتب التي خلفها الشيخ محمد رشيد رضا والكتب التي سجلت أفكاره وجهوده في التجديد والإصلاح. فيخرج من نطاقها إذًا المقالات والبحوث المنشورة في مجلات علمية وكتب محررة لا تركز على الشيخ رشيد رضا تحديدًا. ويبدأ البحث بتحليل للاتجاهات الرئيسية في الكتب المنشورة عن أفكار رشيد رضا وجهوده، ثم يناقش ثلاثة إسهامات كبرى للشيخ رشيد رضا، وهي التي يحملها عنوان هذا البحث.
المبحث الأول
الاتجاهات الرئيسية في الكتب المنشورة عن أفكار رشيد رضا وجهوده
لعل من دلائل تنوع عطاء الشيخ رشيد رضا أن يهتم بدراسته والانتفاع به باحثون ذوو مشارب شتى. فمنهم الأدباء والمؤرخون وطلبة العلم الشرعي وطلبة العلوم الاجتماعية، وكل يدرس جانبًا من جوانب هذا العطاء. وقد أبرز الدكتور إبراهيم العدوي هذا التنوع في كتاب كان من أول وأشمل ما كتب عن الشيخ رشيد رضا.[4] فأطلق المؤلف على الشيخ لقب الإمام المجاهد، لأنه جمع بين ميداني العلم والسياسة دون أن يطغى نشاطه في أحدهما على الآخر. وينطلق المؤلف من أن دراسة منهج رشيد رضا في معالجة المشاكل التي أحاطت بالمسلمين والعرب، وكفاحه المتواصل في حل تلك المشاكل والنهوض بالعالمين الإسلامي والعربي، تتطلب عرضًا دقيقًا للعصر الذي شب فيه وترعرع، ثم جاهد فيه وناضل، وهي السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين والتي يعتبرها المؤلف من أشد السنوات قسوة على النفس والضمير، إذ التقى فيها الاستبداد العثماني بالاستعمار الأوروبي المتحالف مع الصهيونية، حتى صار عبء الإصلاح ثقيلًا ينوء به أولو العزم من القادة. ويرى المؤلف أن رشيد رضا استطاع أن يحمل رسالته في تلك الأيام في قوة وإيمان لأنه درس في روية وإمعان مشاكل الأمة العربية والعالم الإسلامي، فضلًا عن أنه تربى في مهاد تلك المشاكل والأحداث، وتابع تياراتها وتدفقها، وهاجر إلى مصر التي أصبحت في مطلع العصر الحديث قاعدة النضال العربي.
ولم يقتصر عطاء الشيخ رشيد رضا على العلم والسياسة، بل امتد ليشمل الأدب الإسلامي أيضًا. فكتب أحمد الشرباصي عن عطائه الأدبي وتأثره في أدبه بالقران والسنة وإسهامه في إعزاز أدب الإسلام.[5] فرأى المؤلف أن رشيد رضا لم يكن رجل دين وداعية عقيدة فقط بل كان أديبًا أيضًا. فكل ما خلفه من آثار قلمية يستحق أن يُدرس دراسة أدبية. فقد كتب رشيد رضا المقالة، وألف الكتاب، وصاغ الرسالة، وصنع القصة والمقامة، ومارس الجدل والمناظرة، وكتب في الوصف والنقد وتراجم الأشخاص، وعلق على بحوث غيره، وكتب في الأمالي الأدبية واللغويات. وكل هذا التراث يعد أدبًا، لأن الأدب هو كل مأثور من النثر أو الشعر له قيمته وأثره.
ويطلق المؤلف على أدب رشيد رضا أدبًا إسلاميًا لأن موضوعه ومضمونه إسلاميان، ولأنه تأثر ببيان القرآن والسنة تأثرًا عميقًا. وقد قوَّم المؤلف أدب الشيخ من ناحية اللفظ والمعنى ومن ناحية العاطفة والانفعال، وأبان كيف غلبت عليه الخطابة في صدر حياته الأدبية، ثم غلبت عليه الكتابة بعد ذلك. وتحدث عن تأثره العميق بالجملة القرآنية. ودرس المؤلف أدب الرسالة عند رشيد رضا مستعينًا بنماذج من رسائله فيها معلومات أدبية ولغوية وتاريخية ذات قيمة كبيرة، ثم قارن بينه وبين غيره في كتابة الرسائل. وتحدث عن مقومات الخطابة عند الشيخ، كاشفًا عن نص أول خطبة ألقاها في حياته، وهي خطبة لم تنشر من قبل. وحدد المؤلف موقف الشيخ من القصة، ورأيه غير الإيجابي فيها، وكشف محاولة الشيخ صنع المقامة، وقد وفق الكاتب في العثور على نص المقامة الوحيدة التي خلفها الشيخ، وحللها وقومها من الناحية الأدبية.
ومجلة المنار هي الوعاء الذي حوى معظم كتابات الشيخ رشيد رضا.[6] وتقع المجلة في خمسة وثلاثين مجلدًا يناهز حجم بعضها ألف صفحة، وقد صدر عددها الأول في العشر الأواخر من شوال سنة 1315 هجرية (مارس 1898م) بعد أسابيع قليلة من وصول منشئها الشيخ رشيد رضا إلى مصر طالبًا العلم على يد الشيخ محمد عبده وحرية الدعوة إلى الإصلاح. ويصف الشيخ "المنار" بأنها مجلة تبحث في فلسفة الدين وشئون الاجتماع والعمران، وبيَّن غرضه من إنشائها في عددها الأول، وهو الإصلاح الديني والاجتماعي للمسلمين ومن يعيش معهم وتتصل مصالحه بمصالحهم، وكذلك بيان اتفاق الإسلام مع العلم والعقل، وموافقته لمصالح البشر في كل قطر وعصر، وإبطال ما يرد من شبهات عليه، وتفنيد ما يعزى من خرافات إليه.
وكانت "المنار" في سنواتها الأولى جريدة أسبوعية، ثم أصبحت مجلة تصدر مرتين كل شهر عربي، وانتهى بها الحال إلى مجلة تصدر مرة كل شهر عربي. وبينما كانت المنار في سنواتها الأولى تنشر برقيات وبعض الأخبار بالإضافة إلى المقالات، وكان الشيخ يكثر فيها من الخطابيات ويكتفي في أكثر المسائل بالإجمال ولا يخوض في المسائل السياسية، باتت المنار تخوض في تفاصيل المسائل وتهتم بقضايا الإصلاح الديني والتربوي والاجتماعي، كما أصبحت منبرًا علميًا وأدبيًا رصينًا لكبار أصحاب الأقلام في عصرها، من أمثال عبد الرحمن الكواكبي ورفيق العظم ومحمد توفيق صدقي وبهجة البيطار، وكذلك أمير البيان شكيب أرسلان الذي نشر كتابه (لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم) في مجلة المنار استجابة لاقتراح ورد إلى الشيخ رشيد رضا من تلميذه الشيخ محمد بسيوني عمران إمام مهراجا جزيرة جاوه. وتشير مقدمة الكتاب التي كتبها الشيخ رشيد رضا إلى أن المؤلف رحب بالاقتراح منفعلًا بما شاهد في أسبانيا من مشاهد الحضارة العربية الإسلامية ومتأثرًا بمحاولات فرنسا تنصير شعب البربر في المغرب تمهيدًا لتنصير عرب إفريقيا. وقد علق الشيخ بعض الحواشي المتفرقة على إجابة الأمير شكيب أرسلان.[7]
وقد تعرضت المنار إلى هزة قوية بوفاة صاحبها الشيخ رشيد رضا عام 1935، فلم يصدر منها بعد ذلك إلا تسعة أعداد على فترات متفرقة، كان آخرها في سبتمبر عام 1940. فقد اعتبرها المشرفون على هذه الأعداد الأخيرة معلمًا بارزًا من معالم الدعوة إلى الإصلاح في العصر الحديث يصعب أن تجد له نظيرًا، إذ أسهمت بما لم يقدر عليه غيرها في تنبيه الأذهان وإعادة فتح باب الإجتهاد والدعوة إلى الوحدة والنهضة على أساس إسلامي مع الانتفاع بالمدنية الغربية.
وللانتفاع من هذا العمل الكبير أصدر مشروع دراسات الحضارة الإسلامية في طوكيو فهرسًا للمقالات الواردة في المجلة، سواء ما كتبه صاحب المنار أو ما كتبه 374 كاتبًا من أعلام حَمَلَة الأقلام في زمانها، وما أدرج في المجلة من مقالات نقلًا عن مجلة العروة الوثقى وعن كتب الغزالي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وجمال الدين القاسمي وغيرهم. ويشير الفهرس على سبيل المثال إلى 116 ترجمة لأعلام معاصرين و246 دورية و845 كتابًا مقرظًا و99 وثيقة و1061 فتوى وغيرها من المواضيع البالغ عددها 479 موضوعًا.[8] وببعض الجهد الإضافي كان يمكن أن يصبح هذا الفهرس أكثر نفعًا. فهو لا يميز في التصنيف بين مؤلف وعنوان وموضوع، بل يرتب جميع المدخلات ترتيبًا هجائيًا، كما يصعب التمييز فيه من جهة الخط بين الموضوعات والرئيسية والفرعية. ويبدو الكتاب مجرد تجميع للفهارس التي وضعها الشيخ رشيد رضا في مقدمة مجلدات مجلة المنار.
وأفضل منه تعريفًا بالمنار هو الجزء الأول من كتاب تاريخ الصحافة الإسلامية للأستاذ أنور الجندي الذي خصصه لمجلة المنار باعتبارها عملًا صحفيًا.[9] فقد حلل أثر العروة الوثقى على منهج الصحافة الإسلامية بوجه عام ومجلة المنار بوجه خاص، ثم شرح ميادين العمل الصحفي الإسلامي في المنار من خلال دورها في التعريف بفضل الإسلام، والدفاع عن اللغة العربية، وإحياء التراث الإسلامي، وكذلك تفسير القرآن للشيخ رشيد رضا، والتزام المجلة بمذهب أهل السنة والجماعة، ومواقفها من التصوف والفلسفة والعلاقات بين السنة والشيعة، ودورها في مواجهة الأخطار والتحديات التي واجهها المسلمون آنذاك، والرد على شبهات التبشير والتشكيك في حقائق الإسلام.
وعرض المؤلف خطة المنار وأهدافها خلال أربع مراحل تاريخية متعاقبة من عمر المجلة، تبدأ أولاها بنشأة المنار عام 1898 وتنتهي بوفاة الشيخ محمد عبده عام 1905، وتستمر المرحلة الثانية حتى بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914، أما المرحلة الثالثة فتدوم حتى سقوط الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1924، وتستمر المرحلة الرابعة حتى وفاة صاحب المنار الشيخ رشيد رضا. وعرض المؤلف مواقف المنار من أحوال العالم الإسلامي في الثلث الأول من القرن العشرين، وأهمها مواقفها من الدولة العثمانية في عهدي السلطان عبد الحميد (1898-1908) وحكومة الاتحاد والترقي (1908-1918)، ومواقفها من الجامعة الطورانية ومصطفى كمال أتاتورك ودوره في إسقاط الخلافة. كما ناقش مواقف المنار من الماسونية والصهيونية، ومن حركات الإصلاح الإسلامية كالوهابية والسنوسية، ومن الشخصيات والصحف والمجلات والجماعات البارزة في العالم الإسلامي، ومن قضايا التربية والتعليم والمرأة والمجتمع. وقوِّم المؤلف ما حققته مدرسة المنار من إصلاح. ورغم أن الكتاب يمثل إسهامًا جيدًا في التعريف بالمجلة، إلا أن طابعه الصحفي من حيث العرض والسرد أفقده البعد التحليلي من حيث المناقشة والنقد.
ولا يختلف عن هذا الكتاب من حيث الأسلوب القصصي وغلبة السرد على التحليل، كتاب سمير أبو حمدان عن الخطاب الإسلامي المعتدل للشيخ رشيد رضا.[10] فالكتاب سيرة للشيخ رشيد رضا بالاعتماد إلى حد كبير على ما دونه الشيخ نفسه. فتناول المؤلف طفولة الشيخ في قرية القلمون القريبة من مدينة طرابلس الشام، والبيت الذي نشأ فيه، وحبه للعزلة، وإقباله على تعلم القرآن والخط والحساب واللغة العربية، ومصادر ثقافته وهي القرآن الكريم والحديث الشريف وكتب التراث (وعلى رأسها "إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي و"نهج البلاغة" للإمام علي بن أبي طالب) ومجلتا العروة الوثقى والمقتطف. ورأى المؤلف أن مجلة المنار كانت خطوة في طريق الإصلاح تبعتها خطوات، أهمها سعي الشيخ إلى إنشاء جمعية إصلاحية بمضمون إسلامي يمتد تأثيرها إلى خارج مصر على غرار جمعية الشورى العثمانية التي أسندت رئاستها إليه.
ويرى المؤلف أن أساس الفكر السياسي للشيخ رشيد رضا هو الإسلام، وأنه واصل السير على منهج العروة الوثقى مع التركيز على الجوانب التربوية والتعليمية. وكان للشيخ موقف متميز من العلاقة الثقافية مع الغرب حيث كان يرى ضرورة الجمع بين الأصول الدينية والتراثية للمسلمين من جهة والعلوم والمعارف الغربية من جهة أخرى. وقد دعا الشيخ إلى الإصلاح الاقتصادي وحذر من سيطرة الأجانب على الموارد الإقتصادية في بلاد المسلمين. وعرض المؤلف موقف الشيخ من فكرة الجامعة الإسلامية التي راجت في ذلك الوقت وحرصه على تمتين العلاقة بين العرب والترك. وأورد المؤلف النص الكامل لخطبة في هذا الشأن ألقاها الشيخ في "منى" في موسم الحج عام 1916.
ولعل التقسيم الموضوعي في دراسة فكر الشيخ رشيد رضا ومجلة المنار أكثر بيانًا وتحليلًا من التعريف العام بفكر الشيخ رشيد رضا وجهوده الإصلاحية. ومثال ذلك كتاب محمد المراكشي عن تفكير الشيخ رشيد رضا من خلال مجلة المنار.[11] فقد حاول المؤلف الإجابة عن سؤالين هما جوهر إشكالية هذا الكتاب، وهما: هل صنع رشيد رضا من خلال أفكاره الإصلاحية في ميادين عديدة أيديولوجية موحدة القواعد وصالحة لتغيير أوضاع المجتمع المسلم عمومًا في العصر الحديث؟ وما هو موقف هذه الأيديولوجية من الحداثة؟ ولإجابة هذين السؤالين حلل المؤلف التراث الفكري للشيخ رشيد رضا كما تبلور في مقالاته في مجلة المنار، مقسِّمًا هذا التراث تقسيمًا موضوعيًا. فبدأ بمناقشة تفكير رشيد رضا السياسي ومواقفه من حكم السلطان عبد الحميد الثاني وحكومة الاتحاديين وسقوط الخلافة وإعلان الجمهورية التركية، وكذلك مواقفه من ثورة الشريف حسين والدولة السعودية الناشئة وقضايا السياسة في مصر وسوريا وفلسطين. ثم ناقش تفكير رشيد رضا الديني متمثلًا في تفسيره القرآن ونشاطه في مجال الفتوى ودفاعه عن الإسلام ومفهومه عن التدين والإصلاح الديني ومواقفه من الفرق والطرق الإسلامية والتيار الفكري المتحرر في مصر. ثم تناول المؤلف تفكير رشيد رضا الاجتماعي والاقتصادي في مجالات الأسرة والمرأة وتربية الأطفال وقضايا المجتمع الإسلامي والمعاملات المالية الحديثة والمذاهب الاجتماعية كالاشتراكية وغيرها. ثم شرح تفكير رشيد رضا الثقافي وآراءه الإصلاحية في مجالات اللغة والأدب والصحافة والتعليم والمدارس الدينية والحكومية العثمانية. ورغم أن تفكير صاحب المنار كلٌّ فكريٌّ شاملٌّ لا يتجزأ، إلا أن المؤلف يدافع عن هذا التقسيم باعتباره منهجًا نقديًا يسهل استكشاف معالم الفكر الأيديولوجي ويبيِّن درجات الحداثة في كل جانب منه، مع ملاحظة التطور الفكري عند الشيخ.
ومن أشمل ما كتب من هذا النوع من الدراسات عن فكر الشيخ رشيد رضا وجهوده الإصلاحية كتاب أحمد الشوابكة عن دور الشيخ في الحياتين الفكرية والسياسية.[12] فمن الناحية الفكرية، عالج المؤلف عدة محاولات قام بها الشيخ للتقريب بين أتباع الديانات السماوية الثلاث، والتوفيق بين السنة والشيعة، وتقريب الفوارق بين أتباع المذاهب الفقهية السنية. ورغم هذه النزعة التوفيقية، فإن الشيخ عارض التيارين الفكريين السائدين في مصر آنذاك وهما التيار المحافظ الذي يتكون من غالبية منتسبي الجامع الأزهر، وتيار دعاة التجديد على أساس من الثقافة الغربية. كما انتقد الشيخ المدارس والمعاهد الدينية من جانب ونظيراتها المدنية بنوعيها الحكومي والأهلي من جانب آخر. وكان له أيضًا رؤية إصلاحية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث أبرز خطورة اختفاء دور المواطن المصري في الحياة الاقتصادية واحتكارها من قبل الأجانب (مستعمرين ووافدين). ثم تتبع المؤلف تأثير فكر الشيخ الإصلاحي عربيًا وإسلاميًا ولاسيما في مصر وإستانبول والهند.
وأما الجوانب السياسية في حركة الشيخ رشيد رضا الإصلاحية، فتتبعها المؤلف من خلال تطور مواقفه تجاه الدولة العثمانية بدءً بعهد السلطان عبد الحميد الثاني ومرورًا بحكم الاتحاديين وانتهاءً بالعهد الكمالي. كما عرض تطور مواقفه تجاه القضايا العربية ولاسيما جهوده في محاولة إنهاض دولة عربية مستقلة استقلالًا كاملًا لتتولى بدورها مهمة العمل على استقلال بقية الدول العربية الأخرى وضمها في كيان سياسي موحد. وقد تنقل في هذه المحاولات بين سوريا والعراق والسعودية. وكان للشيخ مواقف أيضًا من القضايا المصرية حيث كان مدركًا لما تمثله مصر من ثقل بشري وسياسي واقتصادي يؤهلها لمركز قيادي عربيًا وإسلاميًا، رغم ما أخذه على عامة أحزابها من انصراف عن الاشتغال بالقضايا العربية وحصر اهتمامها بالقضية الوطنية المصرية. وكان الشيخ من أوائل من تنبه لمخاطر الحركة الصهيونية على فلسطين ودعا إلى اتخاذ الوسائل الكفيلة بإيقاف هذا الخطر. كما تكررت دعوة الشيخ إلى عقد لقاءات إسلامية على مستوى العلماء والحكام. لكن مؤتمرات القاهرة (1926) ومكة (1926) والقدس (1931) وما أسفرت عنه من نتائج جاءت مخيبة لآمال الشيخ.
هذه الجوانب السياسية في حركة الشيخ رشيد رضا الإصلاحية كانت موضوع أطروحات لطلبة في الدراسات العليا في جامعات أمريكية. فقد تقدم عماد الدين شاهين بأطروحة عن الشيخ رشيد رضا والغرب لنيل درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي موضع تحليل في المبحث الثاني. كما تقدم أسعد نمر بصول بأطروحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، موضوعها نضال الشيخ رشيد رضا لإحياء دولة إسلامية. وتنطلق الدراسة من اعتبار الشيخ أحد أهم النشطاء السياسيين في العمل من أجل إقامة دولة إسلامية راشدة في الثلث الأول من القرن العشرين، وليس مجرد تلميذ للإمام محمد عبده، أو مجرد عالم دين له إسهامه الفكري المتميز.[13] وتعالج الرسالة الأنشطة السياسية التي مارسها الشيخ في تسلسل زمني. فبعد الإشارة إلى خلفيته الاجتماعية والعائلية والتعليمية وميله المبكر نحو التصوف، يتناول المؤلف علاقة الشيخ رضا بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وأثر ذلك في أنشطته السياسية في بداية حياته في مصر. ثم يشرح موقف الشيخ رشيد رضا من الدستور العثماني بعد إعادة العمل به عام 1908 ورحلته إلى استانبول في العام التالي التي سعى خلالها لتوثيق عرى الوحدة والائتلاف بين عنصري الدولة العثمانية الرئيسيين، وهما العرب والترك. ويحلل المؤلف التحول الجوهري في موقف الشيخ من الدولة العثمانية، والذي تمثل في تأييده لحركة الإحياء العربي بصفة عامة ومناصرته للشريف حسين في ثورته ضد الأتراك بصفة خاصة. هذا الموقف لم يدم طويلًا، إذ تراجع الشيخ عنه بسبب ولاء الشريف حسين لبريطانيا التي كانت ترفض إقامة خلافة عربية. كذلك تغيرت مواقف الشيخ من الحكومة العربية التي أقامها الملك فيصل في سوريا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث ساندها في بداية الأمر ثم عارضها حين رفض الملك فيصل الخضوع لمبدأ الشورى في الحكم. كما كان له مواقف إيجابية من الحركة الوهابية والدولة السعودية الناشئة في ذلك الحين، حيث اعتبر الملك عبد العزيز بن سعود أول حاكم متمسك بالإسلام حقيقةً منذ عهد الخلفاء الراشدين.
هذه المواقف الإيجابية من الحركة الوهابية كانت موضوع كتاب محمد السلمان عن رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إذ رأى المؤلف أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية تعد أبرز دعوة في التاريخ الإسلامي الحديث من حيث الآثار، وأن السيد رشيد رضا هو أهم شخصية نشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مصر والعالم الإسلامي حينذاك نتيجة انتشار وتأثير مدرسة المنار في العالم الإسلامي، رغم محاولات أعدائها العديدين الوقوف أمام هذا التأثير والانتشار.[14] ويرى المؤلف أن الشيخ رشيد رضا اتجه نحو السلفية قبل هجرته لمصر نتيجة الحالة السياسية والثقافية والدينية في عصره، ونشأته الدينية والتربوية والعلمية. وقد أثرت مدرسة العروة الوثقى في نقله من مرحلة التصوف إلى الدعوة السلفية عامة ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خاصة. ويبرز المؤلف تأثر الشيخ رشيد رضا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آثاره الفكرية، لاسيما مجلة المنار وتفسير المنار. كما بحث في جهود الشيخ رشيد رضا للإصلاح الإسلامي من خلال الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وإنشاء مدرسة الدعوة والإرشاد ودوره في إصلاح نظام التربية والتعليم في الأزهر والقضاء على البدع والخرافات والتقليد الأعمى فيه، فضلًا عن دوره الإصلاحي السياسي ومواقفه من الدولة العثمانية والشريف حسين والدولة السعودية والاستعمار الأوروبي والصهيونية. ورغم فوائد الكتاب، إلا أن أن التزام المؤلف بالدعوة الوهابية دفعه أحيانًا للتحامل في أحكامه وتعميماته.
ولتحقيق الشمول في التعامل مع فكر الشيخ وحركته الإصلاحية، صدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي كتاب عن الجهود الإصلاحية للشيخ رشيد رضا ومنهجه العلمي، شارك فيه اثنا عشر مؤلفًا تناولوا جوانب متعددة من فكر الشيخ وجهوده منها ما يتعلق بتفسيره للقرآن الكريم ومواقفه من النقل والعقل كمصادر للمعرفة ومواقفه من التيارات الفكرية في عصره والإصلاح والتجديد السياسيين وعلاقة المسلمين من الغرب.[15] ولعل اهتمام هذا العدد من الباحثين بفكر الشيخ وجهوده يؤكد ما لهذا الفكر الإصلاحي من فوائد كبيرة في القرن الخامس عشر الهجري، وهو ما يتضح في المبحث التالي.
* دراسة نشرت في مجلة ركائز معرفية، ديسمبر 2014، ص 1-32.
** أستاذ زائر وباحث أول، قسم الدراسات السياسية والدولية، جامعة رودس، جنوب أفريقيا.
[1] انظر أمثلة على ذلك في: أحمد عمر هاشم، الإمام محمد عبده مجددًا
http://www.islamonline.net/arabic/In...icles/05.shtml
[2] لا يقل تأثر الشيخ رشيد رضا بالأفغاني عن تأثره بعبده، إن لم يزد عليه. انظر الحجج المؤيدة لهذا الرأي في: أحمد علي سالم، "الإصلاح السياسي عند محمد رشيد رضا بين بناء دولة إسلامية وإقامة جامعة إسلامية"، محمد رشيد رضا: جهوده الإصلاحية ومنهجه العلمي، تحرير: رائد جميل عكاشة (عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2007) 209-214.
[3] انظر على سبيل المثال غياب اسم الشيخ رشيد رضا في: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث (بيروت: المكتبة العصرية، 2007)؛ عبد المجيد النجار، مشاريع الإشهاد الحضاري (بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، 2006). وانظر تحليلًا لهذه الظاهرة في: زكي الميلاد، "الشيخ محمد رشيد رضا وتحولات الفكر الإسلامي المعاصر"، محمد رشيد رضا: جهوده الإصلاحية ومنهجه العلمي، تحرير: رائد جميل عكاشة (عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2007) 138-142.
[4] إبراهيم أحمد العدوي، رشيد رضا الإمام المجاهد (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر والدار المصرية للتأليف والترجمة، سلسلة أعلام العرب رقم 33، د.ت.)
[5] أحمد الشرباصي، رشيد رضا: الأديب الكاتب الإسلامي (القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية، 1976).
[6] مجـــلة المنـــار (القاهرة: مطبعة المنار، 1898-1940).
[7] شكيب أرسلان، لماذا تأخر السلمون ولماذا تقدم غيرهم (القاهرة: دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع، 1985).
[8] كوسوجي ياسوشي ويوسف حسين إيبش ويوسف قزما خوري، فهرس مجلة المنار (1898-1935) (بيروت: تراث؛ طوكيو: مشروع دراسات الحضارة الإسلامية، 1998).
[9] أنور الجندي، تاريخ الصحافة الإسلامية، الجزء الأول: المنار – محمد رشيد رضا (القاهرة: دار الأنصار، 1983).
[10] سمير أبو حمدان، الشيخ رشيد رضا والخطاب الإسلامي المعتدل (بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1992).
[11] محمد صالح المراكشي، تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار (1898-1935) (تونس: الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1985).
[12] أحمد فهد بركات الشوابكة، محمد رشيد رضا ودوره في الحياة الفكرية والسياسية (عمان: دار عمار للنشر والتوزيع، 1989).
[13] Assad Nimer Busool, Sheikh Muhammad Rashid Rida's Political Activities: A Struggle for the Revival of an Orthodox (Salafi) Islamic State, Ph.D. Dissertation in Near Eastern Studies in the Graduate Division of the University of California, Berkeley, 1974.
[14] محمد بن عبد الله السلمان، رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الكويت: مكتبة المعلا، 1988).
[15] محمد رشيد رضا: جهوده الإصلاحية ومنهجه العلمي، تحرير: رائد جميل عكاشة (عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2007).