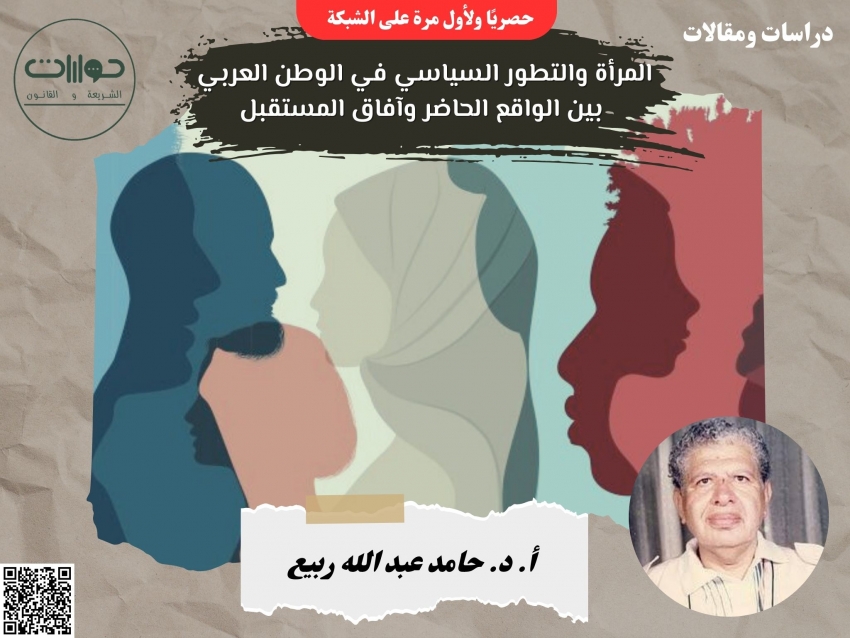المرأة والتطور السياسي في الوطن العربي بين الواقع الحاضر وآفاق المستقبل*
1 - التعريف بظاهرة التطور السياسي وموضع المرأة من العملية السياسية:
العالم العربي يعيش أزمة تطور سياسي، وهي أزمة متعددة الأبعاد، وليس مرد ذلك فقط إلى تعدد المشاكل التي يواجهها ذلك المجتمع وكيف أثبتت خلال فترة الثلاثين عامًا الماضية عدم قدرته على مواجهتها وتخطيها، الأمر الذي ترتب عليه تراكمات متنوعة، ولكن لأن هذا المجتمع أثبت أنه لا يزال لم يخلق بعد أداة التغيير القادرة على الإمساك بتلابيب التطور وقيادة عملية التغيير بأي معنى من معانيه. في مثل هذا الواقع لا بد من طرح التساؤل: ما هي المتغيرات الأصلية المتحكمة أو التي يجب أن تتحكم في عملية التطور خلال الأعوام القادمة؟
قبل أن تحاول الإجابة عن هذا التساؤل وعلى وجه التحديد إبراز موضع المرأة من هذا التطور المتوقع علينا أن نبين بعض الملاحظات:
أول ما يجب أن نتذكره أن كل واقع سياسي يملك منطقه. لقد تعود علماء الاجتماع بصفة عامة وببلاهة مؤلمة أن ينقلوا عن الخبرات الأخرى والمناهج الأخرى قوالب مصطنعة للإدراك وللتصور ويفرضوا على واقعنا أن يتشكل بتلك المناهج أو بتلك الخبرات. علينا أن نتذكر كيف أن كل خبرة تملك مذاقها الخاص بها. ومهما فرضت عملية التنظير مستلزماتها فإن ذلك المذاق يظل دائمًا يحمل الرحيق الذي يميز ويرفض التشبه. بطبيعة الحال هناك عناصر تخلق التقارب ولكن علينا ان نفهم أن ذلك التقارب ينطلق من نسبة معينة لا يمكن أن تلغي خصوصية كل ذاتية. كذلك فإن الواقع العربي يملك ذلك التميز الذي علينا ان نكتشفه، لا فقط بمعنى ابراز متغيراته وموضع كل من تلك المتغيرات، بل وكذلك وزن كل منها من حيث كونها متغيرًا أصيلًا أم تابعًا متحكم في التطور أو هو نتيجة للتطور.
ولعل أحد مظاهر التعبير عن هذه الذاتية مفهوم التخلف. لقد درجنا على أن نصف المجتمع العربي بأنه ينتمي إلى عالم المجتمعات النامية أو المتخلفة، ببساطة ودون أي تحديد أو تخصيص. وقد تصدّينا منذ عدة أعوام لمفهومين كلاهما أثار الكثير من الفوضى الفكرية في تقاليدنا العلمية؛ أولهما مفهوم "العالم الثالث"، وثانيهما مفهوم "التخلف السياسي". وقد استطعنا أن نثبت، من منطلق نظرية القيم، أن مفهوم العالم الثالث يرتبط برفض سيادة قيم العالم الغربي الكاثوليكي من جانب، وقيم الشيوعية الأوروبية من جانب آخر. ومن ثم فإن مفهوم العالم الثالث يقتصر على أغلب دول أفريقيا وآسيا. كذلك فإن مفهوم التخلف السياسي لا وجود له كمفهوم علمي؛ فهناك بُعد سياسي للتخلف الاقتصادي، ولكن الحديث عن تخلف سياسي لغوٌ لا معنى له. وهناك مجال للحديث عن الإصلاح السياسي بمعنى خلق التناسق بين الجسد الاجتماعي في خصائصه والواقع السياسي في تطوّره، بحيث يستطيع النظام السياسي استيعاب القوى الاجتماعية الجديدة دون عنف ودون اضطراب، ومن ثم دون اختلال، في درجة معينة من الاستقرار السياسي. وليس هناك نظام سياسي معين يمثل المثالية، ولكن المثالية تكون في أن ذلك النظام أصلح لذلك الواقع من عدمه. الفاعلية، من حيث التجاوب أو عدمه، هي وحدها محور المثالية.
الملاحظة الثانية التي يجب أن نطرحها منذ البداية تدور حول طبيعة التطور السياسي. الملاحظة السابقة تسمح بتعريف معنى التطور السياسي: هو التفاعل الذاتي الذي قد يترتب على الصدام المستمر، ولكنه دائمًا مرتبط بحقيقة التغير الاجتماعي والاقتصادي وما يتفرع عنه ويفرضه من تنقلات متتالية من وضع إلى وضع آخر، تعبيرًا عن قانون التوالد الذي هو طبيعة الوجود البشري.
هذا التعريف، برغم عموميته، يسمح بتحديد بعض الخصائص:
(أولًا) التطور قد يُفهم بمعنى التفاعل الديناميكي، ولكن قد يُفهم أيضًا بمعنى التنقل المرحلي. التفاعل الديناميكي هو التأثير والتأثر، أي علاقة الشد والجذب بالتأثير المتبادل بين عناصر الوجود السياسي. أما التنقل المرحلي فيعني الانتقال من وضع إلى وضع آخر، أو من صورة إلى صورة، أي من نظام إلى نظام. بهذا المعنى نستطيع أن نسوق نظرية الدساتير عند أفلاطون والتنقل من حكم الفرد إلى حكم الأقلية، ثم إلى حكم الجماعة. كذلك نستطيع أن نضيف فلسفة ابن خلدون وكيف يحدد إطارًا للمجتمع السياسي يبدأ من الطفولة وينتهي بالشيخوخة.
في هذا المفهوم للتطور كتنقل مرحلي نلمس بوضوح عوامل ثلاثة أساسية تكون الحلقة الفكرية لمفهوم التطور: من جانب عنصر الزمان، ثم من جانب آخر عنصر التتابع، ومن جانب ثالث عنصر الاستقلال الشكلي أو الهيكلي لكل من تلك النماذج المتتابعة.
أما التطور بمعنى التفاعل الديناميكي فيقدّم لنا إطارًا مختلفًا، حيث يُلغي عنصر الزمان، وتصير العملية السياسية تأثيرًا وتأثرًا بين المتغيرات، بمعنى الصدام والتعانق بين مختلف مقومات الوجود السياسي في موقف محدد وإزاء ذلك الموقف بقصد تصفيته والتخلص منه. وهكذا، فالتطور السياسي بهذا المعنى يفترض عناصر أخرى: موقفًا قد تحدد مكانًا وزمانًا، ثم مشكلة فرضت وجودها على ذلك الموقف، وأخيرًا سعيًا للتخلص من ذلك الموقف.
وبرغم ذلك، فالعلاقة بين التفاعل الديناميكي والتنقل المرحلي قائمة، لأن الأول لا بد أن يقود أو يفرض الثاني[1].
(ثانيًا) علينا، في كلا التطبيقين، أن نُميِّز بين عملية التطور ذاتها، أي تلك العملية السياسية التي تقود إلى ذلك التفاعل الذاتي وتفرضه، وأدوات التطور، أي تلك المركبات أو الوسائل التي تُجسِّد القوى الاجتماعية وتحمل على عاتقها تحقيق عملية التطور. وإذا كانت عملية التطور قد تتشابه من حيث جوهرها، فإنها تختلف في معظم الأحيان من حيث أدواتها، أو على الأقل فإن تمايزها يغدو أكثر وضوحًا ودلالتها أكثر بروزًا من خلال أدوات ذلك التطور.
(ثالثًا) ومن باب الإضافة، ينبغي التنبيه إلى أن التطور السياسي مستقل عن التطور الاجتماعي؛ فليس كل تطور اجتماعي بالضرورة يفرض تطورًا سياسيًا، ولا كل تطور سياسي يستلزم تطورًا اجتماعيًا. هناك علاقة بينهما، لكنها لا ترقى إلى مرتبة الحتمية أو اللزوم. فالتطور السياسي أوسع نطاقًا وأشد تقييدًا من التطور الاجتماعي، بينما الأخير أعمق وأشد تفصيلًا من التطور السياسي. ومع ذلك، ففي معظم الأحيان تقوم بينهما علاقة تأثير وتأثر، إذ إن أي تطور في أحد الجانبين لا بد أن يقابله رد فعل في الجانب الآخر. وينسحب الأمر نفسه على العلاقة بين التطور السياسي وتطور الشخصية الفردية في إطار المجتمع الكلي. والسبب في ذلك أن التطور السياسي حقيقة ميكروكوزمية، والتطور الاجتماعي وكذلك تطور الشخصية الفردية جميعها تطورات ميكروكوزمية تندرج، بشكل أو بآخر، في الإطار الماكروكوزمي.
أما الملاحظة الأخيرة، المرتبطة بموضع المرأة في التطور السياسي، فإنها تثير إشكالية أوسع، وهي دور المرأة بصفة عامة في ديناميات الوجود السياسي؛ موضوع أثار العديد من التساؤلات وطرح كثيرًا من الإجابات. غير أن الواقع يكشف أن الإجابة المقنعة تنبع من قناعة واحدة: لقد ظلت المرأة، عبر التاريخ البشري، عنصرًا سلبيًا، ومن ثم لم تمثل -سوى في تطبيقات محدودة- أحد عناصر ديناميات التطور. ولسنا هنا بصدد الخوض في الأسباب، لكن المؤكد أنه متى قُدِّر للمرأة أن تخرج من هذه السلبية فإنها فرضت نفسها كمتغير أساسي في عمليات التفاعل السياسي.
النماذج في التاريخ القديم قليلة، لكنها في التاريخ المعاصر أوضح وأكثر حضورًا ولا تحتاج إلى كثير برهان. وسواء كان مرد ذلك الاعتراف للمرأة بدور قيادي داخل الأسرة، أو الظروف التي مكنتها من ذلك بفعل الشلل الذي أصاب متغيرات التطور الأخرى، فإن النتيجة التي يجب التسليم بها هي أن المرأة قادت في بعض النماذج التاريخية عملية التطور السياسي، أو على الأقل أسهمت في فرض وجودها على متغيرات هذا التطور.
2- التطور السياسي في الوطن العربي ومتغيراته:
طرحنا في موضع آخر متغيرات التطور السياسي في الوطن العربي خلال الأعوام القادمة، وحصرنا في المتغيرات الخمس التالية مسالك وأدوات التطور من منطلق الواقع الداخلي:
(أولًا) القيادة.
(ثانيًا) المرأة.
(ثالثًا) عنصر الشباب.
(رابعًا) عنصر التعليم.
(خامسًا) المفاهيم الديمقراطية.
كل من هذه المتغيرات له موقعه من عملية التطور السياسي، وكل منها لا يستطيع -رغم ذلك- أن يمارس تأثيره منعزلًا عن المتغيرات الأخرى.
أول هذه العناصر وأخطرها من حيث وضوح نتائجها هو عنصر القيادة. والقيادة يجب أن تُفهم بأوسع معانيها، لا فقط كحكم وتوجيه، بل وكذلك كإدراك وإدارة وتكتيل للقدرات، وكمسالك لخلق الترابط بين الحاكم والمحكوم.
عنصر الشباب بدوره سوف يُقدَّر له أن يتحكم كمتغير أساس في تطور الوطن العربي. والسبب في ذلك يعود إلى التضخم الكمي الرهيب الذي سوف يعاصره هذا المجتمع في عنصر الشباب في الأعوام القادمة. خلال فترة الخمسة عشر عامًا التي تفصلنا عن نهاية القرن يتوقع الخبراء أن أكثر من ٥٠٪ من عدد سكان الوطن العربي سوف يكونون دون العشرين، وهذا يعني نتائج عديدة: من جانب اختلال الهرم الديموغرافي، ومن جانب آخر إمكانية الاشتغال في المجتمع بسرعة، وخصوصًا مع تضخم المدن الكبرى. والمتوقع أن أكثر من عشرين مدينة سوف يضم كل منها أكثر من عشرة ملايين نسمة. هذا التطور في دلالته الحقيقية يعني فرض عدم الاستقرار السياسي على المنطقة، أو في الأقل فإن احتمالاته سوف تكون قوية.
التخلص من نظام التعليم الحالي هو تغيير آخر يأتي فيكمل هذا الإطار العام. إنه التحدي الحقيقي الذي يجب على الأمة العربية أن تُعدّ نفسها لمواجهته. النظام الحالي، والذي فرضته مرحلة الاستعمار الطويل والتدهور المرتبط والسابق عليه، أساسه التلقين. نحن في حاجة إلى نظام جديد ينبع من واقعنا ولكنه يعمل على تنمية المدارك وخلق إطار يُهيّئ للشخصية الفردية أن تحقق إيقاعها الكامل. هذا التطور هو المقدمة الحقيقية لخلق المواطن الإيجابي صاحب الفاعلية في جميع أنواع الممارسات اليومية.
ويأتي يكمل ذلك التطور الديمقراطي. المفهوم الديمقراطي هو لغة العصر. ولو تركنا جانبًا الصياغات الفلسفية المعقدة، وتعاملنا مع هذه الظاهرة بلغة الواقع اليومي، لوجدناها تدور وتتمركز حول ثلاث حقائق: الأولى احترام كرامة الفرد، والثانية التسليم بحق المواطن في المشاركة السياسية، والثالثة تعزيز مسؤولية من يتولى السلطة. العنصر الأول هو المحور الحقيقي ونقطة البداية في الواقع العربي: هناك حد أدنى للكرامة الفردية يجب احترامه وتقديسه من جانب النظام السياسي. حق المشاركة السياسية بمعنى أن أي قرار على مستوى معين من الأهمية لا يملك فرد واحد أن يتخذه، ولا بد أن يكون حصيلة تفاعل بين القوى بشكل أو بآخر. ثم المسؤولية بجميع معانيها: كل ممارسة للسلطة تملك وجهين، حقوق من جانب والتزامات من جانب آخر.
المرأة ووظيفتها في المجتمع تُكمل هذا الإطار[2]. التسليم بحقوقٍ معينة للمرأة، الأمر الذي يتيح لها أن تؤدي دورًا أكثر فاعلية وقدرة على إثبات الذات، هو محور هذا التطور. بل إن المرأة لن تُمنَح هذه الحقوق فحسب، بل ستنتزعها وتفرض ذاتها ووظيفتها الإيجابية.
وقبل أن نحلل عناصر هذه الوظيفة ونتابع هذا التطور، ينبغي أن نتذكر وجود علاقة وثيقة بين جميع المتغيرات:
أ- عنصر القيادة سيفتح بابًا واسعًا أمام القيادات النسائية لتتصدّر عجلة التطور السياسي.
ب- عنصر الشباب سيجعل التعامل مع المرأة أكثر سلاسة وفاعلية، إذ إن الشباب بطبيعته أكثر تقبلًا للتجديد.
ج- كذلك فإن نظام التعليم، وفتح أبوابه على مصراعيه أمام العنصر النسائي، سيعزز من هذه الحقيقة. لا سيما أن الظاهرة التي سادت العالم المعاصر ستسود بدورها المجتمع العربي، وهي من جهة إقبال المرأة على التعليم العالي بجميع مجالاته، ومن جهة أخرى تفوقها الملحوظ على الرجل في معظم المراحل التعليمية، إن لم يكن في جميعها.
وليس هذا مقام تحليل هذه الظاهرة؛ هل مردّها النضج المبكر للفتاة؟ أم أن تضييق الحرية الاجتماعية عليها يجعلها تركز جهودها في مجال دراستها؟ على أي حال، فهي ظاهرة عالمية راسخة.
أما التطور الديمقراطي فقد دفع بهذا المسار دفعات قوية، سواء من خلال الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة، أو من خلال توجه القيادات الحزبية إلى استقطابها كقوة ناخبة ذات وزن عددي معتبر. والنماذج في هذا المجال واضحة في المجتمعات المتقدمة، ولا يوجد ما يمنع من توقّع تكرارها في المجتمعات العربية.
3- الواقع العربي وفاعلية المرأة في نماذج التعامل السياسي:
بقي السؤال الجوهري: أين موضع المرأة من التطور السياسي في الوطن العربي؟ الإجابة على هذا السؤال في حاجة إلى تحليل من منطلقين كلاهما يُكمِل الآخر: أحدهما مقارن ميداني، وثانيهما مستقبلي تاريخي. الأول يسمح بتحديد مختلف النماذج التي يعبِّر عنها الواقع العربي من حيث تحديد وظيفة المرأة في المجتمع العربي المعاصر، والثاني يحدد خصائص هذا التطور خلال العشرين عامًا الماضية، ويمد عناصر هذا التطور نحو المستقبل.
مما لا شك فيه أن الفصل بين تطور المرأة نحو اكتساب حقوقها في مجتمع سادته خلال قرون عديدة نظرة متميزة ضد المرأة من جانب، وتطور المرأة كعضو في المجتمع من جانب آخر، بمعنى الفصل بين التحرر الذاتي للمرأة والتحرر القومي للمواطن العربي، أمر قد يبدو طبيعيًا، إلا أن هذا يعكس نقصًا في الإدراك بحقيقة التطور. إن متابعة مجموعة معينة من الأحداث تثبت أن المرأة في كثير من الأحيان نسيت قضيتها الذاتية لتؤكد قضيتها القومية. على أنه من حيث الواقع فإن كلا القضيتين مترابطتان: فلا يمكن تصوّر مواطنة حرة في مجتمع من العبيد، ولا يمكن تقبّل مجتمع حر ونصفه طبقة من المحرومين من حقوقهم السياسية. الحرية حقيقة واحدة ومسالكها متعددة، وقنواتها لا حصر لها، وهي تكاد تذكرنا بالأواني المستطرقة حيث كل بُعد منها يقود إلى الأبعاد الأخرى.
أهم ما يعنينا بهذا الخصوص ويؤكد عليه هو أن المجتمع العربي قد فقد أدوات التطور التقليدية. هذه الأدوات، والتي تنبع أساسًا من الرجل الناضج القادر على أن يحمل راية الثورة ويفرض على الأحداث رؤيته، قد تقلصت. قد يُسمى هذا الرجل بالطبقة المثقفة، وقد يوصف بأنه الطبقة العاملة، وقد يُحدَّد بأنه الطبقة الوسطى الصناعية. لا يعنينا موقعه، ولكنه يعكس فئة معينة تتولى قيادة التطور والتصدي لمخاطره. الذي حدث في المجتمع العربي المعاصر هو أن هذه الطبقة أو الفئة قد أصابها التيبّس، حتى الجيش قد تقوقع حول مصالحه الفئوية. لم تعد هذه الطبقات أو الفئات الذكورية قادرة على حمل راية التطور. والتطور حقيقة أزلية، وهو لا بد وأن يخلق أدواته، ومن ثم كان من الطبيعي أن تتقدم المرأة لتحمل راية هذا التطور. قد يبدو ذلك غير واضح، ولكن الدراسة العميقة تُبرزه لنا ملموسًا فاعلًا. ومن الطبيعي، والمرأة إمكانياتها محدودة وقدراتها نسبية، والمجتمع يأبى عليها -أو لا يزال يأبى عليها- إلا ذلك، فإن التطور لا بد وأن يعكس هذا الواقع. التطور الذي يعيشه المجتمع العربي تطور "مخنَّث"، لأنه يعكس ذلك الواقع بكل نقائصه، ومحوره اختفاء الرجولة السياسية في دفع عجلة النهضة نحو الأمام.
مما لا شك فيه أن هذا الواقع يملك قيوده وخصائصه:
أ- فهو واضح في مجتمعات الهجرة الكثيفة، وهي أغلب المجتمعات الشابة ذات الكثافة السكانية: مصر والجزائر والمغرب تقدم بهذا الخصوص نماذج واضحة. في هذه المجتمعات، وكنتيجة طبيعية لهجرة الزوج ورب الأسرة بحثًا عن لقمة العيش في أرض الذهب الأسود وترك الأسرة في الموطن الأصيل، تقودها المرأة وتتحمل مسؤوليتها من حيث الإشراف الواقعي، إذ أضحت المرأة هي ربة الأسرة والمسؤولة عنها، ومن ثم تبلورت ظاهرة "تأنيث الأسرة" التي كان لا بد وأن تعكس نتائجها في الواقع السياسي. ورغم أهمية هذا المتغير إلا أن علينا أن نضيف إليه متغيرات أخرى جديدة جانبية كان لها وزنها الخطير في هذا التطور العام الذي لا نزال نعيش أوائل نتائجه:
(أولًا) اهتزاز الصورة التقليدية للرجل الشرقي. إن الهزائم المتتالية، وما ارتبط بها من إذلال حقيقي للرجل في جميع النظم السياسية للبلاد العربية، أثبتت أن الرجل العربي لم يعد قادرًا على أن يدافع عن حقوقه. والحقوق السياسية تُنتزع ولا تُوهب، وتُفرض ولا تُمنح. لقد برز على حقيقته في الواقع المعاصر: جبان أمام القوى، غير قادر على أن يمارس سطوته إلا أمام الضعيف. فهل هذه هي الرجولة؟ وهل هذه هي صفات الرجولة والشهامة التي عرفناها عن الرجل العربي في تاريخه الطويل من الأنفة والكبرياء؟ اهتزاز هذه الصورة كان لا بد وأن يفرض ثورة على هذا الواقع، وهي ثورة حاقدة قادتها المرأة المتعلمة والمثقفة.
(ثانيًا) الأحداث بدورها ساهمت بدرجات مختلفة في هذا التطور. لقد وجد الرجل العربي نفسه مضطرًا لأن يعتمد على المرأة في مواقف تعوّد ألّا يعتمد فيها إلا على نفسه، وهي مواقف أثبتت قدرة المرأة على المخاطرة بالذات وتحمل مسؤولية الرفض العنيف. برز ذلك واضحًا في ثورة الجزائر ثم في أحداث مصر العديدة، ورغم أنها لم تكن سوى تعبير عن رفض داخلي، بل ووصل ذلك التطور إلى أبعاد أخرى، وهي ظاهرة تتكرر أمام أعيننا كل يوم في أحداث لبنان، ومُتوقَّع قبل ذلك باسم الثورة الفلسطينية. إنها الطليعة الثورية القادمة، التي لا نزال غير واعين بمدى عمقها وتغلغلها في أعماق التطور السياسي في الوطن العربي.
(ثالثًا) ولا يجوز لنا أن ننسى كيف أن نظام القيم التقليدية قد اهتز لدى المرأة بطريقة أكثر عنفًا مما حدث لدى الرجل، بل ويمكن القول دون مبالغة إن اهتزازًا حقيقيًا لنظام القيم التقليدية لدى الرجل لم يحدث بعد، ولكنه لدى المرأة قد حدث وفي صميم وجدانها. ليس فقط بمعنى أنها رأت الرجل على حقيقته وهو يتصف بالجبن والأنانية وتصنّع الشهامة التي لا يملكها، بل لأنه أثبت في الحياة العملية -وبنماذج واضحة تتكرر أمام المرأة في كل لحظة يقدَّر فيها الاحتكاك الحقيقي بالمجتمع- أنه لم يعد يملك أي قيم حقيقية. إنه كذاب، منافق، وصولي، على استعداد لأن يبيع كل شيء في سبيل أتفه المكتسبات. وعلينا أن نتذكر أن الاحترام هيبة يفرضها السلوك، ومتى اختفت الهيبة اختفى الاحترام، أو على الأقل بُذرت حوله عناصر الشك.
ورغم أن المرأة في غالبيتها العظمى غير متعلمة، إلا أنها تملك القدرة على التقييم. وليس عليها سوى أن تعود إلى نظام القيم الذي عاشت وتربّت عليه لتحكم على هذا الرجل الذي يتعين عليها احترامه أبًا كان أم زوجًا، فتكتشف أنه قد فرض عليها احترام أشخاص لا يملكون العناصر الأساسية اللازمة لفرض الاحترام. وأقل ما يمكن أن يقود إليه مثل هذا الواقع تمزقه بين الحب والاحترام، بين العطف والتقدير، وهو تمزق لا بد وأن يقود إلى ثورة على هذا الواقع أو رفض له ولو بأساليب ملتوية.
(رابعًا) مستلزمات الحياة المادية تضيف بُعدًا آخر إلى هذا الاضطراب النفسي الذي تعيشه المرأة. فالرجل كثيرًا ما يضطر إلى الاعتماد على المرأة في تسيير حياته الأسرية، وهو بهذا لا يقتصر على أن يعلن عدم قدرته على تحمل مسؤولياته التقليدية بما يعنيه من ضرورة إعادة تشكيل نظام القيم التقليدية، بل يُسلم كذلك بتبعيته -من حيث الواقع- للمرأة، وهي بذكائها وفطرتها قادرة على أن تفهم ذلك. وللمرأة ميول واقعية، وهي لذلك لا بد وأن تستغل هذا الواقع بأساليب متعددة ومتنوعة.
ب- في دول الذهب الأسود -أي الدول البترولية- أحدثت الظاهرة آثارها بطريقة أخرى ومن خلال نموذج مختلف من حيث التطور الاجتماعي. ومما لا شك فيه أن المعلومات التي نملكها عن المرأة وواقعها الاجتماعي في الدول البترولية، ورغم كثرة ما تم من أبحاث بهذا الخصوص، محدودة، لا تُشبع ولا يمكن الاعتماد عليها. الثروة الفجائية -والتي بلا حساب- أدت رغم ذلك إلى نتائج بعيدة المدى تكاد أن تنتهي بأن تتفق مع تلك النتائج التي سبق أن لمسناها في الواقع العربي بالنسبة للدول العُمالية، ولو في الأمد البعيد، والتي تنبع من محور أساس وهو فقد الرجل لوظيفته القيادية، وبدء عملية إحلال نحو تسلّل المرأة للمساهمة المباشرة في عملية التأثير والتوجيه لعملية التطور السياسي.
الرجل الخليجي الذي يعيش في رفاهية مطلقة مصطنعة، والذي يُذكّرنا بغنى الحرب، وقد سقطت عليه القدرة الاقتصادية والوفرة المالية والنقدية دون أي جهد حقيقي، يعيش -من حيث الواقع- في ملذاته بعيدًا عن زوجته ولو بشكل نسبي. ومن ثم فهو لا بد وأن يتنازل عن جزء من امتيازاته إزاء صمتها، وهي لا بد وأن تحتقره في صمت حتى ولو لم تشاركه في بعض خصائص سلوكياته. نظام القيم التقليدية لا بد وأن يصيبه إخلال في جميع مقوماته: أول مظاهر هذا الاختلال فقد الزوج لسيطرته الحقيقية على الزوجة، ويبرز ذلك واضحًا عندما يُقدَّر لتلك الزوجة أن ترحل بعيدًا عن وطنها في فترات الصيف أو الاستجمام.
هذا التحلل الداخلي في العلاقة الزوجية منح المرأة قدرة -من حيث لا تتوقع- على التحدي والتصدي. وقد ارتبط ذلك بالنسبة للجيل الجديد برغبة وإرادة واضحتين في التعليم والتعلم، وهي رغبة تختلف -من حيث عمقها- عن الشاب الخليجي الذي يدخل الجامعة ويخرج منها وهو على نفس المستوى من النقص الفكري والإدراكي. جميع هذه الحقائق التي يلمسها الجميع ويتغاضى عنها الجميع كان لا بد وأن تقود إلى اهتزاز خفي في العلاقة بين الرجل والمرأة لصالح هذه الأخيرة ولو بطريقة غير واضحة[3].
ومن الطبيعي أن هذا التطور لم تبرز بعد نتائجه، فهو لا يزال في بدايته، وهو لا يُحدث آثاره إلا في دائرة ضيقة، لأن هذه التقلبات ترتبط بشريحة محدودة من المجتمع الكلي. وهو يحدث في مجتمع جامد لم يخضع بعد لهزات عنيفة تتيح لهذه القوى الباطنة أن تبرز على السطح. ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن المرأة لم تعد تقف من الرجل موقف التبعية المطلقة التي عوّدَتنا عليها التقاليد السابقة وحتى وقت قريب.
ج - والخلاصة أنه علينا أن نعترف بأن صورة الرجل التقليدية في المجتمع العربي قد اهتزت وهذا الاهتزاز قد ارتبطت به إرادة ثابتة من المرأة في اكتساب وضع معين في داخل المجتمع يعكس حقوقًا ثابتة ووضعًا اجتماعيًا معينًا ووظائف جديدة. هذا التطور ساهمت فيه أيضًا متغيرات عديدة:
(أولًا) التطور العام الذي تعيشه الانسانية من تحرير الإنسان أيا كانت صورة التحرير: العبد إزاء السيد، والعامل إزاء مالك أدوات الإنتاج، ثم المرأة في مواجهة الرجل. ولا يستطيع المجتمع العربي أن يعيش بمعزل عن التطور الذي يسود الأسرة الدولية.
(ثانيا) تخلي الرجل الشرقي عن التزاماته داخل الأسرة وما تفرضه من تضحيات ونظرته إلى المرأة على أنها أداة مشاركة تسمح له بتحقيق قسط معين من: الالتزامات. وليست هناك التزامات دون حقوق.
(ثالثًا) انتشار أدوات الاعلام الجماهيري ودخولها في كل منزل وفي كل بيئة دون أن تترك القرية أو الصحراء بما في ذلك الأدوات الاتصالية التي تتضمن قسطًا من الإباحية. إن الحديث عن حقوق جنسية للمرأة وتقديم أفلام أضحت منتشرة في أقصى القرية الريفية بفضل الفيديو كان لا بد من أن توقظ في المرأة أحاسيس معينة. وهي جميعها تعني نوعًا من المساواة بين الرجل والمرأة أو في الأقل التطلع إلى الرجل بقسط من عدم الخوف والرهبة الذي تعودته المرأة.
(رابعًا) تملق الحكام وبصفة خاصة في المجتمعات التي قبلت المفهوم الديمقراطي فصوت المرأة يمثل كما مهمًا، وجميع النظم الثورية خاطبت الشباب بلغة مختلفة بما في ذلك النساء وهو أمر كان لا بد وأن يحدث نتائجه في الأمد البعيد.
وقد برز ذلك أيضا في تشريعات مبالغة في التملق للمرأة كما حدث بخصوص حق المرأة في طلب الانفصال عن زوجها في حالة الزواج من امرأة اخرى وبالرغم من أن هذا أمر مستقل عن موضوع فاعلية المرأة في التطور السياسي إلا أنه يملك دلالته الواضحة[4].
4- التطورات المستقبلية والنتائج المتوقعة: افتراضات وتوقعات:
السؤال الذي لا بد أن يطرحه مثل هذا التطور، وهو المرتبط بتدخل المرأة بطريقة مباشرة في عملية التطور السياسي[5]، يدور حول الاستفهام التالي: ما نتائج مثل ذلك المتغير على خصائص التطور المتوقع في الوطن العربي؟
نستطيع أن نميز بين ستة نتائج، بغض النظر عن موضع كل منها من مراحل التطور المستقبلي:
(أولًا) الاعتدال في التطور.
(ثانيًا) برجوازية التطور.
(ثالثًا) التمويه في السلوك السياسي.
(رابعًا) بروز الدور السياسي في القيادة القومية للمرأة.
(خامسًا) انتهاء أو تقلص النظم الدكتاتورية.
(سادسًا) إعادة بناء التراث الفقهي الإسلامي.
المرأة بطبيعتها تميل إلى عدم التطرف، وازدياد موقع المرأة من الفاعلية في التطور السياسي لا بد أن يفرض زيادة في الاعتدال. والمرأة واقعية بطبيعتها، تفضل الحلول الوسطى وتسعى دائمًا إلى التوفيق، وهذا لا بد أن يبرز في التطور السياسي. وهي لذلك تميل إلى الحياة البرجوازية، أي حياة الرفاهية التي لا تعرف التضحيات ولا تقبل المغامرات، وبخاصة كلما ابتعدت عن سن الشباب. إنها لا تقبل المثاليات، وإنما تعيش نمط المصلحة في اعتدال، وهي لذلك بطبيعتها خُلِقَت لتنتمي إلى الطبقة البرجوازية، وهذا بدوره سوف يفرض وجوده على التطور السياسي.
التحدي الحقيقي، والأيديولوجية الثائرة، والسعي نحو تحطيم القائم بعنفوان الإيمان، ليست من خصائص المرأة. وتواجد المرأة في المجتمعات والتجمعات السياسية والنيابية سوف يقود إلى أن يفرض على الرجل الكثير من الحذر؛ فسوف يتأنق في ملبسه، وفي كلماته، وفي تعبيراته، ولن يصير مجاهدًا وإنما يصير رجل الصالونات. سيطرة المرأة على الحياة السياسية بدرجة أو بأخرى سوف ترفعها إلى مستوى القيادات القومية، وهذه سوف تقود إلى نتائج بعضها طيب، ولكن بعضها الآخر يمثل كارثة حقيقية. ومن حسنات هذا الواقع اختفاء النظم الدكتاتورية؛ إذ إن هذه النظم بمفهومها التقليدي تتعارض مع الاعتراف للمرأة بوظيفة سياسية مستقلة وحاسمة. ولكن، من جانب آخر، فإن هذا التطور لا بد أن يفرض إعادة كتابة الفقه الإسلامي بما يتضمن من أحكام لا تتفق مع مثل هذا الواقع الجديد.
فهل جميع هذه النتائج والتوقعات تنقلنا إلى عالم الخيال؟ ولكن، هل التنبؤ السياسي سوى نوع من الخيال؟
بقي أن نسجل ملاحظة أخيرة: علينا أن نؤكد أن فاعلية المرأة في التطور السياسي لا صلة لها بموضوع المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الاجتماعية، موضحين أن كُلًّا منهما يملك استقلاله الفكري بالرغم من التسليم بأن بينهما علاقة تأثير وتأثر.
(أ) فتعدد الزوجات هو مشكلة متعلقة بحقيقة النظرة إلى الأسرة وطبيعة تكوينها، وليست فقط مترتبة على علاقة الرجل بالمرأة. فهل الأسرة يجب ألا تتكون إلا من زوجة واحدة؟ أم من المقبول أن تتكون من عدة زوجات؟ ولا يعني هذا انتقاصًا من الحقوق السياسية للمرأة بأي معنى من المعاني، وإنما يعني فقط نظامًا اجتماعيًا معينًا. فمن الممكن أن يقتصر هذا النظام الاجتماعي على زوجة واحدة دون أن تملك هذه الزوجة أي حقوق سياسية مساوية للرجل، ومن الممكن أن تكون هناك عدة زوجات، ولكن مع وجود حقوق سياسية مساوية للرجل، بل ومع وجود حقوق اجتماعية تسمح بوضع ضمانات للزوجة الأولى في مواجهة الثانية، ولهذه في مواجهة الأولى[6].
(ب) كذلك فإن كون الرجل له ضعف حظ المرأة في الإرث لا يعني انتقاصًا من الحقوق أو تمييزًا أو إجحافًا بالمرأة، وإنما ينبع من الواقع الاجتماعي المرتبط بنظام الإرث. وكما أن الإرث يختلف تبعًا لمدى علاقة الوارث الدموية بمصدر الإرث، فكذلك يمكن أن يتصور تبعًا لجنس الوارث الذي يحدد حقوقه والتزاماته في المجتمع. إنه بُعد آخر لمبدأ التخصص في العمل داخل الواقع الاجتماعي.
هذه جميعها عناصر تنبع من تقاليد الموقع الاجتماعي، وهي مستقلة استقلالًا كاملًا عن البعد السياسي المتطور. ومما لا شك فيه أن القول بأن الرجل لا يملك أن تكون له أكثر من زوجة واحدة يسمح بتضخيم هيبة الزوجة، ومن ثم هيبة المرأة في مواجهة الرجل. كما أن المساواة المطلقة الكمية بين الرجل والمرأة في الإرث تضيف إلى تضخيم تلك الهيبة، وهو ما لا بد أن تكون له آثار سياسية من حيث علاقة المرأة بالرجل في المجتمع الكلي. ولكن هذا لا يعني أن هذه هي الأدوات الوحيدة لتحقيق هذا الهدف، كما أنه ليس بالضرورة ما يفرض فاعلية المرأة في التطور السياسي[7].
* حامد عبد الله ربيع، المرأة والتطور السياسي في الوطن العربي بين الواقع الحاضر وآفاق المستقبل، مجلة المرأة العربية، الاتحاد النسائي العربي العام، العدد الثاني، بغداد: 1985.
** الدكتور حامد عبد الله ربيع (1925–1989) مفكر وأكاديمي مصري بارز، يُعد من رواد الفكر السياسي والدراسات الإسرائيلية في العالم العربي. جمع بين التعمق في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بحصوله على خمس شهادات دكتوراه من جامعات أوروبية مرموقة، وتولى التدريس في جامعات مصرية وعربية وغربية. أسس مراكز بحثية وأكاديمية مهمة وأسهم في إدخال الدراسات الصهيونية إلى الجامعات المصرية. عُرف بتمسكه بالهوية الحضارية الإسلامية مع انفتاحه على دراسة الغرب نقديًا، وترك عشرات المؤلفات في الفكر السياسي، الأمن القومي، والصراع العربي الإسرائيلي. توفي في القاهرة عام 1989 في ظروف وُصفت بالغامضة.
[1] نحيل القارئ في ما يتعلق بالتعريفات إلى مؤلفاتنا في النظرية السياسية، وبصفة خاصة: حامد ربيع، نظرية التطور السياسي، محاضرات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1972.
[2] لا يزال علم الاجتماع العربي عاجزًا عن الارتقاء إلى مستوى التنظير؛ إذ يعيش على فتات العلم بمعناه الحقيقي ويكتفي بالشكليات. وفي بعض الأحيان تتحول وظيفته إلى دعائية، فإذا اجتمع الأمران كانت النتيجة كارثية. انظر نموذجًا لذلك في: سعد الدين إبراهيم، النظام الاجتماعي العربي الجديد، 1982، حيث لم يجد تعبيرًا عن هذا النظام الجديد بالنسبة للمرأة سوى ما أسماه «طالبة الطب المحجبة»، ص 39 وما بعدها.
[3] قارن حول الموضوع:
Farida Allaghi, Aisha Almana, Survey of Research on Women in the Arab Gulf Region, in Unesco, Women in the Arab World, 1984, pp. 14–40.
[4] قائمة المراجع حول المرأة والتغير السياسي يجدها الباحث كاملة في:
Aneo, Gli strumenti della ricerca, vol. II, Il Mondo Contemporaneo, tom. II, 1983, pp. 1464–1469.
[5] انظر حول التطور التاريخي لمكانة المرأة في الواقع العربي:
Naoual El-Saadaoui, La face cachée d’Eve, 1982, p. 22.
[6] قارن: حامد ربيع، سلوك المالك في تدبير الممالك، لابن أبي الربيع، الجزء الأول، القاهرة 1980، ص 59 وما بعدها.
[7] انظر: حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، 1984، ص 182 وما بعدها.